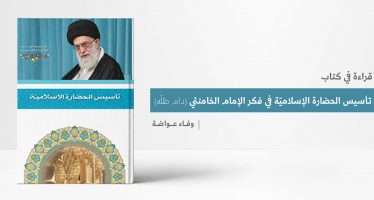تدريس الأديان في العالم

الكتاب: تجارب كونية في تدريس الأديان (محاضرات كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان).
الكاتب: إشراف وتقديم وتعريب محمد الحداد.
الناشر: مركز المسبار، دبي، 2014. في 372 صفحة.
ارتبطت الدعوات إلى الإصلاح في العالمين العربي والإسلامي عمومًا بالوقائع الكبيرة الحادثة في المجتمعات والدول، ولا تخرج المطالبة بإصلاح التعليم ولا سيّما الديني عن هذا الإطار. ومن التواريخ المعاصرة المشهودة ما جرى في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وما أعقب ذلك من أسئلة عن ثقافة أولئك الذين يكرهون الأميركيين. واندفعت مراكز البحث لتقصيّ البرامج والمناهج وطرائق التعليم الديني، وكيفية ضبط “درس الدين” وجعله سبيلًا للسلام والتعاون والحوار بين الشعوب.
وفي هذا السيّاق في العام 2003 صدر كتاب “كيف يُدرس الدين اليوم؟”، بشراكة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ومؤسسة كونراد أدناور في الدار البيضاء، بمشاركة عدد من الباحثين العرب والغربيين. وهي وقائع ندوة عرضت لتجارب وحالات محددة من التعليم الديني، وتناولت المضامين والمناهج الدراسية، والهدف كان: “المساهمة في تحقيق مقاربة علمية لإشكالية التعليم الديني/تعليم الدين بعيدًا من السجالات الأيديولوجية الآنية، وذلك من طريق تبادل الأفكار وتلاقح التجارب المختلفة في بعض مجتمعات حوض البحر المتوسط (…)، وذلك بأسلوب علمي نقدي مقارن ومتعدد الاختصاص، يسائل الأحكام المسبقة، ويفكّك الصور النمطيّة، ويتيح معرفة كونية تساهم في بناء السلم والتضامن”. كما دعت الجامعة الأميركية في بيروت العام 2012 إلى حلقة علمية أدارها تيودور هانف، الباحث الألماني المعروف، وشارك فيها نخبة من الباحثين العرب والأجانب حول واقع التعليم الديني الإسلامي في العالم.
ويأتي كتاب “تجارب كونية في تدريس الأديان” الذي وضع مقدمته تركي الدخيل، رئيس مركز المسبار، بحسب ما يقول، في إطار دراسة الأديان والممارسات الدينية وأنماط التعليم القائمة في البلدان العربية والإسلامية. ويُدرجه، محمد الحداد، المُعِد، في إطار عرض المعتقدات المختلفة تعزيزًا للحوار بين الأديان، وهو سبق ورآه في “قواعد التنوير” (2009) “شرطاً من شروط المعنى، وليس مجرد ترف فكري بين المثقفين”، في عالم التنوع والتعدد، وبروز الشأن الديني إلى السطح، وأهمية النظر إلى “التجربة الدينية” في كافة ألوانها. وقد سعت برامج إصلاح التعليم وراء الانفتاح واحترام التعددية، ولتشير إلى أهمية “التعايش بين الأديان والأقوام والشعوب”.
عالج الجزائري مصطفى الشريف “الأديان والتعارف المتبادل”، فشدّد على احترام الإسلام التنوع والتعدد بشهادة “صحيفة المدينة”، فدعا إلى إيجاد بديل من سرديتان تسودان العالم، واحدة تعتبر الدين عزاءًا (أو سلوى) وتراه الثانية استلابًا. ويجب الوصول، بحسبه، إلى حياة متجانسة وحضارة كونيّة تقوم على المعرفة المتبادلة. ويدافع محمد الحداد، الأستاذ في الجامعة التونسية، عن “ضرورة الدراسة المقارنة للأديان” ورفعها إلى مستوى المعرفة، وعد الدين وأنظمته جزءًا من النتاج الإنساني بما يحمله من دلالات ورموز، وفاعلًا في التاريخ والحوادث. ويدعو العرب إلى درس الظاهرة الدينية وتدريسها انطلاقًا من روافد ثلاثة: التراث القديم، ومقاربات القضايا الدينية في العلوم الاجتماعية، ومحاولة إقامة علم خاص بالظاهرة الدينية منذ أكثر من قرن، تأسيسًا على مسلّمات تعتبرها “ظاهرة إنسانية اجتماعية” تخضع للبحث العلمي فحسب من خلال الاستعانة بثمرات العلوم الإنسانية. ما يُحتِم، في رأي الحداد، التمييز بين “علم الأديان والعلوم الدينية”، حيث يمثل الأول معرفة كونية يعبر عنها بـ”الإنسانيات” مطلوب من العرب المساهمة فيها، في حين يُعبر الثاني عن التقاليد المتنوعة للأقوام.
عرض عبد الرزاق العيادي “تجربة ماجستير الدراسات المقارنة للأديان في تونس” الذي بدأ العمل فيه العام 2004، وقد أثار هذا القسم الجديد تساؤلات عدة من قبيل: كيف يُدرس الشأن الديني في كلية الآداب، وهو من نصيب رجال الدين ومؤسسسات التعليم التابعة لهم، وكيف يمكن التعامل مع نصوص تُعد “مقدسة”، وتدرس بأدوات علوم إنسانية مختلفة؟ ويرى العيادي إن تدريس الظاهرة الدينية في الجامعة على نحو منفتح وعقلاني يتيح التخفيف من حدة الصدام ويفتح الأذهان على “الآخر المختلف” ثقافيًّا ودينيًّا وأخلاقيًّا. وكتب محمد الصغير جنجار، الباحث المغربي في الأنثروبولوجيا، عن “إصلاح التعليم الديني في المغرب: الإنجازات والحدود”، فأقر بداية بوجود أزمة يعانيها هذا القطاع، من سماتها توزعه وتشتته ووجود أطراف كثيرة تبث المعرفة الدينية إلى جانب الدولة، التي أخذت على عاتقها مجابهة تيارات المعارضة العلمانية بوساطة الدين، ما أنتج “أصولية الدولة” بحسب بعض الباحثين. ويُحلل جنجار “خصائص الخطاب الديني والمدرسي”، ويستنتج إنه يجعل من الإسلام “منظومة مغلقة ومنفردة، لا يمكن لها أن تقيم علاقات مع الأديان والعقائد الأخرى”. وبدأت محاولات الإصلاح في العام 2000 – 2001 بمراجعة البرامج التعليمية ووضع محددات لها هي: قيم الدين الإسلامي والهويّة الحضارية والأخلاقية والثقافية للمغرب، وقيم المواطنة وحقوق الإنسان في مفاهيمها الكونية. وقد أدت حوادث 23 مايو/ أيار 2003 إلى الإسراع بالإصلاحات، فشملت مدونة الأحوال الشخصية واعتبار التعليم الديني جزءًا من أهداف المنظومة التربوية والتركيز على الجانب الأخلاقي.
وبسط، ولفرم وايس، الجامعي والباحث، مسألة “تدريس الأديان في أوروبا: دراسة مقارنة لمواقف المراهقين حول الحرية الدينية والحوار بين الأديان”، لارتباط التربية بالسلوك وارتباط هذا الأخير بالدين والوعيّ السيّاسي. يقدم وايس نتائج استطلاع مولته إدارة البحث في اللجنة الأوروبية حول “الدين في التعليم: مساهمة في الحوار أم عامل صدام في تحوّل المجتمعات الأوروبية؟” (2008 – 2009)، وشمل الطلاب بين 14 و16 سنة موزعين على بلدان عدة. وركز الباحث على الإجابة عن مسألة “التعددية الدينية”، والمنحى العام هو “إمكانية وجود تعايش سلمي بين أشخاص ينتمون إلى أديان مختلفة”، مع تحديد الشروط الضرورية لنجاح هذا التعايش، وقبولهم التعليم الديني في المدارس. وانتهى المشروع البحثي إلى تقديم اقتراحات تدعو إلى: دعم التعايش السلمي وإدارة التنوع واحترام المدرسة كل الرؤى (الدينية وغير الدينية)، وترك مكان في الفصول الدراسية لممارسة الحوار والنقاش بين الطلاب. بدوره اهتم الفرنسي جيرار جانيس بمسألة “تدريس الدين في المدارس العامة في ألمانيا وسويسرا وشرق فرنسا” (دراسة مقارنة)، بادئًا بما يتعرض له الدين من ضغوط من جانبي العولمة والفردنة، إذ فرضت العولمة تدريس الإسلام الذي دخل في المناهج التعليمية الغربية، ويشي النموذج الألماني بأن الدولة “تضمن إطار التعليم الديني، والمجموعات الدينية هي التي تحدد القواعد الخاصة بكل دين”. ومن الحالات الثلاث يستخلص الباحث “نمط نموذجي” تولت في إطاره كل مجموعة دينية أمر تعليم أبنائها. وثمة، في رأيه، نموذجًا آخر في طور البروز، يقوم على تقديم “ثقافة دينية” موجهة لكل الطلاب، تُحِدد السلطات مضامينها وأهدافها، كون التعليم الديني في المدارس العمومية بات “رهانًا اجتماعيًّا” في كثير من بلدان أوروبا. وفحص جون فيليب برا، أستاذ التاريخ في جامعة روان، “الإسلام من منظور البرامج المدرسيّة: التجربة الفرنسية”، فعلى الرغم من علمانية بلاد الغال، إلا أنها وفي إطار إصلاح البرامج التربوية أدخلت تعليم الأديان في حصص التاريخ في أقسام السنة السادسة والخامسة والثانية، وأعيد صوغ المقررات لتلبية هذه التوجهات بدءًا من عام 2000، والسبب الآخر في تدريس الشأن الديني يعود إلى تقرير ريجيس دوبريه في العام 2002، الذي اقترح توزيع موضوعاته داخل الاختصاصات. ويقر الأكاديمي الفرنسي إن المعطى الخاص بالإسلام في البرامج “يمثل معطى إيجابيًّا في البحث عن التجانس الاجتماعي”، مع وجود شوائب وبرامج “تتعارض أحيانًا مع الأهداف المعلنة”. ولهذا الغرض يُحلل المواد ذات الصلة بالحضارة الإسلامية، ويرى انحيازها إلى “الجوهرانية”، بمعنى الوقوف عند الأصول، أي أن الإسلام قد تحدد مع النبوة والوحيّ. ويأتي في مكانه “تقرير في تدريس الأديان” الذي حرره دوبريه، وأجيز بمقتضاه تعليم تاريخ الأديان في المدارس العمومية، ضمنًا التعريف بالإسلام للتلامذة الفرنسيين. ومسوّغ ذلك الرغبة الموجودة لدى الرأي العام الفرنسي لتدريس هذا التاريخ، وكذلك ربطًا بالذاكرة الوطنية والأوروبية، ولأن مكان انتقال المعنى أصبح في المدرسة. والعلم بالدين يُمكِن الطلاب من الخيار الحر، وليست القضية، في زعمه، “إعادة الرب إلى المدرسة، وإنما أن يمدد المسار الإنساني ذو الشعب المتعددة”، وهو وسيلة تساعد في فهم الحوادث المعاصرة، ومنها، على سبيل المثل، 11 أيلول/ سبتمبر 2011، والصراعات في البلقان. وفي وجه مقاومات العلمانيين يوضح دوبريه “أن تعليم الشأن الديني، ليس تعليمًا دينيًّا”، وهو يقع في مرتبة المعرفة ويندرج في إطار “إبستمولوجيا العقل”.
وبحث مواطنه، جان ماري هوسير، عميد جامعة ستراسبورغ، في “تدريس الأديان في الجامعات الجمهورية: نموذج ستراسبورغ”، فرأى أن تاريخ الأديان المقارن جاء على خلفية الصراع مع الدين، مثابة نتيجة للعلمنة. وتميّزت جامعة ستراسبورغ بوجود تقليد التعليم هذا فيها، وقد عرض لمساره ومواده الدراسية، في إطار ما يسميه “علمانية مخففة”، وهو درس يؤمن “معرفة معمقة وموضوعية بدين الآخر”، ويتيح “مسافة نقدية اتجاه الهوية الدينية الخاصة”.
أشار القانوني ولفغونغ بوك في “التربية الدينية وتدريس الأديان في القانون الألماني: المشكلات والحلول”، إلى تميّز بلاد الراين عن بقية البلدان الأوروبية في جعلها تدريس الدين مادة قائمة بذاتها من ضمن المواد التربوية المعتمدة. وتناول تعليم الدين الإسلامي ومشاكله في المدارس، ولا سيّما مع وجود جماعات إسلامية تدرسه بعيدًا من رقابة الدولة. وفي سياق متصل سبر الباحث التونسي، معز الخلفاويّ “تدريس التنوع الديني في ألمانيا من خلال الكتب التعليمية الإسلامية”، في دلالة إلى أن ديانة المسلمين باتت جزءًا من النسيج الأوروبي عامة، والألماني خاصة، وأن أوروبا تُعالِج قضية التعدد الديني. وغرض الباحث الإجابة عن مسألتين: الأديان الأخرى في الكتب التعليمية، والهدف من ذكرها في دروس التعليم الإسلامي في ألمانيا. وفي قراءته لمدونات ثلاث تحمل مضامين مختلفة، يخلص إلى وجود تطور مفاهيميّ يُقِر بالتعددية الأكثر تقدّمًا من مفهوم التسامح.
كتب الأستاذ في الجامعة الكاثوليكية بلوفان، ليون كريستيانس، عن “التدريس بصفته بعدًا اجتماعيًّا للحوار بين الأديان” (بلجيكا نموذجًا)، بمعنى مساهمة التعليم الديني في إحداث تفاعل “بين اليقينيات المختلفة داخل المجتمع” في ظل حيادية الدولة، وصولًا إلى “تلاقي العقائد تلاقيًا حقيقيًّا وعمليًّا”. وقارب بيار سيزاري بوري، المدرس في جامعة بولونيا، “التعليم العام للأديان في إيطاليا”، وهو نتيجة اتفاق بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية (اتفاق كونكردا في العام 1929 زمن الحكومة الفاشية، وتعديلاته في العام 1984)، بهدف الترويج لعقيدتها. أما ريستو جيكو، من جامعة هلسنكي، فرأى إلى “الجامعة وحوار الأديان: وجهة نظر من الشمال(فنلندا)”، والمقصود الحوار انطلاقًا من قرارات الكنيسة الكاثوليكية في فترات تاريخية مختلفة، والتي حددت عوائقه في الآن نفسه. وهو يشير إلى دور جامعة هلسنكي خصوصًا في العمل على رهانات هذا الحوار، وفي زعمه “إن تفاعلًا أفضل بين الأديان سيكون نتيجة منطقية للعمل الأكاديمي”، ومساهمة في قضية السلام العالمي، فكما يقول هانس كونغ: “لا تعايش بين البشر من دون أخلاق كونية، لا سلام بين البشر من دون سلام ديني، لا سلام بين الأديان من دون حوار بينها”.
وناقش الجامعي الألماني، هارتموت بوبزاين، “تغيير زاوية النظر لتحقيق الحوار: مثال إقحام دراسة القرآن في أوروبا”، فسرد بداية الاهتمام بدرس القرآن على نحو معمق منذ أيام لوثر في سيّاق التهديد الذي مثله العثمانيين لأوروبا، الأمر الذي فرض الاهتمام باللغة العربية وبالمقارنة بينه وبين الإنجيل والتوراة. وفي القرن العشرين، بعد الحرب الكونية الثانية، وبتأثير من لويس ماسينيون جرت مقاربة القرآن بذاته ولذاته، وعُد “صنف من التدين له مميزاته الخاصة” بتعبير موهلر. ويختم الحداد هذا العمل المتميّز بنص له عن محمد أركون (المتوفي في 12 أيلول/سبتمبر 2010) يعرض فيه لمسار المفكر الجزائري ودعوته إلى “الإسلاميات التطبيقية بوصفها وساطة بين الثقافات”، وهذه بخلاف “الإسلاميات الكلاسيكية” تتبنى المنهج الإناسي والتاريخي وتعيد قراءة التاريخ على نحو استرجاعي، يتيح تحرير الوعي والذاكرة الجمعيّة. ويلخص الحداد مشروع أركون في مفردات ثلاث: انتهاك ونقل وتجاوز، وهي عمليات “ذات غايات معرفية تهيء لمنهجية متعددة الاختصاص”، وتسعى الإسلاميات التطبيقية لطرد “الأيديولوجيا المتألهة” عبر تفكيك الخطابات.
المقالات المرتبطة
الفكر الإسلامي في العصور الوسطى: دراسات في النص والنقل والترجمة – تكريمًا لهانز دايبر
يمكن دائمًا التعويل على دراسات اللغة العربية وآدابها في العصور الوسطى للكشف عن النوادر والقواسم المشتركة في المنظور الثقافي للمجتمع.
قراءة في كتاب: تأسيس الحضارة الإسلاميّة في فكر الإمام الخامنئي (دام ظلّه)
المقدّمة يتساءل المؤمن دومًا، أين تلك الحضارة الإسلاميّة التي نهضت أيّام رسول الله، (ص)، وأين تلك الإنجازات التي ظهرت آنذاك
قراءة في كتاب “زاد المسير”
إذا كانت عبادة الله الحقيقيّة هي وحدها طريق الوصول إلى الكمال، فإنّ معرفته تعالى هي أوّل مراحل العبوديّة.