ميتافيزيقا المحايدة الحياد حضور عارض والتحيُّز هو الأصل
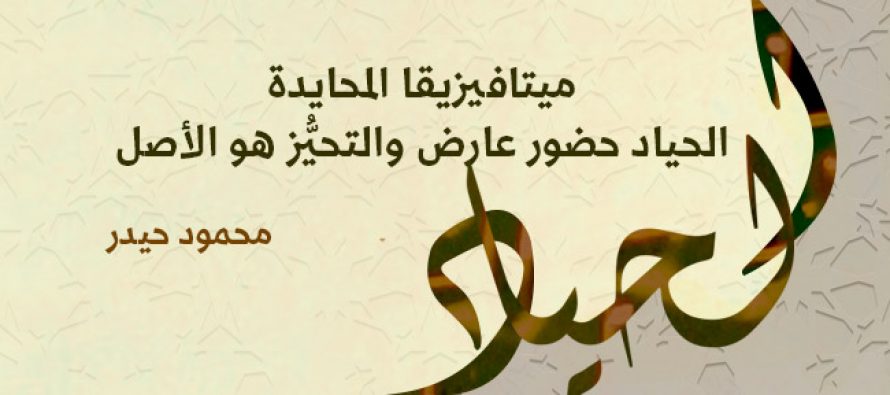
تشير صورة المحايدة إلى قوعها في منتصف الطريق بين حيِّزين. ولو عايَّنا هذه الصورة لظهرت لنا قلقة وحائرة بين بداية الطريق ونهايتها. وعليه، لا تجد المحايدة لنفسها نصيبًا من احتدام التحيِّزين إلا الوصف والاختبار من دون أن تبدِّل في وجهتِهما شيئًا يُذكر. لذا، غالبًا ما تكون المحايدة منزوعة الثقة من أهل البداية وأهل النهاية في الآن عينه. إذ كيف لمحايد أن يحظى بثقة من يفعل، ويحوِّل الوقائع، بينما هو منزوع القدرة على الفعل، من بعد أن كفَّ عن كونه شريكًا إيجابيًّا في صناعة الأحداث؟ مثل هذا التساؤل مرجعُه في المقام الأول إلى أن المحايدة في كثير من الأحوال تولد وتنمو خارج المتون المكتظة بالاحتدام، فهي ظاهرة تنأى من صراع يخيّل إلى أهلها أنهم اتخذوا لأنفسهم حيِّزًا آمنًا من تداعياته.
ومهما يكن من أمر المحايدة، سواء كانت حقيقة واقعية أم مجرد وهم، فهي كثيرًا ما تجري على نحو التبسيط في حقول المداولة. ولأجل تقريب الفهم، تسعى هذه الأملية إلى متاخمة مفهوم المحايدة في أصل صدوره، وإمكان تحقُّقِهِ في الواقع. لذلك سنتعامل معه كفَرَضية من أجل أن نتبين مدى صحته أو بطلانه في الاجتماع البشري.
- خطبة المحايد وطبيعتها.
من صفات المحايدة أنها متعددة كأحوال الداعين إليها. كلُّ داعٍ يصوغ بيان خطبته تبعًا لظروف إقامته، وشروط البيئة التي ينتمي إليها. لهذا قامت فلسفتُها على البساطة والتركيب، وعلى التناقض والتكامل في اللحظة عينها. ومع هذا، يتعذَّر الحكم عليها من دون أن تُرى صورتها من داخل الحدث الذي تتفاعل معه وتعيش على هامشه. ربما لهذا السبب سنرى كيف تبدو.
لغة المحايد في كل مضمار السياسة زئبقية، ولا تُضبط بيسر. ولأنها لغة بينيّة تسعى إلى توليف غير متكافئ بين عناصر متناقضة، فإنها تتسم باضطراب الأداء؛ ذلك بأنها محكومة بهاجسَيْن: هاجس الحيادية، وهاجس النأي بنفسها عن صراع ذي طبيعة جيو-استراتيجية، ولا تستطيع الانفكاك عن شروطه وتداعياته. بهذه المنزلة تظهر خطبة المحايد ملتبسة، وتشكل مزيجًا من ألوان وحروف وكلمات تعرب عن أحوالها وأحوال من حولها بصورة تلفيقية، بل هي من التكثيف واللّبس حتى تكاد لا تُرى إلا في تلك المنطقة الغامضة التي يبقى ظهور كل لون فيها رهنًا بحضورٍ موازٍ للون آخر.
عندما يوصِّف المحايد مشكلة ما، فإن توصيفه يجيء في الغالب الأعم فضفاضًا ومسطَّحًا لأنه يخشى تضمين خطابه الأخطاء التي ارتكبها المتحيِّزون. لهذا الداعي يعكف المحايدون على الانفلات من المنازعات حتى يكون لهم منفسح لدور يُقيَّضَ لهم أن يلعبوه. غير أن رهانهم على هذا المنفسح لا إرادة لهم في صنعه ما داموا يمكثون على هامش اللعبة، أو خارجها. يظنُّ المحايدُ أن حيادَه ناجمٌ عن يقين بالغ الصفاء والنبل، إلا أنه يجهل في الغالب الأعم أنه في نظر المتحيِّز هو كائن واهنٌ وانتهازي وغامض. فالأخير على علم بأن لغة المحايد متوترة، وأنانية، لأنها تعرب عن شغفٍ بالانفلات الحر ولو كان مجرد وهمٍ وسط تنافس محموم على مراكمة عوامل القدرة والغلبة. ولما كانت لغة المحايد على هذا النحو من الالتباس والغموض فهي تنطوي على مفارقة: فهي من جهة لغة سهلة وممتنعة عن الفهم في الوقت نفسه. لذا يحتاج الناظر فيها إلى مشقة التفكيك، والتحليل، والفطنة، والدراية، لكي يتميَّز ما تحمله من ثنائيات الصدق والكذب، والكشف والحجب، والخفاء والظهور.
تفترض الطبيعة المركبة لخطاب المحايد أن يستظهر مفرداته بضمير المتكلم وضمير المخاطب معًا، فهو يبذل ما يسعَهَ من جهد لكي تصير ضمائر المتصارعين من حوله مزيجًا لضمير واحد. ولأن ما يفعله غير ممكن إلى حد الاستحالة، فإن ما يقصده هو أقرب إلى لعبة الحظ. أو لعل قدَرَاً قد يقضي إليه حضورًا ما على مسرح الأحداث أو على هامشه في أقل تقدير. في لحظة ما، ربما يدرك المحايد وهو يحايث دوائر الصراع من حوله، حضوره قيمة لا يعوَّل عليها إلا عند اقتضاء الحاجة إليه. إذن، على قائمة الانتظار السلبي لدور قد يكون أو لا يكون. ولأنه غير قادر على المبادرة والابتكار، فلا حيلة عنده إلا الأخذ بـ”استراتيجية التكرار” من أجل أن يجد له موئلًا يُعترف به فيه، وهو يعلم أنه من دون هذه التقنية التكرارية ـ التي تبدو في الظاهر باعثة على الضجر ـ لن تبلغ خطبته غايتها. إلا أنه تلقاء هذا لا يعقل حقائق الواقع إلا بعد سلسلة من الخيبات. قد يدرك أن المحايدة في أصلها خارجة عن مشيئة المحايد وإرادته، لأنها داخلة في مشيئة المتحيِّز وإرادته. المفارقة في الحياد واقع موهوم يصنعه متصارعان أو أكثر عندما يبلغ صراعهم حدَّ الإنهاك، ولا يجدون من سبيل إلا بثالث ينتخبونه ليكون ناظرًا على احتدامهم. بهذا المعنى يتحول المحايد إلى متحيِّز لذاته ولو أدّى به ذلك إلى الاستباحة.
- المحايدة ليست وجودًا أصيلًا.
تحيل فكرة الحياد من فورها إلى الكيفية التي نظرت فيها الفلسفة إلى مقولة العلاقة، فهي على شَبَهٍ بها ذاتًا وتكوينًا وهوية. وعلى ما نعلم، فقد استغرقت العلاقة مساحة بيِّنة في مشاغل الفلسفة، فإنها كالحياد ليست انفلاتًا حرًّا من أي قيد. هي أمرٌ لا يحدث إلّا بين حدَّين أو مجموعة حدود، فإذا انتفت الحدود فلا وجود لشيء اسمه علاقة، وإذا كانت الحدود متَّسِقة ولا تباين في ما بينها، فلا يستطيع أي حدٍّ أن يستقلّ بذاته لأنه مرتبط مع نظرائه. والناتج أن لا حاجة لحياد في حقل لا صراع فيه. ولأنها بسيطة لا تُدرَك إلاَّ بالتركيب، لا تظهر المحايدة إلا وسط عالم متناقض. فالعلاقة بما هي مقولة مهمتها رسم الفواصل بين الموجودات تعدُّ من أوهن مقولات الفكر، بل إنها الأكثر زوالًا وتبدّلًا. وما ذاك إلا لأنها موجودة مع كونها غير قائمة بذاتها. بها تظهر الأشياء متحدة من دون أن تختلط، ومتميزة من دون أن تتفكك، وبها تنتظم الأشياء، وتتألف فكرة الكون. إنها تقتضي الوحدة والكثرة في آن. هي واحدة، وكثيرة بحكم خصيصة الأُلفة التي حظيت بها بين البساطة والتركيب. على صعيد الفكر تربط (العلاقة) بين مواضيع فكرية مختلفة وتجمعها في إدراك عقلي واحد، تارة بسببية، وأخرى بتشابه أو تضاد، وثالثة بقرب أو بعد. وعلى صعيد الواقع، فإنها تجمع بين أقسام كيان، أو بين كائنات كاملة محافظة عليها في تعدّدها. وإذ يستحيل تقديم توصيف محدد للعلاقة حيث لا وجود مستقل لها، فهي كالماهية من وجه ما، لا موجودة ولا معدومة إلّا إذا عرض عليها الوجود لتكون به ويكون بها. لذلك سيقول عنها أرسطو: إنها واحدة من المقولات العشر، وهي عَرَضٌ يظهر لدى الكائن بمثابة اتجاه. إنها صوب آخر، تطلُّع، ميلٌ، مرجعٌ، ويقتضي دائمًا لظهوره وجود كائنين متقابلين على الأقل؛ صاحب العلاقة وقطبها الآخر، ثم الاتصال بينهما.
في الاجتماع التاريخي، وتبعًا لقوانين الجيو-بوليتك على وجه التخصيص، لا مكان للمحايدة إلا بمقدار ما يفضي إليه التدافع والصراع من ضوابط تفترضها توازنات القوة. أما في عالم الميتافيزيقا واحتدام الأفكار فلا يجري الأمر على خط البراءة؛ ذلك بأن كل فكرة، ما كانت لتكون ذات أثر إلّا تحت تأثير حدث. والذين عاينوا كيف انشطرت مباحث الأنطولوجيا (علم الوجود) إلى مذاهب ومدارس فلسفية شتى، لم يخالطهم شكٌ بأن ظروف المجتمعات القديمة السياسية والاجتماعية والثقافية، والمجتمع الإغريقي على وجه الخصوص، كانت حاكمة في الأعم الأغلب على وجهةِ تلك المذاهب وتحيّزاتها. حتى اللاَّأدريةً التي حيَّدت نفسها عن نظرائها راحت تنشيء تحيُّزها الخاص الإقرار بعجزها عن إدراك الوجود. مع ذلك، لا يمكن النظر إليها كرؤية محايدة بين اليقين والشك، خصوصًا وهي تعلن انتماءها إلى سلالة التحيُّز المقترن بالعدمية. فلقد عمدت اللاَّأدرية وهي تتعقَّل مقولة الوجود إلى الإعراض عن أي جواب، ثم حرصت في الوقت نفسه على إبطال أي جواب آخر، سواء كان إقرارًا بوجود الخالق أو إلحادًا به. وهذا عين التحيُّز لموقف ميتافيزيقي سيكون له أثره العميق في المباحث اللاَّهوتية والفلسفية في ذلك الوقت، فضلًا عن انعكاساته اللاَّحقة على البنية المعرفية للحضارة المعاصرة.
ولو عدنا إلى التأسيسات الأولى للميتافيزيقا لما وقعنا منها على شيء من المحايدة. حتى أرسطو لمّا صاغ “المنطق” ربما لم يكن متنبِهًّا إلى تلك المنطقة المحتمية في ما وراء العقل الذي ينتظم دنيا الإنسان. ومع أن المنطق هو العلم الذي يعلّمنا كيف نفكّر، إلا أننا عندما نفكّر من مجال تحيزُّنا نروح نفكر بمنطق خاص يناسب المكان والزمان الذي نتحيَّز فيه ونعمل لحفظ ديمومته. على الدوام كان ثمة رغبة في التفكير بمجال عقلي يفلت من سلطان المنطق المحبوس في كهف المقولات العشر. راح يبيِّن أن الإنسان حيوان راغب بالمعرفة، بعدما خلع عليه نعت الحيوانية الناطقة. سوى أنه لم يمضِ إلى المحل الذي منه تُستظهر غريزة الكائن الاجتماعي في مقام تحيُّزها. فالإنسان إلى كونه عاقلًا، هو كائن ميتافيزيقي متحيِّز بفطرته إلى يقينٍ ما والإيمان به. من هذا المحل الغائر في الأعماق تنهض غريزة الولاء لتجتاح عوالمه كلها. كانت الحكمة اليونانية تستحث على التحيُّز من أجل أن يغادر الإنسان كَسَلَه ويخوض لجَّة العمل أنَّى كانت الدروب الموصلة إليها والنتائج المترتبة عليها. ثم نبّهت أهل المدن، “إما أن يختاروا الراحة وإما أن يكونوا أحرارًا”. والمقصود بالحرية هنا، هو العثور على ما يحتجب وراء طور العقل، والتعرُّف على حقائقه غير المتناهية. هذا الاستشعار لمعنى التحرّر هو الذي سيحمل الحكماء على شق السبيل إلى التعالي المعرفي، ويتهيَّأوا لظهور الحكيم. فالحكيم وحده من يظهر إلى الملأ كراغب بالمعرفة والمتحيِّز إلى الخيريِّة التامة في آن. في لحظة انهمامه بالكشف عمّا لا علم له به، يرى الحكيم إلى الولاءات والعصبيات بعين العدل الذي لا محلّ فيها للمحايدة. ذلك بأنه يحايث الولاءات بعقل متبصِّر ويتأوّلُها كنمط حياة وتفكير. سوى أنه من قبل أن يصدر حكمه لها أو عليها ينصرف إلى مساءلتها والاستفهام عن بواعثها وديناميات عملها. ليست مهمة الحكيم بما هو حكيم إلّا أن يكون متساميًا على فتنة المتناقضات. وما ذاك إلا قصد الوقوف على متناقضات الكثرة وتظهير خط التواصل والامتداد في ما بينها. ذلك لا يعني البتة الاختلاء أو الحياد. هو ليس محايدًا بين الحكمة والضلالة، إلا أنه متحيِّز إلى الحكمة بما تفيض على سالكها من خيرية المعايشة. ولأن التعرُّفَ على حقائق الطبيعة الإنسانية منفسحٌ يسمو فوق التحيُّزات، لا يلتجئ الحكيم إليه من أجل أن يكون محايدًا بين حق وباطل، وإنما ليتحرَّى منازل الحقّانية، في مجمل التحيُّزات التي يعبر فضاءاتها.
بذلت الميتافيزيقا مذ ولدت في أرض الإغريق وإلى يومنا الحاضر ما لا حصر له من المكابدات. اختبرت النومين (الشيء في ذاته)، والفينومين (الشيء كما يظهر في الواقع العيني)، لكنها ستنتهي إلى استحالة الوصل بينهما. ذريعتها في هذا، أن العقل قاصرٌ عن مجاوزة دنيا المقولات الأرسطية العشر، ولا يتيسَّر له العلم بما وراء عالم الحس. أمّا النتيجة الكبرى المترتِّبة على هذا المُنتهى، فهي إعراض الفلسفة الأولى عن سؤال الوجود كسؤال مؤسِّس، واستغراقها في بحر خضمِّ تتلاطم فيه أسئلة الممكنات الفانية وأعراضها.
لم تقطع ميتافيزيقا الحداثة مع منبتِها الحضاري الذي انحدرت منه. وبهذا لم تكن سوى استئناف مستحدث لميراث العقل الذي وضعه السَلَفْ الإغريقي قبل عشرات القرون. من الوجهة الأنطولوجية لم يأتِ فلاسفة التنوير بما يجاوز ما شرّعه المعلم الأول من تعليمات. لم يكن أرسطو محايدًا لما انحاز إلى العقل المنفصل ليبتني عليه ثنائياته المتناقضة: راح يؤكّد الفصل بين الله والعالم، وبين الإيمان والعلم، وبين الدين والدولة، حتى أوقف الفلسفة عن مهمتها العظمى ليهبط بها إلى مجرد إثارة السؤال من دون أن ينتظر جوابًا عليه…
في كتابه “ما بعد الطبيعة” بدا أرسطو كما لو أنّه يعلن عن الميقات الذي نضج فيه العقل البشري ليسأل عما يتعدّى فيزياء العالم ومظاهره. لكن السؤال الأرسطي- على سموِّ شأنه في ترتيب بيت العقل- سيتحول بعد برهة من زمن، إلى علّةٍ سالبة لفعاليات العقل وقابليته للامتداد. وما هذا إلا لحَيْرة حلّت على صاحبه ثم صارت من بعده قلقًا مريبًا. والذي فعله ليخرج من قلقه المريب، أنّه أمسك عن مواصلة السؤال الذي تعذَّر الجواب عليه في حساب المنطق، ثم مضى شوطًا أبعد ليُعرِضَ عن مصادقة السؤال الأصل الذي أطل منه الموجود على ساحة الوجود. والحاصل أن فيلسوف “ما بعد الطبيعة” مكث في الطبيعة وآَنَسَ لها فكانت له سلواه العظمى. رضي بما تحت مرمى النظر ليؤدي وظيفته كمعلِّم أول لحركة العقل. ومع أنه أقرَّ بالمحرِّك الأول، إلا أن شَغَفَه بعالم الإمكان أبقاه سجين المقولات العشر. ثم لمَّا تأمَّل مقولة الجوهر، وسأل عمَّن أصدرها، عاد إلى حَيْرته الأولى، لكن استيطانه في عالم الممكنات سيفضي به إلى الجحود بما لم يستطع نَيْلَه بركوب دابّة العقل. حَيْرتُه الزائدة عن حدّها أثقلت عليه فلم يجد معها مخرجًا. حتى لقد بدت أحواله وقتئذٍ كمن دخل المتاهة ولن يبرحها أبدًا. مثل هذا التوصيف- يصل إلى مرتبة الضرورة المنهجيّة ونحن نعاين الحادث الأرسطي. لو مضينا في استقراء مآلاته لظهر لنا بوضوح كيف اختُزلت الميتافيزيقا إلى علم أرضي محض. من أبرز معطيات هذا السياق الاختزالي في جانبه الأنطولوجي أن أرسطو لم يولِ عناية خاصّة بمعرفة الله، ولم يعتبرها غرضًا رئيسيًّا لفلسفته، ولم يدخلها بالتالي في قوانينه الأخلاقيّة ولا في نظمه السياسيّة[1]. الأولويّة عنده كانت النظر إلى العالم الحسي وبيان أسبابه وعلله من دون أن يفكّر في قوّة خفيّة تدبّره. مؤدّى منهجه أن الطبيعة، بعدما استكملت وسائلها وانتظمت الأفلاك في سيرها، انتهى بها المطاف إلى محرك أول أخصِّ خصائصه أنّه يحرِّك غيره ولا يتحرك هو[2]. هذا المحرك الساكن أو المحرك الصُوَري هو عنده الإله الذي لا يذكر من صفاته إلا أنّه عقل دائم التفكير، وتفكيره منصبٌّ على ذاته. يتحرَّج أرسطو عن الكلام في المسائل الدينيّة، ويعدها فوق مقدور البشر، ويصرِّح بأن الكائنات الأزلية الباقية، وإن تكن رفيعة مقدّسة، فهي ليست معروفة إلا بقدر ضئيل[3]. لكن أرسطو الذي لم يفكر مبدئيًّا إلا في الطبيعة وعللها والأفلاك ومحرّكاتها سيق في آخر الأمر إلى إثبات محرّك أكبر تتجه نحوه القوى وتشتاق إليه[4].
- الحداثة المتحيِّزة إلى العقل الأدنى.
لقد ورِثَ فلاسفة الحداثة الذين أخذوا دربتهم عن الإغريق، معضلة “الفصل الإكراهي” بين واجد الوجود والموجود الخاضع لمحسوبات العقل الحسي ومقولاته. هذا الفصل لم يكن أمرًا عارضًا في الأذهان، وبالأصل لم يكن محايدًا، بل سيكون له امتداده وسريانه الجوهري في ثنايا العقل الكلِّي لحضارة الغرب الحديث. بسبب من ذلك، غالبًا ما دارت اختبارات الميتافيزيقا الحديثة مدار الفراغ العجيب، ولقد أظهرت معطياتها عن حيرة بين الموجود الفاني والوجود الحي. وكثيرًا ما لجأ المحدثون من بعد يأسهم من تحصيل الأجوبة إلى التعاليم التي تؤنس الذهن الشغوف بعالم الممكنات.
وللدلالة على ذلك، في حقبة الحداثة التي تلت العصر الوسيط في الغرب، أسهم تطوّر العلم الوضعي إلى حدٍّ كبير في بروز الاتجاه المتحيِّز الذي يفصل الإيمان بالله عن الحياة الواقعيّة للإنسان الحديث. وبتأثير من علماء مثل كـوبرنيكُس (Copernicus)(1473-1543)، وغاليليــو(Galileo) (1564، 1642)، وبالأخص نيوتن (Newton)(1642-1727)، كشف نمو العلم الوضعي عن أسلوبٍ جذريٍّ جديد في التفكّر بالكون الماديّ وفهمه[5].
بدءًا من هذه الحقبة، سوف تمضي لعبة العقل العلمي في رحلة لن تتوقف عند حد. إذ مع وفود العلم الحديث، فرضت الرياضيات- وليس الميتافيزيقيا- نفسها كأسلوب مناسب لتشكيل فهمٍ علمي وتجريبي للعالم. لم يستمدّ العلم الجديد في تطوره الناضج قوانينه من اعتباراتٍ ميتافيزيقة، ولم يُقدّم نفسه كتابعٍ جوهريًّا لها أو كطالبٍ للاندماج والاكتمال ضمن منظومة الميتافيزيقا واللاهوت الطبيعي. كانت أي إشارة إلى الله أو إلى الملائكة كأسباب لما يجري في العالم خارجة عن مناط الإسناد المناسب للنظرة العلمية الجديدة. كانت الفرضية الوحيدة المناسبة للاتجاه العلمي الجديد هي تلك التي يمكن من حيث المبدأ إثباتها أو نقضها من خلال الملاحظة التجريبية والاختبار. كان واضحًا في التفكير الفلسفي للحداثة الغربيّة أن الرجوع إلى الإله الذي “لم يره أي إنسان في أي وقت” هو نموذج لما لا يُمكن أن يرد كفرضية حقيقية في هذا السياق. وهكذا جرى تمهيد السبيل لرؤية هي أشبه بعقيدة راسخة لدى الغرب الحديث، وتُفيد بأنّ إثبات الله يُشكّل إقصاءً للديناميكية الذاتية لأكثر إنجازات الإنسان حسمًا، وهي العقلية العلمية. وللمفارقة، فإن الرواد المميزين في العلم المعاصر من أمثال بُويل (Boyle) ونيوتن(Newton) كانوا مقتنعين بأن تأملاتهم تُثبت وجود الله بما لا مجال فيه للشك؛ وأنّ وجود الإله الحكيم ضروري قطعًا لضمان ضبط الساعة الكونية العظيمة كما ينبغي والمحافظة على عملها بشكلٍ جيد. لكن لم يمضِ سوى وقت قصير حتّى ظهر النزوع الإلحادي في أفق المنهج العلمي الذي يُسنده. وبالتدريج، أصبحت أيُّ إشارة إلى الله في التفسير العلمي للعالم عَرَضيةً بشكلٍ متزايد. ومع الوقت، أصبح الله خارجًا عن الموضوع حتى حين يجري الحديث عن مصدر النظام الشمسي وصيانته. كما أضحى التفسير الطبيعي الحصري لكل الظواهر المادية هو محور الاهتمام المسيطر.
وفقًا لما مرَّ معنا من شواهد ينبغي عدُّ تطوّر العلم الوضعي الذي بدّل الأفق الفكري للغرب بشكل دراماتيكي على أنّه عاملٌ ذو أهمية مركزية في حرفِ الميتافيزيقا عن مدَّعاها المحايد في ترشيد العقل. يتضح هذا التطور جيدًا في فكر ديكارت(Descartes) (1596-1650) حيث مضى في التنظير لذاتية مفرطة سيكون لها أثرها العميق في التسييل الفلسفي للإلحاد المعاصر. وكما يُلاحظ البروفيسور فابرو(Fabro) مثّل الإلحاد ظاهرةً متفرّقة تقع ضمن حدود النخبة الثقافية، ولكن بمجرد بروز الكوجيتو على الساحة فقد اتخذ الإلحاد بُنية محيطة وبشكلٍ متزامن اجتاح الحياة العامة والسلوك الفردي[6].
إذا كان ديكارت هو الفيلسوف المؤسِّس لحداثة الغرب فإن مشروعه لم يكن في نتائجه محايدًا؛ فهو لم يقطع مع الأرسطية، بل شكّل امتدادًا جوهريًّا لمنطقها من خلال الخضوع لوثنية الأنا المفكِّرة. وسيجوز لنا القول: إن الكوجيتو الديكارتي ما هو إلا استئناف مستحدث لـ “دنيوية” أرسطو. وبسبب من سطوة النزعة الدنيوية هذه على مجمل حداثة الغرب لم يخرج سوى “الندرة” من المفكّرين الذين تنبّهوا إلى معاثر الكوجيتو وأثره الكبير على تشكلات وعي الغرب لذاته وللوجود كلّه. من هؤلاء نشير إلى الفيلسوف الألماني فرانز فونبادر الذي قامت أطروحاته على تفكيك جذري لمباني الميتافيزيقا الحديثة وحكم بتهافتها الأنطولوجي والمعرفي في آن. وإذا كانت فلسفة بادر النقديّة طاولت الأسس التي انبنت عليها الميتافيزيقا الأولى، فإن نقده للديكارتيّة يشكّل ترجمة مستحدثة للميراث الأرسطي بمجمله.
وللبيان يمكن إيجاز نقد بادر للكوجيتو الديكارتي في النقاط الثلاث التالية:
أولًا: إن الكوجيتو الديكارتي “مبدأ الأنا أفكّر” يؤدّي إلى قلب العلاقة التأسيسية للوعي بجناحيه المتناهي واللامتناهي. يحتج بادر على العقليين بقوله: “كيف يمكن أن يعرفوا بتفكير لا إلهي، أو تفكير لا إله فيه، وبتفكير مدعوم إلهيًّا، مع أن نفس وجود أو لا وجود اللَّه يُحدَّد فقط من خلال تفكيرهم، وطالما أن قضيتهم تجري وفق معادلة مختلة الأركان قوامها: اللَّه موجود مجرّد نتيجة للأنا موجود”[7].
ثانيًا: ما يريد الشك الديكارتي أن يقوله فعلًا، بوصفه حيادًا مطلقًا للمعرفة، ليس أقل من أن الإنسان بوصفه مخلوقًا يكوّن معرفته الخاصة، ويجعلها تؤسّس ذاتها من دون مسبقات. الـ “أنا موجود” (ergo sum) التي تلي “الأنا أفكّر” (co gito) هي تعبير عن كيان يريد إظهار نفسه بالتفكير والكينونة، بمعزل عن الله، وكونه عاجزًا عن فعل هذا، يمنع تجلّي نفسه وتجلّي الله. فالموجود المتناهي، الإنسان، من خلال تأسيس يقينه الوجودي والمعرفي في الأنا الواعي يحاول إظهار ذاته كموجود مطلق، ويجعل نفسه إلهًا مؤسِّسًا لذاته[8].
ثالثًا: يشكّل الكوجيتو الديكارتي، بالأساس، انعطافة إبستمولوجية نحو الأنا، مما يستلزم انعطافة أنطولوجية تليها انعطافة إبستيمولوجية منطقية أنطولوجية للعودة إلى ذاتها، بهذا يساعد ويحرّض على نسيان خاصية الوحدة المرتبطة بالشخصية والعقل الفردي. الأنوية الإبستمولوجية والأنانة الأنطولوجية لـ “الأنا أفكر أنا موجود” في تطبيقها للفلسفة الاجتماعية والسياسية تؤدي إلى أنانية سياسية ليبرالية ذات نظام سياسي واقتصادي أناني[9].
على هذا النحو من النظر إلى “العقل الأناني” المستكفي بذاته، سيؤسّس ديكارت فلسفة العصر الحديث. وهي كما يظهر مما أنجزته في رحلتها المتمادية، فلسفة أيقنت دعوتها على الاكتفاء الذاتي للتفكير والوجود الإنساني. وجل الفلاسفة الذين خَلَفوا ديكارت أو تبعوا دربته الاكتفائية، رأوا أن ذات المرء كافية في تأسيس وجوده وتفكيره، وأن الإنسان بسبب هذا الاكتفاء الذاتي لا يحتاج إلى اللَّه في التأسيس والمساعدة، ولا في وجوده ولا في معرفته ولا في وعيه الذاتي.
لقد نبَّه التحليل النقدي لـ “الأنا أفكر إذًا أنا موجود” إلا أن الأنا، عندما تتأمّل المكان الذي أتت منه، سوف تدرك أنها لا تملك “كوجيتو” خاصًّا بها، ولا وعيًا ذاتيًّا خاصًّا بها، ومنسجمًا معه. عندما نفكّر بشكل أعمق في شروط الوعي- كما يبيّن نقّاد الكوجيتو- يصل المرء إلى معرفة أن الوعي المتناهي يعرف ذاته على أنه وعي لشخص لا يُحدّث نفسه ولا يعرف نفسه بنفسه وحده. وفي ذات الوقت الذي يعرف الوعي المتناهي “الأنا أفكر” ماهيته، يعرف أنه: “مفكَّر فيه”. فالوعي المتناهي مؤسَّس في وعي مطلق مستقل بشكل كامل عن الوعي المتناهي[10].
و”مبدأ المفكَّر فيه” يعبّر عن عقيدة حضور كل الأشياء في اللَّه على مستوى الوعي، بمعنى أن الوعي المتناهي مؤسَّس في اللامتناهي، ومن ناحية أخرى يبيّن أن معرفة الإنسان ليست صنيعة الإنسان، بل هي موهبة إلهية.
- الغيرية وبطلان المحايدة.
هل المحايد ذاتٌ مفارقةٌ لسائر الذوات المنخرطة في تدافع أبدي لتحصين هوَّياتها وحفظ مصالحها؟ الواقع كما مرَّ معنا أن المحايد من حيث كونه محايدًا هو كائن لا فِعَالَ له بين كائنات فاعلة. ولنا من اختبارات الحضارة الغربية الحديثة ما يفيد المقصد. فلو كانت التعاليم الكلية لعصري النهضة والتنوير مثل الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان خارج تحيُّزات الهوية القومية للشعوب الأوروبية، لكان عالمنا اليوم ينعم في أرجاء مدينة كونية فاضلة. أما الذي حدث فهو خلاف ذلك؛ ذلك بأن كل ما تنتجه الحضارات من قيم آيلٌ إلى التوظيف والاستخدام في إطار مجالها الجيو-حضاري. لذا لم تعرف هذه القيم الحياد، بل هي دخلت في صميم التشكُّل الحضاري الغربي مع ما ترتب عليها من نزعات عنصرية حيال الآخر وتسويغ ثقافة الاستعلاء عليه.
على سبيل المثال: لم تأخذ الذاتية والآخَرية كل هذه المساحة من الجدل الفكري بين النخب الغربية لو لم تتحول إلى عقدة “نفس ـ حضارية” صار شفاؤها أدنى إلى مستحيل. وما جعل الحال على هذه الدرجة من الاستعصاء، أن العقل الذي أنتج معارف الغرب ومفاهيمه، كان يعمل في الغالب الأعم على خط موازٍ مع السلطة الكولونيالية، ليعيدا معًا إنتاج أيديولوجيا كونية تنفي الآخر وتستعلي عليه.
إنها معضلة التحيُّز الحاد لهوية أوروبا في امتداداتها الإمبريالية؛ وهي المعضلة التي تسللت إلى روح الحداثة، فأمسكت بها ولمَّا تفارقها قط. فلقد تشكّلت رؤية الغرب للغير على النظر إلى كل تنوع حضاري باعتباره اختلافًا جوهريًّا مع ذاته الحضارية. ولم تكن التجربة الاستعمارية المديدة سوى حاصل رؤية فلسفية تمجّد الذات وتُدني من قيمة الآخر. من أجل ذلك سنرى كيف سينشئ فلاسفة الحداثة وعلماؤها أساسًا علميًّا وفلسفيًّا لشرعنة الهيمنة على الغير بذريعة “تحضيره” وإدخاله قسرًا تحت سطوتها.
لقد عُدَّتِ الحضارةُ الغربية في المخطّط الأساسي للتاريخ وفي الأيديولوجيّات الحديثة، وحتى في معظم فلسفاتِ التاريخ بوصف كونها الحضارة الأخيرة والمطلقة؛ أي تلك التي يجب أن تعمّ العالم كلّه، وأنْ يدخلَ فيها البشر جميعًا. في فلسفة القرن التاسع عشر يوجد من الشواهد ما يعرب عن الكثير من الشك بحقّانية الحداثة ومشروعيتها الحضارية، لكنّ هذه الشواهد ظلّت غير مرئية بسبب من حجبها أو احتجابها في أقل تقدير، ولذلك فهي لم تترك أثرًا في عجلة التاريخ الأوروبي. فلقد بدا من صريح الصورة أن التساؤلات النقدية التي أُنجزت في النصف الأول من القرن العشرين، وعلى الرغم من أنها شكّكت في مطلقية الحضارة الغربية وديمومتها، إلا أنها خلت على الإجمال من أيّ إشارة إلى الحضارات الأخرى المنافسة للحضارة الغربية. حتى أن تويبني وشبينغلر حين أعلنا عن اقتراب أجلِ التاريخ الغربيّ وموته، لم يتكلّما عن حضارةٍ أو حضاراتٍ في مواجهة الحضارة الغربية، ولم يكن بإمكانهما بحث موضوع الموجود الحضاري الآخر، ففي نظرهما لا وجود إلا لحضارة واحدة حيّة ناشطة هي حضارة الغرب، وأما الحضارات الأخرى فهي ميتةٌ وخامدةٌ وساكنة…
حين توصّل جان بول سارتر إلى قوله المشهور: “الآخر هو الجحيم”، لم يكن قوله هذا مجرد حكم يصدِرهُ على آخر أراد أن يسلبه حريته أو علَّةَ وجوده، وإنما استظهر ما هو مخبوء في أعماق الذات الغربية. إذ لا موضع ـ حسب سارتر ـ للحديث عن محبة أو مشاركة أو تآزر بين الذوات، لأن حضور الذات أمام الغير هو بمثابة سقوط أصلي، ولأن الخطيئة الأولى ـ حسب ظنّه ـ ليست سوى ظهوري في عالم وُجِدَ فيه الآخرون..”.
ولأن غيريّة الغرب هي غيريةٌ مشحونةٌ بالخوف على الذات من الآخر إلى هذا الحد، فلن تكون في مثل هذه الحال سوى إعراب بيِّن عن ظاهرة هيستيرية لا تقوم قيامتها إلا بمحو الآخر أو إفنائه. سواء كان محوًا رمزيًّا، أو عبر حروب إبادة للغير لا هوادة فيها.
لقد كان التفكير العنصري جزءًا لا يتجزأ من العلم وفلسفة التنوير. ولم تكن عادة تصنيف الآخرين إلى فئات “طبيعية”، وبالطريقة نفسها التي صنّفت فيها الطبيعة، سوى مظهر من مظاهر “التراث التنويري”. جمعٌ من فلاسفة وعلماء الطبيعة في القرن الثامن عشر من كارل فون لينيه kARL VON LINNE إلى هيغل، سوف يسهمون في وضع تصنيف هَرَمي للجماعات البشرية. الشيء الذي كان له عظيم الأثر في تحويل نظرية النشوء والارتقاء الداروينية على سبيل المثال إلى فلسفة عنصرية في مطالع القرن الحادي والعشرين. أما أحد أكثر تصنيفات المجتمعات الإنسانية ديمومة، والتي تمتد جذورها إلى اليوم، فهي ما تمثله ملحمة الاستشراق التي ولدت كترجمة صارخة لغيرية لم تشأ أن ترى إلى الغير سوى موجودات مشوبة بالنقص، أو كحقل خصيب لاختباراتها وقسوة أحكامها.
إذن، الحياد عَرَضٌ يحدث ويمضي ولا أصالة له. هو خاضعٌ دائمًا لمؤثِّر من خارجه، وإذا لم يوجد المؤثِّر فلا حاجة إليه.
قد يكون من أبرز ما فعلته الفلسفة الأولى أنها أسَّست للتحيُّز عبر إقامة أفهامها لحركة الإنسان في التاريخ على مبدأ الهوية والانتماء. ولأن الإنسان كائن مدني بالطبع، فإن مدنيتَه وحاضريته في التاريخ الاجتماعي لا تستوي إلا بميثاق مبرمٍ مع الجماعة، وبهذا يصير محالًا عليه أن يحقق هذا الميثاق وهو يبتغي الحياد سبيلًا إليه.
* مفكر وباحث في الفلسفة السياسية.
[1] إبراهيم مدكور، فلاسفة الإسلام والتوفيق بين الفلسفة والدين، في إطار كتاب “قضيّة الفلسفة”، تحرير وتقديم: محمّد كامل الخطيب، (دمشق: دار الطليعة الجديدة، 1998)، الصفحة 165.
[2] Aristote, Physique, 258 a, 5-b, 4.
[3] Aristote, Des parties des animaux. 1, 5.
[4] إبراهيم مدكور، مجلة الرسالة، (القاهرة: السنة الرابعة، العدد 141 – 13-9-1936)، الصفحة 200.
[5] H.Butterfield, The Origins of Modern Science 1300- 1800, London, 1951, p.7.
[6] C.Fabro, God in Exile-Modern Atheism: AStudy of the Internal Dynamic of Modern Atheism, from itsRoots in the Cartesian Cogito to the Present Day, NewYork, 1968, pp.26 -27.
[7] Franz von Baader،BB،Brief an Dr. vonStransky،77. April 5485،in SW،Vol. XV،p. 757.
[8] Ipid. P. 776
[9] رولاند بيتشي، نقد العلمانية الملحدة، ترجمة: طارق عسيلي، فصليّة “الاستغراب”، العدد السابع، ربيع 2017. رولاند بيتشي، فرانز فون بادر، ناقد العلمانيّة الملحدة.
[10] رولاند بيتشي، المصدر نفسه.


