قراءة في كتاب الدعاء
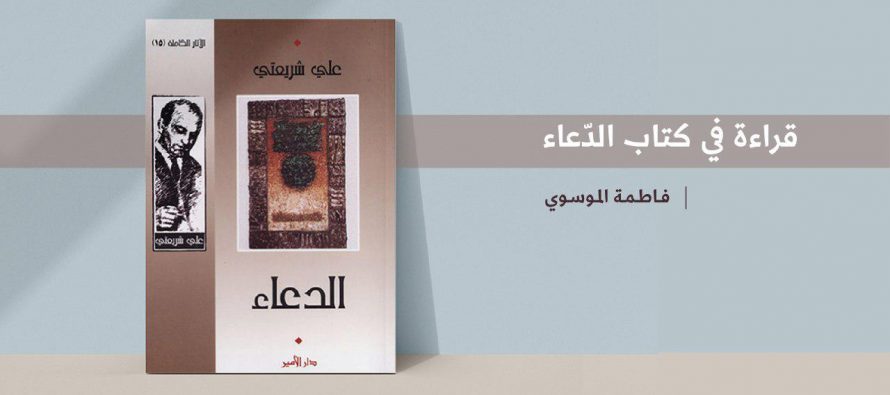
إنّ هذا الكتاب عبارة عن محاضرتين ألقاهما المرحوم في “حسينيّة الإرشاد” بطهران عام 1970. وتمّ إصدار طبعته الثانية في عام 2007، أي بُعيْد حرب تموز التي شنّها العدو الصهيوني وطالت بنيرها دار الأمير المعنيّة بنشر تراث الدكتور شريعتي. وقد اعتمدنا في قراءتنا على هذه الطبعة.
يحاول الكتاب إعادة تعريف الدعاء وبيان فلسفته، لغرض التمييز بين أصالته الإسلامية، وبين ما تولّد عنه من مفاهيم في سياقات العُرف والسلطة، حيث يشير إلى أهم العوامل التي دفعته إلى الخوض في هذا الموضوع، ومنها:
أـ اتّخاذ الدعاء كعقار مخدّر وبديل عن الواجب في حياة الفرد والمجتمع، مؤكّدًا على أنّ الدعاء ليس نقيض هذا الفهم فحسب، وإنّما هو عبارة عن حالة بقاء وديمومة في عملية بناء الحياة الفردية والاجتماعية.
ب ـ تأثّر شريعتي بكتاب الدعاء للعالم الفيزيولوجي ألكسيس كارل، حيث أكّد فيه الأخير على أنّ مفهوم الدعاء يعدّ من أهم السُّنن الباعثة على قوّة الأمّة وتقدّمها، ومتى ما انحطّت الأمم وتدهورت فقد أهملت هذه السنّة.
ويذكر شريعتي عدّة نقاط يتجلّى فيها مفهوم الدعاء:
– المحبة: إنّ الدعاء عبارة عن فيض من الحب يتدفّق فيما لا يُدرك بالمنطق والعلم، وكما عبّر عنه كارل بأنه “وليد العشق”.
– الحاجة: ليس الإنسان بمتعه ولذّاته، بل بحاجته وشوقه للأشياء التي يحسّ بها. إنّ تكامله يساوي تكامل حاجاته ونقائصه؛ فبمقدار ما تكون حاجاته كاملة ورفيعة ومنزّهة يكون كبيرًا بها. فهذا الإمام علي (ع) صاحب الروح الكبيرة الولهى المتعطّشة، قد كان الدعاء طريقه الأمثل لإشباع هذا الظمأ المتّصل بمعرفة الوجود وحقيقته.
– الوحدة والعزلة: وفيه تطرّق لمنهج الفلسفة الواقعية، وما يقابلها من فلسفة تجريدية، والتي تعتقد بتفوّق الإنسان على بيئته وواقعه؛ فبرؤيتها لا بدّ للفرد أن يتجرّد من قيود المجتمع والطبيعة كَيما يرتقي ويتسامى. وقد رأى شريعتي أنّ الهروب من الواقع وعصيانه هو السّمة التي اصطبغت بها أغلب الآداب والفنون الغربية، والتي أفضت إلى خلق مفهوم الوحدة كحالة مقاومة للطبقات البرجوازية المرفّهة، وأكّد على رفضه لهذا الاتّجاه، واعتقد بأنه يؤدّي إلى خلق رؤية فلسفية عبثية كتعبير طبيعي عن شحّ المعنى والأزمة الروحية التي تعاني منها الحضارة المادية. كما أوضح أن مفهوم الوحدة الذي يتجلّى في الدعاء يخصّ روح العاشق واضطرابه واحتياجه للمقدّس المتجاوز ذاته المادية، والشوق إلى المطلق والكمال. فيغدو الدعاء بهذا الفهم معراجًا وتحليقًا إلى ما وراء الوجود المادي.
ثم ينتقل للحديث عن خصائص الدعاء الإسلامي ويعدّدها كما يلي:
– مخاطبة الله: وفيها ذكرٌ للصفات والذات وروابطه بالكائنات والإنسان، فيتحوّل الدعاء إلى نص لمعرفة الله.
– الإرادة: وليس المراد منها إرادة الأمور المادية التي ألِفناها، بل هي إرادة الخصال المحمودة والفضائل، فتتحوّل لهجة الدعاء إلى أداة لتأصيل مفاهيم أخلاقية. كما يتميّز الدعاء الإسلامي بفصاحته التي تعبّر عن عناية خاصة بالجمال والفن لما لهما من قيمة عظيمة في إثراء الحياة الروحية للإنسان. إضافةً للكلمات المسجّعة والمشتقّة، والتي تخلق نوعًا من الموسيقى الموقظة لمنابع الحب في الروح.
– البصيرة والجهاد: ويستعرض نماذج من الصحيفة السجادية باعتبارها خزّانًا ثقافيًّا وروحيًّا مليئًا بمضامين سامية، والتي حوّلت الدعاء إلى مدرسة فكرية على يدَيْ الإمام السجاد (ع)، هدفها: إنماء البناء المعرفي وتبليغ الرسالة، تربية المشاعر، المحافظة على روح الكفاح. فاستُعمل الدعاء كفاعل اجتماعي لمناهضة السلطة والنضال ضدّ الظلم والدفاع عن الحقائق المغيّبة.
وللدعاء في التراث الشيعي خاصيّة إضافيّة، حيث يعمل على ترسيخ فعل الممارسة للشعائر والأهداف الاجتماعية، وواجبات القوم الذين يرتبط بهم الداعي، فإذا هي طرية حيّة دائمًا، تسري فيها الحرارة باستمرار. إذ لا قِبَلَ للحكومات الطاغية والخلافات العاتية بإبادتها وتضييعها؛ ذلك أن الدعاء يلقّن الناس الممانعة ورفض الباطل.
ثم يتطرّق إلى الحديث عن أنواع الدّعاء، ويذكر منها:
أولًا: الدعاء بقصد الثواب، ولا يقصد به مفهوم الثواب الإسلامي الأصيل الذي يعتبر نتيجة منطقية ومعطًى عقليًّا وضروريًّا للعمل الديني أو العبادي، وإنّما يقصد مفهوم الثواب الذي تعرّض لانزياح في معناه، أصّلته الأعراف والثقافات الدخيلة، فتحوّل إلى صيغة تجارية “ادعُ بهذا الدعاء لأعطيك هذا”، و”كرّر هذا الوِرد لتحصل على أجر 70 مجاهدًا”، فأصبح الأجر والمقابل المحدّديْن الفعلييْن للدعاء مع إغفال قيمة التأثير الذاتي على الداعي. ومن الواضح أنّه مع عدم وجود أجر لهذا العمل، فلن يستطيع أي منطق أن يدفع الشخص لإنجازه بالكيفية التي يعتبرها البعض شاقّة ومملّة. ويَذكر مثلًا على ذلك، فيقول: تارةً تطلب من شخص أن يحمل مجموعة من أحجار البناء وينقلها إلى الطابق العلوي مقابل إعطائه أجرًا معيّنًا، وهو بدَوره يتحمّل العناء مقابل ما يريد أن يكسبه، مع أنّ العمل بذاته لن يعود عليه بفائدة فلا رابط بينه وبين الأحجار والمنزل. وتارةً أخرى ينقل هذا الشخص الحجارة ليبني بيته، ومن ثم يسكن فيه فيكون هذا السكن هو الأجر على عمله، إذًا فالثواب حينًا يكون ماديًّا، وآخر عملًا معنويًّا وروحيًّا ذا دور أعمق في تكوين شخصية الفرد وتجربته الدينية. فمرة أقرأ زيارة وارث لأجل الأجر، وأخرى لأكون أكثر وعيًا وفهمًا وإيمانًا واعتقادًا، وأكثر معرفةً في رحاب الرؤية الكونية التاريخية، ويكون توسّع آفاقي الروحية والفكرية هو الثواب الفعلي لقراءتي تلك. فهنا يلزمنا التأكيد على ضرورة دراسة تأثيرات الدعاء على نفس الداعي وسلوكه وخلقه، فضلًا عن أن يكون وسيلة لتحصيل المنفعة وهذا ممّا لا غبار عليه.
ثانيًا: الدعاء الذي نستعيض به عن تحمّل المسؤوليات والواجبات المُلقاة على عاتقنا، ونستعين به للحصول على أشياء لا تتحصّل إلّا بإعمال الفكر والتخطيط والعمل والإرادة. فيكون الدعاء وسيلتنا الأكثر راحة للتهرّب من هذا الجهد والمشقّة، وقد عملت السلطات المستبدّة على تأصيل هذا المفهوم بجعل الدعاء أفيون لتخدير الشعوب عن المطالبة بحقوقها، وصرفها عن السعي لرفع الظلم وتحقيق العدالة.
ثالثًا: الدعاء بوصفه جزء علّة، وعامل شديد الفاعلية من مجموعة العوامل المعدّة للأرضية، والمهيّئة للمقدّمات العملية لتحصيل المطلوب، وهذا مما دعا إليه الإسلام والذي نراه ماثلًا في سيرة النبي (ص) والأئمة (ع). ومن أبرز الأحداث التاريخية المؤيّدة لهذا الفهم، الهزيمة القاسية التي مُني بها المسلمون في معركة أحد، لمجرّد عدم تطبيق أوامر الرسول بالدّقّة الكافية، ففي هذا الموقف لم يكن الدعاء بديلًا عن الأسباب، وإنّما كان له الأثر المكمّل والرّافد.
ثم يتطرّق لمفهوم (سجون الإنسان الأربعة) المتمثّلة بسجن الطبيعة، التاريخ، المجتمع، والنفس.
فأمّا سجن الطبيعة، فالمراد منه القوانين التي تعمل فينا كما تعمل في الحيوان والنبات، ويمكن للإنسان بإرادته أن يتفوّق عليها ويشذبها، وأن يخلق ويفكّر ويبدع.
وأمّا السجن الثاني وهو التاريخ، أي الآثار والتبعات وسياقات الأحداث التي يمكن أن تصوغ شخصية الإنسان وتحدّد خياراته، ويمكن له التحرّر منها من خلال دارسة فلسفة التاريخ والتدقيق فيه، ومحاكمة الظروف، وغربلة الأحداث ومنعطفاتها.
ويعدّ المجتمع السجن الثالث للإنسان، فالفرد فيه محكوم بالنظام الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات القائمة، والطبقية والعلاقات العامة، والتحولات الفكرية. فكل هذه عوامل دخيلة في تشكيل شخصية الفرد الفكرية والروحية، بيْد أنّه يمكن التفلّت منها بالإرادة الحرّة عن طريق تطويع الطبيعة ودراسة فلسفة التاريخ والاجتماع، وكشف القوانين والسُّنن التاريخية والاجتماعية، فيخفّف بذلك وطأة الجبر الاجتماعي والتاريخي.
بينما تكون النفس هي رابع السجون وأشدّها، فلا تُحطَّم بالاستدلالات العقلية المحضة، ولا منطق العلوم، ولا الاكتشافات، ولا علم الأعصاب والنفس والتاريخ والفقه وغيره، فلا يَكسر قيودَها سوى العشقُ الذي يرقى بالإنسان إلى أعلى درجات وقمم الإخلاص، العشق الذين يبرهن للإنسان على أنّ إثبات الوجود لا يكون إلا بإنكار الذات والصلة بالغيب، وهذا ما نراه متمظهرًا في كلام سيّد العاشقين وزين العابدين العالم الساجد علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
وفي الخاتمة، أكّد على ضرورة التنبّه لما يؤول إليه مصير الإنسانية في عالم يتسارع فيه كلُّ شيء، ويشتدّ إيقاعه نحو المادية وعبادة الذات والمنفعة واستعباد الناس باللذة، الزحف نحو المتع الفردية، القسوة، الظلم، العنف، الحروب، المجاعات، البرد، الجفاف، خمود العاطفة والإنسانية. ولئن كانت معجزة الدعاء تسعى لتلطيف الروح وتجميلها بالإيثار والتقوى والعفو ورفض الظلم، فلنتّخذه طريقًا لمساءلة أرواحنا المتصلّبة.
المقالات المرتبطة
قراءة في كتاب “باقٍ لم يمت”
القلوب التي لا تنقاد لها السواعد، القلوب الخائفة النائمة، القلوب المتعلقة بالدنيا الفانية، هي قلوب ميتة. إنّها ليست إلّا قطعة لحم باردة، فأيّ قلبٍ هذا الذي يترك حسيناً!
قراءة في كتاب أصلح الناس وأفسدهم في نهج البلاغة
معيار المحبوبيّة عند الله هو الإيمان الثابت الذي لا يزول بعد مدّة حين تتغيّر الأحوال والظروف. وكلّما زادت مراتب إيمان الإنسان كان محبوبًا أكثر عند الله.
قراءة في كتاب ما وراء الشرّ
فما وراء الشرّ الذي نراه كذلك، وقبله ومعه يكمن الباري تعالى الذي يحملنا على أكفّ رحمته في لحظات ضعفنا إلى كهف الأمان والطمأنينة التي نرجوها، ولن نجدها إلّا بين يديه سبحانه.





