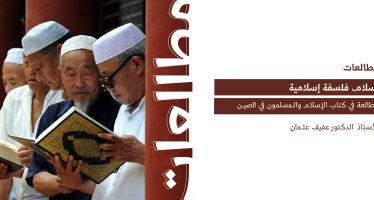قراءة في كتاب (شورا در فتوا)

حميد شهرياري هو أستاذ للبحث الخارج في الحوزة العلمية، وحائز على شهادة دكتوراه في الفلسفة المقارنة. ولد عام 1342 هـ ش في مدينة طهران في إيران، أنهى دراسته الثانوية عام 1360 وانخرط في صفوف الحوزة العلمية في قم المقدسة، وأنهى دراسة السطوح في غضون ست سنوات، ثم التحق بدروس الخارج في علمي الفقه والأصول عند بعض الأساتذة المبرّزين في قم. وفي أثناء دراسته الخارج، نال شهادة الماجستر في الإلهيات والمعارف الإسلامية في جامعة تربيت مدرّس، وكانت رسالته للماجستر تحت عنوان (شورا در فتوا). ثم نال جائزة أفضل تحقيق علمي على هذه الرسالة أيضًا. ومنذ العام 1375 تولى رئاسة مركز نور للتحقيقات الكمبيوترية في العلوم الإسلامية. ثم حاز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة المقارنة في جامعة قم. وكتب كتابًا في فلسفة الأخلاق الغربية، فحاز سنة 1385 في إيران على الجائزة السنوية لأفضل كتاب فلسفي. ثم تصدّى لرئاسة مركز تحقيق وتوسعه علوم انسانى (سازمان سمت). وهو يجيد العربية والإنكليزية. وقد شرع في تدريس بحوث الخارج في علم الفقه في حوزة قم سنة 1391، فدرّس بحث “فقه التكنولوجيا الحديثة”، ولا زال إلى الآن يدرّس بحثًا آخر في علم الفقه[1].
وقد حاز كتاب (شورا در فتوا) على جائزة أفضل تحقيق علمي سنة 1383. وهو حاصل بحث وتحقيق لمدة 3 سنوات (من سنة 1372 إلى سنة 1374). وقد بحث فيه عن إمكانية تشكيل هيئة جماعية للفتوى والاستفتاء تعتمد على الشورى والمشاورة[2]، بحيث تقل على إثرها نسبة الآراء المختلفة والمتعارضة.
فرتّب كتابه على مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة.
فذكر في المقدّمة الفكرة الأساسية التي يريد معالجتها في هذا الكتاب، وهي: رأي الفقه الشيعي فيما يرتبط بشورى الإفتاء. وبيّن مشكلتين واجهته أثناء تدوينه لهذا الكتاب، وهما:
- عدم وجود بحث مستقل مطبوع في هذا المجال.
- اقتضاء هذا البحث لقدرة علمية وتحقيقية كبيرة.
ولم يطرح ما ذكره في هذا الكتاب كحل نهائي للمسألة، بل ترك المجال مفتوحًا أمام سائر الباحثين ليشبعوه بحثًا وتدقيقًا.
وأما في الفصل الأول (المعنون بـ “دور الشورى والمشاورة في صدور الفتوى)، فبيّن معنيين للشورى وهما:
المعنى الأول: وعبّر عنه الكاتب بلفظ الشورى، وهو أن يجتمع بعض الأشخاص ويبحثون في مسألة، فيخرج عنهم نتيجة واحدة هي حاصل رأي الأكثرية أو المتخصصين بينهم. ويُعدّ مجلس النواب في أغلب البلدان مصداقًا لهذا المعنى.
المعنى الثاني: وعبّر عنه الكاتب بلفظ المشاورة، وهو أن يجتمع بعض الأشخاص ويتبادلون الآراء في مسألة محدّدة، فيصبح كلّ منهم مطّلعًا على جوانب المسألة كلها، بحيث يستطيع أن يبدي رأيه الخاص في المسألة. وتُعدّ جلسة رئيس الجمهورية مع مستشارينه مصداقًا لهذا المعنى.
وكلّ من هذين المعنيين قابل للتصوير فيما يرتبط بالفقهاء، فيمكن أن يكون لدينا شورى فقهاء، أو مشاورة بين الفقهاء. وأشار الكاتب إلى وجود عدّة صور للشورى لأجل أن يقول بأن ورود إشكال على إحدى هذه الصور، لا يعني بطلان هذه النظرية من رأس.
ثم بحث المعنى اللغوي لكل من الشورى والمشاورة، فعرض جزءًا معتدًّا به من كلمات اللغويين، وخلص إلى أن معنى المشاورة والشورى في كلام العرب هو طلب رأي شخص بصير. كما يوجد معنى آخر للشورى وهو التشاور بين شخصين أو أكثر لاتخاذ قرار في موضوع ما.
ثم تعرّض لمدى دلالة القرآن الكريم على الشورى والمشاورة في الفتوى، فوجد أن مادة الشورى قد استُعملت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. وصبّ بحثه على موردين منها، وهما: الآية 38 من سورة الشورى[3]، والآية 159 من سورة آل عمران[4].
أما آية سورة الشورى، فبيّن أن الاستدلال بها يتوقف على مقدّمات ثلاث:
- أن تكون جملة [وأمرهم شورى بينهم] صفة لازمة للمؤمنين، فتدل على لزوم الشورى. وقد أثبت هذه المقدمة ببيانين. وبيّن بأنه حتى لو لم تدل هذه الآية على لزوم الشورى، إلا أنه لا شك في أنه يستفيد المفسرون من هذه الآية حسن الشورى.
- أنه يجب أن تكون الشورى بين المتخصّصين وأهل الفن، وفيما يرتبط ببحثنا يجب أن تكون بين الفقهاء، لا بين المؤمنين. ويدل على ذلك سيرة العقلاء وسيرة النبي الأعظم (ص) في موارد الشورى.
- أن تكون كلمة [أمرهم] شاملة للفتوى أيضًا. فالفتوى هي من الأمور المرتبطة بالمؤمنين، بل هي أهم هذه الأمور.
ولا يُشكل على هذه المقدّمات الثلاث بعدم عمل المسلمين الأوائل بالشورى في الفتوى؛ لأننا نقول: إن سبب عدم عملها بها هو اعتقادهم بعدم إمكان تحققها في ذلك الزمن. كما أنه لا منافاة بين الشورى وبين الآيات الذامّة للأكثرية، لأنه لا منافة بين الآية التي تشير إلى أن أكثر الناس لا يعلمون فيتبعون ظنهم، وبين أن يتبع الناس رأي مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
وأما آية سورة آل عمران، فبنى الاستدلال فيها على مقدّمات أربع:
- أن تدل جملة [شاورهم] على الوجوب الشرعي لأنها صيغة أمر، وليست إرشادًا إلى حكم العقلاء حتى نحتاج إلى إثبات سيرة العقلاء على لزوم الشورى. فحمل الأمر على الإرشاد خلاف الأصل ومفتقر إلى دليل. ولو ادُعي القطع بدلالتها على الإرشاد، فإنه يُستفاد منها حسن الشورى على الأقل.
- أن لا تكون الآية مختصة بالنبي (ص)، بل تشمل سائر المسلمين.
- أن لا تكون كلمة [الأمر] المطبّقة على الحرب، مختصة بها، بل تكون شاملة للأمور التي لها صلاحية الشورى – بقرينة مناسبة الحكم للموضوع-، فتخرج عنها الأمور الحقيرة.
- أن يكون المفعول في جملة [فإذا عزمتَ] محذوفًا، ويُراد منه –بقرينة الآيات السابقة واللاحقة- الأمر المُراد التشاور فيه.
وبسبب ورود بعض الإشكالات على هذه المقدّمات، ذهب الكاتب إلى عدم إمكان الاستدلال بهذه الآية على الشورى في الفتوى؛ بخلاف الآية الأولى. ثم أشار إلى وجود آيات أخرى تدل على حسن المشاورة دون الشورى.
وبعد أن أنهى البحث القرآني، شرع في البحث الروائي، فقسّم الروايات المرتبطة بالمشاورة إلى طوائف، والروايات المرتبطة بالشورى إلى طوائف أيضًا. فمن الطوائف المرتبطة بالمشاورة: ما وردت فيه المشاورة بصيغة الأمر، وما بُيّن فيها فائدة المشاورة، ما أشارت إلى مشاورات الرسول (ص) في إدارة أمور المسلمين. ويرى أن هذه الروايات إما متواترة أو مستفيضة، فلا حاجة للبحث عنها من حيث السند. وأشار إلى أنها غالبًا ما لا تدل على أزيد من بناء العقلاء على مشاورة أهل الخبرة. ثم ذكر بعض الطوائف المرتبطة بالشورى: فمنها ما دل على الشورى وترجيح رأي الأكثرية، ومنها ما ورد فيه لفظ الشهرة المنسجم مع الأكثرية. وخلص إلى أن دعوى استفادة الشورى في الفتوى من الروايات المذكورة محل إشكال. ولو تمّ دليل عليها، كبناء العقلاء، فإن هذه الأدلة تكون مؤيدة لترجيح رأي الأكثرية في صورة التعارض.
وبعد ذلك، عرّج المؤلف على سيرة العقلاء فيما يرتبط بالشورى والمشاورة. فكما ميّز في المعنى اللغوي بين الشورى والمشاورة، بيّن هنا أيضًا نحوين من سيرة العقلاء، مع الإشارة إلى أنه لا ملازمة بين البحث اللغوي وبحث السيرة. ولفت إلى أن سيرة العقلاء تصلح دليلًا على المدعى فيما لو لم يردع الشارع المقدّس عنها. ويرى أن الآيات والروايات إن لم تكن كافية في إثبات وجوب الشورى، فإنها لا أقل تمضي سيرة العقلاء في باب الشورى. وسيرة العقلاء تدل على لزوم الشورى في مورد الفتوى أيضًا. وإن نوقش في هذا الدليل أيضًا، فإنه لا يُناقش في جواز الشورى أو حسنها، فتدخل في منطقة الفراغ الولائية، وبالتالي يمكن جعلها لازمة من قبَل وليّ الأمر. وهذا ما يقبله حتى الذين لا يقولون بولاية الفقيه المطلقة.
وأما الفصل الثاني (المعنون بـ “مناقشة أدلة الاجتهاد والتقليد ونسبتها مع شورى الفتوى”)، فبدأ فيه بمناقشة أدلة الاجتهاد والتقليد، وملاحظة سعتها وضيقها بالنسبة لمسألة حجية الفتوى. ثم بحث نسبتها مع شورى الفتوى، فيما لو دلّت هذه الأدلة على حجية الفتوى. ولم يُلاحظ في هذا الفصل صورة اختلاف الفتاوى، أو كون أحد المجتهدين هو الأعلم، بل صبّ بحثه على حجية الشورى في إصدار الفتوى، وأوكل البحث عن هاتين الصورتين إلى الفصل اللاحق.
ومن الآيات التي بحث عن دلالتها على حجية الفتوى: آية السؤال (الآية 7 من سورة الأنبياء)، وآية النفر (الآية 122 من سورة التوبة). وبيّن أن الاستدلال بآية السؤال على جعل الحجية لفتوى الفقيه، متوقف على مقدمات ثلاث:
- أن يكون لفظ [أهل الذكر] شاملًا للعالمين بالقرآن والسنة. وبالتالي، يمكن الرجوع إلى الفقهاء لسؤالهم عن الفقه والأحكام، فيكونون من مصاديق أهل الذكر.
- أن يكون المراد من الإلزام بالسؤال هو وجوب العمل تعبّدًا على طبق الجواب، وليس المراد تحصيل العلم.
- أن يكون مفعول [فاسألوا] محذوفًا، فيدل حذف المتعلق على العموم. وبالتالي، ترجعنا الآية إلى أهل الذكر في كل مسألة، مما يشمل الأصول والفروع.
لكن المؤلف يرى عدم إمكان الاستدلال بهذه الآية على جعل الحجية التعبدية لقول الفقيه، إلا أنه يمكن أن تكون الآية ناظرة إلى حكم عقلائي كلّي، بحيث ينطبق على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل مسألة – بما في ذلك الأصول والفروع- وبالتالي، يكون الدليل شاملًا لحجية فتوى الشورى.
وأما آية النفر، فقد أشكل أكثر علماء الأصول على الاستدلال بها على إثبات الحجية التعبدية. وخلص المؤلف إلى عدم إمكان الاستدلال بها على جعل الحجية التعبدية لقول الفقيه.
ثم تعرّض للروايات، فبيّن دلالة الكثير من الروايات على حجية فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، لكنه بحث عن مدى سعتها وضيقها فيما يرتبط بحجية شورى الفتوى. فقسّم هذه الروايات إلى طوائف: ما أرجع إلى عنوان عام (كرواة أحاديثنا والمسنّ في حبنا)، وما أرجع إلى أفراد محددين (كالإرجاع إلى عثمان بن سعيد وابنه، وتأييد فتوى معاذ بن مسلم النحوي، وأمر القُثَّم بن عباس بالإفتاء، والإرجاع إلى محمد بن مسلم الثقفي والحارث بن المغيرة وزكريا بن آدم ويونس بن عبد الرحمن)، وما دل بالملازمة عى حجية رأي الفقيه لعموم الناس. وقد أثبت من خلال بعض هذه الروايات أصل حجية تقليد شورى الفقهاء، في مقابل من ينفي حجيته مطلقًا. لكن هذه الروايات لا تكفي للمنع عن الرجوع إلى فرد واحد، بل إثبات ذلك يحتاج إلى دليل متمّم، وهو ما سوف يذكره في دليل سيرة العقلاء.
ثم استعرض الدليل العقلي، وبيّن أن رجوع الجاهل إلى العالم حكم بديهي وجبلّي وفطري. وعقّبه بسيرة العقلاء، وبحثها من جهتين: من جهة كونها دليلًا للعامي على التقليد، ومن جهة كونها دليلًا للمجتهد على التقليد. وذكر في الجهة الثانية أن بناء العقلاء على لزوم الرجوع إلى شورى الخبراء لو دار الأمر بينهم، وبين الرجوع إلى فرد واحد. لكن ذلك متوقف على شرطين: الأول: أن لا يكون الرجوع إلى أهل الخبرة متعذّرًا؛ والثاني: أن لا يكون مورد الرجوع من المسائل السخيفة والتي يتسامح العقلاء فيها عادة. وهذان الشرطان متحققان فيما يرتبط بالدين، وبالتالي يلزم الرجوع إلى شورى الفقهاء المتخصصين، ولا يُعذر المكلف لو اكتفى بقول أحدهم طالما أن الشرطين متحققان. وبالتالي، يكون هذا الدليل متمّمًا لما دلّت عليه الروايات كما أشرنا.
وقد يُشكل على الاستدلال بسيرة العقلاء بأننا نحرز تأخر هذه السيرة عن زمن الأئمة (ع)، فلا نحرز عدم الردع، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها. وقد أجاب الماتن عن هذا الإشكال بعدّة أجوبة، منها: أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن الأئمة (ع)، ثم لو سلّمنا بعدم وجودها في زمنهم (ع)، إلا أنه يُحكم بحجيتها لأنه يجب على الأئمة (ع) أن يردعوا أيضًا عن السيرة غير المعاصرة لهم لأنهم (ع) يعلمون بأن الشيعة فيما بعد سوف يُبتلون بهكذا سيرة. ومنها: أنه يمكن أن يُستفاد من الأدلة حجية كل بناء عقلائي بتقريب: أن الروايات الدالة على حجية العقل، وأنه حجة في عرض الوحي، يُستظهر منها انطباقها على الجهة العقلائية للعقلاء أو شمولها لها.
وخلص إلى أن سيرة العقلاء في كل مسائل العلوم قائمة على العمل الجماعي والاستفادة من مختلف الآراء والأنظار. وهذه السيرة العامة مؤيدة من الشرع الإسلامي، غاية الأمر أن مصاديقها تختلف من زمان إلى آخر. وألفتَ إلى مسألة وهي أن تعيين فرد خاص –كالأعلم- للرجوع إليه في علم الفقه، لهو أمر غير متعارف في سائر العلوم والفنون. فعندما يُتوفى الأعلم في أي علم من العلوم –كالطب والهندسة وغيرها- لا تراهم ينهمكون في الفحص عن الأعلم الحي. فهل ثمة فرق بين علم الفقه وسائر العلوم؟ وهل يصح هذا التفكيك بين علم الفقه وسائر العلوم؟
وأما الفصل الثالث (المعنون بـ “اختلاف الفتاوى”)، فبيّن فيه صورة اختلاف فتاوى المجتهدين. والإشكالية التي بحثها في هذا الفصل هي: لو حصل اختلاف بين أهل الخبرة، واطّلع العقلاء على هذا الاختلاف، فهل تقتضي الأدلة الرجوع إلى الأكثرية؟ أم تقتضي غير ذلك؟ فبحث المؤلف هذه الإشكالية من خلال بيان ثلاث صور:
- صورة تساوي المجتهدين. وبحث فيها نتائج أدلة حجية رأي الفقيه في حال تعارض رأيه مع الفقهاء المساوين له. ورأى أن بيان هذه الصورة يتوقف على بيان أدلة التخيير حال تعارض فتويين –بغضّ النظر عن مسألة الأعلمية- فذكر أدلة التخيير من إجماع وإطلاق دليل الحجية، وإطلاق إرجاع الأئمة إلى أفراد محددين، وفحوى أخبار التخيير في روايات التعارض وسيرة العقلاء. واستطاع أن يُشكل على أدلة التخيير كلها، فلم يتمّ عنده دليل على التخيير. وبناء عليه، لا يمكن لهذه الأدلة أن تنفي الالتزام بالشورى. ولو تمّت بعض الأدلة، فهي تتم فيما لو لم يكن ثمة مرجحات عقلائية كأكثرية أهل الخبرة. ومن البديهي أن القول بالتساقط لا يحتاج إلى دليل، ففي صورة عدم وجود مرجح، يكون الأصل في التعارض هو التساقط. وأشار في نهاية هذه الفقرة من البحث أنه يبعد عدم وجود مرجحات كمية أو كيفية.
- شرط الأعلمية. وبحث فيه أدلة هذا الشرط، وعلاقته مع شورى الفقهاء. فلو لزم اتباع رأي الأعلم، فإن لم يكن الأعلم في الشورى، كان رأي الشورى فاقدًا للاعتبار؛ وإن كان في الشورى وفي الأقلية، لزم اتباع رأيه أيضًا. فعلى كل حال، دليل حجية قول الأعلم يمنع من التمسك برأي الشورى. لذا لا بدّ من التعرّض لشرطية الأعلمية. فذكر أولًا لمحة تاريخية عن مسألة الأعلمية، ثم قسّم بحث الأدلة إلى قسمين لأن الأدلة في الكتب الأصولية طائفتان: أدلة على ترجيح قول الأعلم، وأدلة على التخيير بين الأعلم وغير الأعلم. فذكر خمسة أدلة على ترجيح قول الأعلم، وهي: الأخبار، الإجماع، الأقربية والأقوائية، بناء العقلاء، دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ووصل إلى أن الأدلة اللفظية والأدلة اللبية غير آبية عن شمول الشورى، واستنتج بأن الأعلمية لا يمكن أن تكون إشكالًا مانعًا من التمسك بالشورى. ثم تعرّض لأدلة التخيير من: إطلاق الأدلة اللفظية وفحوى أخبار التخيير والإطلاق المقامي وصعوبة شرط الأعلمية. واستنتج عدم تمامية أدلة شرط الأعلمية. بل لو تمت، فهي تدل من باب أولى على نظرية الشورى. وبناء عليه، حتى لو لم تتم دلالة الأدلة اللفظية –كآية الشورى- على الشورى، فإن شرط الأعلمية لا يمكن أن يكون مانعًا من القول بها.
- رأي الإسلام في اختلاف الآراء والأنظار. وبحث فيه حسن اختلاف الآراء أو قبحها من وجهة نظر الإسلام. فذكر أن البعض يعتقد أن اختلاف الفقهاء رحمة، وسبب هذا الاعتقاد هو الاستناد إلى حديث “اختلاف أمتي رحمة”. فعرض المؤلف الروايات الدالّة على هذا المضمون وناقشها، فبيّن احتمالين في الروايات: فكما يُحتمل أن يكون الاختلاف بمعنى الاختلاف في الآراء والأنظار، كذلك يُحتمل أن يكون المراد من الاختلاف هو الرجوع والسؤال من أجل التعلّم. وخلص إلى أن الشواهد تدل على ذم الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وأن المسلمين مكلّفون –حتى المقدور وبواسطة الطرق العقلائية- أن يجتنبوا عن هذا الاختلاف. نعم، هذا الذم يأتي عندما ينسحب الاختلاف النظري إلى ساحة العمل فيوجب شق الصفوف. أما لو بقي الاختلاف على المستوى النظري، وكان ثمة معيار صحيح لاختيار أحد الآراء لتطبيقه في ساحة العمل، فلا شك في أن هذا الاختلاف سبب لترقي العلوم وتكاملها.
وأما في الخاتمة، فتعرّض لإحدى المشكلات الجدية في المجتمع الإسلامي وهي العلاقة بين ولي الأمر وبين سائر المراجع. ورأى أنه يلزم تقديم ولاية الولي على فتوى المرجع في مقام العمل. وأشار في النهاية إلى بعض الاقتراحات العملية المرتبطة بشورى الفتوى، من قبيل: انتخاب الأعضاء، وكيفية عمل الشورى (فذكر لها ثلاث مراحل)، وعلاقة الشورى مع الولاية (وبيّن فيها صورتين لمشاركة ولي الأمر في شورى الإفتاء).
وقفة نقدية.
لا يخفى أن ما قدّمه الكاتب هو جهد مبارك، لكن سنح في بالنا ملاحظات على ما كتبه، نذكر بعضها ونؤجّل بعضها الآخر إلى فرصة أخرى:
- استدل الكاتب على لزوم الشورى بكون الشورى في آية [وأمرهم شورى بينهم] صفة لازمة للمؤمنين. وهو يريد من الشورى: الخروج بنتيجة واحدة هي حاصل رأي الأكثرية. وهنا نسأل: لماذا حمل الكاتب لفظ [الشورى] على هذا المعنى الذي بيّنه ولم يحمله على التشاور؟ والمستفاد من اللغة في معنى الشورى هو استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض الآخر، وليس فيه ما يدلّ على لزوم الأخذ بقول الأكثر!
- استدل الكاتب على لزوم الشورى بإمضاء الآيات لسيرة العقلاء في المقام. ولكنه فرع أن تكون الآيات ناظرة إلى هذه السيرة. وهذا يبتني على حمل لفظ الشورى الوارد في الآيات على المعنى الذي بيّنه الكاتب للشورى، وهذا ما استبعدناه في النقطة السابقة.
مضافًا إلى أننا لا نسلم وجود هكذا سيرة بين العقلاء. وإن شئت لاحظ العقلاء كيف يعتمدون في نظامهم على المستشارين فيأخذون برأيهم، لكن مع ذلك تنحصر وظيفة المستشار في النصح وإبداء الرأي، وليس المستشير ملزَمًا بالعمل بقول الأكثرية.
- لقد غفل الكاتب في بحثه عن العديد من الآيات القرآنية التي تنفع في هذا البحث. وسوف نبيّن كيف يمكن أن يُستدل بها على عدم لزوم الشورى، وإن كان يمكن بيان تقريبات أخرى لها. ومن هذه الآيات نذكر:
- ﴿قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾[5]، إذ من الواضح في هذه الآية أن بلقيس استشارت قومها، فأشاروا عليها، وتركوا الحكم لها لأنهم يعلمون أن وظيفتهم تنحصر في إبداء الرأي، ولا يجب أن يكون القرار تابعًا لما يراه أكثرهم.
- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾[6]، إذ تدل هذه الآية على أنه لو أُلزم رسول الله (ص) باتباع رأي أمته لوقعت في العنَت والمشقة.
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[7]، حيث إنها تنهى عن التقدّم على رسول الله (ص). والقول بلزوم الأخذ بحكم الأكثر هو نوع من أنواع التقدّم على الرسول (ص) إن كان معارضًا لرأيهم.
والحمد لله رب العالمين
[1] انظر: موقع المؤلف على صفحة الإنترنت: https://www.shahriari.ir/bio-abs؛ تاريخ زيارة الموقع: 11/ 3/ 2018.
[2] سيتضح فيما بعد أن الكاتب قد فرّق بينهما، فانتظر.
[3] ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [36] وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ [37] وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [38].
[4] فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [159]﴾.
[5] سورة النمل: الآية 33.
[6] سورة الحجرات: الآية 7.
[7] سورة الحجرات: الآية 1.
المقالات المرتبطة
مطالعة في كتاب الإسلام والمسلمون في الصين.
السؤال الكبير هو عن كيفية تعامل السلطة التي يمسك بها الحزب الشيوعي الصيني منذ العام 1945 مع الإسلام في الصين؟
مطالعة في كتاب: الإصلاح الإسلامي في الهند
ثلاث رؤى للدولة الإسلامية الموعودة الكتاب: الإصلاح الإسلامي في الهند: الدولة في فكر شيراغ علي- محمد إقبال – أبي
قراءة في كتاب “الغرب: الشباب في معركة المصير”
إنّ ما يُقال عن الإسلام ليس كما يصوّرونه، فالجماعات التكفيريّة لا تمثّل الإٍسلام البتّة. هم لا يعادون الشيعة فقط بل يعادون الإنسانيّة ككلّ. يشوّهون صورة الدين الرحمانيّ الذي أتى به محمّد (ص) “إنّا أرسلناك رحمة للعالمين”.