تلخيص كتاب وصايا الإمام الصادق للسالك الصادق
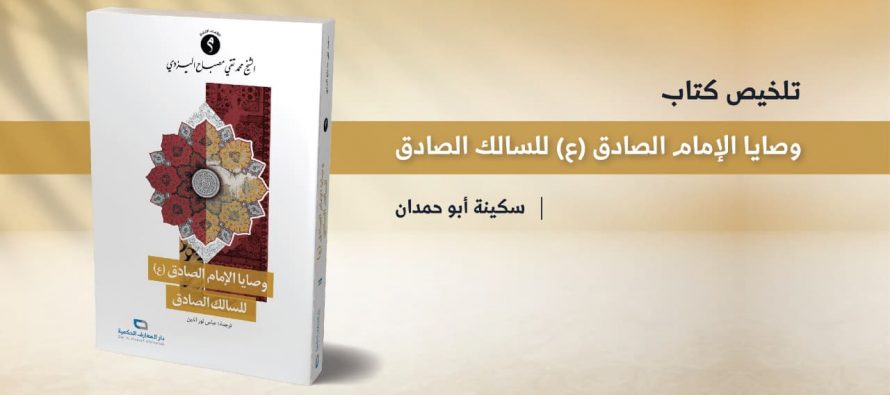
يعدّ هذا الكتاب الإصدار السادس من سلسلة الأعمال الكاملة لآية الله محمّد تقي مصباح اليزدي (رحمه الله) التي أخذ دار المعارف الحكميّة على عاتقه ترجمتها ونشرها تباعًا. وهو كغيره من كتب الشيخ التي تتناول وصية من وصايا أهل بيت النبوّة (ع)، فيشرحها الشيخ بأسلوبه العذب وكلماته التي تدخل صميم القلب، ولا تخرج منه إلّا بترك بصمة حبّ إلهيّ يسمح بإزالة بعض أدران المادّة وتلوّثاتها.
وكما تسمية الكتاب، فهو عبارة عن شرح وصيّة للإمام الصادق (ع) أوصى بها عبد الله بن جندب في ثمانية وعشرين درسًا، وهي تحمل في طيّاتها الكثير من الدروس والعبر التي تعين السالك في رحلته التكامليّة. وقد عكف أهل بيت النبوّة (ع) على هذا النوع من الوصايا، والتي لا تعني الشخص الموصى إليه وحده، بل هي عبارة عن دستور حياة يلقيها النبي (ص) أو الإمام (ع) على تلميذ من تلامذته أو وصيّ من أوصيائه، وهو يقصد أن يستفيد منها كلّ سالك يريد وجه الله تعالى بصدق.
يبدأ الكتاب بعرض نصّ الوصية كاملةً، ثمّ يفنّدها مقطعًا مقطعًا، ووصيّة وصيّة شرحًا وتفصيلًا.
يشير الإمام الصادق (ع) في بداية الوصيّة تحديدًا لأولياء أهل بيت النبوّة (ع) الحقيقيّين ومطاردة الشيطان لهم على الدوام، وأنّهم مَن يسعى جاهدًا لإيقاعهم في حبائله، وهذا ما يناله لأنّهم يتّصفون بأوصاف منها:
- عظمة الآخرة في أعينهم، فلا يقايضون على الأمور الأخرويّة، ولا يستبدلونها بما هو زائل دنيويّ.
- نورانيّة قلوبهم، والطاقات المعنويّة التي يدّخرونها، وتستقرّ في أرواحهم، وهي التي تدفعهم للإعراض عن زخارف الدنيا وملذّاتها.
- اجتنابهم للنزعة الدنيويّة، وانصرافهم عنها لأنّها تمثّل بالنسبة إليهم الأفعى السامّة والعدوّ الذي يبتعدون عنه.
- أُنسهم بالله باعتباره المحبوب الأصلي، فيستوحشون بغيره، وينصرفون عمّا سواه.
يرى الشيخ المصباح أنّ التقرّب إلى الله تعالى دافع فطريّ أصيل في النفس الإنسانيّة. وإنّ ضالّة الإنسان هي القرب من الله سبحانه، فيسعى إلى تحصيل الكمالات المعنويّة والمقامات العالية على نحو انسيابي. هذا الميل الفطري تجلّى في أبهى صوره ومراتبه في الأنبياء والأولياء، وأعظمهم الرسول الأكرم محمّد (ص) والأئمّة الأطهار من بعده، وفي كلّ إنسان يسعى لاتباعهم وسلوك الطريق الذي سلكوه.
إلّا أنّ هذا الطريق محفوف بالبلاءات والمصاعب والمعوّقات، وكلّما ارتقى الإنسان في سلّم التكامل يصبح خطر السقوط أشدّ وأقسى. لذا، على السالك أن يلتفت إلى عدوّه الأكبر، وهو الشيطان الذي يسعى جاهدًا لحرف مسار الإنسان عن الخطّ الصحيح. هذا العدوّ الذي لا يعنيه المنحرف بقدر ما يسعى جاهدًا للإيقاع بأولياء الله، وكلّما ازداد المرء إيمانًا، كلّما بذل طاقته لنصب حبائله أكثر.
هذه القاعدة التي بنى عليها الإمام (ع) قاعدته؛ ليبدأ بعرض ما يعين هذا السالك في رحلته نحو الله، وليوجّه تفكيره دائمًا نحو عدوّه الأوحد.
وبناءً على هذه القاعدة في التنبّه الدائم للعدوّ المتربّص، يطرح (ع) قاعدة أخرى، وهي محاسبة النفس الدائمة في كلّ يوم وليلة “فإن رأى حسنةً استزاد منها، وإن رأى سيّئة استغفر منها”. ولم يكن موضوع محاسبة النفس جديدًا، فقد تمّ التركيز عليه في الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت (ع) جميعهم.
وتكمن أهميّة هذا العمل في المراقبة الدائمة للنفس والإشراف عليها، ووضعها الدائم في حالة ترقّب للأعمال والتصرّفات؛ لأنّ الإنسان إذا ترك نفسه على هواها، فإنّها ستجنح. وقد عدّ العلماء مؤلّفات عدّة في هذا المجال، وقدّموا البرامج المفيدة في هذا المضمار. ورسموا أربع مراحل لمحاسبة النفس:
- مرحلة المشارطة، وهي أن يشارط الإنسان نفسه في أوّل اليوم أن يؤدّي التكليف، ولا يرتكب الذنب.
- مرحلة المراقبة، وهي أن ينظر المرء في أعماله، ويراقبها كي لا يخالف ما اشترطه على نفسه.
- مرحلة المحاسبة، وهي التي تكون في آخر النهار، فيرى في عمله مدى الالتزام بالمسؤوليات والوقوع في التقصير.
- مرحلة المعاتبة، وهي أن يعاتب المرء نفسه حين يجد فيها زللًا أو خطأً، فيلزم نفسه بعمل خير كي يجبر ما فات.
كما يعرض الشيخ اليزدي نقاط مهمّة في محاسبة النفس، ومنها: أنّ اجتناب المعصية تستلزم التعرّف إلى المعاصي وكذلك الحسنات، ومعرفة التكاليف والواجبات التي أمرنا بها الباري. إذ كيف يمكن للسالك العارف أن يجتنب ما لا يعرف ضرره وقبحه، أو يعمل ما لا يعلم. وهذا الأمر لا ينحصر فقط في التكاليف العباديّة كالصلاة والصوم مثلًا، بل ذلك ينسحب على الأمور الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية والعسكرية وغير ذلك. ومنها أيضًا الالتفات إلى ذات الباري تعالى وعظمته، وليس إلى حجم المعصية والذنب حتّى لا يستصغر ذنوبه، ويراها بحجم مَن يعصيه.
ولا تنحصر المحاسبة في الواجبات والمحرّمات فحسب، بل المحاسبة حتّى فيما يتعلّق باجتناب اللغو والشبهات والمكروهات. فأولياء الله تعالى، أو السالكون إليه لا يكتفون بالقليل من الزاد المعنوي، ويطمحون لأكثر من ذلك، إلى المقامات العالية، وهي بطبيعة الحال تحتاج إلى جهد مضاعف للوصول.
ثمّ يضيف الشيخ أنّ من المسائل التي ركّز عليها القرآن الكريم هي أهميّة استحقار الإنسان للدنيا واستصغاره لها وفنائها، وأنّ الآخرة هي خيرٌ وأبقى. وليس المطلوب في ذمّ الدنيا الإعراض عنها بتاتًا كما يعرض بعض الذين يسمّون أنفسهم بالزهّاد. فالدنيا هي دار تكليف، ولا ينبغي للمؤمن أن لا يراها غير ذلك. وهي الدار التي من خلالها يمكن له أن يرتقي في سلّم الكمالات، ويحقّق رضا الرحمن. لكن ما هو مذموم هو الانغماس في ملذّاتها التي تبعده عن الهدف الأساسي من خلقه. فيمكن له أن يرتوي من الدنيا بما يحقّق له السَّكينة والرزق الحلال، وتلبية الشهوات بما يرضي الباري تعالى. حتّى الحصول على المال فيها، ما هو مذموم هو الانغماس بمفاتنها، وإلا فالتنعّم بحلال الله هو أمر مطلوب، وكذلك يمكن لهذا المال أن ينفع في تبليغ دين الله كما كان لمال خديجة أثر في الإسلام.
والمؤمن في الحياة الاجتماعية وغيرها هو نموذج للإنسان الإلهي الذي يؤثّر في الآخرين، ويدفعهم لعمل الخير وأداء التكليف. ولا شكّ أنّ العلاقات المتبادلة والمتفاعلة فيها من التأثّر والتأثير من الجوانب كافة، إن من ناحية القول أو من ناحية الفعل، وإن كانت هذه التأثيرات على الصعيد الكلامي بنسبة أكبر.
هذا في الشكل العام، لكن في الحديث عن الدعوة وضرورة التبليغ الجيّد، فإنّ الالتفات إلى القول والفعل يكون أوجب من أيّ شيء آخر، وإنّ السلوك الفعلي أو الكلامي يصبح حينها محسوب بشكل أعمق. وإنّ الداعي إلى الله عليه أن يتوجّه إلى القوم بما يليق بهم من الفهم والاستيعاب، ومراعاة قدراتهم العقليّة، واستعداداتهم الذهنيّة وقابلياتهم المعرفيّة، وهذا الأمر يشدّد عليه اليزدي في تفسيره للوصيّة. فمن المنطق أن نحدّث القوم بما يستطيعون فهمه، فما الفائدة مثلًا من عرض معارف عالية ومضامين كلاميّة على أحد لا يمكنه فهم حتّى الكلمات التي تُقال؟ وما الذي يمكن أن نحصّله حينها؟ ولا يمكن أن نحقّق الهدف من الدعوة بهذه الطريقة، وقد علّم أئمّة أهل البيت (ع) أن نحدّث الناس على قدر عقولهم حتّى نحصل على النتيجة المتوخّاة من ذلك.
وليس هذا فقط، بل هناك من الأسرار أو الكلام الذي يفوق قدرة التحمّل يجب الالتفات إليه، وإلى الأسلوب الصحيح الذي تُعرض فيه المسائل. وهناك شرط أساسي للتأثير بالآخر هو انطباق القول مع الفعل “كانوا دعاة لنا بأعمالهم ومجهود طاقتهم”.
كما يطرح الإمام الصادق (ع) في القسم الآخر من الوصية مسألة مهمّة، وهي كيف يمكن للفرد أن يميّز بين الإيمان الحقيقي والإيمان الظاهري، ومقابله الكفر أيضًا.
ولأجل التفكيك بين الإيمان الظاهري والإيمان الواقعي، عبّر الشيخ اليزدي عن الإيمان الظاهري بالإسلام، وهو الإظهار اللفظي وأداء الأعمال الظاهريّة والتظاهر الخارجي، في حين أنّ الإيمان يرتبط بالباطن والقلب، وفي ذلك مراتب كثيرة ودرجات يحصّلها الإنسان كلّما سعى لتحقيق الإيمان الواقعي من جميع الجهات. ومن تلك العلائم: ذكر الله على الدوام، في حالة سير وسلوك لا يهدأ، التوكّل على الله في كل حال، والخوف الدائم من السقوط، ما يجعله في حالة تيقّظ دائم لئلّا يقع في مهالك الشيطان.
ولكي يحافظ الإنسان على إيمانه، ينبغي له أن يحصّن نفسه من الجهل. والجهل بحسب المفهوم القرآني هو جهل بالهدف من الحياة والخلقة والمآل، وجهل في العلوم والمعارف التي أتى بها أنبياء الله تعالى؛ ليعينونا على سلوك الطريق الصحيح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكمن الجهل أيضًا في أولئك الذي يستغلّون دينهم ويجعلوه وسيلة للعب وتحصيل المعاش وغيره من الأغراض الدنيويّة، كحال المسيحيين حين روّجوا لعقيدة التثليث، وجعلوها أصلًا في إيمانهم برغم عدم مقبوليّة العقل لها إذا عُرضت عليه.
بناءً عليه، فإنّ مسؤوليّتنا تجاه المجتمع هي في تبيان هذه العقائد الخاطئة، وترويج العقائد الصحيحة بالإضافة إلى شياع السلوكيّات الجديّة والواقعيّة التي تجعل الناس يقبلون على الدين، ولا ينفرون منه ومن ممارسات المتديّنين. وأفضل ما يمكن أن يقوم به الفرد منا أن يلزم الاستقامة، وهي تعني الالتزام الصحيح بالمسؤوليات الدينيّة والتمسّك بالعقائد وعدم الخروج عن الصراط المستقيم.
فصحيح أن البشر يختلفون في تحديد معنى السعادة وسُبُل الوصول إليها، إلّا أنّ جميعهم يرجونها، وينشدونها. منهم من يراها في اللذائذ الدنيويّة العابرة، ومنهم من يدرك زوال هذه اللذائد، ويعلمون أنّ السرّ يكمن في القرب من الله تعالى. إلّا أنّ طريق السير محفوف بالمصاعب التي لا بدّ من اجتيازها برضا وثقة أنّ الله تعالى لا يضيع أجر الساعي إليه. فلا يكفي مجرد الإيمان بالله وقبول الدين الحقّ ومذهب أهل البيت (ع) لتحصيل السعادة، بل يجب الاستقامة على هذا الطريق، والتنبّه من عدم السقوط.
ومن شروط السعادة أيضًا تلازم الإيمان والعمل، وتولّي أهل بيت النبوّة (ع). ومن الأمور الملفتة التي يشير إليها الشيخ اليزدي في بيان شرح وصية الصادق (ع) هي التحذير من الإساءة إلى شيعة أهل البيت (ع) ولو كان يرى فيهم خطأً، أو أن ينعتوهم بأنّهم من أهل جهنّم، بل يجب أن ندعو لهم بإخلاص لكي يوفّقهم الله للتوبة وترك المعاصي. فليس جميع الناس معصومين، وإذا وجدنا بعض الصفات القبيحة بشخصٍ ما فلا ينبغي لنا أن نسبّه، بل ينبغي أن نحرص عليه ونعطف ونسعى لإرشاده، ونتضرّع إلى الله لتوفيقه بترك تلك الذنوب. وعلى المؤمن أن يحافظ على دينه، ويحفظه من التشتت لكي يخرج من هذه الدنيا نقيًّا طاهرًا يستحق رحمة الباري وشفاعة المعصومين (ع).
ثمّ يحدد الإمام الصادق (ع) الناجي من العذاب الإلهي؛ فلا هو المتّكل على عمله، ولا هو المتجرّئ على الذنوب الواثق برحمة الله، بل هو ذلك الذي يتردّد بين الخوف والرجاء؛ خوف لا يصل حدّ اليأس، ورجاء لا يتعدّى الجرأة على ارتكاب الذنوب، فهما – الخوف والرجاء – ككفّتي الميزان متعادلتان.
لقد خلق الله الإنسان مختارًا، يعمل بإرادته على أداء تكليفه الذي أراده الله، وعلى اجتناب ما نهاه عنه، إلّا أنّه يحتاج بطبيعة خلقته إلى الدافع الذي يحثّه على أيٍّ منهما. ويكمن أهميّة موضوع الخوف والرجاء في كونه عاملًا محرّكًا للإنسان نحو عملٍ ما أو الابتعاد عنه. وهذا يستلزم بالطبع وجود نوع من التوازن والتعادل بين هذين العاملين، وإلّا اختلّ النظام، ولم يؤدِّ الغاية منهما. ويتجلّى الخوف والرجاء في أبهى صورهما عند المعصومين، فبالرغم من أنّهم يعلمون مكانتهم عند الله، يتوجّهون بالخوف إلى صفة القهّاريّة الإلهيّة، وبالرجاء إلى الصفات الجماليّة لله، ما يجعل كفّة الميزان متعادلة في هاتين الصفتين، ويؤدّيان أجمل ما يريده الله منهم.
ومن المسائل التي تعدّ من العبادات الكبرى عند الله تعالى هي إدخال السرور إلى قلب الأخ المؤمن. وقد ورد ذلك في الكثير من الروايات بالإضافة إلى قضاء حاجته. والساعي في حاجة أخيه المؤمن كالساعي بين الصفا والمروة على حدّ تعبير الإمام الصادق (ع)، وقاضي حاجة المؤمن سيكون له ثواب من جاهد في سبيل الله في بدر وأُحُد، وتشحّط بدمه.
وإذا كان الفرح والسرور هو أمر فُطر عليه الإنسان، يطلبه وينشده دومًا، فليس كل فرح وسرور في الدنيا مطلوبين، بل فقط الفرح الذي يعين السالك على الحركة التكاملية إلى الله. وقد يكون الحزن أحيانًا هو المطلوب في هذه الرحلة؛ الحزن الذي يوجّه الإنسان إلى الله، ويُلفت نظره إلى الآخرة وإلى المسؤوليات الشرعيّة والاجتماعية الملقاة على عاتقه.
ومن الموضوعات التي يعرضها الإمام (ع) في وصيّته لابن جندب، والتي أكّد عليها علماء الأخلاق وأهل السير والسلوك اجتناب كثرة النوم وكثرة الكلام، فقد عدّوا هذين الأمرين من المعوّقات الشائعة أمام الوصول إلى الكمال المعنوي. فكثرة النوم تورث الكسل والخمول والانصراف عن تأمين مصدر العيش بالكدّ والتعب. وكثرة الكلام دون منفعة هي عادة قبيحة تجعل الأشخاص الذين يعتادون على ذلك لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم بسهولة.
والحلّ هو في الاعتدال في كلّ شيء ولا سيّما بهما، فلا إفراط ولا تفريط؛ فيتخذ من النوم معينًا له حتّى يتمكّن من أداء واجباته وأموره على نحو جيّد، وكذلك في الكلام، فلا ينبغي للسالك أن يكثر من كلام لا نفع فيه دون جدوى.
كما إنّ من أكبر مصائد الشيطان التي يتصيّد بها الناس هي منع الناس من خدمة الآخرين وخصوصًا إخوانهم في الدين، وانصرافهم عن ذلك بحجج واهية من قبيل عدم المقدرة أو عدم استحقاقهم، وعدم أداء الصلوات في أول وقتها ممّا يؤدي إلى استهزاء بالواجبات والانحراف عن التكليف.
فلا ينبغي للمؤمن أن يكون همّه سوى آخرته وقربه من الله تعالى، لأنّ الألم والعذاب من أي أمر آخر هو أمر نسبي، أمّا الهمّ من عذاب الآخرة فلا يمكن أن يزول إلّا بالالتفات إلى حضرة الباري، وهذا الأمر يعود إلى مدى يقين وإيمان الفرد بما حدّث عنه سبحانه من جهنّم وعذاباتها.
ويطرح الإمام (ع) كذلك قضيّة في غاية الأهميّة في الحياة عامّة هي قضيّة الحسد؛ “ومن حسد مؤمنًا انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء”؛ لأنّ حسد الآخرين على ما أتاهم الله من نعم يعود في الحقيقة إلى الاعتراض على فعل الله، وهذا يتنافى مع الإيمان. وإذا لم يلتفت المرء باكرًا إلى وقع هذه المفسدة الأخلاقيّة فإنّ نتيجة ذلك سوف يكون هو الكفر، وقد كان أساس كفر إبليس هو حسده.
كما يحذّر الشيخ اليزدي بناء على شرح الوصية بأنّ هناك نقطة مهمّة على الشيعة أن يلتفتوا إليها، وهي أن لا ينخدعوا بخدع الشيطان بسبب الغفلة عن تحقّق الوعود الإلهيّة فيحصل الاستغلال السيء لهذا الأمر.
ويعرض الإمام (ع) الخصال التي تميّز الشيعي عن مجرّد محبّ لهم، ومن هذه العلامات:
- بسط اليد تجاه الإخوة المؤمنين: هم أهل جود وكرم وسخاء، لا يتوانون عن قضاء حاجة من يطلب منهم ومن لا يطلب سواء إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.
- صلاة إحدى وخمسين ركعة: سبعة عشر ركعة واجبة، وضعفاها من النوافل في الليل والنهار.
- عدم الهرير والطمع، وهي من صفات الحيوانات المنبوذة عند الإمام (ع)، ومفادها أنّهم لا يتوجّهون إلى أذية الآخرين، ولا يجمعون من المال والثروة ما يزيد عن حاجتهم.
- عزّة النفس مقابل أعداء أهل البيت (ع) والابتعاد عنهم: فلا يستعينون بالفسّاق ومبغضي أهل البيت (ع) لقضاء حاجاتهم ولو ماتوا جوعًا.
- الالتزام بفتاوى أهل البيت (ع) في جميع الأحكام، فيلتزمون بما أمر الله وأجازه من الحلال ويبتعدون عن الحرام.
- الانغماس في الأنشطة الاجتماعيّة والبرامج العباديّة، بل هم سبّاقون إلى الخير، وحاضرون في كلّ الساحات لتقديم الخدمات والتضحيات.
وهم كذلك يحفظون هويّتهم الشيعيّة، وينتسبون بحقّ إلى أئمّة أهل البيت (ع)، لا يتركون الأمور المستحبّة ولو كانوا في دول غير إسلاميّة، ولا يتذرّعون للتهرّب من واجباتهم الاجتماعيّة والسياسيّة والأخلاقية، ولا يتركون أمرًا يقرّبهم من الله إلّا ويخوضون غماره.
فإنّ الله يغفر الذنوب جميعًا إلّا الشرك به، وطبعًا هذا يعني أن ينتقل الإنسان من هذه الدنيا وهو على هذه الحالة، لا بمعنى أنّه لا يمكنه أن يعود عن شركه إلى الإيمان في حياته، وإلّا فإنّ رحمة الله تسع كل شيء.
كما أنّ الله يقبل جميع الأعمال إلّا ما كان رياءً لا يبغي المرء فيه وجه الله. ويشير الإمام (ع) إلى قاعدة أساسيّة هي “أحبب في الله وأبغض في الله”، فلا يكفي أن تكون الأعمال والسلوكيّات الظاهريّة لله فحسب، بل حتّى الحب والبغض ينبغي أن يكون بدافع إلهي. وينبغي للمرء أن يعتصم بحبل الله لأنّه الحبل الأوثق الذي يمكن للإنسان أن يتّصل به ويقيه من شرّ الوقوع، وينجيه من المهالك الدنيويّة والأخرويّة.
ثمّ إنّ الإيمان على مراتب، كما وسبق ذكره، فتتفاوت معرفة الناس بحقائق الدين كما تتفاوت هممهم. وبحسب الهدف الذي ينشده السالك يكون سلوكه وسعيه. لذا، يشير الإمام الصادق (ع) إلى أنّ من يبغي مجاورة الإله ونيل المراتب العليا، فمن لوازم الوصول إلى مثل هذا المقام أن يهيّئ السالك مقدّماته في الدنيا. لازم ذلك أن تهون الدنيا في عينيه، ولا ينظر إلى ملذّاتها على نحو الرغبة فيها، وأن يكون دائم الذكر للموت والرغبة في الاستزادة من زاد الآخرة.
ويطرح (ع) عدّة وصايا أخلاقية تعين على نيل المراتب العليا، وهي:
- رفع الاضطراب في ظلّ الاعتماد على الله في كلّ شيء. فالله تعالى خالق العالم قادر على تأمين حاجاتنا دون اللجوء إلى الأسباب الماديّة، ولكنّه يضعنا في موضع الاختبارات والامتحانات الإلهيّة من أجل أن يوفّر لنا أرضية التكامل المعنوي.
- ضرورة الشكر والصبر في مقابل النعم من أجل أن تزداد، وفي مقابل البلاءات لكي يزداد الأجر والثواب.
- النظرة الصحيحة إلى مشاكل الدنيا على أنّها من أنواع المزعجات التي ستزول حتمًا، وحتّى النعم على أنّها لا تدوم، وهي عبارة عن أمانات وضعها الله بين أيدينا لكي نحافظ عليها ونردّها بأحسن حال.
كما ينبغي للسالك الصادق أن يدرك حقيقة الأفراد، ويلتفت إلى انعكاسات سلوكيّاتهم حتّى لا يقع في مكر الحاقد والمتملّق. وهذا الأمر يمكن أن يعالج في تنظيم العلاقات والمعاملات بين الناس بشكل صحيح وسليم، ويعتمد على الأسلوب الذي يتعاطى به الأشخاص في المجتمع من أقوال وأفعال، فلا ينخدع بكثرة الإطراء والمديح الذي يفتعله المتملّق لكي يتقرّب منه، وينال الحظوة. كما عليه أن يقوّي روحيّة تقبّل النقد، وبذلك يلقّن نفسه ويهذّبها ليفسح المجال أمام الآخرين لتوجيه الملاحظات، فيقبلها ويحسّن من أدائه، ويقطع المسافة على المفاسد الأخلاقيّة كالعُجُب والتكبّر.
وإنّ من أقبح الرذائل الطمع وعدم القناعة فيما عنده، وتعلّق القلب بالدنيا. والمؤمن الحقيقي هو ذلك الشخص الذي لا يرى في متاع الدنيا إلّا سببًا في بعده عن الله، فيزهد بكل ما فيها، ويرى في العمر فرصة لأداء التكليف، فلا يعنيه التعب طالما أنّه في سبيل تحصيل لقمة العيش بالحلال. كما أنّه لا يجمع الثروة ولا يعنيه كثرة المال إلّا من أجل مساعدة ومساندة الآخرين. ليس لأنّ الثروة في نظر الإسلام منبوذة، بل ما هو مرفوض أن تستولي فكرة جمع المال على المرء دون مراعاة الحدود الشرعيّة في ذلك، والبطر في استخدام الموارد المالية المتاحة.
هذا من ناحية الأمور العامّة، أمّا في العلاقات الشخصيّة بين الناس، فعلى السالك أن يكون طيّعًا غير واهن، بمعنى أن يتصرّف بطريقة تجعل الناس يرغبون في التعامل معه، ويقبلون منه النصيحة، ولا مانع أن يكون ذا مكانة اجتماعية مرموقة ما لم يؤثّر ذلك على سلوكيّاته التكامليّة، فيسخر ممّن هم دونه ويحقّرهم، ولا أن يكون هيّنًا واهنًا يسمح للآخرين بإهانته وإهانة الدين الذي ينتمي إليه. فالتواضع بحسب شرح الشيخ اليزدي لا يعني أن لا يكون للإنسان أيّ مكانة اجتماعية بحيث يتمكّن الجميع من فرض رغباتهم عليه دون أن يكون له أيّ رأي، بل أن يسلك طريقًا وسطًا بين الإفراط والتفريط، فلا يكون مغرورًا إلى الدرجة التي يعدّ نفسه فوق الجميع بحيث لا يتواضع لأحد أصلًا، ولا أن يجعل نفسه ذليلًا وحقيرًا إلى الدرجة التي لا يرى الآخرون له أيّ موقعيّة.
“وقف عند كلّ أمر حتّى تعرف مدخله من مخرجه قبل أن تقع فيه فتندم”، ينصح الإمام (ع) المؤمن بأن يكون عاقلًا وبعيد النظر يتقن تشخيص النفع والضرر من الأمور، فيتحسّس مداخل الأمور من مخارجها، أي إيجابيّاتها وسلبيّاتها حتّى يتمكّن من تقييمها واختيار أفضلها وأقربها من الله تعالى. ويشير إلى إشارة لطيفة، وهي الالتفات إلى آفة العمل، وهي المنّة التي تعود بالأذى على مَن تصله المساعدة، وكذلك كثرة ذكر العطيّة. ويوصي (ع) بالصمت الذي يورث الحِلم في كلّ الحالات، فمع الجهّال ستر، ومع العلماء زينٌ.
ويشير (ع) أيضًا إلى وصايا النبي عيسى (ع) إلى حواريّيه، ومنها:
- ضرورة ستر عيوب الآخرين من الجسد والعمل، بل ويسعون إلى عدم انكشاف هذا العيب. وليس هذا فحسب، بل يجب عدم تتبّع عثرات وعيوب الآخرين، ويهتمّ الفرد بأخطائه وعيوبه هو لإصلاحها.
- مواجهة الرغبات النفسيّة وعدم الركون إلى الأهواء والميول الحيوانيّة والشيطانيّة، لكن دون إفراط، بل مع مراعاة حدّ الاعتدال فيها.
- الصبر مقابل المشاكل ومقابل ما يكره الإنسان، لأنّ الصبر على ما يكره أوثق عرى في النفس من الصبر على ما نحبّ.
- ضرورة اجتناب الأحكام المتسرّعة بشأن الأشخاص، ولا نكتفي بظاهرهم للحكم عليهم سواء من الناحية الإيجابيّة أو السلبيّة.
كما ويعرض الإمام (ع) بعض النقاط الأخلاقيّة المفيدة في مسار السير والسلوك، ومن أهمّها التصرّف الحسن مقابل التصرّف السيء الذي يصدر من الغير “صل من قطعك، وأعطِ من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلّم على من سبّك، وأنصف من خاصمك، واعفُ عمّن ظلمك”. كلّ هذه التصرّفات تحتاج إلى نفس راضية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالله تعالى، خضعت لتجارب عديدة من التربية الأخلاقيّة، ونجحت في الدخول إلى ساحة القدس الإلهي من الرحمة والعفو والمغفرة. وهذا هو المنهج الإسلامي التربوي الذي يلحظ مراتب معرفة الناس بالله تعالى وإدراكهم الحقيقي لحقيقة وجوهر الرحمة والعفو عند المقدرة، ولكن على نحو من القوّة المرتبطة بالحقّ لا على نحو الضعف. وهذه التصرّفات يحدّدها السالك بما يتناسب مع الحفاظ على الحدود الشرعيّة ومصالح المجتمع فإمّا يلجأ إلى إقامة الحدّ أو التسامح، وفي كلا الحالين يكون الهدف من فعله هو رضا الله تعالى.
فغاية أفعال الإنسان هو تحقيق هذا المقام من القرب الإلهي، وهنا يبرز دور النيّات وصفائها في قيمة الأعمال التي يقوم بها. فلا تكون قيمة الأعمال بحسب كميّتها، بل بما تحمله من صِرف الإخلاص، وخلوّها من آفة الرياء والسمعة.
أمّا عن شروط قبول الصلاة التي يذكرها الإمام (ع) باعتبارها معراج الوصول إلى حضرة الباري، بالإضافة إلى تحقيق الشروط الظاهريّة من الطهارة وغيرها، فهي:
- أن يكون المصلّي ذاكرًا لعظمة الله. وكلّما وُفّق الإنسان لإدراك عظمة الله سيزداد تواضعه بين يديه سبحانه، وسوف يدرك أكثر مدى صغره وضعفه.
- أن يكفّ المصلّي نفسه عن الهوى والهوس الباطل لأجل الله.
- أن يقضي المصلّي وقته خلال النهار بذكر الله. ولا يعني الذكر اللفظي منه حصرًا فيمكن أن يكون الإنسان ذاكرًا وهو يمارس أموره الحياتيّة الطبيعيّة.
- أن يكون متواضعًا بين يدي الله، ولعباده تعالى. وكذلك ساعيًا لخدمة عيال الله.
وإنّ الذي يراعي شروط قبول الصلاة، سيسطع وجهه في عالم المعنى والملكوت كالشمس، وسوف يرى أصحاب البصيرة الباطنيّة هذا السطوع في الدنيا قبل الآخرة.
كما أنّ الحياء لباس الإسلام. وهو أعمق من المعنى السطحي المرادف للخجل، وهو أصل أخلاقي يؤدي إلى صيانة المرء من كثير من الرذائل الأخلاقيّة كاتباع عورات الآخرين والإساءة إليهم، والفجور في محضر الحقّ تعالى، واتصافه بالإنسانيّة السمحاء التي تحترم الإنسان كيفما كان شكله ومظهره فيعزّه بناء على ما يحمل من ملكات أخلاقية مرتبطة بالله.
وأفضل الحياء المطلوب أمام الله أن يراعي السالك مقام الباري تعالى فيخجل من نفسه لارتكاب الذنب، ويلتفت إلى قبح ذلك الفعل بالتوجّه إلى مَن يعصي، وأنّه دائمًا في محضره وشاهد على عمله.
ويختم الإمام الصادق (ع) وصيّته للسالك الصادق بإشارة هي أساس وعقدة الارتباط بالله تعالى وبالإسلام، وهي محبة أهل بيت النبوة (ع). وهذا الأساس هو البنيان الوثيق الذي من دونه لا يمكن لهذه الرابطة أن تبقى قويّة ومتينة في وجه العواصف والبلاءات. فهم الأنوار القدسيّة الذي وجودهم في هذا العالم يشكلّ المرتبة القصوى من العبوديّة، ومحبّتهم هي شعاع تلك المحبّة التي يحملها الإنسان تجاه الله.
إنّ رحلة السير إلى الله جميلة بقدر ما هي شاقّة وصعبة للوصول، يكفي أن يخلص الإنسان لله روحه، ويسلّم نفسه إلى بارئها طائعًا خاضعًا له تعالى بإرادته وعزمه على الوصول، فيرى كلّ الأشياء فيه وبه ومعه ليقطع كلّ تلك المسافات الطويلة بومضة حبّ ويصل إلى حيث يريد.
المقالات المرتبطة
عاشوراء… مواسم الثقافة
روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) أنه قال للفضيل بن يسار: “يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟” قال: نعم جعلت فداك.
الإنسان ومسار الاستخلاف بين الشهيد الصدر وأبو القاسم حاج حمد
تقدّم هذه الورقة قراءةً موجزة وسريعة، لمسار الاستخلاف الإنساني على الأرض، من وجهتي نظر كل من العلامة الشهيد السيد محمد باقر الصدر، والمفكر الدكتور أبو القاسم حاج حمد.
قراءة في كتاب وداع الربيع
إنّ الربيع إذا غادر حقول الأزهار دون أن تستطيع أن ينشل منها روحًا بقيت تلك الزهور يابسة دون رائحة. وإنّ ربيع الشهور، شهر رمضان، إذا غادر القلوب دون أن تنتقي تلك القلوب زادًا لبقية أيام السنة ذبُلت تلك النفوس وبقيت أيامها الآتية دون حبٍّ ورغبة.





