أهمية البحث في الفلسفة والعرفان 2
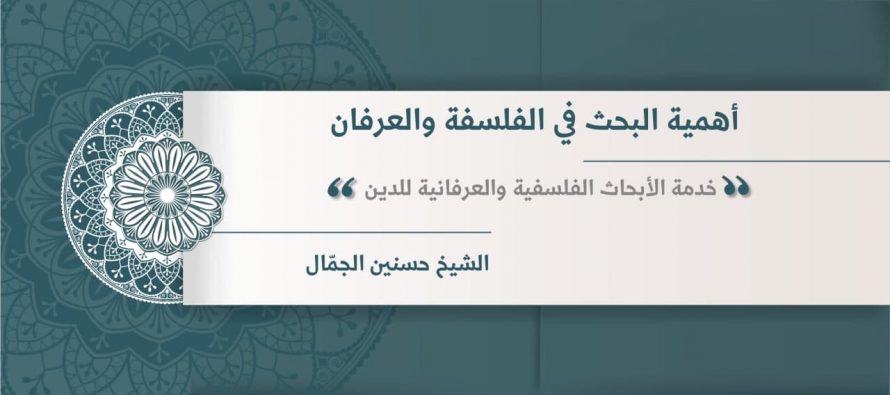
السبب الثاني: خدمة الأبحاث الفلسفية والعرفانية للدين.
لا زال الكلام في أهمية الأبحاث الفلسفية والعرفانية، وذكرناه أننا سنتعرّض لبيان أربعة أسباب لهذه الأهمية، هي:
-
الوظيفة الأساسية للفلسفة والعرفان.
-
خدمة الأبحاث الفلسفية والعرفانية للدين.
-
تأثير الأبحاث الفلسفية والعرفانية على علم الكلام.
-
تأثير الأبحاث الفلسفية على العلوم الإنسانية وعلى الحضارة.
وقد تقدّم الحديث في الحلقة السابقة عن السبب الأول، ونشرع فيما يلي في الخوض في السبب الثاني:
السبب الثاني: خدمة الأبحاث الفلسفية والعرفانية للدين.
ثمة علاقة جدلية بين الأبحاث الفلسفية والعرفانية من جهة، وبين الدين من جهة أخرى. ويمكن الحديث في كلّ منها في مرحلتين: قبل إثبات الدين، وبعد إثبات الدين. لكننا هنا سنغضّ النظر عن الخدمات التي يقدّمها الدين للفلسفة والعرفان[1]، ونسلّط الضوء على خدمات الفلسفة والعرفان للدين.
المرحلة الأولى: قبل إثبات الدين.
في هذه المرحلة، إما أن تقف الفلسفة بوجه الدين أو تكون مُثبِتا ومؤيّدًا له. فبعض الفلسفات، كالفلسفة الإلحادية والمادية –إن صحّ التعبير-، تسدّ الطريق أمام الماورائيات وتقف بوجه الدين، بينما البعض الآخر، كالفلسفة الإسلامية، فإنها تخدم الدين فتُثبِت بعض القضايا الأساسية فيه، وتساهم في إثباته. وبالتالي، إن واجهنا الفلسفة المادية والإلحادية بالفلسفة الإسلامية وأبحاثها الرصينة وبراهينها القويمة، كانت هذه المواجهة في باطنها دفاعًا عن الدين الإسلامي.
فعلى سبيل المثال، تُثبِت الفلسفة الإسلامية وجود الواجب جلّ اسمه، وتُثبِت صفاته التي منها الحكمة، والتي بها يُستدل على بعثة الأنبياء، واستمرار خط الإمامة بعد خاتم الأنبياء (ص). كما تُثبت المعاد، وتدفع بعض الشبهات المرتبطة به وببعض الصفات الإلهية[2].
المرحلة الثانية: بعد إثبات الدين.
يمكن لنا ملاحظة تأثير الأبحاث الفلسفية والعرفانية على فهم الدين من جهات ثلاث:
-
فهم مبادئ الدين.
-
فهم القضايا الدينية المعرفية.
-
فهم الإطار العام للدين (أي فهم الدين ككل).
ولكي تتضح هذه المسألة أكثر، نذكر مقدّمة تنفع في هذا المجال وفي مجالات أخرى، ومفادها:
لدينا تراث قرآني وروائي ضخم وغني جدًّا، ويمكن للفقيه أن يفهم هذا التراث بمستوى معيّن. لكن لو كان الفقيه متخصّصًا في مسائل الحقوق، ومطّلعًا على القوانين العالمية، ومتمكّنًا من مداخل هذا العلم ومخارجه، فعندما يواجه رواية، أو مجموعة روايات حقوقية قانونية، فإنه بإمكانه أن يفهمها أكثر من غيره من الفقهاء غير الواردين في هذا المجال، كما لديه قدرة الالتفات إلى الكثير من الجوانب الخفية في هذه الروايات، أو إلى بعض النقاط التي ترمي إليها.
وهكذا، لو كان الفقيه متخصّصًا في العلوم التربوية، فإنه سيلتفت إلى الكثير من الجوانب التربوية في الروايات أكثر من غيره من سائر الفقهاء.
ويمكننا تأييد هذه الفكرة بما جرى بين نبي الله موسى (ع) والسحرة، حيث ظن عامة الناس أن فعلَ موسى (ع) سحرٌ، بينما أيقن السحرة –وهم أهل الفنّ والاختصاص- أنه ليس بسحر، فهموا ذلك فهمًا عميقًا، فآمنوا.
فإذا التفتّ إلى هذه المسألة العقلائية، نقول: إن الروايات الواردة في المجال العقلي والفلسفي غير شاذّة عن هذا الأصل. وبالتالي، من يبحث في المسائل العقلية الفلسفية ويتأمل فيها، سيحصل عنده استعداد أكثر من غيره –بلحاظ هذه الجهة- لفهم الروايات المرتبطة بهذا المجال. هذا على مستوى التنظير والثبوت، وأما على مستوى الإثبات، فمن يقرأ الأبحاث الفلسفية والعرفانية بتمعّن، يجد فيها ما يساعد على الفهم الدقيق لبعض القضايا الدينية، من قبيل ما ورد عن الإمام علي (ع): “هو في الأشياء كلها غير متمازج بها، ولا بائن عنها”[3]، أو ما ورد عن الإمام الرضا (ع) في خطبته: “أحد لا بتأويل عدد، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجلّ لا باستهلال رؤية، باطن لا بمزايلة”[4]. والحديث في هذا المجال موكول إلى محله.
نعم، لا بدّ من الالتفات إلى عدم الوقوع في إسقاط الأبحاث الفلسفية – أو غير الفلسفية- على النصوص الدينية. وهذا مطلب سيّال لا يختص بمن يهتم بالمجال الفلسفي والعرفاني، بل يشمل المهتم بالجانب الفقهي والأصولي والتربوي وما شاكل. ولا نوافق على أنه يجب أن يرِد الباحث النصوص الدينية بنحو يكون خالي الذهن عن كل العلوم البشرية، فيجب عليه عدم تعلم الفلسفة حتى لا يفهم هذه النصوص بشكل خاطئ ومشوب. نعم، هذا صحيح بالنسبة للكثير من الأفراد ذوي المستوى العلمي والفكري الضعيف، فيقودهم تعلّم مثل هذه العلوم إلى الإسقاط على النص الديني، وبالتالي إلى التفسير بالرأي. أما لو كان الدّارس للفلسفة – أو لغيرها من العلوم- واعيًا ولديه القدرة الكافية على التفكيك بين محتوى النص، وبين القبليات، فلسنا نقول: إن هذه القبليات العلمية لا تضرّه فقط، بل إنها تنفعه أيضًا في استظهار ما قد لا يستظهره غيره[5]. وقد أشرنا إلى هذه النكتة سابقًا، فالتفت.
ولا يفوتنا في هذه النقطة أن ننبّه إلى مسألة مُلفتة، وهي أن المتتبّع في كلمات أهل البيت (ع)، يجدهم ألقوا الكثير من الأبحاث الدقيقة أثناء حديثهم مع العلماء، سواء كانوا مسلمين أو زنادقة. وهذا ما يساعد عليه مشي العقلاء، فإنهم يبيّنون أدق أبحاثهم أمام أهل الفن، لا أمام العوامّ.
فتحصّل أن الفلسفة تخدم الدين في أنها تساهم في فهم قضاياه المرتبطة بالمجال العقلي بنحو دقيق وعميق[6].
كما يوجد خدمة أخرى تقدّمها الفلسفة للدين، وهي أنها تدافع عن الدين. وماهية هذا الدفاع تختلف عن مرحلة ما قبل إثبات الدين. فبعد إثبات الدين، قد يطرح الدين قضايا يستهجنها الناس والعرف العام مثلًا، أو يرفضها وينكرها عرف خاص. ففي هذه الحالة، يمكن للفلسفة أن تبيّن هذه القضايا بمنهج عقلي، فترفع الاستهجان أو تحوّله إلى تسليم بهذه القضايا. هذا، لا سيما مع الالتفات إلى أنه ليس من وظيفة الدين بيان المسائل المرتبطة بكل العلوم، بل قد يطرح بعض المسائل النافعة جدًّا في العلوم، لكن يذكرها على نحو الإشارة والإلفات، ويحتاج بيانها وتفصيلها إلى خبير يراعي الموازين العلمية الدقيقة في التعامل مع النصوص الدينية[7].
وبذلك ينتهي البحث في السبب الثاني، تاركين الحديث عن السببين الثالث والرابع لحلقتين مقبلتين.
والحمد لله رب العالمين
[1] فعلى سبيل المثال، الدين – قبل إثباته- يهدي الفلسفة والعرفان هداية إرشادية –لا إلزامية- تكون مؤثّرة في العقل الحر. فحديث الدين مع العقل البشري في هذه المرحلة – أي مرحلة قبل إثبات الدين- هو كحوار المفكّرين مع بعضهم البعض. وهذه خدمة كبيرة يقدّمها الدين للفلسفة.
وأما بعد إثبات الدين، تكون القضايا الدينية بمثابة الميزان للقضايا الفلسفية. كما يقدّم الدين بعض الأفكار التي يجب على الفلسفة أن تتأمّل فيها وتبحث عنها. وفيما يرتبط بالنقطة الأخيرة، يمكن الحديث عن العقل المنوَّر بالدين –كما يمكن الحديث عن العقل المنوَّر بالشهود عند الحديث عن العلاقة بين العقل والشهود-. فقد يوجد بعض الموارد، لا يمكن للعقل وحده أن يلجها أو أن يفكّر في الخوض فيها، لكن الدين يدلّه على هذه المجالات، فيصبح العقل بتبع الدين قادرًا على فهم بعض القضايا بنحو عقلاني. ولا يخفى على الباحث أن الدين الإسلامي قد دعا للتدبّر في القضايا التي يطرحها. وبالتالي، يكون الدين عاملًا لتطوّر العقل والأبحاث الفلسفية، وهذه خدمة جليلة أيضًا يقدّمها الدين للفلسفة. والحديث عن خدمات الدين للفلسفة، وبيان بعض النماذج يحتاج إلى بحث مستقل، نسأل الله أن نوفّق لتنقيحه وبيانه.
[2] وقد أجاد سماحة الشيخ أميني نجاد – دامت إفاداته- حيث كتب تكملة لنهاية الحكمة ضمّنها أبحاث النفس والمعاد والنبوة والولاية.
[3] نهج البلاغة، من كلام له وقد سأله ذعلب اليماني، باختلاف يسير؛ التوحيد، باب حديث ذعلب، ح 2.
[4] التوحيد، باب التوحيد ونفي التشبيه، ح 2. أمالي الطوسي، المجلس الثلاثون، ح 4، لكن ورد واحد بدل أحد.
[5] على سبيل المثال، عندما يكون الفقيه مهتمًا بالشأن السياسي والحكومي، قد يقرأ النصوص الدينية المرتبطة بالخمس والحدود والديات و… فيستظهر ضرورة الحكومة. وهذا ما قد لا يستظهره فقيه آخر. ونؤكّد على أنه ليس الكلام عن الإسقاط، بل عن أمور تساعد على الاستظهار.
[6] ينقل جلال الدين الآشتياني أن الميرزا أحمد – ابن الآخوند الخراساني صاحب الكفاية- أخبره مرارًا أن الآخوند الخراساني كان يقول: إن من لم يفهم الفلسفة الإلهية بشكل جيد، لا يفهم أخبار آل محمد (ع) في العقائد، فكما أنه لا معنى للفقه بلا الأصول، كذلك لا يمكن إدراك الأصول والعقائد الحقة بدون بنية علمية فلسفية وكلامية. انظر: جلال الدين الآشتياني، نقدى بر تهافت الفلاسفه غزالى، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، 1378، الصفحة 80.
[7] وهل يكفي علم أصول الفقه في هذا المجال بحيث يمكن الاعتماد عليه لفهم كل القضايا الدينية، أم أنه مختص بالقضايا ذات الطابع التكليفي والعملي، وأما القضايا الحاكية عن الواقع، فلا بدّ فيها من ضوابط أخرى؟ هذا ما يحتاج إلى تنقيح ويستحق أن يُفرَد له بحث مستقل، فيُكتَب مثلًا علم أصول العقائد أو ما شاكل. وكيفما كان، يكفينا أن نشير إلى هذه المسألة ونلفت إليها في المقام، فاغتنم.
المقالات المرتبطة
الإنسان الحَبْريّ والإنسان البروميثيّ
كان للانقلاب البروميثيّ على السماء أثرًا وبيلًا على هذه الحياة الأرضيّة. فالإنسان، في قابليّاته التألّهيّة، محوريّ في هذا العالم، ويؤثّر في تناغمه.
قانون العلية | قراءة جديدة
يوم أبصرت وجودي كنت لا أزال فتًى صغيرًا، كنت أشعر بالغربة القاسية، أنظر إلى العالم الخارجي بكل تفاصيله فأدرك أنه
الشهيد الحاج قاسم سليماني: أيّ معنى لمسار الشهيد؟
إنّ الشهادة ترقّي في الوجود وليست خاتمة للوجود، لهذا كان الشهيد حيًّا ما بقي الليل والنّهار، وعنوان خلود ما طلعت الشمس وهبّ النسيم.





