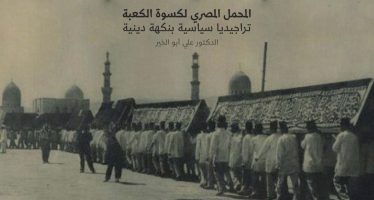الفكر العربي الحديث والمعاصر | المنهج في فلسفة زكي نجيب محمود (3)

نظر زكي نجيب محمود إلى الفلسفة باعتبارها منهجًا، فهي ليست كما اعتاد الناس النظر إليها كموضوعات ترتبط بوقائع تشكل الميتافيزيقا ركنها الأساسي، بل كلّ قضيتها تنحصر في تحليل الكلام والبحث عن الروابط، من هنا أقام منهجه على الأسس التالية:
أ. الفلسفة والدين: لا يوافق زكي نجيب محمود على التوفيق بين الفلسفة والدين، فالأول منهج فكري واضح المعالم: “يبدأ دائمًا من السطح الفكريّ الذي يعيشه الناس، ثمّ يأخذ في الغوص تحت هذا السطح، ليصل آخر الأمر، إلى حقيقة عامة شاملة تفسر ذلك الذي يجري على السطح، وتشير بالتالي إلى ما كان ينبغي أن يكون”[1]، بينما الثاني عقيدة.
فالفلسفة وعلى الرغم من اعتنائها بتاريخها إلا أنّها لا تقدس هذا التاريخ، فهي تنظر إلى الفلاسفة من خلال تزمُّنهم، فالفيلسوف هو رجل عاش في عصر ورأى ما حوله من الظواهر الحياتية والكونية، وقام بتثبيت ما قد وصل إليه، إمّا تلقينًا لتلاميذه، وإما كتابة يدون بها ما قد رأى، وتتراكم هذه التدوينات من مختلف الفلاسفة، في مختلف العصور. حتى يُصبح بين أيدينا – نحن الورثة- ما هو في حقيقة أمره تاريخ للفلسفة، وعلى الدارسين لهذا الفرع من الميراث الفكري أن يلموا بذلك التاريخ ما استطاعوا دقة وشمولًا، لا ليعيشوا ذلك التاريخ، إنّما لاستكشاف المنهج الذي استخدمه.
وهذا هو محور الفرق بين الفلسفة والدين، فالفلسفة عمل منهجيّ، يخضع للزمن وللذاتية، إنّ الفيلسوف إذ يبني بناءه الميتافيزيقيّ، فإنّما يقيمه على مبدأ من عنده، وأيّ فيلسوف آخر من حقه كذلك أن يقيم بناء آخر على مبدأ من عنده، وبذلك تتعدد البناءات الفلسفية بتعدد أصحابها. وأما في حالة الدين فالأمر مختلف أشد ما يكون الاختلاف، لأنّ البناء الدينيّ قائم على وحي مُنزل. وليس من حقّ أحد آخر أن يبني دينًا على شيء آخر من عنده، اللهم إلّا إذا كان خارجًا على هذا الدين، وعندئذ يحسب له حساب، فبينما تتعدد البناءات الفلسفية بتعدد الفلاسفة، يظلّ البناء الدينيّ واحدًا لوحدانية الموحى به والموحى إليه[…] والفروق بين الدين والفلسفة واسعة عميقة بحيث يستحيل أن يخطئها بصر، والاختلاف بينهما متعدد الجوانب، فهو اختلاف في المصدر[…] وهو كذلك اختلاف بينهما في الطريقة التي يتلقى بها المُتلقي ما يُقدم إليه[…] وهو فوق هذا وذاك اختلاف في الوظيفة التي يؤديها كلٌ منهما”[2].
انطلاقًا من هذا الفصل الحاد بين الحقلين، بدأ زكي نجيب محمود ببناء منهجه الفلسفيّ، رافضًا كلّ علاقة مع الدين حتى في الحدود الدنيا، فالفلسفة في بنيتها العامة علمانية أي محورها الحياة الدّنيا ومحاولة تفسيرها.
ب. الفلسفة واللغة: ركّز زكي نجيب محمود على اللغة، فنطاق الفلسفة هو الألفاظ والعبارات والكلمات لا الأشياء، لذلك يجب أن يُفرّق بين البحث الذي يتناول الأشياء ومورده العلم، وبين البحث الذي يتناول اللغة وهو الفلسفة التي تبحث: “عن كلمة أو عبارة، فإنّك بذلك تدخل في نطاق غير نطاق العلوم بمعناها الدقيق؛ وهذا النطاق الآخر هو ما اخترنا له كلمة فلسفة”[3]، دون أن يعني ذلك إطلاق الفكر بالحديث عنها كعبارات وتراكيب لغوية عشوائية لا معنى لها، فالفلسفة تحليل منطقي للغة يسعى إلى تقديم تعريفات دقيقة للأشياء التي تتكلّم عنها، أي أنّها ليست سوى التحليل المنطقيّ كي يزول عنها الغموض، وكي يتمّ القضاء على التشويش وعدم الدقة، وعلى اللغو.
وبذلك يصبح البحث في القضايا المنطقية، والارتداد على الشكل تنقيبًا وتوضيحًا، وتحليل قضايا العلم، موضوعًا للفلسفة بمعناها ومقاصدها. وبذلك فالفلسفة والتحليل لا ينفصلان إلّا أنّ هذا الأخير يسير باتجاهين أحدهما أفقي هو الذي ينظر في الجملة بحثًا عن: “العلاقات التي تربط أجزاءها بعضها ببعض كأن ننظر إلى جملة تقول: “إنّ الشمس طالعة”، فندرك أنّ فيها موضوعًا دار حول الحديث هو الشمس صفة تنسب إلى ذلك الموضوع”[4]. والآخر عمودي: “وهو يتناول الفكرة المعنيّة ليتعقبها إلى العناصر الأولية التي هي قوام تلك الفكرة كأن نتناول مثلًا مفهوم الفن فنحلل محتواه إلى العناصر التي تجعله فنًا”[5].
وهكذا نلاحظ أنّ زكي نجيب محمود يتمسك بفلسفة التحليل التي تقوم على الدّقة في تحديد المفاهيم، وضبطها، وتحليل وظيفتها في التفكير، خاصة دلالة المفاهيم، لأّنها تمارس دورًا فاعلًا وأساسيًّا في نظم المعرفة؛ فالتحليل انطلاقًا من هذه الرؤية ليس تفتيتًا للموضوعات، إنّما هو دراسة للعلاقات التي تربط بين المفردات، وساهمت في إقامة الفكرة ودرس الظروف التي أوصلتها إلى ما هي عليه.
كما إنّ التحليل عملية منطقية نحلل فيها العبارات للكشف عن صورتها المنطقية للحكم عليها، وغالبًا ما يتمّ تحويل القضايا إلى صورتها المنطقية عبر نقلها من شكلها الماديّ إلى آخر صوريّ، مثال ذلك قولنا: مسألة صعبة، ومدينة قديمة، فالعلاقة بين هذين الجزئين من القول علاقة صفة بموصوف، وبإمكاننا أن نستبدل الصفة برمز ص والموصوف برمز س، فنحصل على قضية س[ص]، فنرى: “كيف يتحدان في الصورة رغم اختلافهما في اللفظ والمعنى”[6]، وبهذا يتم إفراغ العبارات من مضمونها الشيئي والإبقاء على المعاني البنائية المنطقية.
وبهذا يتمكن التحليل من الكشف عن البنية الميتافيزيقية للعبارات أو للفكر، عبر تركيب لغويّ منطقيّ يقفز فوق الأسماء المفردة القابلة للتغيّر نتيجة الزمن ومجرى الحضارات، وهذا الأمر يتمّ حسب الإجراءات التالية:
- يتطابق المبنى اللغويّ والمنطقيّ على المستوى الصوريّ، والمقصود بالنحو ليس خصوص النحو في لغة معينة، فهو على هذا المستوى علم، إنّما المقصود النحو بالمعنى العام الذي يتميز بالكونية، من هنا كانت المفاضلة بين السيرافي وبشر بن يونس لا معنى لها، لأنّها حاولت المفاضلة بين أمرين لا يمكن المفاضلة بينهما، فالتحليل المنطقي يتجاوز الصورة النحوية للعبارة، فالنحو مثلًا يقبل العبارتين التاليتين “الذهب عنصر بسيط”، و”العقل عنصر بسيط”، بينما المنطق يقبل الأولى ويرفض الثانية[7].
- الإبقاء على الثوابت المنطقية عبر المفردات البنائية، أو تكون الجمل على الشكل التالي:
* جملة خبرية تحمل إمكانية الإجابة عليها بالصدق والكذب كالاستفهام والتعجب …
* القضايا التكرارية كالقضايا الرياضية، التي يكفي أن نقوم بتعريفها دون الحاجة للعودة إلى العلوم الطبيعية، لأنّها لا تنبئ عن العالم الخارجيّ بشيء جديد.
فالتحليل بالنسبة إليه لا يطال إلا الأفكار عبر تناول تركبيها، فالفكرة هي اللغة، وحتى الألفاظ التي يتصور بعض الفلاسفة أنّها عبارات مفردة كالعدل والصداقة، ما هي إلا جمل ضغطت في لفظ واحد والكشف عنه يكون بالبحث عن المضمر في الوحدة اللغوية، شرط أن تكون من المفاهيم الكيفية المستخدمة في العلوم، فالتحليل من خلال هذا الفهم يتدرج طبقًا للآلية التالية:
- عبارات تتحدث عن أشياء يمكن الإشارة إليها لوجودها في الخارج مثل قولنا قطعة السكر المربعة.
- عبارات تتحدث عن كلمات يمكن الحديث عنها بالرجوع إليها كقولنا السكر كلمة مؤلفة من خمسة أحرف.
- عبارات نتصور أنّها من النوع الثاني ولكنّها من النوع الأول كالكلمات الكلية.
انطلاقًا من ما سبق، تصبح الفلسفة بالنسبة إلى زكي نجيب محمود متصلة بقوة بالإجراءات التحليلية، فاللفظة لا تكون لها قوة دلالية إلّا إذا أشارت في نهاية الّتحليل إلى معطيات حسية مستمدة من كائنات حسية في العالم الخارجيّ، ومن ثم فالقضية التي لها معنى هي التي يمكن اختبارها تجريبيًا، والمقصود من هذا هو اعتبار هذه الفلسفة منهجًا أكثر منها مذهبًا، إذ أن المنهج طريقة للنظر في كل ما تتقدم فيه اللغة والرموز الأخرى من مذاهب الفلسفة ونظريات العلم، وتمييز لهذه عن تلك في سائر ضروب القول والكتابة.
يقوم هذا المنهج على أنّ وسيلة المعرفة وطريقتها، إنّما تبدآن من خارج الإنسان وتتجه إلى داخله، فلا معرفة إطلاقًا ما لم نتحصل على معطيات حسيّة عن طريق الحواس وبهذا حدّد للغة استعمالين رئيسيين:
- إشارية للإشارة إلى أشياء العالم الخارجيّ.
- لغوية تستخدم لإثارة العواطف، أو لإقامة بناء ذهنيّ صرف تتسق أجزاؤه من داخل، لكنّه لا يعني شيئًا من خارج، مثل علم الأخلاق، والقيم الروحية، وقضايا التاريخ، والجماليات.
وهذا الاستخدام للغة يضعنا أمام نوعين من المعرفة، هما:
- المعرفة التجريبية التي تمنح الحواس أولوية مطلقة في تشييد المعرفة، لتحقيق التوافق بين اللفظ الدال والشأن الخارجي.
- المعرفة العقلية التي تمنح الحدس والإدراك الداخليّ كلّ الأولوية في تشييد المعرفة، وهذا الأمر يؤدي إلى بناء نصّ يقوم على تصورات ذهنية محددة، لا تعنى بأيّ نوع من أنواع التطابق مع الوقائع الخارجية.
ما أوردناه حتى الآن يوصلنا إلى القول: إنّ اللغة بما هي لغة توقعنا بأخطاء وتضللنا، فهي تحتوي في طياتها عناصر ميتافيزيقية تقودنا في وجهة خاطئة، فهي تأخذ الإنسان إلى أوهام السوق بحسب تعبير فرنسيس بيكون عندما تجعله يستخدم ألفاظ كلية ليس فيها أفراد أو أجزاء في الخارج يدلون عليها. كما أنّ اللغة ليست وسيطًا شفافًا يعبر عن الأشياء كما هي، بالتالي فهي تحتاج إلى خبير يعاينها لمعرفة الحقيقيّ من المزيف.
ج. الفلسفة الوضعية: بعد هذا التقسيم، نستطيع أن نرى بوضوح الطبيعة التجريبية لزكي نجيب محمود، فهو يذهب مذهب ديفيد هيوم والتجريبية العلمية، في اعتبار الأفكار صورًا للانطباعات الحسية. فالمعرفة، في ذلك المذهب، مستمدة من تلك الانطباعات أو الأصول الحسية[8]، من هذا نلاحظ أنّ الصياغة اللفظية عنده حاملة لمعنى؛ ولأنّها كذلك فهي تحتمل الصدق والكذب، ومعيار الصدق الواقع التجريبيّ، وذلك عند المطابقة بين المعنى والواقع، وما عدا ذلك فهو بُنى ذهنية تصورية وصورية.
فالفيلسوف الوضعيّ كزكي نجيب محمود يرفض الاستبطان كطريقة علمية، ويرفض الحدس من حيث الزعم بأنّه: “وسيلة إدراكية أستطيع أن أعلم بها ما يستحيل على الحواس أن تجيئني به”[9]، فالاستبطان ذو مجال محدد، وليس هو منهج صارم؛ أما الحدس فهو، أحيانًا عديدة، غير كافٍ، وفعل تبريريّ، وادِّعاء لا يمكن تحقيق صدقه، أي فارغ وبلا معنى. إنّ الحدس، في الفلسفة الوضعية، هو الإدراك الحسيّ المباشر لنتيجة تلزم من مقدمات معترف بها، أو تلزم عن تعريفنا لبعض الألفاظ. فالفلسفة الوضعية تقوم على قواعد محددة هي:
أولًا: مهمة الفلسفة تحليل ما يقوله العلماء وما يقوله الناس في حياتهم اليومية.
ثانيًا: يشترط في كلّ عبارة تدّعي الإشارة إلى دنيا الأشياء أن يكون صوابها قائمًا على تصويرها لتجربة حسية، مما يؤدي إلى حذف الميتافيزيقا من مجال الكلام المشروع.
ثالثًا: تحليل السببية تحليلًا يجعل العلاقة بين السبب والمُسبب علاقة ارتباط في التجربة، لا علاقة ضرورة عقلية.
رابعًا: قضايا الرياضة -وكذلك المنطق الصوريّ- تحصيلات حاصل. لا تضيف عن العالم الخارجيّ علمًا جديدًا”[10].
هذا الكلام يضعنا أمام ثلاثة أنماط من التفكير بواسطة اللغة:
- نمط التفكير الرياضي: وهذا النمط من التعبير استنباطيّ يستند إلى مسلَّمات ينطلق منها، وقوته من قوة هذه الأخيرة، وطالما أنَّ المسلَّمات يقينية الصواب، فإنَّ نتائج هذا التفكير- كذلك- تبلغ درجة اليقين، فهل يمكن أن نشك في أنَّ محيط المربع يساوي طول أحد أضلاعه أربع مرات؟ مما يعني أنّ قضايا الرياضة وكذلك المنطق الصوريّ لا تضيف إلى العلم علمًا جديدًا.
- نمط التفكير العلمي: الذي يضيف معلومات جديدة لمعارفنا بناءً على ما تفصح عنه التجارب الحسية، وطالما أنَّ التجريب يقبل النقد، فإنَّ نتائج هذا التفكير أقلُّ يقينًا من نتائج التفكير الرياضيّ، وهذا المجال العلميّ بالذَّات هو محلُّ التطبيق الكامل للفلسفة الوضعية المنطقية.
- نمط التفكير الأدبيّ: وهو لا يقاس بالواقع الخارجيّ المشترك بين الناس، وإنّما بالعاَلم الداخليّ للأديب والفنان، فكلُّ كلامه بالنسبة لعاَلمه الداخليّ صحيح، أما بالنسبة للآخرين، فهو خاضه للقبول أو الرفض، ولا يحكم عليه بالصدق الخالص أو الكذب المطلق، فقد يقبل أو يرفض.
وما يهمنا في هذا الموضع مورد التطبيق المنهجيّ المتمثل في نمط التفكير العلميّ، الذي اتكأ عليه في منظومته الفلسفية، فزكي نجيب محمود ينطلق من مسلمة أنّ اللغة هي الفكر من حيث هي وسيلة التي لا وسيلة سواها لنشأة المعرفة الإنسانية وتطويرها، وبهذا: “كان للفلسفة مجال واحد ليس لها سواه، وهو تحليل الألفاظ والعبارات تحليلًا منطقيًّا، لتمييز ما يمكن قبوله من أصناف القول وما لا يمكن قبوله”[11]، وهذا ما يرفع الوهم المتمثل بوجود موضوعات محددة لها، تعمل على أساسها.
د. الإجراءات المنهجية: الفلسفة تحليلٌ صرفٌ، تسعى إلى فحص قضايا العلم، من هنا جاءت الدعوة لأن: “تكون الفلسفة منهجًا بغير موضوع، ومنهجًا هو منهج التحليل، الذي يرد الفروع إلى جذوعها، ويرد الجذوع إلى الجذور، في ميادين العلم وغير العلم من مقومات الحياة الثقافية، وذلك يفسر لماذا أُطلق على عصرنا بعصر التحليل”[12]. وبهذا المعنى زكي نجيب محمود يحيل الفلسفة إلى فلسفة اللغة، وهذا ما يظهر عندما يردد في أكثر من موضع: “إنّ الفكر الفلسفيّ قوامه منهج في تحليل المعاني، دون أن يكون له بالضرورة موضوع معين خاص به، يحتكره لنفسه، حتى ليمكن تعريف الفلسفة من هذه الزاوية بأنّها علم المعاني لأنّ المادة التي تصب عليها فاعليتها، هي تلك المعاني الأساسية المحورية التي تدور حولها رحى الحياة الفعلية كلّها”[13]، وانطلاقًا من ذلك تعمل الفلسفة على: تحليلات منطقية لبعض المفردات والعبارات اللغوية، وتدرس مشكلة العلاقة بين اللغة والواقع، وبين اللغة العادية وفلسفتها، وتعالج المواضعة اللغوية ويقين بعض القضايا، وتحلل نظريات المعنى، وتشرّح العلاقة بين اللغويين وفلسفة اللغة، بالإضافة إلى فلسفة اللغة عند العرب. وبهذا تصبح: “منطقًا للعلم، وذلك لأنّها لا تبحث في مادة العلوم، وإنّما تبحث في منطقها”[14].
ومن خلال هذه الرؤية تتخلص الفلسفة من المفاهيم المبهمة التي علقت بها نتيجة تاريخها، وتعمل على تحليل الألفاظ لتوضيح ما استغلق منها، يقول محمود: “إنّ الفيلسوف المعاصر ذو النزعة العلمية يترك الخبز للخباز يُنضجُه على النحو الأكمل، فيترك الفلك لعلم الفلك، والطبيعة لعالم الطبيعة، والإنسان لعالم النفس أو عالم الاجتماع، أنّه لا شأن له بشيء من أشياء الوجود الواقع، بل يحصر نفسه في كلام هؤلاء العلماء، ليحلل منه ما قد تركوه بغير تحليل، وبخاصة إذا كان في العبارة لفظ يثير المشكلات، ويكون مدار خلاف”[15].
وهكذا، عمل هذا المفكر على إعادة نظم منظومة فلسفية لا تعتمد في بنيتها على مقولات غامضة -كما يرى-، إنّما تعمل على أسس منهجية تفضي إلى الوضوح وحذف الالتباس، وهي تقوم على المبادئ التالية:
- العالم متعدد ومترابط: فالعالم ليس عبارة عن حادث واحد، بل هو عبارة عن حوادث كثيرة مترابطة، فكلّ: “شيء من هذه الأشياء ليس في حقيقة أمره كيانًا واحدًا متصلًا كما نتوهم، إنّما هو إذا ما حللت الموقف إلى عناصره الأولية البسيطة حادثات يتبع بعضها بعضًا[…] والذي يخلع عليه الواحدية هو ما بين تلك الحالات من روابط وعلاقات”[16]، وهذا ما يحتم عدم التعاطي مع القضايا وكأنّها واحد بل هي مركب من عناصر علينا أن نفككها ونحللها لتفهمها وإدارك محتواها.
- الكلمة في سياقها: لا يمكن معرفة معنى الكلمة إلا في سياقها: “خُذ مفهوم الحرية مثلًا فلا يؤدي بك إطالة النظر في هذا اللفظ إلى شيء ينفع، لكن ابدأ بوضع اللفظ في جملة تحويه[…] فها هنا يصبح واجبًا على من أراد ضبط المعنى، أن يسأل بالتفصيل عن الأنماط الحياتية التي كانوا يدعون إلى إقامتها للنظر في عناصرها وطريقة بنائها”[17]، وهذا التوجه باتجاه القضية يبعد عن التحليل النفسيّ الذي ميّز تجريبية لوك وهيوم[18]، وأعاد الربط بالمنطق ليضمن عدم السقوط في غياهب الميتافيزيقا مع استمرار الصلة بالخبرة الحسية إذ يعتبر القضايا الأولية نتاجًا لها.
والغاية التي أرادها محمود من هذا الأمر، تتمثل في إخراج الفلاسفة من الصراعات التي وقعوا فيها عبر إقامة مرجعية تحسم الصراعات بينهم، وهذه المرجعية ذات طبيعة حسابية ينحلّ فيها الكلام إلى قضايا شبيهة بالمعادلات الرياضية.
- تحديد معنى الكليّ: جرت العادة أن يُستخدم الاسم الكليّ في كثير من مواضع الكلام، فيُقال منزل، نهر، وهذا الأمر ينطبق على السياق الاجتماعيّ والتفكير المنطقيّ، وعلى الرغم من تداوله إلا أنّه لا يستطيع أن يدلّ على المعنى، لأنّنا إذا أحلنا هذه الكلمة إلى تركيبة رياضية لا نستطيع أن نحدد صدقها أو كذبها، كأن نقول: “س” عدد، فهذا الكلام لا قيمة له إلا إذا دلّ على طبيعته باعتباره عدد مفرد أو مزدوج، ثم حددنا العدد المطلوب، فالاسم الكليّ: “بمثابة عبارة مثقوبة بما هو مجهول وإلى أن يمتلئ الثقب بمفرد معلوم، تظل التركيبة معلقة خارج نطاق الأفكار الكاملة والمقبولة في التفاهم العلمي”[19].
فالمعنى الكليّ يبقى وصف لغير موصوف حتى يتحقق من خلال أفراد يحملون هذه الصفات، وفي حال دلّ الاسم الكليّ على أمر غير متحقق بالخارج كالعفريت أو جبل من ذهب تصبح: ” كالقالب الفارغ الذي لا يجد المادة المتعينة التي تملؤه، وإذن فالسم الكليّ هو عبارة وصفية مجهولة الموصوف[20].
- التمييز بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية: أثناء الكلام لا بد من التفريق بين الجملة التحليلية والجملة التركيبية، والنوع الأول من القضايا لا يمكن التحقق منه إلا من خلال عدم تناقض مقدماته مع النتيجة، فهذه الجمل لا تفيد جديدًا يساعد في قيام بناء فكريّ، فإذا قال أحدهم: “إنّ الديمقراطية هي مساواة الفرص أمام المواطنين”، وقال آخر: “إنّ الديمقراطية هي أن تكون القرارات في المجالس العامة بأغلبية الأصوات”، هذان القولان مختلفان عن مفهوم واحد. وكلّ منهما لا يزيد على كونه تعريفًا من القائل لا يقتضي المفاضلة بينهما، وكلّ ما يمكن أن تؤدي إليه هو الصراع والتناحر بين الاتجاهات الفكرية. في حين أنّ النوع الثاني من القضايا يمكننا التحقق منها عن طريق الواقع، فجملة “الحديد يتمدد بالحرارة قضية تركيبية تثبتها التجربة وعبر استخدام الخبرة الحسية إلا إذا اعترضتها استحالات ثلاث:
- استحالة فنية: وتكون هذه الاستحالة ناجمة عن عدم قدرة الأدوات المتوفرة على التحقق من القضية.
- استحالة تجريبية: وهي التي تناقض قانونًا عامًا من قوانين الطبيعة كقولنا: “طيران الطائر في خلاء لا هواء فيه”.
- استحالة منطقية: وهذه تعني اجتماع النقيضين، مثلًا قولي: “إنّني أحسّ بوجع ضرسك فهذا مستحيل استحالة منطقية”[21].
ه. البحث عن المعنى: وهذه النقطة بؤرة فلسفة زكي نجيب محمود، حيث لا يبقى الفكر دون مقياس يحدده بشكل دقيق، فنحن نعيش في عالم أصبحت من شروطه لكلّ عبارة ينطق بها اللسان مُشار إليه في الخارج، فيكون هذا المشار إليه هو مدلول الفكرة أو معناها، فالفكرة من المنظور الوضعي: “هي في حقيقتها خريطة عقلية يسلك الإنسان على هداها، وذلك بالإضافة إلى احتوائها دائمًا على قيمة معينة، أي على معيار محدد يقاس به الصواب والخطأ في ذلك السلوك، ثم عن احتوائها كذلك على “الغاية” التي من أجلها يسلك السالك في حياته العملية”[22]، وهذه الفكرة لا تكتفي بتوصيف الواقع، إنّما تساهم في صياغته المستقبلية.
ولكن هذا الكلام لا يلغي إشكال علاقة الأشياء بالعالم والإنسان، فالمعنى قد لا يكون واضحًا دالًّا في كلّ مرة يتحدث فيها الإنسان، ولحلّ هذا الأمر يقسم زكي نجيب محمود المعاني إلى ثلاثة أنواع:
- المعاني التي لها مصاديق في العالم الخارجيّ، حيث يكون اللفظ شيئًا مُجسدًا يمكن الإشارة إليه والحديث عنه، وهنا يكون اللفظ: “طريقة وعمل ووسيلة أداء”[23]، أي ما يطلق عليه مبدأ التحقق.
- المعاني التي نتحدث فيها، وهي عبارة عن تصورات عقلية لا هي مجسدة ولا هي محسوسة، كالحرية التي أستطيع أن أتكلم عنها وأن أشرحها، وعلى الرغم من عدم شيئيتها، أستطيع أن ألحظ مفاعيلها في أنماط سلوكية نراها في حياة الناس الفعلية، وهذا نقل للمعنى من الجانب التصويري إلى الجانب التعبيري[24].
- المعاني التي تتحدث عن الكائنات الذهنية الخرافية، فهذا النوع لا معنى له.
فزكي نجيب محمود ينطلق من الخلفية الإسمية، حيث لكلّ كلمة معنى محددٌ لها في الواقع، وحتى الكلمات مثل الحرية والعدالة والصدق، تخضع لهذا المقياس مع الأخذ بعين الاعتبار أنّها: “تكثيف لجملة كاملة في مفرد لغوي واحد”[25]، وبهذا تصبح المعاني حاملة لثلاث قيم، فهي إما صادقة أو كاذبة أو بلا معنى، الذي يعتبر الوجه السلبيّ للمعنى، وهو يحدث لسببين:
- استخدام الألفاظ بطريقة تخالف ما تواضع عليه أفراد الجماعة اللغوية، بحيث لا يكون لها مدلول في الواقع: “كقولنا في هذا الصندوق أربع مشقرات”[26]، فكلمة مشقرات لا مدلول لها.
- استخدام الألفاظ في غير موضعها أو بطريقة مخالفة لما هو مفهوم.
فالمعنى لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن مبدأ التحقق، الذي يتم عبر وسيلتين، تتمثل الأولى بالمعاينة الحسية المباشرة، أما الثانية وسُمّيت بالإمكان الضعيف، فتعتمد على مجرد الإمكان المنطقيّ: “فإذا وجدنا العقبة التي تحول دون التحقيق الفعليّ عقبة فنية، أو عقبة تجريبية، لم يكن ذلك مانعًا من قبول الجملة أو السؤال من الوجهة المنطقية”[27]، وهذا الموقف الفلسفيّ، ينطلق من الخلفيات التالية:
- طبيعة اللغة: فاللغة لا تنفك عن عالم المادة، وهي وجدت لتشير إليه: “ألفاظ اللغة على اختلاف صورها وأوضاعها قطع من مادة ولا روحانية في الأمر، فاللفظة المكتوبة قطرة من مداد جفت على الورق، لا فرق بينها وهي مسكوبة على الورق كلمة وبينها وهي في الزجاجة قطرة إلا الاتفاق الذي تواضعنا عليه بأن تكون على صورتها على الورق رمزًا لا يقصد لذاته”[28].
- طريقة تعلمها: فالإنسان يتعلم اللغة عن طريق ربط الأصوات بالأشياء: “وهذا هو بعينه الأساس الذي نقيم عليه تعليمنا اللغة لأطفالنا، فأشير إلى شيء قائم على مرمى من الطفل قائلًا له: شجرة، ولولا أنّ هناك الشجرة التي أشير إليها لذهبت لفظتي عند الطفل عبثًا”[29].
وهكذا تصبح حقيقة اللغة لا تنبع من ذاتها إنّما من خارجها ووفق عملية اجتماعية تتواضع عليه المجموعة اللغوية، والوصول إلى المعنى يقتضي دراسة الجملة كاملة وتحليلها عبر درس الألفاظ وطرق تركيبها والعلاقات المتبادلة بينها والسبب الدافع إلى القول، بالإضافة إلى دراسة علاقتها بالواقع الخارجيّ، وهذا ما ينتج عنه انقسام المعنى إلى نوعين من حيث الهدف منه:
- واحدية المعنى: وهذا المعنى نجده في النصوص العلمية، حيث يقتضي الواقع: “أن يكون للاسم مسمّى واحد، وألا يكون لهذا المسمى إلا اسم واحد هو الاسم الذي تصطلح عليه جماعة العلماء ذات الاختصاص الواحد”[30]، فالحقائق العلمية واحدة وإذا تعددت المعاني تخلخل العلم.
- تعدد المعنى: وهو ما نجده في الأدب والشعر وحتى في الفلسفة: “أليست الفلسفة هي الأخرى في كثير جدًّا مما أورده أصحابها فيما قالوه أو كتبوه كلمات تحت كلمات”[31]، فالمعنى في هذه المجالات لا يثبت على صورة واحدة منذ أن يولد بل ينمو بنمو الحضارة، وهذا راجع للقيمة التداولية التي يضعها أفراد المجتمع والمفكرون في تلك الألفاظ حسب القصد وطبيعة التعامل: “فقد تعني العدالة في عصر فكريّ معيّن أن يقتص المظلوم من ظالمه متى استطاع ذلك بشخصه، ثم يتغير العصر فتصبح العدالة أن يقف بين الطرفين قاض محايد وهكذا سائر المعاني”[32].
فهذا المفكر كما رأينا مقتنع بتاريخية المعنى ونسبيته، كما ينظر إلى الواقع المعاش والحياتي وأثره في الإنتاج الدلالي، فتعدد المعاني يُكسب بعض المصطلحات مرونة تسمح لها باستيعاب مختلف المواقف الحياتية للإنسان، وهذه المرونة الدلالية نلمحها في أسماء القيم كالحرية وطريقة فهم الناس لها، حيث نلاحظ قراءات ومستويات متعددة لها.
هوامش البحث:
[1] زكي نجيب محمود، في مفترق الطرق، الصفحة 19.
[2] زكي نجيب محمود، في قيم التراث، الصفحة 115.
[3] زكي نجيب محمود، برتراند راسل، الصفحة 7.
[4] زكي نجيب محمود، موقف من الميتافيزيقا، الصفحة 17.
[5] المصدر نفسه.
[6] زكي نجيب محمود، المنطق الوضعي، ( القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة 2، 1956)، الجزء 1، الصفحتان 4- 5.
[7] أنظر: ركي نجيب محمود، بذور وجذور، الصفحة 198.
[8] زكي نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، (بيروت، دار الشّروق، 1971)، من الصفحة 284 إلى الصفحة 290.
[9] زكي نجيب محمود، خرافة الميتافيزيقا، الصفحة 82.
[10] زكي نجيب محمود، حياة الفكر في العالم الجديد، (بيروت، دار الشّروق، الطبعة 2، 1982)، من الصفحة 238 إلى الصفحة 239.
[11] زكي نجيب محمود، قشور ولباب، (بيروت، دار الشّروق، الطبعة 2، 1981)، الصفحة 221.
[12] زكي نجيب محمود، حصاد السنين، (بيروت، دار الشّروق، الطبعة 1، 1992)، الصفحة 202.
[13] المصدر نفسه.
[14] زكي نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، مصدر سابق، الصفحتان 65- 66.
[15] المصدر نفسه، الصفحة 10.
[16] المصدر نفسه، الصفحة 114.
[17] زكي نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، مصدر سابق، الصفحة 364.
[18] هذه التجريبية تحيل الفكر إلى انطباعات حسية فحسب.
[19] زكي نجيب محمود، قصة عقل، الصفحة 58.
[20] المصدر نفسه، الصفحة 60.
[21] زكي نجيب محمود، موقف من الميتافيزيقا ، (بيروت، دار الشّروق، الطبعة 4، 1994)، من الصفحة 90 إلى الصفحة 91.
[22] زكي نجيب محمود، بذور وجذور، (القاهرة/بيروت: دار الشروق، الطبعة1، 1994) الصفحة 206.
[23] أنظر: زكي نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، مصدر سابق، الصفحة 116.
[24] أنظر: زكي نجيب محمود، في مفترق الطرق، الصفحة 43.
[25] زكي نجيب محمود، حصاد السنين، الصفحة 49.
[26] زكي نجيب محمود، حصاد السنين، الصفحة 162.
[27] زكي نجيب محمود، الوضعية المنطقية، الجزء 1، الصفحة 16.
[28] زكي نجيب محمود، من زاوية فلسفية، الصفحة 119.
[29] المصدر نفسه، الصفحة 10.
[30] زكي نجيب محمود، حصاد السنين، الصفحة 85.
[31] زكي نجيب محمود، الكوميديا الأرضية، الصفحة 205.
[32] زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، مصدر سابق. الصفحة 177.
المقالات المرتبطة
شيلر، فيلسوف البراغماتيّة
ولقد توصلت بعض أدبيات العولمة للربط بينها وبين الفكر البراغماتي الأميركي عامة مما حدا بها إلى اقتراح إبدال مصطلح “العولمة” بمصطلح “الأمركة”.
قاموس الخوف والعذاب في القرآن محاولة درس آيات التخويف
تمهيد لقد تحدث القرآن الكريم عن العذاب بأشكال مختلفة يقصد من بعضها التهديد والوعيد، ومن بعضها الآخر الإخبار عن أحوال
المحمل المصري لكسوة الكعبة تراجيديا سياسية بنكهة دينية
فتح المسلمون مصر عام 20 من الهجرة النبوية /641 من ميلاد السيد المسيح، فكانت إضافة مالية اقتصادية مهمة بالنسبة للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة، فقد كانت مصر سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية طوال 600 عام…