التعددية الدينية
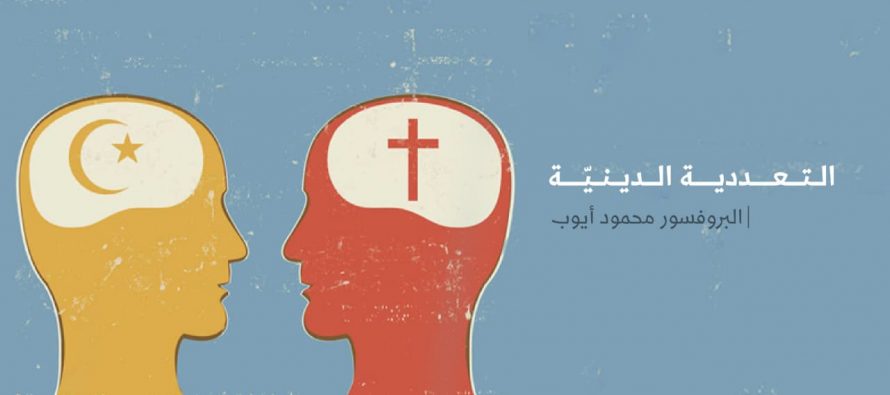
من البديهي القول: إن الأديان جاءت مترابطة ومتداخلة بعضها مع بعض، ولم يأت دين إلى العالم هكذا “موضبًا” ليعطى لأمة، ويقال لها: هذا هو الدين الوحيد. لكننا نرى في الحقيقة أن العديد من الأديان، بل ربما كلها قديمة ومتأخرة، أديان عالمية وأديان بدائية، بدأت كثورات تصحيح في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر ثورات احتجاج على ظروف اجتماعية قائمة وعلى أفكار وعبادات سائدة في المجتمع، وقدّر لبعض هذه الأديان أن تكون إطارًا وينبوعًا لحضارات عالمية غيّرت وجه التاريخ؛ ومن هذه الديانات: البوذية والمسيحية والإسلام. ويمكن أن نضيف إليها أيضًا اليهودية كونها وإن لم تكن ديانة عالمية لعدم انتشارها في العالم ولقلة تعداد أتباعها، لكنها عالمية في تأثيرها على الأديان الأخرى، خصوصًا المسيحية والإسلام، فهاتان الديانتان العالميتان تعتبران تفسيرًا راديكاليًّا للفكر والدين اليهودي. ونلاحظ هذا في القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً﴾[1]؛ مسلمًا بالمعنى العام الأساسي للفظة الإسلام، الإسلام بمعنى التسليم في ما يتعلق بالإنسان، التسليم الطوعي لإرادة الله كما جاءتنا عن طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام.
من هنا نرى أن الأديان إذًا مترابطة، وهذا يعني أن التعددية الدينية يجب أن تكون أمرًا مسلّمًا به، ولكن الحقيقة غير هذا، لأن كل دين أو أتباع كل دين يريدون لدينهم أن يكون هو الدين الوحيد الذي جاء إلى البشرية، ويجب أن يُتبع، فإن لم يتبعه جميع الناس فهم إما جهلة أو معاندون، وهذا ما يدفع الإنسان إلى القول: إن الإسلام لا يختلف في هذا عن غيره من الأديان، وعندما أتكلّم الآن عن الإسلام أتكلم عن الإسلام الشرعي، الهوية الإسلامية التي تعطي المرء الحقوق والواجبات المحتمة على جميع المسلمين.
إذًا مشكلة التعددية الدينية هي مشكلة قديمة وحديثة، فاليهود لم يهتموا – أنا الآن سوف لا أتحدث عن ديانات الشرق الأقصى والهند وغيره– مثلًا بالديانات الأخرى ولو أن في التوراة – بمعنى توراة موسى- هناك إشارات إلى التعددية الدينية، فمثلًا ما يسمى بـ “شرائع نوح”، أو “ميثاق نوح” في التوراة والأدبيات اليهودية يفيد أن الله أوحى إلى نوح بعض التشريعات التي لم تكن تقتصر على فئة معينة من الناس، بل كانت لجميع الناس وهي سبعة؛ منها: إن الإنسان لا يزني ولا يسرق ولا يأكل الدم ولا يتزوج أخته وقوانين من هذا القبيل، ولكن أول أحد عشر فصلًا من فصول التكوين، وهو أول الكتب المقدسة اليهودية ليس إلا مقدّمة للتاريخ الإبراهيمي اليهودي الذي يبدأ بإبراهيم، ثم إسحاق ثم يعقوب ثم أسباط بني إسرائيل وبني اسرائيل فيما بعد. غير أنه لا بدّ أن نلاحظ أن التوراة نفسها تذكر أن ابن إبراهيم الأكبر لم يكن إسحاق، بل إسماعيل، لكن إسماعيل لم يكن ابن المرأة الشرعية، بل ابن السرّية هاجر. فبالتالي الابن الحقيقي لإبراهيم بحسب التفسير اليهودي هو إسحاق وليس إسماعيل بمعنى البكر. فمن هنا نشأت في اعتقادي فكرة الحصرية اليهودية التي تعتبر اليهود شعب الله المختار، والذي أعطاه الله الحق بأن يتملك ويستوطن ويطرد سكان كنعان الأصليين، وأن تكون له أرض الموعد كما أراه الله كل هذه المنطقة، وقال له: إن هذه المنطقة كلها من الفرات إلى النيل سأعطيها لك ولنسلك من بعدك. فأنا عندما أتحاور مع اليهود في أميركا وكندا أقول: لا أريد لله أن يكون بائع أراضٍ، ولكن فليكن كذلك إذا كنتم أنتم تريدون ذلك، ولكن من هم أولاد إبراهيم؟ أولاد إبراهيم بحسب التوراة هم: إسماعيل وإسحاق وثلاثة أولاد آخرون من امرأة ثالثة اسمها “كتورة”، وهكذا لإسحاق كان ولدان “عيسو”،
و”يعقوب”. عيسو طُرد وأصبح أب الشعوب المدنسة غير اليهود، ويعقوب أصبح أب اليهود، ولكن نرى أنه عندما احتك اليهود من وقت سبي بابل، ثم بعد الحكم الفارسي الذي دام مدة في بابل وغيرها، نرى أن هناك شيئًا من الكونية والشمولية للدين عندما يتكلم الله عن لسان الأنبياء أمثال “عاموس”، و”أرميا” وغيره ويقول: إن المصريين شعبي كما إن الأثيوبيين شعبي والسوريين، يعني الشعوب السورية (السريان) شعبي أيضًا، والكل سيأتي ليعبد الله في جبل الله المقدس أي في صهيون. فنرى إذًا توترًا دائمًا حتى اليوم في الأمة اليهودية بين الحصرية والإقصاء للآخر، وبين الشمولية والكونية، وهذا إلى حد ما ورثته المسيحية؛ فعندما قامت الكنيسة الأولى ونظّر لها “بولس” الذي يسميه المسيحيون رسولًا، اعتبر بولس أن سقوط الهيكل وانتهاء عبادة العبرانيين القديمة بالذبائح والقرابين، وهكذا؛ يعني أن الميثاق أو العهد القديم بين اليهود والله قد انتهى، وبالتالي الكنيسة هي إسرائيل الحقيقية، وهي إسرائيل الجديدة، وإذا لم يدخل اليهود في المسيحية فهم فقط معاندون ولا يريدون أن يقبلوا بالحقيقة. وقسّم آباء الكنيسة الشرقيون الذين صاروا يُعرفون فيما بعد بالبيزنطيين البشرية إلى ثلاث فئات: اليهود الذين رفضوا المسيح، والعهد الجديد الذي قطعه الله مع البشرية من خلال المسيح، والكنيسة المسيحية التي هي إسرائيل الحقيقية وبقية الناس، لم يعرفوا الكثير عن الديانات وتاريخ الأديان. هناك بعض الإشارات إلى بعض الرهبان الهنود، ولا شك في اعتقادي أن الرهبانية المسيحية أخذوها عن الرهبانية البوذية التي نشأت في الهند، ولكن ليس هذا موضع بحثنا الآن. الذي أردت أن أقوله: إن المسيحية في جوهرها ليست ديانة تعددية بالحقيقة، ولكن التعددية كما سنرى – يعني كظاهرة دينية في المسيحية- جديدة، ثم ننتقل إلى الإسلام. في اعتقادي أنا أن الإسلام أكثر الديانات قبولًا للآخر، وأكثر الديانات تأكيدًا على التعددية البشرية في كل أنواعها. فمثلًا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾[2]؛ إن اختلاف ألسن الناس وألوانهم هو آية من آيات الله؛ فاختلاف الألوان يعني اختلاف الأعراق والإثنيات، واختلاف الألسن يعني اختلاف الحضارات بما فيها الدين، لأن الدين في اعتقادي ليس مجرد مجموعة عقائد وطقوس، ولكن الدين أيضًا حضارة. ويفسِّر القرآن هذه التعددية بقوله: إن الناس في زمن ما كانوا أمة ثم بعث الله النبيين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، والسؤال هنا، هل تعدّد الأنبياء وإنزال الكتاب معهم كان سبب التعددية؟ أو إن التعددية حصلت ثم بعث الله النبيين ليحكم كتابه المنزل عليهم فيما اختلفوا فيه؟ ثمّ يشرح القرآن الكريم التعددية بآيات تتردد تقريبًا في أكثر من موضع، وتحمل نفس الموضوع وهي: ﴿وَلَوْ شَاء اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾[3]. لماذا لم يجعل الله الناس أمة واحدة؟ في آية يقول: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[4]؛ يعني التعددية هي نوع من الابتلاء الإلهي ليرى الله أي الناس أحسن عملًا، وأنا أعتقد معنى هذا بأن يعيش الناس رغم هذه التعددية كأسرة واحدة، خُلقوا من ذكرٍ وأنثى، وجُعلوا شعوبًا وقبائل مختلفة ليتعارفوا، فأكرم الناس عند الله أتقاهم إذًا ليبلوكم أيكم أحسن عملًا فاستبقوا الخيرات. هذه التعددية التي يطرحها القرآن تدل على اختلاف الحضارات والألسن والأعراق، وهذا طبيعي بين البشر، ولكن الله لا يريد الخلاف، يعني أن تختلف الناس بحيث تتنافر وتتشاحن وتتباغض، ذلك لأننا نحن هنا في هذه الحياة الدنيا لا نعلم الأمور على حقيقتها، لذلك يردّد القرآن قول الله: ﴿إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾[5]، هذا يعني أن الحقيقة العظمى أو الحقيقة الكبرى واحدة في الأساس تتمحور حول فكرة وحدة الله، لأن الله هو الحق والحق هو ما أنزله الله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾[6]. هذه التعددية بمقتضى هذه الآية أيضًا قائمة على الاختيار الحر للإنسان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعندما يتحدث القرآن الكريم عن الإكراه في الدين وينفيه نفيًا باتًا، يعني ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾[7] لا تحتمل التأويل والتفسير، ولكن لا يتوقف القرآن عند ذلك، فهو يقول: قد جاء الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن؛ ومن شاء فليكفر؛ في هذه الآية يقول: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[8]. هذا أيضًا يعطي الحرية للإنسان في قبول الحق عندما يتبين له؛ الآن أنا قلت الكثير مما تعلمون، ولكن أردت من وراء هذا أن أتوصل إلى ما نحن بصدده وهو التعددية الدينية. ومن المفيد التوقف عند حقيقة علمية هامة في الإسلام، وهي الدراسات الخاصة بالأديان، فالعلماء المسلمون كانوا أول من اهتم بتاريخ الملل والنحل؛ أما النحل فهي الفرق الإسلامية أو الفرق في الأديان الكبرى الأخرى، والملل هي الديانات العالمية، ولم يكن الشهرستاني وكتابه الشهير الملل والنحل أول من اهتم بهذا الموضوع، فأبو ريحان البيروني سبقه، ثم اهتم ابن حزم الأندلسي والكثير غيره بهذا الموضوع.
وهؤلاء العلماء الذين اهتموا بتاريخ الأديان عملوا على دراستها من خلال منهج يدرس بنية هذه الأديان وعلاقتها مع الأديان الأخرى، ولم يكتف بعرضها بشكل هامشي في منظومتهم الدينية؛ بل هم أفردوا لها مكانًا مميزًا في علومهم، حتى إن هذا الموضوع أصبح جزءًا من علم الكلام، يعني معظم كتب علم الكلام فيها فصل على الأقل عن الأديان الأخرى بما فيهم البراهمة. فالإسلام إذًا لم يهمل هذه التعددية التي طرحها القرآن كمنظار للحقيقة التاريخية لبني البشر.
ولكن مع ذلك نرى بروز توتر في التعاطي مع هذا الموضوع بين المنظومات المعرفية الإسلامية، فهناك فرق بين الفقه في هذا المجال وبين ما يمكن أن نسميه علم دراسة الأديان في الإسلام، وربما يتم بحث هذا فيما بعد.
وبالعودة إلى الموضوع الأساسي، مرّت المسيحية بعد عصر النهضة، يعني في القرن الخامس عشر وما تلاه، بتحولات جذرية للعقيدة المسيحية ولمعظم مفاهيمها، أنا لا أقول: أنْ ليس هناك ثمة استمرارية بين مسيحية الكنيسة الأولى والعصور الوسطى، ومن ثم القرون المتأخرة فترة التنوير وغيرها، ولكن أقول: إن نشأة الطوائف البروتستنتية أو ما صار يُعرف بطوائف الإصلاح البروتستانتي غيّرت وقلبت مفاهيم كثيرة، من ثم ظهور العلمانية في أوروبا أيضًا غيّر الكثير من المعايير، وعندما نريد أن نتحدث عن التعددية الدينية عند المفكرين في العصر الحاضر بمن فيهم “جون هيغ” – وأنا أعرفه شخصيًّا – هذه التعددية ليست نابعة من صميم العقيدة المسيحية، ولكنها نابعة من إنسانوية العلمنة أو ما نسميه العلمنة الإنسانونية، أو العلمنة الإنسانية التي وضعت الإنسان على أنه هو المعيار الأساس وليست الحقيقة الدينية، فبحسب الفكر العلماني المعاصر -حتى بين رجال الدين- يمكن القول: إن كل الناس إخوة؛ وبالتالي لا بدّ لنا من قبول التعددية الدينية. وهذا الأمر تشجعه حركة المجتمعات الإنسانية، حيث أصبح الناس في الشرق والغرب، يعرفون عن الأديان الأخرى أكثر بكثير مما كان يعرف آباؤهم وأجدادهم، هذا شيء، والشيء الآخر أن الكثيرين من مؤرخي الأديان واللاهوتيين المسيحيين في الغرب تأثروا بالفلسفات الهندية بمن فيهم “جون هيغ”، وعلى وجه التحديد “الفيدنتا”، أو فلسفة وحدة الوجود الهندية وبعض الفلسفات البوذية؛ لأن البوذية لم تقم على أي عقيدة أو على أي إيمان بالله، ولكن على فلسفة أخلاقية وإنسانية؛ فبالتالي تأثر هؤلاء بهذه الفلسفة، ولهذا التأثير تاريخ يعود إلى القرن التاسع عشر عندما تُرجمت بعض النصوص الهندية المقدسة “الأوبانيشاد” إلى اللغات الأوروبية. من الطريف هنا أن أول من ترجم هذه النصوص هو “المير فيندرسكي” الفيلسوف الإيراني المعروف، ثم “دارافكو” أخو الإمبراطور المغولي في الهند أكبر، ومن ثم تُرجمت هذه النصوص من اللغة الفارسية إلى اللغة الهندية فيقول مثلًا الفيلسوف الألماني “شوبنهاور”: إن “الأوبانشيد” هذه النصوص هي عزائي في هذه الدنيا وستكون عزائي في الآخرة، أيضًا يعني فلسفة “الأوبانشيد” إجمالًا تقول: إن حقيقة الوجود هي واحدة، وإن هذه الحقيقة المطلقة الواحدة هي أيضًا النفس الإنسانية “براهمن أتمن”، لا داعي لشرح هذه الفلسفة أكثر، وبالتالي معظم المنظرين للتعددية الدينية الآن ومن جملتهم “جون هيغ” لا يقدّمون نظرية يمكن أن تقبلها لا المسيحية ولا الإسلام، بل إن هذه التعددية بنظر “هيغ” ترتكز أساسًا على ديانة، أو على فكر غير منظور، أو على حضور إلهي غير منظور، أو على وجه التحديد فلسفة توحد هذه الأديان مع تعددها، والشيء الآخر، أنا الآن أكتب ردًّا على لاهوتي وكاهن كاثوليكي مسيحي في أميركا كتب مقالًا عن كلمة الله في المسيحية والإسلام، يعني هو يريد أن يقبل الإسلام، ولكن لا يستطيع لأنه قال لي: إنه إذا أنا قبلت الإسلام هكذا بدون أي شروط أفقد المسيح مركزيته في حياته؛ فأنا قلت: لا! لماذا عندما تتحدث عن اليهود تقول: اليهودي هو أخي الكبير لأننا نحن ورثنا كتابهم المقدس، يعني العهد القديم، وعندما تتحدث عن الإسلام تمدح تقوى المسلمين والتزامهم بدينهم، ولكن تقول: العقائد الإسلامية هي في نهاية الأمر عقائد خاطئة؟ فأنا قلت له: ما هي العقيدة الخاطئة أن نحتار بكون الله واحدًا أو ثلاثة أو أن نقول: إن الله واحدٌ خالق كل الأشياء؟ هل هي عقيدة خاطئة أن نأخذ الكثير من العقائد الوثنية، ونترك الكتب المقدسة التي أنزلها الله على أنبياء بني إسرائيل؟ فأنا قلت: سأرفض كتابة مقال لأنه لا مجال للحوار؛ فهو كتب لي عدة مرات يرجوني أن أكتب له شيئًا، حتى قال لي: اكتب ردًّا على ما قلته أنا وبيّن نقاط خطئي.
فالجو الحواري سائد بيننا وبين المسيحية وهناك مواضيع كثيرة للنقاش، فأنا أرى أن الغربيين غير “صاموئيل هانتغنتون” الذي تحدث ليس عن تعددية الحضارات والحوار، إنما عن تصادم الحضارات عبر خلط غير مفهوم بين الإسلام والصين أو”الكونفوشستية”، ولكن هو يريد أن يعمّم الفكرة التي تقول في اللغة الانكليزية: ” the west against the rest” “الغرب ضد بقية العالم”؛ وهذه النزعة التي يروج لها هانتغنتون جرت إشكالات للكثير من المسيحيين الذين الآن يعتذرون عنه ويقولون: لا، نحن نريد أن نتعايش بإخاء وسلام مع المسلمين. يعني أنا لا أتكلم عن “جورج بوش” و”بيل كلينتون”، أنا أتكلم عن الإنسان العادي في الكنيسة الذي أحاوره، فهؤلاء الناس، وأنا على يقين أنه في معظم الحالات هم بالفعل مخلصون في ما يقولون، يريدون تعددية دينية تسودها المساواة الإنسانية، وهذه التعددية الدينية لا تنطلق من العقائد المسيحية والأصول المسيحية المعروفة، ولكن من المسيحية المعاصرة التي أصبحت، تقريبًا وخصوصًا في الكنائس البروتستانتية، مسيحية إنسانية؛ ربما يقال: إنه إذا أخذنا الإسلام ببعده الفقهي الضيق، إجمالًا أقول: الضيق الفقهي أي فقط الفقهي، لا أقول: إن الفقه ضيق، ولكن ببعده الفقهي الضيق، وأخذنا المسيحية بحسب تعاليم العهد الجديد الضيقة أيضًا، فلا المسيحيون ولا المسلمون الأصوليون يريدون أن يعترفوا بهذه التعددية. فأنا إلى حد ما أكاد أن أكون -كما يقول كتاب التوراة وخصوصًا على ألسنة الأنبياء في سفر أشعيا- صوتًا صارخًا في البرية، لأني أنا أدافع عن التعددية الدينية والحضارية والعرقية التي قال بها القرآن. هذه التعددية تنبع من توحيد الله سبحانه وتعالى ووحدة البشرية، وهذه التعددية في نهاية الأمر تؤول إلى الوحدة عندما تكشف للناس حقائق الأمور كما هي عند الله سبحانه وتعالى. فبما أن الله هو واحد ومنه المبدأ وإليه المعاد، فتاريخ البشرية لا يمكن أن يكون تاريخ حضارات غنية، وتاريخ فنون جميلة وتاريخ آداب وفلسفات إذا لم تكن هناك تعددية حضارية ودينية؛ فمن هنا نرى أنه وفي اعتقادي أن كل الأديان القائمة هي بأمر الله ومشيئة الله، الذي لم يترك الناس بدون هاد وبدون أنبياء ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ﴾[9]. إذًا السؤال الذي يتحدى المسلمين هو: كيف ننظر إلى “كنفوشيوس”، وإلى “بوذا”، وإلى “زردشت”، وإلى فلاسفة اليونان القدماء الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة، وحتى إلى “أفلوطين” الذي جاء بعد المسيحيين؟ ما هو النبي، هل النبي هو فقط الذي يتنبأ بالغيب؟ أم النبي الذي يهدي الناس إما من خلال الشريعة أو من خلال نظام فلسفي أو إيماني معين؟
إذا عمّمنا مفهوم النبوة ربما نصل إلى فهم أفضل للآخرين، ونحن بذلك لا نكون مبتدعين، بل نذهب إلى ما ذهب إليه الرسول (ص). في القول إن أفلاطون، كان نبيًّا اضطهده قومه، فهذا القول ربما فيه شيء من النظر، وأنا أنتظر في الحقيقة أن يقوم بعض الباحثين، أنا أو غيري بكتابة تاريخ للأديان بمنهجية جديدة، ومن منطلق قرآني يؤكد على أن الله لم يترك أمة في العالم بلا نذير ومع التوسع في تاريخ الأديان لتشمل الأنبياء في المجتمعات الأخرى، لأن الأنبياء المذكورين في القرآن بمجملهم إما أنبياء بني إسرائيل أو بعض الأنبياء العرب الذين أرسلهم الله إلى القبائل العربية كمدين وثمود وعاد.
إذًا، فأنا أعتقد أن التعددية الحضارية والدينية قد تكون هي المخرج من كابوس العولمة التي تسعى إلى خلق حضارة سطحية منحطة تفرضها القوة على جميع الناس، أنا أستعمل الحاسوب أو الكمبيوتر كل يوم والإنترنت أيضًا، ولكن لا أعبد الإنترنت. الإنترنت ليس إلا وسيلة لإرسال الرسائل وتقبل الرسائل وإجراء البحوث في المكتبات وغيرها، ولكن لا يجب أن يكون له أي سلطة اقتصادية أو روحية أو اجتماعية على الناس.
وأنا أعتقد أن ما يقوله الناس الآن: إن العالم أصبح قرية صغيرة، هذا كذب وافتراء، الناس لا يزالون يعيشون في قرى صغيرة وحتى في أكواخ، يعني أبناء الوطن الواحد كما في الهند وغيرها يتكلمون بلغات عديدة، ويدينون بأديان عديدة، ويقتل بعضهم بعضًا باسم العولمة والتعددية. فأنا إذا كان عندي هدف من كل نشاطاتي في مجال الحوار فهو محاربة العولمة والدعوة إلى التعددية الدينية والحضارية.
[1] سورة آل عمران، الآية 65.
[2] سورة الروم، الآية 22.
[3] سورة المائدة، الآية 48.
[4] سورة هود، الآية 7.
[5] سورة المائدة، الآية 48.
[6] سورة الكهف، الآية 29.
[7] سورة البقرة، الآية 256.
[8] سورة البقرة، الآية 256.
[9] سورة فاطر، الآية 24.
المقالات المرتبطة
تواصليّة التقليد المنطقيّ
هي قراءة في كتاب Relational Syllogisms and the History of Arabic Logic, 900-1900، للمؤلّف خالد الرويحب، خطها الدكتور سجّاد رضوي،
الهوية المصرية بين الفرعونية والإسلامية/العربية
تقديم يثار الجدل حول الهوية المصرية، (والهوية بضم الهاء وليس بفتحها، فكلمة الهوية جاءت من فعل هو)، هل هي دولة
محاورة لقمانية مليكة وليل غزة وسورة الإسراء | الحلقة الثانية
وضعت مليكة يدها في يد مريم ومضيا إلى غرفتهما… تمتمتُ وأنا أتابعهما بعينيّ: “ليحفظْ الله كل أطفال فلسطين!!…”. قالت أم مليكة: “يا رب المستضعفين!”.





