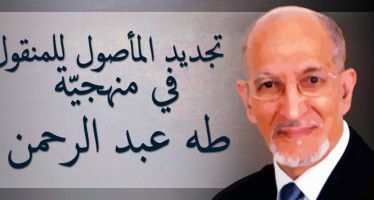“وحدة في التنوع” لأديب صعب: المسوغات “الداخلدينية”
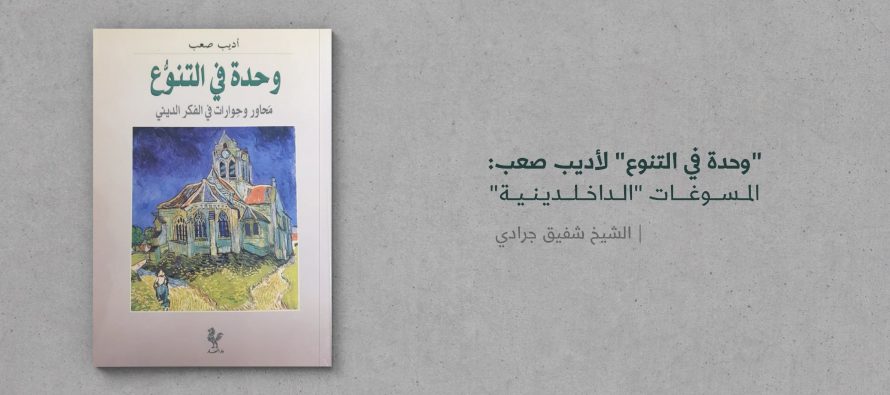
“وحدة في التنوع”* عنوان لكتاب لم يخفِ صاحبه ميادين اهتماماته المتعددة المحور والحوار، الموصولة على قاعدة الفكر الديني. وفصول الكتاب المتشعبة، التي وصلت إلى اثني عشر فصلًا في القسم الأول، يتضح لديك، بعد قراءتها، عين ما أعلنه صاحبها الباحث الدكتور أديب صعب من “أن الفصول، كما هي، تشكل وحدة ينطبق عليها عنوان الكتاب انطباقًا تامًّا”. وبسبب هذا الانطباق – كما يتابع المؤلف – يعود إلى “أننا توصلنا إلى منهج، هو الذي أرسيناه في المقدمة، نستطيع اعتماده لمعالجة شؤون الفكر الديني”(ص12). و”المقدمة” هي كتابه السابق المعروف: “المقدمة في فلسفة الدين”، الصادر قبل عقد من الزمن.
ما نلاحظه مع المؤلف، أولًا أن الكتاب استكمال رباعي لثلاثية سبقته. وثانيًا أنه ينطوي على وحدة آتية من وحدة المنهج. وثالثًا أن الكتاب والكلام – للمؤلف – “أقرب إلى القارئ المثقف أو طالب الثقافة غير المختص فلسفيًّا”. ورابعًا أن “كل محور من هذه المحاور يمكن أن يشكل موضوعًا قائمًا في ذاته، يتولد منه عمل رئيسي في الفكر الديني” (ص12).
وبما أنني سوف أركّز اهتمامي على القسم الأول من الكتاب دون أن يعني ذلك أن ما يلي هذا القسم غير مهم، فإني سأركّز أيضًا على المنظار البارز في هذا الكتاب والذي يسعى فيه الكاتب إلى قراءة الفكر الديني على أساس مرتكزات ومنطلقات فهمه الديني الذي عبّر عنه بفلسفة الدين. وخصائص هذا الفهم تقوم على ستة عناصر:
العنصر الأول: اكتشاف الدين الطبيعي في ذات الإنسان، والذي جاءت الأديان لتعبّر عنه ولتؤكده.
العنصر الثاني: استجلاء القاسم المشترك بين الأديان، على تعددها، إذ كما يقول أديب صعب: “الإيمان الذي نتكلم عنه هنا لا يقتصر على الاعتقاد بدين معيّن، ولا بطائفة معينة، ولا بطائفة أو مذهب أو فرقة ضمن دين واحد… إن الإيمان كما نتكلم عنه هنا هو ذلك العنصر المشترك بين الأديان كلها”.
العنصر الثالث: يوضح المؤلف “أن نطاق الدين هو العالم مخلوقًا، أي نطاق السببية الغائبة والإعجاز. وعندما يتلاقى المؤمنون وغير المؤمنين ليشكلوا مجتمعًا واحدًا، بل عالمًا واحدًا، فهم إنما يتلاقون على مفهوم الغائية وإن عجزوا عن اللقاء على مفهوم الإعجاز. لكن مبدأ الغائية كافٍ لإقامة عالم يكتنفه العدل والسلام والسعادة إلى أبعد حد ممكن”(ص11). وهذا يعني، مما يعنيه، إمكان توظيف المنظار الفلسفي للدين لإيجاد قواعد اللقاء حتى بين أصحاب الاتجاه الديني واللاديني، وتسويغ التنوع واحترامه، مع الاجتهاد لاكتشاف عناصر الاشتراك الجامعة.
العنصر الرابع: أن التنافر بين الدين من ناحية، والعلم والثقافة والفلسفة وغيرها من ناحية أخرى هو تنافر مفتعل. كما أن العلاقة بينهما ليست تبادلية، بل لكلٍ نطاقُه الذي يتحرك فيه. ولو صح القول بأن نطاق الدين هو “المعجز” و”المقدَّس”، فهما، في نظر المؤلف، ليسا خارج العالم، بل إن العالم، عبر تلاقيه بالخبرة الدينية، يصبح وجهًا للقدسية ونظرة الإعجاز.
العنصر الخامس: بمقتضى ما مرّ، يقدّم الدكتور صعب جملة من الآراء المتعلقة بروح الحوار وموجبات التعليم الذي يلحظ الآخر كما يلحظ حركة التوسّع العلمي والمنهجي والمعرفي كحاجة ضرورية يتوجّب على معاهد اللاهوت أو الدراسات الدينية السعي للاهتمام بها ونشرها.
العنصر السادس: يؤكّد المؤلف على وظيفة يعتبرها خاصة جدًّا لفلسفة الدين هي الدفاع عن الدين في وجه النظرات المعادية، معتبرًا “أن الدراسة اللاهوتية المتوازنة، التي تجمع النصوص المقدسة والتفسير والعقائد جنبًا إلى جنب مع الفلسفة والفنون والتاريخ والعلوم السلوكية والآداب، من شأنها أن تُفضي إلى النظرة البديلة المنشودة للدفاع الديني أو اللاهوت” (ص102).
يذكّرني النص الأخير بما يقوله الداعون من المسلمين إلى قيام علم الكلام الجديد حول ضرورة مراعاة هذه الجوانب في بناء الهوية “الوسيطة”، والهوية “الدفاعية” لعلم كلام جديد يتناسب مع مقتضيات التطور ومتطلبات الحياة وتغيّرات الزمن. وهذا التشابه ليس بالأمر المستهجن. فالحاجة (كما الابتلاء) إذا نزلت عمّت. والحاجة التي يفرضها الواقع لا بدّ أن تلزم أصحاب كل دين بل كل رسالة وفكر إعادة المراجعات النقدية لمستويات فهمهم ونظرتهم الدينية.
لكن الذي أثاره علماء الكلام الجديد أن الدفاع عن الدين، كما التوسط بين الوحي والناس، هو من هوية علم الكلام الجديد لا الفلسفة، وأن استفادة هذا العلم من القواعد والحجج والبراهين الفلسفية. إلا أن التوظيف لهذه الاستفادة يحصل من أجل الدفاع والتبيان والتسويغ للدين وقضاياه، وهي قضايا متعلقة بالوحي.
هنا يختلف علم الكلام الجديد عن فلسفة الدين التي تعتمد القواعد والحجج والبراهين، من أجل إجراء نقد استكشافي للمنظومة الدينية ومحاكمة قضاياها على أساس الصدق والكذب. وأعتقد أن اللاهوت “السجالي”، أو “الإيجابي”، أو “الفلسفي” حسب مصطلح المؤلف، ينطوي على مهمات مشابهة لتلك المطروحة في بناءات الهندسة المعرفية لعلم الكلام الجديد.
بل من اللافت هذا التلاقي مع ما أسسته أوساط علمية ولاهوتية في الكنيسة الكاثوليكية وأطلقت عليه اسم “لاهوت الأديان غير المسيحية”. وهو كما يوضحه الدكتور مشير عون، “علم لاهوتي حديث العهد نشأ في السنوات التي سبقت انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني. وحظي باعتناء خاص إبان انعقاد المجمع، وما عتم أن اكتسب مداه اللاهوتي الشرعي في الكنيسة الكاثوليكية ولاهوت الكنائس المسيحية الأخرى… وإن نشوء هذا العلم اللاهوتي الحديث يواكب بحث حثيث عن مكانة هذا العلم المعرفي… واجتهاد دائم في تبيين خصوصية دعوته وميزة وظيفتـه وفرادة رسالته اللاهوتية في خضــم التنـوع المطــرد”[1].
وتحدّي الفرادة هذا هو باعتماد النظم المعرفية المعاصرة في التعرف على الأديان الأخرى غير المسيحية لاستجلاء القواسم المشتركة معها، مع الحفاظ على أمانة البشارة المسيحية. بناء على هذا، ما هو التقاطع بين مثل هذا الاتجاه اللاهوتي أو الكلامي الجديد وفلسفة الدين؟ وهل يجب علينا، ونحن نقدم أي حقل علمي أو معرفي، أن نعمد في تحديد هويته إلى ما اصطلحت عليه بعض الضوابط المنهجية المنطقية بالحد التام أو الرسم التام على الطريقة الأرسطية؟ هذه الطريقة تفضي إلى أمرين: أولهما أن بناء أي علم يكون على أساس تحديد موضوعه الجامع بين مسائله، وعلى جوهر يتقوم بتمايز الهوية الخاصة به من جهة، والمغايرة مع الخارج عنه من جهة أخرى، وذلك لتثبيت التعريف الجامع المانع. وثانيهما تكريس التفاصيل بين العلوم ومسائلها ومستلزماتها.
فهل نحن مضطرون لمثل هكذا ضوابط في التعاريف ومستلزماتها؟ أم يمكن لنا نفض اليد عن مثل هذه الضرورة المنطقية الصورية، والاكتفاء بتحديد المشخصات والسمات المفاهيمية والمعرفية لذاك العلم، بحيث نتعرف إلى خصوصياته من جهة، ونترك باب التفاعل والارتباط – ولو بنحوٍ ما – مفتوحًا بين العلوم والمعارف من جهة أخرى.
إني أذهب مع أديب صعب إلى أن الاختلاف على الأسماء ليس أمرًا ذي بال عند الباحثين. وقديمًا قيل عند علماء الأصول إن “لا مشاحة في الاصطلاح”. بل أذهب إلى القول بأن ما قدمه الدكتور صعب من توفير أرضية معرفية للحوار الديني لهو أكثر استقلالًا مما قدمته طروحات لاهوتية أو كلامية جديدة. ذلك أن المطمح المعرفي عند الكاتب يشتغل على أرضية أكثر حيادية في البحث. من هنا يعمل على جملة من القواعد والمنطلقات، مثل الدين الطبيعي أو الفطري ومركزية الإنسان كمقصد غائي للدين، والبحث في هواجس معرفية عن القواسم المشتركة بين الأديان لاكتشاف “الدين في الأديان” كما يسمّيه. لكن هذا لم يمنع الكاتب من استعارة مبان ومرتكزات وشواهد تسويغية مستمدة من تراثه الديني، مع ترك الباب مفتوحًا على استنتاجات أوصله إليها بحثه. وهذا أمر طبيعي لدى كل باحث. فالقَبْليّات حال يعيشها الباحث في أي حقل معرفي، كما يشير غادامر في مباحثه المتعلقة بالهرمينوطيقا الفلسفية.
أخيرًا، لا بدّ من ملاحظة جملة أمور حول فلسفة الدين عمومًا:
أولًا: لا يصح حصر فلسفة الدين بتحليل مفهوم الله أو الإله المطلق، لأن استكشاف الفلسفة للدين قد يتمركز حول العلة الغائية للخطاب الإلهي (الدين)، المتمثل بالإنسان. وقد يتناول الدين كظاهرة سلوكية أو طقوسية أو ما هو أعمق من ذلك.
ثانيًا: علينا أن نفرّق أثناء البحث في فلسفة الدين بين الاهتمامات التي تصب ضمن دائرة العلاقات الاجتماعية والتربية وشؤون التعليم، والتي تثيرها وسائل الحوار والتفاهم بين الجماعات، وبين الرؤية المعرفية التي هي بالخصوص مدار اهتمام فيلسوف الدين. وهذا لا ينطلق من مبتغيات عملية مقررة سلفًا، وإن كان ممكنًا لأي حركة عملية أن تستفيد من النتائج والنقد المعرفي الذي يتوصل إليه البحث.
ثالثًا: إن أخذ الدين كظاهرة هو المدخل الطبيعي لإجراء الاستكشاف الفلسفي النقدي لفلسفة الدين. والظاهرة قد نعالجها كما تتبدى في جامعية الأديان تارة، وفي دين محدّد تارة أخرى، دون أن يؤثر ذلك على طبيعة المعالجة الفلسفية. عليه، فلا يشترط أن يكون البحث في ظاهرة الأديان عمومًا لينتمي إلى فلسفة الدين. إذ قد نبحث في دين محدد، مميزين فيه بين الجوهر والأعراض ومنتهجين نهجًا معرفيًّا ينطوي على نقدية فلسفية استكشافية، ليصح تسمية البحث بفلسفة الدين.
رابعًا: علينا الاعتراف بأن فلسفة الدين لم تتحول بعد إلى علم مستقل، وأن مناهجها ما زالت في مراحل الاختبار، سواء على صعيد المنطلقات أو الموضوعات أو اللغة أو المسائل أو المقاصد. لذلك، من المبكر اختزال الرؤية بنظرة واحدة، خصوصًا أنه لا يزال هناك جملة من الأسئلة تحتاج إلى إجابات، مثل: إلى أي مدى ينبغي علينا البحث عن منهج موحد لفلسفة كل دين أو للدين الجامع؟ هل هناك من مانع معرفي يحول دون البحث عن منهج ومنظومة كل دين على حدة؟ هل علينا أن نطوّع التعرف إلى الحقيقة الدينية لمصلحة المنهج، أم نبني المنهج على ضوء الحقيقة الدينية ومعطياتها؟ هل تعدد المناهج والمنظومات يعوق تسمية كل منها بفلسفة الدين على طبق معايير محددة؟ هل يمكننا الخروج من اقتناعات وسائل ومعتقدات داخلدينية” لبحث “خارجديني” تمارسه فلسفة الدين؟ هل حسمت الأديان ومؤسساتها وشخصياتها المسوغات “الداخلدينية” للقيام بمعالجة شؤون حقل معرفي هو فلسفة الدين؟ وهل لهذه الأديان القابلية للاستجابة إلى مفردات منهجية في المعالجة وطرق في الفهم ونتائج في الحكم، حتى وإن اختلفت مع ما اعتادته من مسلّمات فكرية دينية؟ كيف نوفّق بين التعالي في الحقيقة الدينية ونسبية التعددية الدينية في ظروفها القائمة فعلًا؟
إنها أسئلة، كما غيرها من الأسئلة ستبقى بحاجة إلى إعمالات فكرية جدية نتمنى لأصحابها كل التوفيق كما تلمَّسنا التوفيق الذي حظيت به الأبحاث الرائدة للفيلسوف الديني الدكتور أديب صعب. وإذا كان العام 1994 قد شهد إجماعًا على الترحيب بهذه الريادة إثر صدور العمل الذي يعتبره المؤلف محوريًّا في فلسفته المتكاملة، وهو “المقدمة في فلسفة الدين”، فليسمح أن أقول له: حللت أهلًا ووطئت سهلًا. فها هو مشروعك الجدّي في فلسفة الدين قد استقرّ على الأجوَد، راجين لك الاستمرار في هذا الزخم المعطاء، ولجهدك أن يفتتح على الدوام تباشير قطاف لثمار من المعرفة الرائدة.
* أديب صعب، وحدة في التنوع، (بيروت: دار النهار، 2004)، 256 صفحة
[1] مشير عون، “الأسس اللاهوتيــة في بنـاء حـوار الاســلام والمسيحية”، الصفحة 68.
المقالات المرتبطة
مصطلحات عرفانية | الجزء 17
تشبيه – تنزيه – التمثيل والتشبيه: وذلك أن من شاهد الوجود كله وجودًا واحدًا، وما عرف كيفية كليته وكيفية معيته
تجديد المأصول للمنقول في منهجيّة طه عبد الرحمن
على إيقاع التفلسف المتجدِّد، ينبري العلّامة طه عبد الرحمن لتناول التراث المنقول بمنهج فلسفي، منطقي/ لساني، مأصول. ويتوسَّل آليّات منهجيّة تحديثيّة، وفقًا لنظرته الفلسفيّة القائمة على اعتقاده بأنّ لكلّ عصر حداثته
نهج الاقتدار عند الإمام علي (ع)
هناك اتجاهان سادا في تقديم الإسلام. الاتجاه الأول: وهو اتجاه العزلة النصوصية أو الروحية الذي عمل على أن يتفاعل مع