مع علي حرب في منطقه التحويلي مأزق الاستقراء ونهاية المثقف
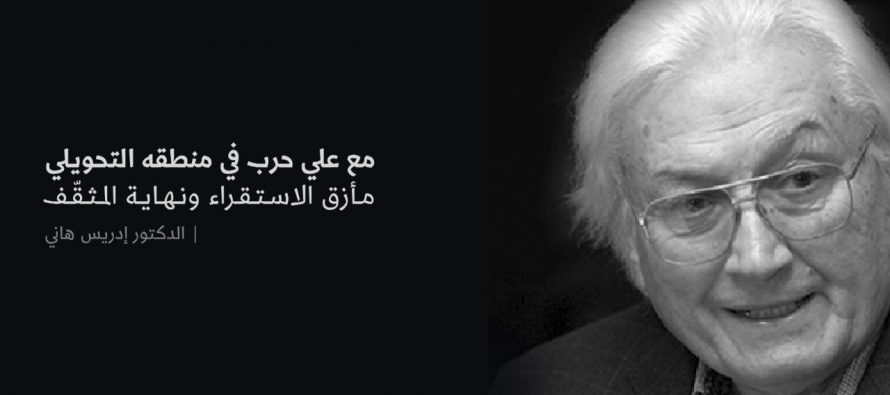
افترض لو أن كل مثقفي العالم قرروا أن يصبحوا نيتشويين بامتياز، من يضمن بألا ينبري من بينهم من يعلن موتهم جميعًا..يا له من انتحار جماعي!
مدخل
إذا كان لا بدّ من ممارسة نقدية واختلافية مع أعمال د. علي حرب – حيث تبدو في هذه الأيام، وكأنها في نزعها الأخير، بعد أن مرت كموضة عابرة، لكنها صاخبة – فليس معناه النقض على التفكيك أو الوقوف منه موقف السلب، بقدر ما يتجه نقدنا إلى التفكيك، حيثما ولد خداجًا في محيط، إشكاليته بنائية بامتياز، أو حينما يصبح هوسًا أو مرضًا نقدويًّا، أو حينما يصاب بعدوى اللاحقة “ism”، فيتحول إلى تفكيكانية “Destructuralism”، مذيبة لكل ما هو صلب في عالم الأفكار، أو حينما تتضخم رسالته فوق الحاجة، كأن نفكك أنقاضًا مفككة سلفًا، أو تفضح مفضوحًا أو نحاكم أنساقًا مجبولة على الهشاشة، أو حينما يستأسد التفكيك في مجال لم ينجز حداثته ولم تكتمل بناه. ها هنا يصبح التفكيك أيديولوجية رثة ومضللة، وترفًا في النقد دونه مندوحة، وطريقًا ملكيًّا مغريًا، إلى مزيد من البؤس والاضمحلال، وعنوانًا لأزمة البدايات المجهضة وهشاشات المشاريع المغتصبة. لا نخاصم التفكيك على نحو الإطلاق، فبقاؤه ضرورة لا ينهض نقد إلا بها، لكنه تفكيك إجرائي وحفر قاصد. غايته إثراء الفكر وإسناد البناء وإعادة تأهيل المفاهيم، وليس هدمًا لا مشروطًا يكتفي بممارسة السهل المتاح، أو معاقرة الفكر عبثًا وانتشاءً. لست خصيمًا للتفكيك، بل لعلّي من هواة الحفر السالكين فيه مسلك العابر فوق حقل ألغام. فهي محاولة لإخضاع على حرب للسؤال التفكيكي نفسه. فما أكثر النصوص والمواقف والتراجيح، التي يبدو فيها هذا الأخير أبعد عن التفكيكية وإن حرص على التعبير عنها تفكيكيًّا. إن ممارسة التفكيك “لا بشرط” في مجال كمجالنا العربي، مفكّك البنى والعمران، هو موقف غير تفكيكي. بل لعله بالأحرى موقف اختزالي، نزاع إلى ممارسة الهدم المحض الذي لا يعقبه بناء. على أن التفكيك – وكما يؤكد جاك دريدا- هدم وبناء (1). فلا يكون البناء ممكنًا إلّا إذا كان التفكيك مشروطًا بقصوده؛ إذ قصد القصود، إعادة بناء المفكك، وإعادة تشكيل المحلل على أسس أكثر نضوجًا وبإيقاع رفيع للنظر.
يمارس علي حرب نقده بلا هوادة ضد الأفكار، كل الأفكار، ويشوشر بما فيه الكفاية ضد الأنساق، كل الأنساق، ويزدري في حماسة بالمشاريع، كل المشاريع، وذلك حقه المشروع كناقد، لكنه لما يا ترى يتفلت من النقد تفلت الغزال من قبضة اللبوة؟ بل ولما يقرف أيما قرف من أن يكون هدفًا للنقد؟ فهو يقبل بالنقد فقط كلعبة تمارس من جهة واحدة، بل تراه يأبى أن يقبل من نقاده إلا أن يكونوا مدّاحين ليس إلا. أما ما كان اختلافيًّا منهم تراءى له استئصالًا واستبعادًا(2). وهو كما يبدو، منطق فيلدوق لا يرى لزوم ما يلزم، وبذلك يضعنا أمام مفارقة “كذاب كريت”(3).
يقف علي حرب فوق أرضية تزحلق، يتعذر عليك استهداف موقعه أو تأطير حركته التي تبدو بهلوانية أكثر منها حركة مستقيمة، بل – وكما البهلوان (4) – يفاجئك في سرعة انتقالاته وحركاته إلى حد يجعلك عاجزًا عن التنبؤ باتجاهاته وقفزاته، وها هنا تكمن صعوبة نقد أعمال تفكيكية لا تستند إلى معايير ثابتة ولا تستجيب لقصود بنيانية جادة. يفرض علي حرب على نقاده أن لا يحاكموه انطلاقًا من مدرسة معينة أو مفاهيم مسبقة. وعليه، فلا نرى أنجع في نقد مفككات وتفكيكات علي حرب من “التفكيك” نفسه. فهو الشيء المشترك، الذي يمكننا من إلزامه بما يلزم، وإن كان مفهوم الإلزام آفة من آفات المنطق الصوري التي لا وزن لها يذكر ولا اعتبار ينهض بمشروعيتها في منطق علي حرب التحويلي. من هنا لزم أن يكون نقدي له، رحلة معه حيثما رحل، ووقفة معه حيثما وقف، وارتماءً معه حيثما ارتمى ودورانًا معه حيثما دار. سوف نتصيده في كل المواقع الممكنة، ونتربص به في كل حالة من حالاته، لكن، أيًّا كان أمر هذه الرحلة فستبقى سفرًا عقليًّا يتوسل بالمحاورة ويستقوي بتفكيك ما خفي أو ما سكت عنه في هذا الخطاب “الحربي” المهووس بالسلب، الهارب من قبضة الإلزام والالتزام، بعد أن صارت الأفكار لديه، طرائد في صحراء عديمة الآفاق، والحقائق ظبية مستنفرة في براري موحشة. هو فكر يشاكس بقدر ما يخفي هجره البارانوياني لحظة اجتياح العماء(5)، لا من حيث كون التفكيك والجري خلف اللامفكر فيه أو الغياب، هو مسافة مشروعة لامتدادات جديدة أمام “آخر العقل” (6)، بل بما هو صدمة انسدادات عقل محنط، يفرز أوهامه وتعويضاته. على أن العماء ليس بديلًا كفؤًا للانسداد. فالعماء انسداد خادع واستدراج ذكي نحو الاضمحلال المبكر.
إذن، مع علي حرب، في لعبته الشيقة، المثيرة، لكنها في الآن نفسه، التي تنطوي على ذخيرة حية من المتفجرات المعرفية والفظاعات الأيديولوجية المبيتة. معه حيث يفكّك أو يخفي رغبته في البناء… معه حيثما استجاب لنداء أصول راسخة في أعماق مفكك يعلن ثورته الكوبرنيكية ضد كل الأصول ليخفي طقوسه الأصولية السرية. تفكيكي مؤدلج حتى النخاع… أصولي تمامي حد المشاش… حداثي متنكر خلف أصباغ ما بعد الحداثة … مقلد أمين لأفكار ومواقف وأذواق لا يملك إزاءها سوى الاتباع … ناقد متنكر لبضاعة ليس له فيها من قيمة مضافة، سوى متعة القول حيث عزّ هذه الأيام من يجرؤ على الكلام… صانع أوهام، حاجب حقائق… يفكك هنا حيث يخفي انتصاره سرًّا لِبُنى هناك… يعلن النهايات فيما يحجب بدايات نقيضة وأحيانًا مشوهة… ينسف مشاريع ليواري مشاريع بديلة… يتعرض لأوهام فيما يخفي أوهامًا أخرى. لكنه من ناحية أخرى، هو التفكيكي العربي الذي تماهى مع اختياره مثلما تماهى حداثيون كثر مع حداثتهم تمثلًا وممارسة… عرف كيف يمتع قراءه ويستفز فضولهم… ساءل نظمًا ومشاريع أيديولوجية اعتادت على الصمت عقودًا أو قرونًا من الزمان… أزعج أنساقًا مغلقة، وحرك قضايا عالقة. هو نقد لناقد… وتفكيك لمفكك، اختار طريقه بوضوح، وقدم اعترافاته صراحًا. نقد اختلافي يسمو عن ذهان التشخصن، حيث ننوي معانقة المضامين ومحاورة الأفكار بغية إثراء الفكر لا قمعًا للسؤال… وتقريب النظر لا استبعادًا للنظار…
ترى، كيف نقد علي حرب المثقفين العرب؟ … كيف عالج معضلات الفكر العربي ومشكلاته العالقة؟ … ما مقدار صلابته التفكيكية وحنكته الحفرية، ولياقته الجينيالوجية؟ … ما هي مصادره المعلنة ونزعاته غير المعلنة؟… ما هي قصوده الخفية ومشاريعه الباطنة؟ … ما مدى صدق ادعاءاته ومعاييره وإجراءاته النقدية؟… وإلى أي حد يمكننا القبول – ولو لمرة واحدة – بمشهد يكون فيه علي حرب موضوعًا للتفكيك وليس لاعبًا تفكيكيًّا؟
ماذا وراء فضيحة المنطقيين
“نحو منطق تحويلي”… يا لها من يافطة مثيرة! فلقد احتلت في هذا المهرجان الصاخب، مكان يافطة كتب عليها قبل فترة “مكيفات كرافتا، نحو مستقبل أفضل…؟ ألا يذكرنا ذلك على الأقل بذلك الدير “المسياني” الحزين، حيث كتب على بابه “نحو حياة خلاصية أبدية”. لكن المثير، أو ربما ما يدعو للمفارقة أنه عنوان توضيحي لأحد كتب علي حرب المعنون بـ: “الماهية والعلاقة”. والكاتب المفكك يدرك بأن التوضيحي هو العنوان الأساسي. فالحقيقة هي ما اتسع لها الهامش. يلخص الكتاب بين دفتيه المنظور المنطقي الذي يستند إليه علي حرب في تفكيكاته للنصوص وللشخوص. وبما أن النقد – كل نقد- يستهدف الأساسات والأطر المعرفية، ويحاكم الأفكار من خلال يقينياتها التي تنهض عليها، يسعى الكاتب إلى تبني مشروع منطقي تحويلي يحاول جاهدًا، من خلاله، تقديم مسوغ حجاجي لبديل عن منطق صوري بدا له جامدًا ومتجاوزًا.
يتوسل علي حرب بخطاب حجاجي في دحض المنطق الصوري. مع أن الأول يمثل فسحة أخرى ممكنة للثاني. لقد تراءى له بأن الحجاج بديل عن المنطق، خصيم لصوريته، ناقض ليقينيته. فأغرق في نقض الاستقراء بناءً على ما سبق، دون أن يشير إلى أهميته من الناحية العملية. وهو بذلك يقوض حتى إحدى أهم مميزات الحجاج الذي يستهدف النافع العملي، مرجحًا إياه على الصوري، ليس من ناحية مطابقته للواقع على نحو ضروري وأتم، بل لوجود المصلحة واشتداد الظن. حيث أدلة الحجاج ليست كالمنطقية البرهانية، يقينية بل ظنية. وهي لهذا السبب تحديدًا تراتبية تقبل بنسبية التراجيح بين أدلتها بحسب قوةكل دليل إزاء الآخر. علي حرب، الذي يهتم بالمحسوس، شأنه شأن كل النتشويين، تراه يستند إلى نقد الاستقراء في نفيه. أي يحكم بهشاشته لعدم يقينيته، رغم أنه غير معني بهذه الهشاشة الصورية بوصفه حجاجي وحسي، ولكون آثار الاستقراء بادية على الأرض، مثمرة ما ينفع الناس. إذا كان علي حرب يقدم كتابه الأخير بوصفه حجاجيًّا ضد جمود المنطق الصوري، فلما يعتبره منطقًا بديلًا أو خصيمًا؟
ينتصر الكاتب للفلسفة على حساب المنطق. إن استقالة المنطق تمكن الفكر من تحقيق فتوحاته بلا شرط. تفكير مطلق لا يتقيد بموازين أو قصود معتبرة. فكر يستجيب لرغبة في الفكر لا تتعداه إلى نزولات وتشخصات عينية. هي متعة فكر مجرد ومجرد فقط. على أن مناط الفكر وإجراءاته وعلة علل نزوله، الحاجة إلى تمثل الفكر أو تقاسمه وممارسة الإقناع به والتواصل حوله. والتواصل والإقناع – سواء إقناع الذات بنتائج فكرها أو إقناع الآخر – يفرض وجود معايير تواصلية. فممارسة الإقناع تقتضي منطقًا للإقناع، ولغة تواصلية، ومجالًا تداوليًّا. فالأفكار لا تنتشر في العادة بواسطة “العدوى”. غير أن علي حرب يرفض أن يكون داعية فكر أو مبشرًا بعقيدة. فالفكر إمتاع والنقد مؤانسة، فلا تفسدوا ذلك بمشاريعكم الأيديولوجية. لكن الكاتب يقلب ظهر المجن لهذا النمط من الحجاج البروتاغوراسي المفتوح على مصراعيه، حيثما احتاج إلى ذلك. إنه يمارس الكتابة والتبشير والدعوة، وبالتالي، الأيديولوجيا. فعنوان “نحو منطق تحويلي” هو دعوة اختزالية تحمل في طياتها نبرة التبشير بالبديل الخلاصي، بل هو كتاب ينطوي على تأسيسات ومعايير وتقنيات للإقناع، تفوق كتب المنطق التقليدي. ما يعني أن لا تفلسف من دون تمنطق ولا تمنطق من دون تفلسف. فالفلسفة تتأطر بالمنطق بمقدار ما يتطور المنطق بها. فالعلاقة التقليدية التي حكمت الفكر والمنطق على نحو الإجرائية البحتة، هي علاقة تنتمي إلى زمان غير زماننا. بينما العلاقة السائدة اليوم هي علاقة تأثير متبادل.. ليس المنطق الذي يتحدث عنه علي حرب ويحاكم عليه خصومه اليوم، منطقًا أرسطيًّا خالصًا. فالتطور الذي شهده المنطق أو لنقل المنطقيات، هو في عداد اللامفكر فيه في هذه المقاربة الحربية التهافتية. وإذن، فعلي حرب يتحدث عن مشكلة منطق أرسطي في طوره الأدنى وليس عن مشكلة منطقيات، هي اليوم بعدد الصنعات التي تحضنها، كالمنطق الرياضي والمنطق الفزيائي ومنطق اللغة و… وفي كون علي حرب يختزل مشكلته المنطقية في المنطق الأرسطي التقليدي – متورطًا في لعبة “رجل القش”- وفي كونه لم يقف عند العلاقة الخلّاقة التي تتيح للفكر أن يتكامل مع تطور منطقه على نحو الموازاة، حجة أخرى على أن الناقد سقط في مأزق التمامية وفي نزعة أصولية محكومة بمبدأ الثالث المرفوع – وهو أصل في المنطق الصوري –؛ نزعة استئصالية، مبنية على ثنائية منطقية حصرية: إما فلسفة وإما منطق، فلا بدّ لأحدهما أن يستقيل: فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكون علي حرب يميز بين الفلسفة والمنطق من حيث هما متدابران، وبالتالي لا يمكن اجتماعهما في شخص الفيلسوف أو المنطقي، أثبت إيمانه بأصل التناقض الذي هو أصل الأصول المنطقية، وعليه يقوم صرح المنطق برمته. إذا كان علي حرب يرفض صرامة المنطق الصوري وإجرائيته، وربما رائيًا في ذلك نوعًا من ديكتاتورية المنطق؛ من تمنطق استبد!؟ ففعل الانتهاك، حاضر أيضًا في محاولته المعكوسة، بأن يجعل الفلسفة حاكمة على المنطق، مستبيحة حدوده. أي أن المسألة هي أن يستجيب المنطق لإكراهات الفلسفة وليس العكس. على أن علاقة التأثير المتبادلة هي ما يتيح لكليهما تطورًا حقيقيًّا مع حفظ استقلاليتهما، المفتوحة وليس المغلقة؛ علاقة معانقة ومفارقة على طول الخط. بذلك يتطور المنطق بموازاة الفلسفة، تطورًا تكامليًّا وليس تطورًا مفروضًا من جانب واحد.حتى يصبح للمنطق وظيفة تفوق مجرد كونه إمداد الفكر بقوانين صيانته من الخطأ؛ أي أن يساهم في تعليم الفكر طرائق الكشف والإبداع. غير أن علي حرب لا يجد مخرجًا إلا بقلب الآية، بناء على مبدأ الثالث المرفوع. فبدل أن يكون المنطق حاكمًا على الفلسفة، فلتكن الفلسفة هي الحاكم على المنطق!
منطوق علي حرب ينطوي على ما يفيد هذه الحقيقة ويلامسها ملامسة سطحية عابرة، دون أن تترك تصميمًا غائرًا على منطقه التحويلي. ففي واحدة من أذكى التفاتاته يقول: “بهذا المعنى ليس المهم معرفة الحد الأوسط الذي به ينعقد القياس البرهاني، بقدر ما يهم خلق الوسط المفهومي الذي يتيح للفكر أن يشتغل بالحدس وللمنطق أن يشتغل بالبرهنة والمحاججة. ولعل هذا ما يفسر كون كبار المناطقة هم أفشل الفلاسفة، وكون كبار الفلاسفة يسهمون في تطوير المنطق، بقدر ما يخلقون عوالم مفهومية تتيح بناء الأنساق وصوغ النماذج” (7).
أجل، لقد ساهم الفلاسفة في تطوير المنطق بقدر مساهمتهم في تطوير الفلسفة ذاتها. وذلك من خلال إنتاج أفكار جلى وتكثيف مفاهيم كبرى. فالفيلسوف يتفلسف بقدر ما يتمنطق. ففي أعماق كل فيلسوف يكمن منطقي. والفلاسفة يمارسون تمنطقهم بعنف، لكن بتقية. فلا تطور في الفلسفة إلا بمنطق ولا تطور في المنطق إلا بفلسفة. إن المفكرين لا يتناسون مسبقاتهم كما يقول بورديو، بل لعلهم مارسوها بلياقة أعلى وإيقاع أسرع وتقنية أرفع وذكاء أبلغ.
لست في شك من أن المنطق التحويلي الذي يتبناه علي حرب كبديل عن المنطق الصوري، هو خطاب حجاجي أوسع مما هو منطق معياري. فنقدي له في هذا المجال ليس نقدًا لنقد المنطق الصوري، بقدر ما هو فضح للأسس المنطقية الصورية التي يستند إليها داعية المنطق التحويلي سرًّا أو ذهولًا. هكذا يكون شأنه شأن كل من قدّم منطقًا دون أن يملك القدرة على تطبيقه على المصاديق … إما تنكرًا وانتهاكًا لمنطقهم المختار، كابن خلدون الذي أذهل قرّاءه الحدثاء بتأسيسه فلسفة فاردة للتاريخ، في حين عجز عن تطبيقها على تاريخه. فإن كان عاجزًا عن تطبيق منهجه، فغيره – ولا شك – أعجز، أو كابن تيمية الذي نبغ في حجاجه ومؤاخذاته على المناطقة ثم لم يفد من ملاحظاته العقلانية في مجال الإلهيات.
تبرز مظاهر الهجر البارانوياني في مشروغ “الفلدقة” الحربية (8)، في أجلى صوره، حينما يتمثل استعلاءً ممسرحًا، على عالم الاجتماع والإناسة، الباحث في بنية الاجتماعي، بحجة أن الفيلسوف منتج أفكار، كاشف عن المآزق، لا عن الظواهر. مع أن إصرار علي حرب على منطقه التحويلي، لم يجعلنا نقف بدهشة فيما أنتجه، بل ظل وضعه وضع كل المثقفين العرب، المحكومين بمعادلة الاتباع والتقليد. فهو يتمثل التفكيك مثلما يتمثل غيره الحداثة، شبرًا بشبر. فعلي حرب المفكك والتحويلي لم ينتج من الأفكار مقدار ما أنتجه دركهايم في الاجتماعيات أو ستراوس في الإناسة. فلن يشفع للباحث أن يتبنى التفكيك بلا شرط. فثمة دوافع واقتضاءات. فالفكر، أيا كانت وجهته، ليس بريئًا. والتحرر الذي يبديه علي حرب، لا يتطلب منطقًا تحويليًّا، حيث هو شكل من أشكال القمع الذكي والهروب المحتال، من سؤال التقدم.
ينتقد علي حرب المفاهيم الحداثية المغلقة وشعارات الهوية والتقدم و… لكن ألا ترى أن الحرية التي ينشدها علي حرب ويزف الغرب كنموذج لها – وهو كذلك بالفعل- تحرر قام على شعارات الأنوار وأيديولوجيا التقدم ومشروع الدولة – الأمة … ألا يرى، أن الخطاب المابعد – حداثي الذي يتبناه، هو سليل الحداثة وابنها المتمرد الذي يعرف كم بلغ حجم دلالة اتجاه الحداثة. فهو مغمور بالحرية التي تتيحها إلى حد ما، ومشمول برعاية منطقها الذي يبدو قابلًا بنقيضه إلى حين ومتسامح مع خصيمه ولو على مسافة منه…
وعليه، إذا كان علي حرب يجد في منطقه التحويلي المذكور، كيمياء تحرره واقتداره على إبداع ما لم يكن، وإعادة إبداع ما كان … وبأن الفلسفة لا تتقيد بموازين، بل هي استشكال مستدام وتكوثر مستفاد، فلما لم نصادف في فكره وحجاجه سوى نغمة متقادمة عثيانية من فرط التكرار، ومرتجعات تفكيكانية عليها ختم “الاتباع”، لا استشكال فيها على أهلها ولا انتهاكًا لـ”فلدقتهم” اللانهائية. إذ آية نزوعه التبعي ذاك، احتلاله دومًا رتبة أدنى من سادة التفكيك ورواده “Ses maîtres penseurs”. فأقواله ذيول لأصول مصممة أو “سيمولاكر” لا يعكس كامل الصورة. فما المائز – يا ترى – بينه والمريد، وما هو المدهش لديه بعد أن حررته وصفته التفكيكية – بالنسبة لمن عاقر نقديات نيتشه وفوكو ودريدا ودولوز و… وهل يملك علي حرب – مفككًا –إدهاش الغرب بانتصاراته التفكيكية الجديدة – التي يتقمصها ولا ينتجها – مثلما أدهشنا فوكو ذات مرة. أم أنه قدر على المثقف العربي، أن يدهش محيطه بالثرثرة؟! ثمة معيار للإبداع لا يخفى على صاحب المنطق التحويلي، هو أن الحد الفاصل بين الإبداع والاتباع، ابتكار المدهش (9). وما يقدمه علي حرب لا يدهش بقدر ما يؤكد على القاعدة، كون انسدادات الفكر العربي هي أحكم من أن تنحل بتبديل منابع التقليد أو تغيير مصادر الاتباع. إذا كان علي حرب يمارس ساديته المفرطة، ناقدًا أغياره، مهونًا حد الإسراف من إنجازاتهم، فلما لم نقف عنده على نقد وإن خف لميشيل فوكو مثلًا، أم أنه يتبنى أفكاره، تبني الأصولي لأصول اعتقاده، ما الفرق إذن؟
ومع أني لا أعتقد بأن المشكلة هي أصولية بقدر ما هي مشكلة علاقة أهل الأصول بأصولهم. فلا وجود لفكر يتولد في سدم العماء، ولا إقلاع من دون قاعدة، وإنما المشكلة، هي حينما نفكر دون أن نطور أصول النظر. فإذا كانت علاقة الفكر بأصوله مفتوحة ونقدية، فذلك هو المطلوب. أما إذا كانت علاقة مغلقة وإجرائية، فإن الفكر يتحول إلى تمامية. يستطيع علي حرب، أن يتقمص دعوى ما بعد الحداثة باعتبارها فكرًا متحررًا من أصوله. لكن ربما لا يملك – أو ربما أذهله سبات التفكيك – كي يتبرأ من علاقته السرية بأصوله! ليس للفكر مندوحة إلا أن يحقق إقلاعه على قاعدة صلبة، هي أصوله التي يؤسسها لنفسه بنفسه، كي يضمن إقلاعًا معافى من خطر السقوط. لا يهم إذ ذاك، أن تلازمه أصوله على طول الخط أم يشرع في محو آثارها فور إقلاعه، لكن، لا بدّ للفكر من عودة ومن بدايات واستئنافات، حيث يتوقف ويبحث عن أرضية جديدة لاستئناف رحلته. إذا كان دعاة ما بعد الحداثة، ينكرون كل أصل، ويعانقون خاووس اللانهاية أولًا ومآلًا، ككائنات محلقة بأجنحة دون أن تزود بقوائم للرسو والوقوف، ليكون نزولها كارثيًّا واستئنافاتها مستحيلة، فإن علي حرب يجعل من أفكار ما بعد الحداثة نفسها أرضية إقلاعه، وأصولًا لا ينشئ معها علاقة جديدة وحرة. وإذ يعيب على الأصوليين تشبثهم وجمودهم على أصولهم، فهو يفعل فعلتهم مع أصوله المتنكرة هذه. إنه يمارس من خلالها سلطة معرفية على الفكر. مصادرًا على الفكر نزوعه إلى البناء والتناسق، فارضًا عليه إمكانية أخرى من إمكانياته باعتبارها الإمكانية الوحيدة. فيتبنى أصوله تلك بكثير من اليقينية، وتتحول الدعوة إلى نبذ الأصول، إلى أصولية قاتمة، لكنها مقنعة.
في نقضه للمنطق الصوري، يستند إلى مسلك التقويض. ما يعني أنه لم يتخلص بعد من عقيدة الثالث المرفوع، التي هي فارس الحجاج التغالبي الذي أسفر عن فصامية العقل العربي، حيث صار إلى عقلين متناحرين: عقل أرسطي برهاني، وعقل خطابي حجاجي. ربما كانت مشكلة الغزالي فيما تراءى لخصيمه الأرسطي، ابن رشد، سقوطه في مسلك الحجاج الخطابي على منحى المتكلمين، وتقديم ذلك للعامة والفقهاء، والمحدثين، بوصفه الحقيقة المطلقة، لكن ابن رشد نفسه لم يختر طريقًا آخر غير الموقف النقيض _ الذي يتوسل هو الآخر بعقيدة الثالث المرفوع نفسها، زافًّا الدليل البرهاني الأرسطي، رئيسًا للأدلة وحاكمًا عليها مستبعدًا بعض أشكالها. وهو بذلك يتنكر لتعدد مسالك الحجة واتساع رحابة الدليل. فالأدلة مع تفاوتها في مراقي حجيتها، تظل جميعها طرائق استدلالية معتبرة. وإذا كان علي حرب ـ في معرض نقده لطه عبد الرحمن بخصوص صياغة: “انظر تجد”ـ يرى ما يراه ديكارت في علاقة الفكر بالوجود. فإن ما لم ينظر إليه في هذه العلاقة، كونها علاقة متحولة وتراتبية. إذ حيثما وكيفما “نظرت”، “تجد” بالقدر ذاته. فإذا كانت الخبرات الوجدانية متفاوتة في دنيا البشر، فذلك آية على أن تفاوت مسالك الدليل، حقيقة واضحة في “انظر تجد”، أو “أنا أفكر إذن أنا موجود”؛ سمها ما شئت. إنها ليست علاقة الكائن بالفكر فقط، بل هي علاقة الكائن بكيفية التفكير، أي علاقة الكائن بالمنطق، وبالتالي علاقة الفكر بالمنطق!
ليس الزمان والمكان، ولا المجال التداولي، أبعادًا اقتضائية فحسب، بل هي لوازم مفروضة بالفعل لا بالقوة. فقد يرى علي حرب، أن الفكر كوني لا يتأطر بخصوصية ما، فهو لا جنسية له (10). من هنا إمكانية اختصار الزمان. وهنا يبدو الفكر عماءً منطلقًا لا يتحدد بتاريخ ولا جغرافيا. هذا التوق إلى الحرية مغشوش، حيث الحرية هي ما كان بالفعل. وما كان بالفعل، وجب له الحضور بعد أن كان في نطاقه القوي مجرد هيولى لا صورة لها. فالتحرر ليس تحرر الفكر، بل هو تحرر الكائن. هو بشكل آخر، تحرر بالفكر الذي هو عنوان تحرر الكائن، وتحرر زمانيته ومكانيته. هو تحرر لمجاله التداولي بقدر الاندماج فيه. إن التفكيك الفوكوني له تاريخه وجغرافيته. لقد أجاب الغرب عن سؤال صميمي: سؤال النهضة – كيف ننهض ونتقدم-؟ أما الآن فالسؤال التاريخي هو: كيف نعيد التفكير فيما تواطأت الحداثة على السكوت عنه أو عملت على استبعاده؟ وهذا يتطلب إعادة بعثرة الفكر والعود إلى البدايات من حيث إن البدايات هنا، هي معانقة للمستبعد للاستئناف منه. يجرد علي حرب الفكر من زمانيته ومكانيته بوصفهما أبعاد الكائن وحدوده، وبالتالي الفكر؛ حيث رأينا كيف تنتظم علاقة الكائن بفكره. يجرد الفوكونية من شروطها التاريخية والجغرافية، لكي يصبّها صبًّا في زمانية ومكانية لا معنى لها. قد يبدو ذلك النشاز نوعًا من الرياضة الفكرية الممكنة، لكنها على أية حال ليست إلا رياضة عدمية. فإذا كان السؤال الجوهري المطروح في مجالنا: كيف نتقدم؟ فما معنى –عند ناقد المعنى- أن يطرح سؤالًا – وهو ليس سؤالنا – كيف نفكر بطريقة مختلفة لرفع الملل واستجلاب المتعة، لا لإحراز التقدم؟ وإذا كان الغرب قد تقدم بفكر موسوم بالقمع والاستبعاد وبناء السجون والمعسكرات، فالمشكلة إذاك، ليست في المجاوزة بلا قيد ولا شرط، ولا هي في وجود الموازين والأطر المعرفية، بل هي كامنة في الفكر ذاته الذي يتعين عليه تقديم جواب عن السؤال التاريخي: كيف نتقدم؟ كيف نتقدم، هو السؤال المستبعد والمقموع في حجاجيات علي حرب، وفي تهميش سؤال التقدم والانهمام بسؤال: كيف نفكر بلا قصد، فضيحة من فضائح المنطق التحويلي.
واضح، أن علي حرب، يشتغل- كغيره من المثقفين العرب – على التطبيق والتنزيل، تطبيق التقنيات الفوكونية إلى حد ما – حتى لا أقول بكاملها – على يوميات الحياة العربية وعلى النصوص التي ينتجها المثقفون العرب. إنه يسلك مسلك التطبيق والتنزيل، وهذا يكفي لكي نصفه بأنه ملتزم بطريقة ما أو مريد لها. إنه مهما فعل، فهو يسوق تقنية جديدة في مجال جديد. لكنه ليس طرفًا في إنتاج هذه التقنية. إنه ممارس للتفكيك ولكنه ليس منتجًا له أو موسعًا لطريقته أو مجددًا لمسالكه. مع أن التفكيك هو استراتيجية متقلبة وثورة مستدامة، بقدر ما هي إنتاج للمعنى، تبقى في حاجة إلى توليد تقنيات جديدة للتفكيك. نعم، إن التفكيك طريقة مغايرة في التفكير، لكنها طريقة غير مكتملة. فإذا ما قال علي حرب، إنها اكتملت أصبحت حينئذ رسالة تامة وخالدة. الأمر الذي يضعنا أمام مفارقة “كذاب كريت” مجددًا. إن مشكلة عقم المعنى في المشهد الفكري العربي، ليست هي المشكلة الوحيدة. فهناك مشكلة “اللامعنى” وطرائق التفكيك، يجري عليها ما يجري على سواها في هذا المشهد المأزوم. طريقة التسويق والتقمص والانتماء. تلك هي مشكلة الفكر العربي، سواء في شقه الحداثي أو ما بعد الحداثي، تشملها أزمة عامة، هي عقم آليات الإبداع وتناهيها ـ كلنا في الهوى سوا ـ. كن من شئت في هذا الفضاء المأزوم – داعي حداثة أو داعي ما بعدها- فلن تكون أكثر من مرحل، متبع ومتمسرح. إن مشكلة الفكر العربي تكمن في كونه عاجزًا حتى الآن عن إبداع حداثته. وإن رفض طريقتها، فهو أعجز عن خلق ما بعد حداثته غير الناجزة. وذلك طبيعي، فالطفرة التي يعدنا بها علي حرب تريد إدخال العرب إلى الحداثة من سدم ما بعد الحداثة، وإن اقتضى الحال، القفز بهم إلى أشكال جديدة من اللامعنى استبدالًا لنكباتهم بعمائيات، قد تكون وصفة مهدئة أو ومخدرًا يحجب الفكر العربي عن مهامه ومسؤولياته في تحقيق نهضته. إذا كان عجزه عن إبداع حداثته، هو عجز في البدايات، فأحرى به أن يكون أعجز في النهايات، لأننا لا نبلغ التخمة ونحن جياع. والمصابون بسوء التغذية لن تفيدهم دروس الوقاية من السمنة. والحال، إذا كان الجنون الفوكوني الذي أنتجته شروطه، هو جنون ما بعد الحداثة بامتياز، فجنوننا أو بالأحرى جنون علي حرب، هو جنون يقع تحت الدرجة الصفر لحداثة مغتصبة من قبل ذات مشبعة بالإخفاق والخواء والهجر البارانوياني.
إذا كانت الحداثة القائمة بالفعل، في ذلك المجال الذي شكل على امتداد قرون، النموذج الجاذب/ الطارد في آن واحد، قد استنفذت مخزون العقل الأداتي إلى حدوده القصوى، ما جعل النظر في انثناءات العقل ومخزونه الاحتياطي وفي ذلك التشكل المختلف الذي هو آخر العقل، الملاذ الأخير للفكر؛ فإننا في العالم العربي، لم نستنفد هذا المخزون. إذ لا زال العقل بشروطه أوسع من إمكانية تفكيرنا المعاق أيديولوجيًّا ودوغمائيًّا. وجدير إذ ذاك بناقد النص والمعنى، أن يستنفذ مساحات العقل التي هي في حكم الموات، قبل أن ينتهي إلى دهاليز ما بعد العقل وطياته المعتمة. وإذا صح ذلك إزاء العقل، فهو يصح بالفحوى، إزاء المعنى؛ إذ مساحة المعنى لما تكتمل في ربوع فكرنا، حيث شروط إنتاج المعنى لا تزال مأزومة، متمأزقة في سؤال النهضة والتقدم. وعليه فأي داع يا ترى يجرفنا إلى جنون تصيد اللامعنى؛ وقد تبين أننا نعيش أدنى درجات سلم المعنى. فخطاب اللامعنى هو نفسه شكل من المعنى، حينما يكون خطابًا يفرضه تضخم المعنى. اللامعنى هو معنى المعنى، حينما يبلغ هذا الأخير حدود الإشباع. فأي معنى للامعنى في مجال لم يستوف مشوار معناه بإكراهاته وتحدياته؟! فإذا اتضح أننا نعيش الحداثة بالسماع أو ربما بالفرجة وفي أفضل الحالات بالتمسرح “La théatralisation”، فهذا إنما يعني أننا نعيش على هامشها أو على حافة مقولاتها ومفاعيلها ومشمولاتها… إننا نعيش ما وراء الحداثة، وما وراء العقل والمعنى؛ تلك حقيقة وضعنا الذي يتعين على علي حرب استيعابها قبل انخراطه البارانوياني في نقد حداثة النصوص المغشوشة. فالهامش الذي مثل دائمًا فسحة الآخر التي استلهمها دريدا وأجاد فن استحضارها فوكو، هو هذا المجال؛ مجالنا الذي يبدو كإمكانية واعدة لإجبار الحداثة على معانقة مساحاتها المستبعدة. لقد اشتغل علي حرب على نصوص الحداثة المستحضرة في خطابات المثقفين العرب، ونقض المعنى الذي لا يحضر إلا في تلك النصوص، فيما الحقيقة –حقيقة وضعنا- هي تلك الإمكانية المفتوحة لإعادة بناء الصلة بالوجود والعقل. وإن كان الوجود أوسع مدى وأقدم تاريخًا من العقل، وإن كانت شروط العقل التي افترضها لتسهيل اشتغاله لا تصلح شروطًا للمساحات الأخرى التي يطالها المدى الوجودي الفسيح. فالذي يتجاهله علي حرب وكل العدميين، هو أنهم لا يخالفون الحداثة ومنطلقاتها إلا في لعبة الفضح التي يصرون على ممارستها بعبثية طفالية. متجاهلين كون الحداثة ممارسة تدرك أن إنجازاتها ممتنعة التحقيق إلا بممارسة الإضمار والاستبعاد. وبهذا يكون التفكيك تجريدًا لا يقدم فتحًا حقيقيًّا للحداثة، ثم إن التفكيكي يجد نفسه مرغمًا على التوسل بمنطق الحداثة وحجاجياتها المضمرة، لفضحها والكشف عن هوامشها. إذن فهو عالة على أدوات الحداثة. ليست الإشكالية إذن تتعلق بكيفية الكشف عن الوجه الآخر للحداثة والخطاب، فالحداثة نفسها تفعل ذلك بشكل من الأشكال. وما كشف عنه هربرت ماركوز أو هركومر … من جماعة فرانكفورت، هو أكثر فظاعة مما كشف عنه التفكيكيون. بل لعلهم اقتبسوا من نقّاد فرانكفورت الكثير من الحقائق… إن الإشكالية الكبرى، هي سؤال التقدم، الذي هو حقيقة محسوسة وخبرة وجودية، تواجه النسيان والقمع من نقّاد الحداثة. كيف نحقق تخارجاتنا مع حداثة تبدو كبنية تناقضية، قابلة لسؤال التجنيس والتأقلم بقدر إصرارها على الاستبعاد والقمع؟
إذا كان ما يطرحه علي حرب، لا يعدو أن يكون – وباعترافه- مجرد لعبة وضرب من اللهو، قصاراه تحقيق قدر أعلى من الإمتاع والمؤانسة، فهل المطلوب أن يتحول كل المثقفين العرب إلى صناع متعة، ورواد مجالسات وشراح أوهام، ويكفّوا عن التفكير أو الدعوة إلى المشاريع. هل فعل التفكير فعل إمتاع خالص أم أنه مسار معاناة ومخاض وجودي وقلق مستدام؟ ومن يضمن لهؤلاء النتشويين الذين تكاثروا كالفطر، إن استجاب لهم العالم، فأصبح كل مثقفيه نيتشويين بامتياز؛ من يضمن إذن ألا ينبري منهم من يدفعه الملل إلى إعلان موتهم جميعًا؟! لا أدري كيف يملك علي حرب هذه الجرأة على صنع المفارقة وقضم الحقائق، فيما يرى أن الممارسة ليست شيئًا آخر عن الفكر. فالفكر هو نفسه ممارسة. فإذا كانت هذه الممارسة ليست سوى لعبة لا نهائية، وفتح للتفكير بهدف بلوغ منتهى العماء، فهذا يعني أن علي حرب زاد الطين بلة بتعميقه الهوة بين ممارستين: ممارسة التفكير وممارسة البناء. بوصف الأولى، لهو خارج قصود المشاريع الجادة، وتحليق خارج أسباب النزول. وبوصف الثانية إلزام وجهد ووسع. الأولى سلب محض، والثانية رهان عملي وإيجاب. ومع ذلك، فعلي حرب منخرط في محيطه، غير ناشز عنه إلا بلعبته الاستيهامية هذه. إنه ملتزم بكل ما تمارسه الحداثة اليوم … مندهش من روائعها فيما يظهر من كتاباته الموسمية؛ يركب سيارته، يساهم في تلويث البيئة ويمارس الكتابة والنقد، ونقد النقد، والتهافت، وتهافت التهافت … يساهم في صناعة الخطاب العربي ويحضر مؤتمر الجنادرية، ويأخذ مقابل وتعويض عن نشاطه الكتابي الذي يعتبره لعبة تفكيكية، في الوقت الذي يدعو فيه إلى استقالة أو انتحار المثقف العربي!؟
إن علي حرب لا يمارس جنونه إلا في النصوص والخطاب، لكنها ممارسة لا تحضر بحقيقتها الوجودانية. فعلي حرب يلهو بالكتابة، لكنه متقيد بجدول زمني … هو مدني مندمج وليس فوضوي أو “بهول” عربي أو مجنون ليلى … تلك هي المسافة التي تفصل بين ممارسة الفكر وممارسة الوجود. فعلي حرب يؤمن بوحدة الممارستين قولًا، لكنها لا تظهر عليه في ممارسته الوجودانية. فطالما لم يمارس جنونه بالفعل، وطالما لم تحتضنه السجون والمعسكرات والعيادات كشاذ فوكوني عن لغة الأجرأة والضوابط، أو كمهووس نيتشوي، بإرادة القوة والمعرفة… وطالما لم ينتحر، فإنني أشك في لعبته الخادعة، أي في كونه يمارس اختلافًا تفكيكيًّا وأنطولوجيًّا، كما لاحظنا ذلك عند دعاة الحفر والتفكيك والتمرد والرومانسية … ما يعني أن خطاب ما بعد الحداثة عند علي حرب لا يختلف عن حداثوية خصومه؛ إنها ما بعد حداثة التمسرح. التفاف على سؤال التقدم، وقمع لسؤال النهضة، وتعويض عن مأزق الفكر العربي المعاصر.
إن كبرى المفارقات التي ينضح بها النص العربي، هو ذلك المنظور الوظيفي للتفكيك بوصفه استراتيجية للهدم والبناء، لا الهدم فقط، وهذا ما يردده علي حرب نفسه، متقمصًا إياه من دريدا، دون ممارسته. إنه يبحث عن المساحات الأخرى، التي تبدو معتمة في منظور الأنوار، أو لا معقولة في منظور العقلانية، أو ممنوعة في منظور السلطة أو مستقبحة من منظور القيم. وهي المساحات التي ترصدها ميشل فوكو مفككًا وناقدًا، مشخصًا إياها في مساحة الجنون والسجون والعيادة والجنس… إنها المساحات الأكثر قمعًا واستبعادًا، وهروبًا من قبضة اللوغوس وخطاب التنوير وسلطة الأنساق. ومع ذلك، فإن علي حرب يرى – ناقدًا هابرماس باختزالية شديدة – أن فوكو، وخلافًا لما زعمه هابرماس- ليس هدامًا للعقلانية أو الأنوار، بل متممًا لها. إنها عملية إعادة تأثيث المنظومة العلائقية بين العقل واللاعقل… بين المباح والتابو … بين العقل والجنون. إذن، هي إعادة انتشار لمجالات الفكر، وإعادة بناء العقل بشرط المعانقة للامعقول. هو ما نعني به أن التفكيك في نهايته بناء أو إعادة بناء… تركيب أو إعادة تركيب… اعتراف وليس نفيًا.
ومع أن نقد الحداثة هو، إكمال وتوسيع وفعل إثراء للحداثة كما يزعم التفكيكيون، من دريدا إلى دولوز، إلا أننا سرعان ما نجد علي حرب يتحدث عن طي مسافات، ليبرر كيف أن نقده للحداثة يحمل المشروعية ذاتها في العالم العربي، كما بات يحملها في الغرب، حيث الحداثة بلغت نهاياتها. وبما أن علي حرب يتحدث عن طي مسافة، فهو يشهد ويؤكد على أننا نعيش حداثة غير مكتملة أو لنقل مجزأة ومغشوشة. فلئن كنا نعيش خارج أسوار الحداثة، فما المبرر لطي المسافة. إن كان التفكيك في حقيقته إكمال وتوسيع – لا سيما وأنه يدرك أن الحداثة ما كان لها أن تبلغ ما بلغته إلا بهذا الثمن، وكأن لسان حالها: ليس في الإمكان أبدع مما كان – فإن القول بطي المسافة لا يتفق والقول بضرورة استكمال البناء. فالاستكمال لا يبدأ إلا بعد الإنجاز، فهل أنجزنا حداثتنا – كما ذكرنا سابقًا – أم أن عملية الاستكمال، والحالة هذه، سوف توقفنا أمام بناءات مشوهة، ومبتسرة. إن نقد الحداثة يمارس التعتيم على الحداثة بقدر ما تمارس ذلك الحداثة على المساحات الأخرى للتفكير. فنقد الحداثة، بالنتيجة، هو فكر واشتغال على الموجود قصد استكماله. فإذا اشتغل نقد ما بعد الحداثة على معطيات خداج غير مكتملة، فهو حاله حال فكر الحداثة، سينتج بالضرورة أوهامه ومنطقه – التحويلي- ويستكشف عتماته.
ومع أن علي حرب يؤاخذ هابرماس على ممارسته الاستبعادية لفوكو، كاشفًا بذلك عن أن العقل التواصلي يحبل بمعوقاته ويخفي إرادة النفي، فهو على الدرجة ذاتها من إرادة الرفع والنفي للحداثة التي ينقدها ويندهش من إنجازاتها في آن واحد، ويكسر طوق منطقها وصرامتها، ويفتت مادة أنساقها الإبستيمية والأيديولوجية، بحثًا عن منطق تحويلي جديد، منطق تسويغي يتمتع بالقدر الممكن من الرخاوة والنعومة واللامعقولية. يرتبط علي حرب بمفاهيمه التفكيكية والمابعد-حداثية، ارتباط الحداثيين بمقولاتهم وأنساقهم ومقتضيات انتماءاتهم الباراديغمية. وهذا أمر تظهره حماسته المفرطة للهدم الهوسي. إنه يمارس هواية الكشف عن المستور، وعن الوحوش الممتنعة عن الظهور، وعن الظباء الهاربة، حيث تطاردها الحداثة وخطاب العقلانية. إنه لا يحدثنا إن كان من المتاح للحداثة أن تحتضن لا معقولها بدل أن تقمعه، لضرورات ما، أم أن الحداثة مكرهة على ذلك؟ والحال، أن المسألة، ليست مسألة إرادة واعية، بل هو فعل استبعادي حتمي، لأن معانقة المعقول للامعقول، خرافة جميلة، لكنها ممتنعة التحقق في منطق الأشياء، إلا بفعل استبعاد الحداثة، وإن راوغت وادعت أنها متممة لها. لأن فعل الإكمال له شروطه ومقوماته، لعل واحدة على الأقل في مجالنا العربي، استكمال النسق. إنه يعيش لحظة زهو كبرى، لما يكشف عن مستور هنا أو مخبوء هناك. لكن ما قيمة ذلك طالما أن الحداثة تفعل ذلك وتعترف به، لكن ما لا يستطيع نقاد الحداثة الإجابة عليه أو الاعتراض عليه، هو كون الحداثة لا تتحقق دون ممارسة الاستبعاد. فالتفكيك لا يملك إجابة عن ذلك، لأنه لا يحمل في جعبته مشروعًا عمليًّا، وليس معنيًّا بالإنجاز… إنه لعبة خطرة وممارسة استيهامية. فهل يحتاج التفكيك إلى منطق؟ ألا ترى أن التفكيك إذا تمنطق تزندق؟
يرسم علي حرب الخطوط الكبرى لمنطق تحويلي معانق للصيرورة، منتهكًا حدود المنطق الصوري الموسوم بالجمود والثبات والشكلية. ويوهمنا، بأن التفكيك هو هذا المنطق التحويلي أو منطق الصيرورة. وها هنا تبرز إشكالية أخرى. إذ يتبنى علي حرب، ككل التفكيكيين، فكرة الوجود كصيرورة. في حين، فعل التفكيك يناقض طبيعة الصيرورة، من حيث التفكيك لا يتم إلا على نصوص جامدة، أو ظواهر ثابتة. وحينما نفكك أو نعيد بناء النص، ننتقل إلى نص آخر ونسقط خبراتنا السابقة على نصوص أخرى، أي أننا نسلك منطق المقايسة الأرسطي. وإذا كان “المعنى” لا يتم النظر إليه إلا إذا أصبح إشكاليًّا، فهذا معناه، أن “المعنى” لم يعد منتجًا طبيعيًّا للنص، بل مرضًا من أمراضه يتوصل إليه بما يشبه آليات التحليل ـ نفسية “Psychanalytique”. كما لو كان المعنى هو جنون اللغة. فالتوصل إليه يتطلب اعتقادًا بثبوت وثبات النص. إن النص مثله مثل الذرة، لا يمكن إحراز الدقة في امتلاك طبقاته وحركته في آن واحد. فحتى تدرك مكوناته يتعين افتراضه ثابتًا. وهذا يجعل فعل التفكيك لحظة التفكيك يوقف زمان النص. وهو بذلك يوقف واحدة من أهم مكوناته وبنيته. باعتبار الزمن ليس فقط بعدًا تخارجيًّا لبنية النص، بل الزمان هو الحركة التي يتمتع بها النص النابض، في ديناميته، التي ليست إلا حقيقة وجوده كمعطى أو ظاهرة لغوية أو سيميائية. وهكذا لا يمكننا أن نحرز كامل المعنى من نص انتزعت منه بعض مكوناته. إذن لا خيار لنا في ضبط المعنى إلا باستيعاب النص في كامل حركيته وديناميته، وليس في مكوناته المفككة. فالأمر أشبه بـ “لا دقة” هيزنبرغ في مجال الكوانتا. والتفكيك بعزله النص عن حركيته، والاشتغال عليه كأحناط وأحافير، يساهم في شل النص وجعله يستجيب لمسبقات المفكك وأوهامه. التفكيك ليس بالضرورة كاشفًا للمستور، بل كثيرًا ما يكون سببًا في احتجاب النصوص.
إن الممارسة الاختلافية التي ينهجها علي حرب ضد خطاب المثقف وضد لغة المشاريع، هي ممارسة تفوق كونها فضحًا لأكاذيب الخطاب أو كشفًا عن مناورات البناء، إلى ممارسة “الاستبعاد” والنقض. وفرق كبير بين الممارسة التفكيكية حينما يكون منزعها التكامل مع الخطاب أو إرادة بناءه على خلفية أكثر انفتاحًا أو أوسع مدى … وبين الممارسة التفكيكية حينما يكون هاجسها، التدمير والسلب والتقويض … تلك هي المسافة الفاصلة بين النقد والنقض. بين النقد كاستراتيجية تعويضية وبين النقض كنزعة تقويضية هوسية “Maniaque”. بين التفكيك كتكتيك يصب في استراتيجية البناء أو إعادة البناء، وبين التفكيك، كغاية غير قاصدة أو فاقدة للتكتيك والاستراتيجيا. حينما يكون التفكيك هدفًا في ذاته، أي استجابة لرغبة في الهدم أو لنزعة سادية في التدمير؛ هنا، الحديث عن لا جدوائية هذه الممارسة. مع ذلك نرى أهمية استمرار الممارسة النقدية والتفكيكية، بالمعنى الأول. لأنها تشكل رقابة ما معكوسة على كل أشكال الخطاب، رقابة تفضح الجنوح إلى الاستئصال الهوسي، وتكشف عن الشطط في ممارسة سلطة المعرفة والخطاب. وربما قد يؤدي إلى سحب الثقة عن هذا الخطاب أو ذاك، ويحول دون استفحاله. إنها بمثابة سلطة رقابية أو كتلة معارضة، لتتبع فضائح الخطاب. وهي من ناحية أخرى لعبة “جادة” تستدرج الخطاب إلى ما لا قبل له به من مساحات تفكير جديدة، وتدفعه إغواءًا وإكراهًا، لتوسيع إمكانات النظر ومراتب التفكير الأخرى. إنها دعوة لممارسة تفكيكية لا بنائية، تعيد الفكر وهندسته. فما الذي يبرر – إذن- لناقد أن يختار منحى التمرد على ما هو الكائن بالفعل وعلى ما ينبغي أن يكون، بدعوى النظر فيما هو ممكن أن يكون أو ما هو ممتنع الوجود، إن كان كيف كان يكون؟ إن النتشوية منذ رائدها الأول(=نيتشه) حتى آخر ممثليها البارعين (=فوكو) حملت مبررات وجودها بامتياز. فكان لتمردها معنى، و”للامعنى” الذي تنشده، معنى! ففي محيط متخم بالخيارات والمشاريع والإنجازات، لا جرم أن ينهض من يغرد خارج السرب، كي يعمق ممارسة الاختلاف. لكن، أي عماء يطلبه ناقدنا العربي، وأي لامعقول يسعى للاستشكال به على عقل غير ناجز أصلًا في مشهدنا. أليس هو محيط زاخر بالعماء ونازف باللامعنى … أليست حركتنا تتجه عكس واقع الحداثة، من اللامعنى إلى المعنى، من الهامش إلى المركز. ليس في مشهدنا سوى مشاريع فاشلة، وخرائط ممزقة، وخيارات مستعارة ومتعثرة. هل نحن في قامة الدعوى إلى “النهايات”؟
إنه لمن العبث أن ننكر “الوجود”. وإلا، فلنخرج من الوجود ثم ننكره. فإذا خرجنا منه فعلًا – وهذا أمر متخيل- وقعنا في العدم. وهناك فقط، لا يمكننا الحديث أو الحكم على الأشياء. لأن الحكم علم، والعلم والمعرفة من الوجود. إن دعاة العدمية، وأنصار اللامعنى، المهووسين برؤية ما لا يرى، حتى إذا رأوه جعلوا في أعينهم غشاوة أو سماع ما لا يسمع، حتى إذا سمعوه، جعلوا في آذانهم وقرًا، وكأن همهم التقاط العابر، أو طلب الصور المعلقة، حيث لا بداية تؤرخ لميلادها ولا نهاية تستشرف مستقبلها. مع أن علي حرب تخونه مفارقاته ليسقط في خطاب النهايات، متنكرًا وذاهلًا عما تفرضه عليه عمائيته. وحينما يدعونا ما بعد حداثيونا – وعلي حرب يسلك مسلكهم، ويصطنع له ورشة تفكيكية عربية تعمل وكيلًا عربيًّا لهذه الصنعة المأزومة غربًا – حينما يدعوننا إلى أن نقطع مع المنطق الصوري واجتراح المنطق التحويلي، فإنهم لا يملكون التملص من إكراهات المنطق الصوري. إنه منطق تحويلي ينهض على دعائم خفية من المنطق الصوري،كما سنرى لاحقًا.
*الالتفاف على المنطق الصوري
يتنكر علي حرب للمنطق الصوري، حاكمًا على أقيسته بالهشاشة، فيما هو يقيم عليه حجاجاته. ألم يتهم خصومه بالتناقض والمفارقة والخرافية وانتهاكهم لمقدمات أفكارهم … أليس ذلك كله لا يستقيم إلا على أسس منطقية صورية؟! يخفى على “علي حرب” أن كل خطاب لا يمكن إلا أن يكون حجاجيًّا. وأن كل حجاج لا يمكنه الاستغناء عن الأدلة القياسية مهما ضمرت مقدماتها واختفت (11). نقول ذلك بصيغة الجمع، لأن المقدمة قد تكون مقدمات وقد لا تكون، كما في الحدوس، بناء على مستوى المخاطب – بفتح الطاء- وحاجته لذلك. ويخفى عليه أيضًا أن كل خطاب لا يستغني في أقل التقادير عن التمثيل بوصفه عند بعضهم أدنى درجات الاستدلال، لضيق المسافة بين مقدماته ونتائجه، فيما التمثيل شامل لأشكال القياس البرهاني الأخرى، لاشتماله على نحو استنباط ونحو استقراء معًا (12). وإذن، أنّى يذهب علي حرب، وخطابه يفتقر إلى حجية المنطق الصوري وينتهض على أساساته، ولم يتحرر من مقولاته البتة؟
يقول مثلًا: “وإذا كان الاستقراء لا يفيد يقينًا، فإن الاستدلال هو دومًا خادع، إذ المقول في الخطاب الاستدلالي أنه صحيح ومنتج، ولكن المسكوت عنه، هو أن النتيجة مقررة سلفًا، أي متضمنة في المقدمات، كما في البرهان المشهور ضد أرسطو: الإنسان فان، وسقراط إنسان، إذن الإنسان فان” (13).
إن هذا النقد- بطبيعة الحال- ليس من ابتكارات خصوم المنطق، بل هو نقد المناطقة لمنطقهم، حيث هو مجال اشتغالهم. بهذا المعنى، هو نقد منطقي. فالعجز عن وجود أساس لبرهانية الاستقراء، يستند إلى تعريف منطقي للبرهان، من حيث هو ما كانت مقدماته يقينية. فالمناطقة وحدهم من يملك الكشف عن مأزق كهذا، أما خصومهم من السفسطائيين والفلادقة، فلا يميزون بين البرهان وغيره. وإذن، الكشف عن استحالة الاستدلال على برهانية الاستقراء، هو في حد ذاته انتصار للمنطقيين وليس فضيحة للمنطقيين. بدأت إرهاصات هذا الانتصار مع ظهور الأرغانون الأرسطي، حيث نفى هذا الأخير البرهانية عن الاستقراء الناقص، مؤكدًا فقط على برهانية الاستقراء الكامل. وعند دراسة التقسيم الأرسطي للاستقراء، إلى كامل وناقص، نلاحظ التفافة مبكرة على إشكالية الثاني – الذي هو الاستقراء المعروف حاليًّا- على أن الاستقراء الكامل الذي اعتبره أرسطو دليلًا، هو قياس استنباطي، من حيث نتائجه المستوفاة جميعها في المقدمة. وبأن الكلية يصار إليها بخطوات متوالية دونما الحاجة إلى قفز. على هذا الأساس يمكننا اعتبار أرسطو أول ناكر لبرهانية الاستقراء-الاستقراء الناقص – يخفي علي حرب مسألة، لا تقل أهمية عن سابقاتها؛ فمع استشهاده ببعض أقوال كارل بوبر – من نقاد الاستقراء – لم يقف مليًّا عند التخريج البوبري لمسألة الاستقراء، حيث للباحث أن يتساءل: إذا كان الاستقراء غير برهاني، فلماذا فشل المناطقة في طرده من دائرة المنطق نهائيًّا. ومن أين له هذه الصولة في عالم المعرفة (14)؟ ولماذا يتحرج المناطقة من التخلي عنه بالسرعة التي يدعي خصومهم بأن لا جدوى منه طالما أنه ليس برهانيًّا؟! فالعجز عن الاستدلال على برهانيته ليس دليلًا على هشاشته. إذا كان كارل بوبر يتحدث عن مفهوم “الدحض”، فهو دحض ذهني تجريدي، لو أننا أمعنا فيه النظر، لوجدناه مفهومًا ينهض هو الآخر على أساس الاستقراء. ذلك لأنه يشتمل على كلي، في عبارة كارل بوبر مثلًا: “كل قضية علمية قابلة للدحض”. قد يبدو الاستقراء بمثابة الشر الذي لا بدّ منه، من المنظور المنطقي. فهو بقدر ما يضع المناطقة في حرج من أمرهم، نجده أساسًا لنتائج مذهلة في مضمار البحث العلمي. الاستقراء بهذا الاعتبار مسلك منتج، وذلك أمتن الأسس وأوثق المناطات لحجيته المنطقية. فهو إذن نافع، وفي ترجيح منفعته على برهانيته، معناه أن المنطق تحرر من صوريته. إذ لا ترجيح من دون دليل. هذا مع أن علي حرب في نقده للاستقراء، يسلك مسلكًا استقرائيًّا، لما يدعي بأن كل أشكال الاستقراء لا برهانية. لقد أطلق حكمًا كليًّا من خلال صور محدودة للاستقراء. فالاستقراء لم يعد بهذا المعنى يشكل حرجًا على مريديه فحسب، بل أصبح إحراجًا لخصومه أيضًا باعتبار إنكار الاستقراء هو استقراء، وهذا شكل من أشكال التهافت (15).
حجية الاستقراء، حتى وإن لم يقف المناطقة على أسسها المنطقية، فهي أشبه بالحجة المجعولة باعتبار ما فطر عليه الاجتماع (16)، في كل أشكال الخطاب. وهي جعلية، ليس على نحو تواضعي تعييني، هنا، بل مجعولة على نحو التعين والإمضاء، لما هو راسخ في بنية الخطاب الطبيعي. وهذا الرسوخ يتأكد طورًا فطورًا، فتتنامى حجيته في الاعتبار، ويشتد الظن به إلى ما هو دون القطع – أي دون أن يكون قطعًا، لمن يرى القطع حجة ذاتًا لا جعلًا- على أننا نخالفهم إلى أن القطع هو نفسه مجعول جعلًا ما، على كيف ما، غير أنه جعل مضمر، راسخ، كامن، لشدة تناميه في الاعتبار (17). على هذا الأساس، فالآثار النافعة للاستقراء، تجبر كسر الاستقراء أو إقواء ما تبدّى منه هشاشة عند البعض. مع أن الحكم بالهشاشة لا أساس منطقي ينهض به. فالعجز، هنا، عجز المناطقة لا عجز المنطق. وعليه، نرى أن الآثار النافعة للاستقراء، هي مدرك حجيته ومناط جعلها. وهذه المصلحة النافعة في تصوري على قسمين، هما دعامة المصلحة، العملية للاستقراء:
– منفعة علمية، حيث لا غنى اليوم للبحث العلمي عن الدليل الاستقرائي. وآثاره دالة على نجاعته. وحيث لا يعقل قيام بناء على هشاشة، فكيف نحكم بهشاشة الاستقراء فيما كل البناء العلمي اليوم ناهض على الاستقراء والاحتمال. فالتنكر للاستقراء يترتب عليه – إذن – ضرر علمي.
– منفعة تواصلية اجتماعية، إذ، لا يقوم اجتماع إلا على تخاطب. ولا تخاطب إلى بحجاج وتعاقل… ولا حجاج إلا ويشتمل على أدلة قياسية. وإذا سلمنا بأن التمثيل هو نوع من الأقيسة الأكثر تداولًا في الخطاب الطبيعي باعتبار البعض رآه أدنى درجات الدليل، فيما رأى فيه بعضهم دليلًا فطريًّا، قلنا، بأن القياس التمثيلي نفسه – كما يكشف بعض المشتغلين في حقل التداولات -، وخلافًا لمن ميزه عن القياسيين البرهانيين، هو أعقدهما، لاشتماله عليهما معًا. “فتكون المماثلة استدلالًا مركبًا من الاستقراء والاستنباط معًا، وهذا بالذات ما يبرر تأرجح عدد من الفلاسفة وفقهاء العلم، بين المواقف الثلاثة الآتية: فمنهم من جعل هذه الآلية استقرائية، ومنهم من رأى فيها ضربًا من الاستنباط، ومنهم من ذهب إلى أنها عملية استدلالية معقدة تجمع بين الاستقراء والاستنباط” (18).
إذا كان التمثيل لا غنى له عن الاستقراء، بحسب هذا الرأي، فقد غدا هذا الأخير إذن، أساسًا في الخطاب الطبيعي. وإن التنكر للاستقراء، معناه تنكر للحجاج والخطاب رأسًا. وعليه، يكون في إنكاره ضرر على التواصل وضرر على الاجتماع، أو لنقل بتعبير أوضح، أن إنكار الاستقراء فيه تعطيل للمعرفة وتعطيل للتواصل.
في عدم جدوى الاستدلال على برهانية القياس
لقد جارى علي حرب، الرأي السائد بخصوص الاستقراء. رأي يكشف عن موقف حرج، ربما تجشم المناطقة، عناء الكشف عنه. مأزق الاستقراء من هذه الناحية، هو مأزق تاريخي ولد مأزومًا مع الأغانون الأرسطي. الأزمة هي هاهنا أزمة عجز المناطقة وشدة اختفاء آلية الطفرة في الدليل الاستقرائي من الخاص إلى العام. ما جعل محاولات تفسير ذلك أشبه بالمستحيل كما يقرر بوانكريه (19). مهما تنامت المحاولات التي على الأقل نعترف لها بالقدرة على التقليل من غرور المنطق الصوري وجعله يفتح جيوبًا وفتوقًا للإيمان. على الأقل أظهرت حالة العجز هذه، بأننا – وخلافًا لادعاءات البعض، بأننا خرجنا من عصور الإيمان إلى عصر العلم والعقل- بأننا لم نبرح عصور الإيمان. فاللوغوس هو التفاف محتال على الإيمان، لا، بل إن عصر الإيمان نفسه ظل متجليًا في سيد الأقيسة النافعة والمنتجة، أي الدليل الاستقرائي(20). مع أننا نعتبر قياس التمثيل نفسه منتجًا. كما هو الحال في التأويل والاعتبار وإحكام المثل بالممثول. على أن التمثيل منتج من جهة ما ينطوي عليه من استنباط، بل من جهة ما ينطوي عليه من استقراء. فإذا كان الاستقراء يتمنع عن التفسير ولا يقبل إلا بأن يقدم نفسه كمعطى، فذلك مفاده، أن أعلى درجات الأدلة المنتجة، حيث تندك الوسائط، وحيث يسود الحدس، تستند على أساس الإيمان.
في نقد لامعقولية الاستقراء
المشكلة فيما جرى عليه عرف المناطقة، تكمن في ذلك التفاوت في درجات تعريفاتهم إلى حد المسامحة. فما أكثر تعريفاتهم اللفظية والتقريبية. إذا استحضرنا عبارة علي حرب: “غير أن البرهان هو أضعف أجزاء المنطق، وعلى عكس ما يحسب المناطقة […] فماهية البرهان أنه ضروري. ولكن لا برهان يتحقق موجودًا على هذا النحو. هناك فرق بين الماهية والوجود، بحسب تمييز المناطقة العرب […] ولهذا فإن ممارسة البرهنة، مآلها مخالفة الماهية وانتهاك معناها” (21).
والواقع أن الأمر لا علاقة له بماهية الاستقراء على نحو الحقيقة. بل لعل ذلك انزياح من علي حرب، في اختزالاته المكرورة، حيث يرى إلى التعريف كماهية حقيقية، دون أن يلتفت إلى إشكالية التعريف عند الفلاسفة أو المناطقة، كما لو كان التعريف مرتبة واحدة. فالماهية (=ماهية الاستقراء) التي يتحدث عنها علي حرب، هي ماهية كما عرفها المناطقة، لا ماهية الاستقراء كما هو واقعًا. وسبق وأشرنا إلى أن أرسطو نفسه لا يعتبر الاستقراء الناقص دليلًا. وبالتالي، فليست البرهانية ماهية له. والالتباس واضح هنا، فأرسطو اعترف بدليلية الاستقراء الكامل، الذي هو – في حقيقته- استنباط. لقد عرف المتكلمون مثلًا “الوجود” بثابت العين، مع أن هذا التعريف يؤدّي إلى دور منطقي. لكنها مسامحة منهم. وقد كان أحرى بعلي حرب أن يستحضر الرأي السينوي بهذا الخصوص، حيث أشار في إشاراته إلى ظاهرة سهو المعرفين في تعريفاتهم. فربما عرفوا الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة، أو عرفوا الشيء بما هو أخفى منه كقول بعضهم أن النار هو الأسطقس الشبيه بالنفس، والنفس أخفى من النار…” (22). وهذا ما أوضحه الطوسي في شرحه على الإشارات: “وجميع ذلك رديء، لأنه لا يفيد المطلوب، وبالأخفى أردأ منه لأنه أبعد عن الإفادة (23).
الشاهد في كلامنا، أن ما تراءى لعلي حرب، ماهية للاستقراء، هو سهو المعرفين وتساهلهم في التعريف. وعليه نقول: إن ما يعرف بما هو أخفى منه – كالوجود – ممتنع عن التعريف نظرًا لا حدسًا. فالوجود مدرك بداهة، ممتنع نظرًا؛ لأن في تعريفه بغيره خلف، فهو لا يعرف، لكونه معرف الأشياء، ومثل ذلك حال الاستقراء. فأنّا يعرف، وكل تعريف لا يتم إلا بقياس، وكل قياس ينطوي على استقراء. فهو دليل لا يقوم قياس إلا به، لضرورة وجود القضية الكلية في القياس، وحتى مع ادعاء عدم وجودها كما هو شأن قياس التمثيل المتجه من الخاص إلى الخاص، فقد أشرنا إلى أن ذلك ظاهر منه، بينما حقيقته اشتماله على القضية الكلية في جانبه الاستقرائي. من هنا، فما اعتبر برهانيًّا ارتد إلى ما اعتبر ظنيًّا. فإذا كان القياس يتوقف بأشكاله على وجود الاستقراء، وبأن حاله إزاء الاستقراء، حالة المفتقر إلى دليلية الاستقراء – أو ما أسميه بالفقر الدليلي-، وهو تعريف الاستقراء بواسطة دليل أخفى أو مفتقر إليه، ففي ذلك دور، ولن يفيد المطلوب. وإذن، سوف يظل الدليل الاستقرائي، أبو الأدلة المنتجة، ممتنعًا عن التعريف، لشدة دليليته، وافتقار كل الأدلة إليه حدًّا وتعريفًا. على أن الحدس ليس إلا شكلًا آخر من الدليل، وها هنا نكتة جديرة بالبيان. إن تفصيل القول برهانًا، ليس بالضرورة ارتقاءً في مقام الدليلية. ربما كان التفصيل والبسط، وإظهار الخفي أو المهمل من وسائط الدليل، نزولًا- لا ارتقاءً- في مسالك الدليلية. على أن الدليل متى ما اندكت وسائطه حتى قاربت الحدوس، كان برهانًا كامنًا يمكن بسطه وإظهاره. إن ما يبدو من تقسيم للعلم إلى نظري وضروري، تقسيم ملتبس، كتقسيم الدليل إلى برهاني وحجاجي (24). وذلك، باعتبار الدليل هو في نهاية المطاف حدس ظهير كما أن الحدس دليل ضمير. يؤكد صدر المتألهين الشيرازي على حقيقة مفادها، أن لا نفور البتة بين ما هو بحثي وما هو حدسي… بين ما هو نظري وبين ما هو إشراقي. فهما متآلفان متصالحان، لا متعارضان متدابران. وكل ما أمكن التوصل إليه حدسًا أمكن التوصل إليه بحثًا. من هنا، فالخلاف في التوصل إلى الحقائق هو في رتبة الدليل ودرجة إيقاعه… إظهارًا للوسائط أم إضمارًا لها … وإذن لا مفاضلة ها هنا بين الطريقتين ولا في مستواهما الدليلي إلا بما يقتضيه مقام البيان وحاجة المخاطب – بفتح الطاء- إذ كل أشكال الدليل هي معتبرة. فالتفاوت في درجات الحجاج ومسالك الأدلة هي بلحاظ حاجة المخاطب ومقام المناظر وظروف المعاقلة. من هنا لا قيمة للبرهان الصوري في مورد معاقلة جارية بين أطراف متحاججة أو أطراف “متحادسة”، تكتفي بالحد الأدنى من المقدمات والوسائط، وربما استغنت عنها نهائيًّا. من هنا، لا غرابة إن اعتبرنا المائز بين الأقيسة البرهانية والحدوس هو في مقدار الحاجة إلى الحجج والوسائط. وثمة إشارة لطيفة للشهيد الصدر، أدرجها ضمن العلامات الفارقة بين القضية الأولية والقضية الاستقرائية التي تكمن في طبيعة دور الشواهد والأمثلة الإضافية. فازدياد وضوح قضية ما متوازي مع عدد الشواهد والأمثلة. فحيثما احتجنا إلى مزيد من الشواهد، كانت القضية استقرائية، ومتى أصبحت القضية واضحة إلى حد لم تعد تحتاج إلى شواهد إضافية أو استغنت عنها، كانت أولية قبلية. على أن الشهيد الصدر لم يلتفت هنا إلى جهة الاقتضاء أو الحاجة إلى الشواهد والأمثلة. هل يكمن ذلك في طبيعة القضية، أم في وضعية المخاطب – بفتح الطاء- نقول: إنها حاجة المخاطب، لأن القضية الاستقرائية قد تصبح أولية إذا ما اختلف المقام وقلت حاجة المخاطب لمزيد من الشواهد، وحيثما ارتقى إدراك المخاطب، وقلت حاجته للوسائط، وتسارعت لديه وتيرة الإدراك، وضمرت لديه المقدمات. فليس من الغرابة في شيء، أن لا يرى ملا صدرا ما بين البحث والإشراق – والنظر والحدس – خلافًا إلا بمقدار ما أسميه: “استبصار الدليل وتدليل المستبصر”. وكل ذلك مما فطن به المناطق الإسلاميين، وعلى رأسهم الشيخ الرئيس ابن سينا.
ومع ذلك نقول: إن سر الطفرة في الدليل الاستقرائي، بما أن الاستقراء دليل عقلي محض، معقولة. فإذا استحضرنا العبارة السينوية نفسها التي استدل بها علي حرب، وأشرنا إليها قبل قليل: الحسبان “إن الماهية تلتئم في الذهن بإسقاط الوجود من الحسبان”، فسوف نكتشف، بأن آلية التعقل بما هي آلية تجريدية، تتصف بخاصيتين هما: الانتزاعية، والطي.
فمن الناحية الانتزاعية، يكون الاستقراء مستوفيًا لعناصره، بناءً على قدرة العقل على تصور اللانهاية. وهو تصور معقول، وممكن، ولا يترتب عليه تناقض عقلًا، بموجب اللزوم المنطقي خلافًا للزوم الواقعي. وهو متضمن فيما تجاوزته الطفرة، طيًّا لا قفزًا. وبالتالي فعبر مسلسل لا نهائي من التمثيل، يستطيع أن يستوفي كل عناصر الدليل الاستقرائي، كي يكون المطلوب مساويًا لمقدماته دائمًا فيكون بهذا اللحاظ، الاستقراء استنباطًا مقدرًا. وقد يقال، كيف ذلك والتمثيل هو نفسه مشتملًا على استقراء، كما تقدم. ونقول، إن لا وجود لتسلسل أو تناقض بين ما أكدناه سابقًا وما نحن بصدده آنًا. ذلك، لأن الحديث يجري ضمن مجالين مختلفين في الاعتبار: مجال التعقل والواقع الخارجي. فالتمثيل هاهنا، لا نريد به ما كان انتزاعيًّا، أي تجريدًا لمشخص وجب له الوجود. بل هو تمثيل للممكن الافتراضي. على أن الممكن الافتراضي هو في حكم المعدوم- وليس معدومًا بالفعل، إذ لم يجب له لا وجود ولا عدم- فهو تمثيل لممكن وليس لمتشخص. فالمتشخص هو فضلًا عن كونه واقعًا في الأعيان، هو مما وجب له الوجود. وعليه، فتمثيل الممكن أو تمثيل المتصور، لا يفترض إنشاءً “كليًّا” انتزاعيًّا للمشخص. فهذا منحفظ عقلًا انخفاض استنباط لا استقراء. لأن الدليل الاستقرائي مستوفي للشواهد المشخصة التي هي في حكم ما وجب له الوجود، وما تبقى هو من الإمكان. وعليه فالتمثيل هنا، تجريد في تجريد، ثم لا يخفى أن التمثيل يجري هنا داخل مجال التعقل، حيث إنشاء الكلي من خلال استقراءات الذهن لا يترتب عليه الإشكال نفسه في الاستقراء الخارجي (25). والكلي هنا يتوصل إليه من دون قفز، بل بطي تنحفظ معه الشواهد انحفاظًا إجماليًّا، فهو طي وليس مجاوزة. وهكذا تكون الشواهد الاستقرائية مستوفاة تشخصًا؛ لأن ما تبقى من الشواهد هو إمكان محض. لنقل إذن، إن الوضع الأولي للاستقراء في مرحلته التشخصية، هو بهذا المعنى، استنباط؛ أي أن الكلي هنا ينطبق على المشخص من الشواهد. أما ما تبقى منها من إمكان محض، فتعالجه المرحلة التجريدية التعقلية للاستقراء. وكذلك الأمر بالنسبة للمرحلة التعقلية أو التمثيلية، فهي أيضًا استنباطية بنحو ما من الاعتبار، فالنتيجة تأتي في هذه المرحلة مساوية للمقدمات، المستوفاة جميعها طيًّا وإجمالًا. وقد قلنا إن الطي خاصية تعقلية إلى جانب الانتزاع. بهذا يصبح الاستقراء مؤلفًا من استنباطين: استنباط تشخصي وآخر تعقلي، يتكامل فيه دور التشخيص بدور التجريد. إن المشكلة التي تواجه الاستقراء، هو كون عالم الأعيان يفرض إشكالية استحالة استيفاء الشواهد والأمثلة الخارجية؛ من حيث هو عالم موسوم بالتكاثر والصيرورة، فلا يسمح باستيفاء كل شواهده المشخصة. ما يجعل العقل يتقدم على الواقع مستفيدًا من خاصية الانتزاع والطي، التي تبدو للناظر طفرة أو قفزة. فالعقل أسرع. فيكون الاستقراء من الناحية الواقعية دليلًا غير ناجز حتى لا نقول عنه دليلًا ناقصًا. فالفرق بين نقصانه – على ما جرى عليه وصف المناطقة – كونه مثغورًا بفقدان حلقة الطفرة، وبين كونه غير ناجز- أي من حيث هو دليل مفتوح ومستدام- ودليل تتكامل حجيته بتكامل شواهده.
فلماذا إذن لا نعتبر النتيجة الاستقرائية في طورها التشخيصي استنباطًا؟ فالقفز هاهنا إلى “الكلي” ملحوظ فيه وسع الناظر. لكأن العالم انتهى واستوفي بحسب هذا الوسع. فعالم الاستقراء لا يتعدى إلى الإمكان إلا عقلًا، وإلا فإن عالمه لا يتعدى وسع الناظر، ومتى اتسع مداه، أدرك إذ ذاك أجزاءً غير مستوفاة. إن فكرة “الكلي” هاهنا نفسها، لا ينبغي أخذها بوصفها كلية مطلقة، بل هي كلية نسبية تضيق وتتسع بقدر سعة مجال الناظر وجهد المجتهد وبقدر المتاح من الشواهد المعطاة، وفي ارتباط مشكلة الاستقراء بالعائق الوجودي، يصبح الاستقراء إشكالًا أنطولوجيًّا.
لقد أجاد كارل بوبر لما قلب منظور دافيد هيوم بخصوص موضوع التكرار والعادة (26). لكن لا أحد منهما استطاع أن يربط بين التكرار – كيف ما كان وضعه، علة أو معلولًا- وحقيقة اللزوم. فإذا سلكنا مسلك من رأى من المعاصرين المنطق علمًا للزوم، أدركنا بأن التكرار، وإن لم يورث يقينًا – إذ اليقين ينمو من الظن نفسه – فإنه يعمق الظن وينميه بالملازمة (27). وهذه الملازمة، إذا ما نحونا منحى ابن تيمية في رده على المنطقيين هي – أي الملازمة- ليست ناتجة عن الحجة بما هي علة- حيث اعتبر الوسط علة، تسامحًا، بل هو علاقة قد تكون علية وقد لا تكون. فاللزوم درجات وليس درجة واحدة. فالمشكلة تبدأ حينما نتحدث عن البرهان اليقيني والحجاج الظني بلسان المفارقة. إن ما فعلناه، وإن بدا راسخًا في التجريد، فهو تبرير للصورة المنطقية للاستقراء ذهنيًّا؛ بمعنى، أن الاستقراء معقول ذهنًا، منتج خارجًا. حتى ندفع دعوى من تراءى له “لا معقولًا”. فعالم الذهن من اللطافة والدقة حيث لا يتوصل إلى فهمه تسرّعًا وذهولًا (28).
أشرت إلى أن المشكلة تبدأ حينما نقابل بين البرهان اليقيني والحجاج الظني. وهاهنا يسعفنا علم “أصول الفقه” ليقلل إلى حد ما من سلطة المطابقة، بلوغًا إلى الممارسة. وهو مثال عن منطق عملي تكليفي مجعول لأجل الممارسة العملية وليس تجريدًا محضًا. لذا كانت الأولوية فيه للنافع على حساب الصورة البرهانية والكاشفية الدليلية في حالة فقد الدليل، باعتبار المنطق هنا مأخوذ فيه المصلحة الوظيفية. علم الأصول، يعتبر القطع الطريقي حجة لمقام طريقته- اللازمة ذاتًا لا جعلًا كما يقولون (29)- من حيث هو محض اطمئنان. فليس لسانه لسان مطابقة للواقع إلا على نحو “الإمكان”، لكنه شعور يتجه إلى المكلف بالدرجة الأولى. يحدثنا علم الأصول إذن – من حيث أتاح مساحة أعظم للمنطق العملي وسعة أكبر لمسالك الأدلة – عن “الأصل” الذي يلحظ الوظيفة أكثر من الواقع – أي المطابقة- في حال فقد الدليل. من هنا سمي أصلًا عمليًّا، حيث المعول عليه هنا، المضمون العملي أكثر من صورة الأصل أو مقدار كاشفيته للواقع. فالمعيار هو النفع والجري العملي. من هنا ندرك أهمية ما جاء عن الشيخ الأنصاري في رسائله، معللًا قيمة “الأصل” بما أسماه: “المصلحة السلوكية”. فإذا كان الأصل العملي لا يحرز واقعًا، ولا يتمتع بالدليلية، وبأن الكاشفية غير مأخوذة في موضوعه، فإن الذي يدعم مكانته في الاعتبار هو مقدار ما يحققه من مصلحة سلوكية، أهمها إثبات معذرية المكلف. وعليه، إذا ما وسعنا من مفهوم الدليل، كي يشمل كل أشكال الملازمة، أصبح من الممكن اعتبار الاستقراء يحقق درجة من الاطمئنان، وبأن مقدار ما به من كاشفية يعدل مقدار ما به من مصلحة سلوكية، فيكون حاله في الدليلية والأصولية، حال الاستصحاب في منطقته الوسطى، من حيث هو أدنى درجات الإمارة أعلى درجات الأصول؛ إذ وجه الدليلية فيه، أن الاستقراء أساس العلوم جميعًا من حيث كاشفيته المنتجة، ووجه أصوليته، أن في إهماله ضررًا بالغًا على مسيرة البحث العلمي. إن تمثيلي للاستقراء المنطقي بالاستصحاب الأصولي ليس جزافًا؛ ذلك لأن الطفرة الاستقرائية تفترض بقاء الحكم فيما لم يستوف من شواهد؛ تعدي الحكم اليقيني نفسه للشواهد المشخصة إلى الممكن الافتراضي، استصحابًا(30).
إن التكرار على الأقل ينتج افتراضًا – هو قابل للتكذيب لو أردنا التعبير على طريقة بوبر (31)- وبأن التكرار يقوي الظن ببقاء الحكم، ويعززه مع طرو كل شاهد جديد، إلى أن يبلغ لحظة الإشباع- أسميه الإشباع الدليلي- وهي اللحظة التي لم يعد للشواهد الزائدة أي أثر إيجابي على اطمئنان المخاطب بالدليل. وهو ما يترتب عليه نحو من اللزوم، ينمو هو الآخر مع نمو الحجة. ليبلغ منتهاه مع الإشباع الدليلي. إن البحث عن أساس منطقي للاستقراء، هو في حكم المستحيل كما يؤكد “بوانكريه”. لكن ذلك في الحقيقة مرده إلى إشكالات التعريف وقصور في تحرير محل النزاع.
وعودة إلى علي حرب، نقول: قد يكون من المتاح، الانخراط في حركة الاحتجاج على هشاشة البرهان المنطقي، أو الكشف عن فضيحة المنطقيين، لكن ثمة بون شاسع بين دحض مقالة المنطقين قاصدًا توسيع مسالك الدليل، ومؤسسًا لعلاقات اللزوم، وبين مقوض للمنطق ولكل أشكال اللزوم. فإذا سلمنا بهشاشة البرهان، وسلمنا بأن لا منطق إلا بوجود “ما يلزم”، فإن منطق علي حرب التحويلي التلفيقي الذي يقوض الإلزام من أساسه، ليس توسيعًا لمسالك الدليل، بقدر ما هو تضييق أو طمس لمسالكه. فقد تنطلي حيلة هذه الدعوى على من رأى في نقض البرهان انفتاحًا على كافة ضروب الحجاج، غير أن علي حرب يرفض كل أشكال الدليل المنطقي وكل أشكال الإلزام، وهو لذلك يرجو أساس الفعل التواصلي. مع أنه يمارس الخطاب، والخطاب إلزام. فإن عدم لحظ النافع ومقتضيات الجري العملي في الخطاب، فضلًا عن كونه لغوًا لا طائل من ورائه، فهو شكل من اللزوم – إذ لا إلزام من دون لزوم- لنقل إن مناط هذا الإلزام، إيجاد متعة لانتهاك الخطاب؛ متعة القراءة. فإذا كان علي حرب ينكر أن يكون رسولًا للحقيقة أو داعية لها، من حيث أخرج نفسه من دائرة الإلزام بوجهيه: الصوري والعملي، فلما يا ترى، كل هذا الإصرار على منطق بديل، أيًّا كانت دعواه، طالما لا يوجد له موضوع، وهو الإلزام؟ فهل يا ترى ثمة ما “يلزم” علي حرب أن يخرج منطقه هذا ليحاجج به أشكال المنطق الأخرى؟! فحتى لو جاء منطقه تقويضًا للإلزام – والمنطق هو علم اللزوم- فإن منطقه الفوقي – Métalogique- ناهض على الإلزام، وذلك غاية التهافت!
وعليه، نقول، إن ما سقناه من أدلة مختلفة، ليس في محصلته النهائية دفاعًا عن الاستقراء أو رأبًا لصدعه البرهاني. بقدر ما هو ممارسة حجاجية، تجعل الهشاشة- وإن كان ولا بدّ لنا من استعمال هذا الوصف- ليس محصورًا في المنطق الصوري، بل يتسع أيضًا للمنطق التحويلي. حتى ليبدو لنا، أن كل من تمنطق ألزم، وكل من ألزم، تهافت. حيث من الوارد أن يواجه سيلًا من التحديات والاستشكالات المختلفة. فالفكر، أي فكر، هو قابل للنقد. وأن المعول عليه، هاهنا، هو مواصلة الحجاج؛ لأن ذلك لازم أيضًا. ومدرك لزومه ضرورات التواصل وحتمية الاجتماع. وسيظل نداء “قل هاتوا برهانكم” (32). ذلك التحدي الكبير، الذي يفرض مواصلة الممارسة الحجاجية والفعل التواصلي، حتى لا نقع في مأزق الاستقالة، ومصيدة الغيتوهات المنطقية وأيديولوجيا تساوي الأدلة، فبنية الدليل مفتوحة، وفعاليته الدليلية مستدامة.
*وهم الاستقالة والتعسكر المضاد
لخطاب الحداثة أوهامه مثلما لخطاب ما بعد الحداثة أوهامه. فلئن كانت أوهام الحداثة تتوارى خلف الإنجازات التي تنتجها الحداثة – أي إذا كانت أوهام الحداثة مشوبة بحقائق واقعية – فإن أوهام ما بعد الحداثة، تكاد تكون أوهامًا خالصة. إذ قلما لاحظت الواقع وضروراته، وقلما نظرت إلى ضرورات الإنجاز العملي. إنها أشبه ما تكون باستراحة على هامش العقل المقيد، أو لنقل، إن الجنون – جنون ما بعد الحداثة- هو راحة العقل ومتنفسه. لكن، هل هذا يعني يا ترى، أن نقد الحداثة، استقالة أو تحرر من سجون الأيديولوجيا، ونجاة من خطر التعسكر الدوغمائي؟ هل ثمة من يملك القول، بأن الفكر فاعلية حرة على وجه الإطلاق؟
إن ثمة ما هو مشترك بين الخطابين، يجعلهما معا تحت إكراهات التعسكر والانتماء. ما بعد–الحداثة، تعسكر معكوس ومقنع وليس تحررًا بالفعل. إنه تعسكر تفرضه قوانين الاستعارة، وفي أهون الحالات، تعسكر تحتمه ضرورات الاشتغال. إن فعل القراءة والكتابة – وقد لا يخفى ذلك على من رأى الموضوعية وهما – غير بريء. إن للأيديولوجيا طبيعة اختراقية وتنكرية، تمكنها من ولوج كافة الخطابات. إنها تولد مع الأفكار وتلازمها إنتاجًا ونقدًا. إنها بالتالي الخطر الذي يتهدد الموضوعية تباعًا، فكون الموضوعية وهمًا، دليل على عدم انفكاك الفكرـ أي فكرـ عن الأيديولوجيا. فهذه الأخيرة هي مرض الفكر وقدر الخطاب، بقدر ما هي فضاءه المتاح. قد ينتقد علي حرب – جريًا على عادة أهل التفكيك- الهوية والأيديولوجيا والانتماء والمنطق… وهنا يكون نقدهم أشبه ما يكون بتعسكر آخر يفرضه مجال الاشتغال التفكيكي نفسه. فحينما يمارس نقاد الحداثة نقدهم للحداثة، فهم يكتشفون ويفضحون تناقضاتها ومفارقاتها استنادًا إلى أصل التناقض، وهو أصل الأصول المنطقية!؟
*أوهام المثقفين وهشاشة الشعائر التقدمية
لم تنج من آفة التقليد، حتى أكثر الاتجاهات العربية ميلًا إلى العمائية، يا للمفارقة!؟ بل إنه قدرنا منذ اخترنا التمسرح في كافة أشكال تفكيرنا واستشكالاتنا. على أن العمائية العربية التي اختارت أن تحذو حذو النيتشوية الفرنسية الجديدة، متمثلة في المشروع الفوكوني، من حيث هو – في حقيقته- محاولة مهووسة بإصرار فذ على مساءلة الأنساق واستنطاق شروطها التي ساهمت في بروزها وفي اغتيال كافة الخيارات أو حجبها، لم تكتشف بعد طريقها أو تستبين مهمتها. فحتى عالمية التفكيك تستوجب قابليته للتبيؤ من منطلق أن للفضح نفسه وظيفة نسبية. فالفضح يستمد قيمته من المجال التداولي؛ فرب مفضوح هنا، طبيعي هناك. لقد كان المشروع الفوكوني الأركيولوجي والجينيالوجي حاجة ماسة فرضها السبات الأنثربولوجي في الفكر الغربي، وردة فعل قصوى على تمركز اللوغوس وجبروت الميتافزيقا الغربية. إن ثمة شيئًا لم يشأ الغرب اقتحامه، منذ النهضة والأنوار، شيئًا استمر في حجبه وقمعه وممارسة النسيان في حقه. إنه السؤال الحينيالوجي الارتكازي في المشروع الفوكوني؛ لماذا تبرز هذه الأنساق وتختفي أخرى؟ أدرك فوكو أن مهمته تنحصر في هذا التحليل التاريخي الذي يسعى إلى ضبط الحقائق التي تتحكم بالخطاب. لقد حاول علي حرب مشاغبًا في ممارسته النقدية وتنويعاته الفوكونية، أن يتمثل عبثًا هذا الاتجاه، وأن يكتسب بفعل الممارسة والتقادم، صفة الممثل الشرعي لهذه الفوكونية في المجال العربي.
إن الذي يجعل علي حرب ينتصر لاندفاعات العامة مصوبًا وعيها على حساب النخب، في نوع من الاستخفاف بخطاب المثقف، هو أن الجماهير تمارس حياتها وتنتج أنماطها على أرض الواقع. في حين، لم يعد في جعبة المثقف، سوى صناعة الأوهام (33). لقد أضحى واضحًا أن علي حرب يعبر عن نزعة براغماتية، حيث لا قيمة لفكر لا يقيم علاقة منتجة مع واقعه. وهذا هو فعلًا ما يمثل روح الحداثة، وهو ذاته جوهر ما دعى إليه هابرماس، الذي لم يمارس استبعادًا أو تقويضًا لنقد الحداثة، بقدر ما احتواه واعترف بأهميته، على ألا يكون هروبًا إلى العماء. إن الدور الذي يتمناه علي حرب للمثقف، هو تمامًا استقالته وانشغاله في الصفوف الخلفية، حيث لا يصبح له دور غير الكشف عن الوقائع التي تجري في رأيه جزافًا وبمكر التاريخ، حيث يكون دوره دور “بومة” هيغل التي تخرج ليلًا لتصف ما حدث.
إذا كان علي حرب يتبنى التقنيات النقدية الجديدة – وتحديدًا الفوكونية، التي جاءت في سياق تضخم في مشاريع المثقفين- باعتبارها لحظة أعقبت مشروع النهضة والأنوار وتداعيات الثورات الصناعية المتعاقبة، التي هي كدح الأحرار ومعاناة ومهام قادها مثقفون ووضعوا في طريقها مشاريع، فإنه بالفعل، لا تهمه البدايات التي لا تقوم إلا بعودة دور المثقف العضوي. حيث مثقف النهايات والتفكيك يمكن أن يتعايش معه كاشفًا عن مزالقه وهناته دون أن يعمل على نفيه واستبعاده. إن علي حرب وهو يشكو من الاستبعاد والاضطهاد المعرفي، تراه يمارس استبعادًا واضطهادًا معكوسًا ضد المثقف المسؤول – وهو ما أسميه الهجر البارانوياني – في حين، وجودهما معًا ضروري لبعضهما البعض. يكفي أن علي حرب يقدم نفسه ناقدًا، وأن كل أعماله هي تفكيك وتناص، فلولا وجود المثقف العضوي لما وجد داعية التفكيك. إن استقالة المثقف العضوي، صاحب المشاريع والشعائر التقدمية هي بهذا المعنى استقالة لنقاده ونهاية لأنصار التفكيك الذين يتوقف وجودهم على وجود الأوائل. ما يعني أن وجودهم هو لغيرهم؛ وجودًا عرضيًّا.
مع ذلك لا أبرئ الواقع العربي من هذا التردي الذي استفحل إلى حد التمأزق. إننا لسنا بالتأكيد البديل عن هذه الحداثة التي أنتجها الغرب – بإصرار مستدام – فمأزقنا واحد، سواء حملنا مشاريع الممكن أو مشاريع الواجب. إننا قلقون مما يجري في عالم مأزوم ومستباح، بين حداثة تقوض الروح وتدمر النداء الإنساني العميق… وبين محيطنا الذي يمثل حداثة البؤس وبؤس الحداثة، لكن هذا لا يمنع من وجود إمكانيات على هامش هذا الاستفحال. إننا ننظر بقلق إلى العالم، لكننا لا نستسلم لإكراهاته وانهزامياته، فلا بد من ممارسة الفضح لهذه اللعبة، التي وكما عبر سعد الله ونوس “تمضي حتى الآن ببراءة”.
إن مشروع نقد المثقف العضوي، تحديدًا المثقف العربي الذي استولى عليه السبات الأنثربولوجي والأيديولوجي، هي مخاتلة حربية، لإخفاء السؤال عن مشروعية اشتغاله كناقد عدمي في مجال مضمخ باللامعنى. إنه اشتغال نقيض للبناء، لكنه ينطوي أيضًا على هواجسه؛ إرادة الاختلاف. إن نقد المثقف العضوي هي بمثابة صك لإيجاد دور على خلفية هشاشة الآخر ومشاريعه. فإذا كان مأخذ ناقد الحداثة، على الحداثة، كونها تسعى في أوج تمركزها، إلى نفي آخر العقل ـ L’autre de la raisonـ، فإن القبض على آخر العقل لا يكاد يتحقق إلا باستبعاد العقل. بهذا الفعل التناقضي التناوبي، يكشف علي حرب عن أنه يسلك مسلك النفي، ويتمثل الحداثة وتمركزها على نحو معكوس، وكما أكدت مرات عديدة؛ إن نقد المركز هو تأسيس لمركز مختلف. والحديث عن النهايات، هو حديث عن البدايات المشوهة. ففي نقد مشروع الحداثة يكمن نزوع إلى تحقيق مشروع الحداثة المعكوسة. في النتيجة نحن أمام فعل تغالبي، حيث السعي إلى تغليب ما بعد الحداثة على الحداثة لن يتحقق إلا عبر توسل خفي بتقنياتها في النفي والتمركز.
إن الفكر العربي اليوم، سواء أكان أيديولوجيًّا صارخًا أو علميًّا مدعيًّا، فهو تعبير عن مخاض. والحديث عن السبات الأنثربولوجي في هذه الآونة التي لا تزال الحداثة فيها جنينية، وربما مشروعًا لم تنعقد نطفته في رحم الانهيارات العربية المتوالية، هو ضرب من البهتان، طالما أننا لم ندق عسيلة هذا السبات. وكما رأت الهيغلية دائمًا في هذه المخاضات، تطورًا للروح، وخروجًا من السبات الذي تعكسه اللحظات التي تمر بلا تاريخ. إن حالة المخاض هي داعي تفاؤل وإن على المدى البعيد، وأن صراع المثقف العضوي ليس صراع دانكشوت يقارع طواحين الهواء، بل هي ممارسة تدفع بالفكر إلى أن يأخذ مكانته الطبيعية. إن نفي واستبعاد المثقف العضوي، معناه أن نجعل التاريخ يمر بلا أفكار تتلاقح وتمارس اختلافها حول المشاريع لا على خلفية تقويضها.
لا ننكر أن المثقف العربي – وهو جزء من أزمة العرب وإن قدم نفسه بوصفه طليعيًّا – قد وقع في الثرثرة، ولا ننكر كونه لم يصنع أوهامه أو لم يمارس البطش والتعسف الأيديولوجيين في أبشع صورهما. كما لا ننكر أن المثقف العربي ساهم بشكل أو بآخر في تمأزقه، بفعل ما مارسه من حجب للحقائق والتفاف حول المعقول وبفعل التحرش بالاستبداد أو الإسهام في خلط الأوراق وتمزيق الخرائط. ولا أزعم أن كل مثقف قدم نفسه بوصفه مثقفًا عضويًّا يستحق شرف هذا المقام أو هو فعلًا يمثل نموذجًا للمثقف التنويري أو التقدمي. لكن هذا لا يبرر خطاب النهايات وانتحار المثقف. نعم، لا يقدم علي حرب نفسه كصاحب مشروع أو برنامج ناجز، ويقرف – ككل العدميين- من ذلك النشاز الذي يحدثه قرع طبول الأيديولوجيات، لكنه سرعان ما تخونه الذاكرة والموقف، فيظهر اندهاشًا نادرًا من منجزات حداثية ومدنية. إن قمع الوجه الآخر للحقيقة قد يكون هو الشرط الممكن، وربما الضروري للتنزيل والممارسة. فالفكر لا ينزل إلى الواقع ملبدًا بغيوم العماء، أو دون أن يبرح فورًا راحة الخيال. إن الواقع لا يتسع إلا للعياني؛ والعياني هو الوجود الذي يحمل في ثناياه إمكانية التعين التي لا تقوم إلا على أساس قمع الوجه الآخر للحقيقة، كضرورة لإحكام النسق. فالعقلانية في صرامتها قد تغازل سرًّا مساحتها المستبعدة، وقد تضطر بين الفينة والأخرى، إلى اختلاس حدوسها من خزائن الخيال، لكن الواقع في نهاية المطاف لا يتسع إلا للمشاريع التي تحمل ختم العقل بحمولة تنوء صرامة وقمعًا وتسلطًا، وتلك هي حقيقته. فالعقل قد يقبل بمغازلة آخره –l’autre de la raison – انتزاعًا وتجريدًا، لكنه يطارده خارجًا. لا يخفي علي حرب أحيانًا إعجابه أو اندهاشه أمام بعض الظواهر المدنية، التي هي في حقيقتها إنجازات الحداثة وابتكاراتها. إنجازات تعتبر صنيعة ذلك القمع الذي يرفضه الناقد في الحداثة فيما هو يمسك بعصى “نيتشه” من الوسط. هكذا ألاحظ كيف أصبحت العولمة في نظر علي حرب، فتوحًا وخلاصًا تاريخيًّا. متعرضًا لنقادها بشتى التهم. وكان يفترض من المفكّك العربي أن لا يستسلم للشعارات النيوليبرالية، كي يزف لنا العولمة “بأختامها الأصولية وشعائرها التقدمية” كما هو عنوان إحدى مؤلفاته. لقد تبنى شعاراتها والتبس عليه أمرها، فيما هو يحجب فظاعاتها منافحًا عنها، على عكس نقادها الذين بدوا أكثر تفكيكية منه لشعاراتها، فاضحين مخاتلاتها، قارئين ما وراء خطابها “الميديولوجي”، وما هو مسكوت عنه في خطابها الرسمي، بوصفها تحمل من عناصر القمع والاستبعاد ما هو ظاهر لنقادها. لا يجد علي حرب حرجًا في أن يقدم قراءة احتفالية للعولمة، كما لو أنها لا تمثل أوج الحداثة في قمعها وتمركزها، وكما لو أنها الجنة الموعودة. فخطابه الحداثي التنكري تفضحه لغة النهايات، (حديث النهايات)، الذي يجعل منه كاهنًا تاريخانيًّا، أو يفضحه عنوان: فتوحات العولمة، الذي يجعل منه داعية نيوليبراليًّا. ذلك هو الوجه الآخر لتلك الملحمة التفكيكية “الحربية” المغشوشة، حيث تظهر حقيقة أصوليته الحداثوية المقنعة، وعنوان شعائره التقدمية، أو لعلها بدت رائعة الروائع في سياسته الفكرية. تلك باختصار المسافة الفارقة بين علي حرب مفكِّكًا – بكسر الكاف الأولى وتشديدها- ومفكَّكًا – بفتح الكاف الأولى مع التشديد – هناك بالتأكيد، الكثير مما يكفي قوله بخصوص هذه الملحمة، وثمة ما يستحق المزيد من الفضح لما يخفيه منطوق نصوصها. إلا أن ذلك لا يعني غياب مساحات أخرى، يبدو فيها المفكّك العربي أكثر جرأة وصراحة من نظرائه. ويظل النقد الحربي التفكيكي – رغم هشاشته- ضرورة تسند الخطاب العربي، وصوتًا جميلًا يزف متعته الفكرية إلى عقل صمت آذانه عن سماع همس آخره. إنه على أية حال، ليس استبعادًا، بقدر ما هو تفكيك التفكيك، على غرار تهافت التهافت، وذلك سعيًا منا حثيث للتخفيف من العمائية العربية، في محاولة لاستئصال شؤفة هجرها البارانوياني.
الهامش:
(1) في رسالته إلى صديقه الياباني، البروفسور أزوتسو، يشرح جاك دريدا ملابسات اختياره لمصطلح “التفكيك”. حينما تراءى له المفهوم نوعًا ما قابلًا لمزيد من التوضيح، حيث لفظ Destruction على الأقل في الفرنسية يدل على معنى الهدم، وهو “اختزال سلبي” يفيد معنى أقرب إلى الهدم Démolition كما عند نيتشه منه إلى التفسير الهايدغيري “ونمط القراءة الذي اقترحه، فاستبعدتها”. ويبدو أن دريدا لا يستخدم التفكيك بهذا المعنى السلبي الاختزالي، بل التفكيك في نظره مفردة لا تتمتع “بقيمة إلا في سياق معين تحل فيه محل كلمات أخرى أو تسمح لكلمات أخرى، بأن تحددها: الكتابة مثلًا أو الأثر أو الاختلاف: ترجمة كاظم جهاد، الطبعة 1-1988- تبقال – المغرب.
(2) يقول علي حرب متهمًا كاتب هذه السطور بإرادة الاستبعاد: “وشاهدي على ذلك يقدمه الكاتب المغربي إدريس هاني في قراءته لبعض نصوصي، فقد اعتبر من جهة أولى بأنني مستوعب قدير للتفكيكية، وممارس ماهر لطريقتها، وناقد بامتياز على مذهب دريدا؛ ثم عاد لكي يتهمني بأن قراءتي هي مغامراتية، بهلوانية، نخبوية، سريعة، لا تتعايش مع النصوص من داخلها. بذلك يقدم هاني نموذجًا لقارئ ينتهك للتو ما يدعو إلى ممارسته…”. أنظر: علي حرب، أوهام النهبة أو نقد المثقفين، الصفحة 214، الطبعة 2-1998- المركز الثقافي العربي بيروت.
أقول: إن في ذلك تأكيدًا على ما أشرنا إليه في المتن، من أن علي حرب يلتمس من نقاده أن يكونوا مدّاحين فقط، وبأنه يرى في الاختلاف، اتهامًا واعتداءًا… وبأن الناقد إن رأى إلى النصوص التي يشتغل عليها من زاويتين، فهو منتهك لما يدعو إلى ممارسته. والحال، إن د. علي حرب، يحاكمني على أساس أصل امتناع التناقض، وهو أصل منطقي، بل أراه يمارس بعض الاختزال حتى في تطبيقه لهذا المبدأ، حيث لم يلحظ اختلاف الموضوع وتغيير السياق. ولا أزال أنظر إلى علي حرب كناقد ومفكّك له مغامراته الكتابية، وهو بلا شك دريدي أو فوكوني بامتياز – قل ما شئت- لأنه من الممثلين الميدانيين للتفكيك، وهو بقدر ما ينتجه من متعة القراءة، لم تنج محاولاته من هنات، وهنا تبرز الحاجة للنقد. عجبًا، كيف يتعالى علي حرب على النقد – ناظرًا إلى أهله كمعتدين أو غير مستوعبين لنصوصه، وهو تعبير عن التعالي على النقد -، فيما هو لم يترك نصًّا حيًّا أو ميتًا إلا واشتغل عليه كأشد ما يكون النقد استئصالًا واستبعادًا. وهو بذلك يذكرنا – وهو من تحدث عن ديكتاتورية المعنى – بالمستبد الذي يرى في مخالفته، مروقًا وخروجًا وزندقة. وفي أهون الحالات؛ فهمًا سيئًا وخاطئًا لمقوله. وذلك حقًا، ما أسميه، انتهاكًا لما يدعو، ناقدنا إلى ممارسته.
(3) صورة هذه المفارقة كالتالي: يقول “إيبمند” الكريتي: “كل الكريتيين كذابون”. فإذا صدق إيبنمد، فهو كاذب؛ لأن صدقه بلحاظ انتسابه لكريت؛ يعني كونه كاذبًا، وإذا كذب، صدق، لأن كذبه يرفع حكم الكذب عن الكريتيين.
(4) لم أكن أعني بالبهلوانية هنا تهمة قدحية؛ فالبهلوانية هي صفة موضوعية للتفكيك، من حيث هو طريقة لا ترسو على الأرض ولا تتمتع بإقامة؛ فالحركة البهلوانية، حركة يصعب ضبط إيقاعها، لأنها لا تتقيد بموقع أو بتسلسل علّي، تمامًا كالتفكيك. من هنا صعوبة نقده.
(5) الهجر، لغة، يفيد معنى الهذيان Le délire. أما البارانويا، فهي تكشف من الناحية التحليل-نفسية عن مسلكين على تمام التضاد: الشعور بالعظمة، والشعور بالاضطهاد. فممارسة التعالي، هو ميكانيزم دفاعي لا شعوري يحركه الإحساس بالاضطهاد. وهذا حال ما أسميناه بالهجر البارانوياني، أي بقدر ما يمارس الناقد تعاليًا على المثقفين، قامعًا لأسئلتهم، مستخفًّا بمشاريعهم، يرى في النقد المعاكس اضطهادًا واستبعادًا.
(6) في نقدهما الجذري للعقل، يرى كل من هارموت وجزنوبوم إلى “آخر العقل” باعتباره: “هو الطبيعة، البدن، التخييل، الرغبة، المشاعر، أو بتعبير أفضل، كل هذا معًا بقدر ما عجز العقل عن احتوائه”. أنظر: يورين هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، ت د. فاطمة الجيوشي، الصفحة 470، الطبعة 1، منشورات الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق –1995.
(7) علي حرب؛ الماهية والعلاقة: نحو منطق تحويلي، الصفحة 38، الطبعة 1- 1998، المركز الثقافي العربي – بيروت.
(8) نسبة إلى علي حرب. والفلدقة نسبة إلى الفيلدوق ـ Philodoxeـ الذي هو خلافًا للفيلسوف Philosophe، ينهض خطابه الحجاجي على المفارقات والالتفاف على الحقائق، متوسلًا بالخطابة لا البرهان. وهو تمييز توقف عنده فرانسوا شاتلي، بين الـ Philosophe والـ Philodoxe.
(9) يدرك علي حرب ذلك تمامًا، يقول مثلًا في كتابه الموسوم بـ: الأختام الأصولية والشعائر التقدمية: “ومع ذلك لا افتئات في القول بأن المحاولات الفلسفية لدى العرب المحدثين والمعاصرين، لم تسفر بعد عن ابتكار حقول ومفاهيم ومناهج تجتاز الحدود الوطنية… أو تستشير نقاشًا خصبًا على الساحة العالمية أو في الأوساط العلمية، كما هي مقولات مثل “نهاية التاريخ” أو “صدام الحضارات”، أو كما هي مناهج وعلوم مثل “التفكيك”، و”النحو التوليدي”، و”المجال التداولي”. وهل “فقه الفلسفة” عند طه عبد الرحمن العروي، أو “الإسلاميات التطبيقية” عند أركون أو “الشر المحض” عند صفدي، هل هذه المقولات والمصطلحات هي إبداع فلسفي خارق؟”، الصفحة 136، الطبعة 1 – 2001، المركز الثقافي العربي – بيروت.
وهذه شهادة من الناقد، على أن مناط العالمية هو إبداع ما هو خارق ومدهش. والسؤال هو مطروح بإلحاح، على طريقته –التفكيكية- باعتبارها تحرّرًا من قيود المنطق الصوري، وبأنها طريقة في إنتاج الفكر وتجدد في المفاهيم. هذا مع أن علي حرب فيما ذكره من عناوين وأمثلة وقع في اشتباه صارخ. وكان أحرى بالمفكك العربي أن يرى إلى عالميتها من زاوية أعمق. فمقولة كـ”نهاية التاريخ” أو “صدام الحضارات” ليست مدهشة بقدر ما هي اختزالية تسطيحية، تستند إلى قوة المجال والزمان الذين طرحت فيهما، وقوة الدعاية أو لنقل قوة الميديا، فكل ما يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يكتسب صفة العالمية، لا لقوته، بل لأنه محكوم بشكل من أشكال عالمية النموذج الغالب (=الأمركة). ولعل أبرز دليل على ذلك، أن علي حرب، ضرب مثالًا بمقولة “المجال التداولي” معتبرًا إياها منهجًا عالميًّا، مع أنها من إنتاج د. طه عبد الرحمن، حيث تساءل إن كان ما أتى به هذا الأخير – والآخرين معه- إبداعًا فلسفيًّا خارقًا. وذلك بعد أن نسب إليه “فقه الفلسفة” بدل أن ينسب إليه مقولة “المجال التداولي” التي هي نفسها من وحي المنقول التراثي، وتحديدًا من الغزالي أولًا، ومن ابن حزم ثانيًا. مثل هذا الالتباس، نجده في قوله: “فحتى الآن لم يخرج أحد من العرب بفكرة تتحول إلى حدث فكري خارق يخلق مجاله التداولي على ساحة الفكر في العالم”، أنظر: علي حرب “الأختام الأصولية …”، الصفحة 104.
(10) مع أن علي حرب ينتقد تجنيس الفكر، ويستشكل على مقاربات طه عبد الرحمن في الترجمة، لكنه سرعان ما يعود فينتهك ادعاءاته ليقول في مورد آخر: “والأعجب من ذلك كله، أن الأستاذ بو طيب، فيما هو يدعو إلى تأصيل المفاهيم الغربية، إنما يستخدم بعض المصطلحات بشكلها الخام دون تحول أو تكييف، كما هي حال العبارة التي استقاها من كتاب للجابري، حول تاريخية الفكر، أو “جينيالوجياه”، مع أن هذا المصطلح الأخير يحتاج على أقل تعديل إلى من يشتغل عليه ويقوم بترجمته أو تعريبه، على نحو يجعله مقبولًا أو منسجمًا مع الذائقة اللغوية العربية [ثم يردف قائلًا:] من نافل القول، بالطبع، إن المناهج والنظريات المأخوذة عن الغير، لا ينبغي أن تستخدم بصورة آلية أو حرفية، حتى لا تكون محصلة الاقتباس التبسيط والاختزال أو المسخ والتشويه. أنظر: علي حرب، “الاختام الأصولية …”، الصفحة 183.
يوهمنا علي حرب أن الذين يسعون إلى إعادة انتهاك المفاهيم وإخضاعها للمجال التداولي، إنما يسعون لمحو أصولها، بينما يبدو من ظاهر ما ذكره آنفًا، يفيد نزعة غامضة للتقريب التداولي، الذي هو استراتيجية لتحرير الفكر من جنسيته الأولى وإعادة تكييفه مع المجال التداولي الجديد. فقدر الفكر أن لا يكون عالميًّا، إذا لم يبرح سجنه القوي، فلا يتعولم إلا إذا كان قابلًا للتشخص المختلف والتصرف إلى وجوه. فلا عالمية إلا مع قابلية التشخص والتصرف المحلي. هذا مع أننا نحتفظ بمسافة نقدية من أيديولوجيا المجال التداولي على الطريقة الطهائية.
(11) يورد ابن تيمية في ردوده على المنطقيين ما يفيد عدم التقيد بمقدمتين في القياس المنطقي، حيث يمكن أن تزيد على ذلك أو تنقص أو تختفي نهائيًّا، فيكون العلم ضروريًّا. وكل ذلك حسب حاجة المتلقي لهذه المقدمات. يقول: “إن من الناس من لا يحتاج في علمه بذلك إلى الاستدلال، بل قد يعلمه بالضرورة، ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين، ومنهم من يحتاج إلى ثلاث، ومنهم من يحتاج إلى أربع وأكثر”. أنظر: “د. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، الصفحة 303، الطبعة 2، المركز الثقافي العربي – بيروت، وبين أن هذا ليس جديدًا على المناطقة، وإن حاول ابن تيمية أن يستند عليه في نقضه على منطقهم.
(12) ” … وجهة نظر فقهاء العلم الذين قالوا، ابتداءً من “هانس ريشنباخ” وانتهاء بـ “ميشيل ميير”، بمرحلتين اثنتين في العلم، هما مرحلة الاكتشاف ومرحلة الاستنباط. أنظر، طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي – بيروت. أقول: وستكون لنا وقفة في مناسبة أخرى مع ردود ابن تيمية على المنطقيين، ومع طه عبد الرحمن في مدعى توسيع ابن تيمية لمسالك الدليل.
(13) علي حرب، الماهية والعلاقة، الصفحة 37.
(14) أصبح مسلّمًا لدى المناطقة، ضرورة الاستناد إلى غير القياس، لتأمين صحة المقدمات، وإلا، إذا اكتفينا بالقياس وحده، فسيتسلسل الأمر. يقول روبير بلانشي بهذا الخصوص: “لأن هذه الصحة إذا لم تكن ذاتها قابلة للمعرفة إلا ببرهان قياسي، فإننا ندخل إما في تراجع إلى اللانهاية وإما في حلقة مفرغة: فإما أن لا يكون هناك علم […] وإما أن يكون العلم دائمًا […] ولا ننجو من هذا الخيار المدمر إلا إذا قبلنا أن المبادئ الأولى للبرهان معروفة بشكل آخر غير البرهان”. أنظر: روبير بلانشي، المنطق وتاريخه، ترجمة: د. خليل أحمد خليل، الصفحة 104، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – لبنان.
(15) لا شك أن علي حرب في قراءته للنص أو ممارسته التفكيكانية، يمارس خطابًا. وكل خطاب ينطوي على إلزام ومن ثمة قياس، ولا قياس دون استقراء، إن دعوته التفكيكية تشتمل على قضايا مثل:
“كل نص يحجب بقدر ما يظهر”.
أو “كل نص يحمل وجهًا آخر”.
أو “كل معقول ينطوي على لامعقوله” إلخ …
وواضح أنها قضايا تشتمل على أقيسة وكليات. والكلي هو نتيجة استقرائية، حيث يمكننا تحليل القضايا السابقة كالآتي:
كل نص يحجب بقدر ما يظهر
مثال القياس: وهذا الذي نشتغل عليه، نص
إذن، هذا نص يحجب بقدر ما يظهر
ولتبرير المقدمة الأولى، من حيث هي قضية كلية، يتم الاستدلال كالآتي:
أجرى فوكو تجارب على عدد من النصوص، فتبين أنها تحجب
مثال الاستقراء: بقدر ما تظهر
إذن، كل النصوص تحجب بقدر ما تظهر.
(16) إذا سلمنا بالتصور السابق الذي يرى للمماثلة بنية مزدوجة تتراوح بين مرحلتين: استقرائية واستنباطية، أدركنا أن التمثيل الذي اعتبره البعض قياسًا فطريًّا، تداولًا في الخطاب الطبيعي. فاتضح أن المماثلة هي أعقد من باقي الأقيسة. وإذا تبين أن الاستقراء ثاو في قياس التمثيل، فهو بناءً على المعنى السابق، ثاو في الخطاب الطبيعي ويجري عليه كونه فطريًّا، وكل ما هو فطري مجعول بنحو ما في تصورنا. أعني جعلًا تكوينيًّا.
(17) حيثما نما الاعتبار، ارتفعت الحاجة إلى إظهار المقدمات أو تعريف الأشياء. وهكذا، فإن مقدمات الحدوس كجعلية الاستقراء ورسوخها في الفطرة وفي ثنايا الخطاب الطبيعي، لا تظهر إلا بالقدر الذي تفرضه الحاجة والطلب. فالاعتبار من العبور، وهي طي مسافات الدليل ومقدماته، فلا يخلو منها لاتصالها واحدًا واحدًا بالنتيجة.
(18) أنظر، د. طه عبد الرحمن، المصدر نفسه، الصفحة 66.
(19) يقول بهذا الصدد: “لا أريد أن أبحث في أسس الاستقراء، فأنا أعرف جيدًا أنني لن أنجح في هذا، وأن صعوبة تعليل هذا المبدأ لا توازيها إلا صعوبة التخلي عنه”؛ قيمة العلم، ترجمة: الميلودي شعموم، الطبعة 1-1986، دار التنوير – بيروت.
أقول، إن المحاولات التي وصلتنا بهذا الخصوص، والتي رامت البحث عن أسس منطقية للاستقراء منذ راسل حتى السيد باقر الصدر، لم تكن أكثر مما يسميه الفقهاء، بتحرير محل النزاع. فلو أخذنا على سبيل المثال المحاولة القيمة للسيد الصدر الموسومة بـ: الأسس المنطقية للاستقراء، فسوف نقف على الحقيقة نفسها، وهو استحالة البرهنة على اليقينيات الأولى التي تنهض عليها المعرفة البشرية. إن قصارى ما توصل إليه الصدر، التمييز بين اليقين الموضوعي، حيث هو تعبير عن درجة ما من التصديق، واليقين الذاتي المعبر عن الدرجة الاحتمالية الموجودة في نفسية الشخص. أما عن اليقين الموضوعي الذي هو محور إشكالية الاستقراء، لأنه يتصل بالمعرفة الموضوعية، فإنه لا يبلغ أقصى درجات التصديق التي هي الجزم. فاليقين بالمعنى الذاتي هو تصديق وهمي في نظر السيد الصدر. هذا الوهم منظور إليه من الزاوية الموضوعية أو الدرجة الاحتمالية الموضوعية، حيث تنمو درجات الاحتمال الموضوعي أو القيمة الاحتمالية الموضوعية بصورة لا تعانق اليقين الجازم مطلقًا.
(20) اليقين الجازم هو درجة من التصديق لا توجد إلا بالإيمان وفي الاعتقاد. وهذا ما يقلب ظهر المجن لمزاعم الحداثة نفسها، وخطابها العقلاني، حيث اعتبرت العلم قطيعة مع عصور الإيمان. وبأن اللوغوس قد هزم الميتوس، وقد بدا أن سيد الأدلة المنتجة (=الاستقراء)، مثال صارخ عن هذه الأكذوبة التي دامت طويلًا، وبأن زواجًا بين العلم والإيمان لم ينفك إلى الآن.
(21) أنظر: الماهية والعلاقة، الصفحة 36.
(22) أبو علي ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، الجزء 1، الصفحة 107، الطبعة 1- 1375 ه. مطبعة القدس، ثم ولمزيد من التوضيح يقول ابن سينا في “منطق المشرقين” مثله في النجاة والإشارات: “واعلم أن كل حد ورسم فهو تعريف لمجهول نوعًا ما، فيجب أن يكون بما هو أعرف من الشيء، فإن الجاري مجرى الشيء في الجهالة لا يعرفه”. ولذلك قد غلط القوم الذين يقولون: “إن كل واحد من المضافين يعرف بالآخر”. ولم يعرفوا الفرق بين ما يتعرف بالشيء، وبين ما يتعرف مع الشيء، فإن الذي يتعرف به الشيء هو أقدم تعرفًا من الشيء، والذي يتعرف معه ليس أقدم معرفة منه..”، منطق المشرقين، الصفحة 81، الطبعة 1- 1986 دار الحداثة – بيروت.
أقول: إذا كان كل معرف للاستقراء هو قياس، وبأن لا تمام لقياس إلا بالاستقراء، اتضح أن التعريف يؤدي إلى دور. ثم لا يخفى أن الاستقراء إذا كان هو أساس القياس، فهو أقدم تعرفًا من غيره، فكيف يعرف بها. ولقائل أن يقول: إن “التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا بالحد”. ابن تيمية يرده الحد إلى قول الحاد، الذي هو دال على ماهية المحدود. وبذلك يكون الحاد قد تعرف إلى محدوده قبل الحد، أي بغير حد. ما يعني في اعتقادنا، أن الحد إظهار وليس إنشاء؛ إظهار لمعلوم لا تأليفًا له، لكن هذا لاحظ للحاد لا للمخاطب بالحد. فابن تيمية يخلط بين الوضوح وبين البداهة، فوجود التصور عند الحاد حصوليًّا لا يتم إلا بالحد، ونقله للمخاطب لا يتم إلا كذلك، فليس كل متصور هو بديهي. الإشارات والتنبيهات، شرح الطوسي، المصدر السابق، الصفحة 107.
(23) تسالم الفلاسفة والمناطقة على أن يقسموا العلم إلى نظري وضروري، وقد عنوا بذلك أن بعض أشكال العلم يتم فيها الحمل بمجرد تصور الموضوع والمحمول من دون الحاجة إلى واسطة في الإثبات، بينما النظري هو ما احتاج إلى المقدمات. وهذا مردود بما ذكرنا سابقًا، حيث الحاجة إلى إظهار مقدمات الدليل، هي بحسب طلب المتلقي، فليس الاختلاف بين ما احتاج إلى مزيد من المقدمات وما لا يحتاج إليها، سوى اختلاف حالة المتلقي. وبذلك نقول بأن الفرق بين النظري والضروري ليس خاصية في الدليل، بل خاصية في المتلقي، وأن المقدمات هي هي في كل الحالات داخلة في تكوين النتيجة، وظهورها هو بحسب الحاجة. وعليه، فما قد يكون ضروريًّا عند البعض، قد يكون نظريًّا عند آخرين، وربما ما كان نظريًّا الآن قد يكون ضروريًّا مستقبلًا عند نفس المتلقي، والأمر سيان بالنسبة للفرق بين البرهان والحجاج. وقد بينا، أن البرهان يحتوي في ثناياه على الظني، كما هو شأن القياس في افتقاره للاستقراء. كما أن الحجاج يحتوي على ما هو برهاني، لانطواء التمثيل – وهو فارس الحجاج- على بنية مزدوجة: استنباطية واستقرائية. وعليه نقول: إن تقسيم العلم إلى نظري وضروري أو تقسيم الدليل إلى برهاني وحجاجي، هو تقسيم اعتباري وليس حقيقيًّا.
(24) هذا تخريج غارق في الاعتبار، قصدنا منه فقط بيان، أن ما يبدو طفرة يمكن استيعابه عقلًا، دفعًا لمن يرى أن الاستقراء دليل غير لائق، وإن كان الرأي السائد، لا يرى للمفاهيم الاعتبارية – خلافًا للحقيقية – أي قيمة منطقية باعتبارها افتراضية غير انتزاعية. لكنها هنا تصلح لتبرير هذه القفزة الاستقرائية واستيعابها عقليًّا، لأن المقام ليس مقام صدق مطابقي خارجي، بل المقام مقام ثبوت عام. وكان السيد باقر الصدر في محاولته الجادة، قد ربط بين الاستقراء والتوالد الذاتي للمعرفة. فالمرحلة الأولى التي هي مرحلة التوالد الموضوعي، هي في تصور الصدر، مرحلة استنباطية (المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي). على أن درجات التصديق الاحتمالي في المرحلة الاستنباطية الموضوعية، تتم على وفق المنطق الصوري، وهي مستنبطة. بينما في المرحلة الاستقرائية تعتبر درجة التصديق التي تصل إلى درجة الجزم اليقيني غير مبرهنة، بل تتوقف على افتراض مصادرة يتعذر البرهنة عليها.
(25) يقلب كارل بوبر معادلة دافييد هيوم بخصوص مسألة التكرار، فبينما يرى الثاني أن القانون هو وليد التكرار. يرى الأول أن التكرار ينسف القانون، حيث التكرار لا وجود له في الخارج، وإنما هو حكم عقلي محض. مؤكدًا بذلك على أهمية وأسبقية الفرض.
(26) حيثما اقترنت قضيتان، فإن مقدار اللزوم يتكثف منمّيًا معه درجة الصدق. على أن الفرق بين اللزوم الظني والجزم بوصفه لزومًا يقينيًّا هو فرق في الدرجة. وكما أن الظن مراتب فاليقين مراتب أيضًا. والحد الفاصل بين أعلى درجات الظنون – الظن الخاص – وأدنى درجات اليقين، هي طفرة داخل مراتب الظن الخاص نفسه، مناطها زيادة في التصديق إلى درجة تفوق اللزوم الظني إلى القيمة الاحتمالية شديد التوقع والاحتمال. وذلك أيضًا له علاقة بمقدار وقوة تصورنا للملزوم، حيث تتكثف درجة اللزوم بقدر تصورنا للملزوم.
(27) إن تخريجًا كهذا ـ قائم على التمثيل ونظرية العوالم الممكنةـ بقدر ما يحل بعض الإشكالات، فهو يخلو منها على الإطلاق. ما يعزز استحالة البرهنة على الاستقراء على أساس التسليم بالمنظور المنطقي التقليدي لمفهوم الصدق نفسه. وهنا تواجهنا مسألة الإقناع بالنتيجة الاستقرائية، فيغذو هذا الوصف – ولا أقول التبرير – للطفرة الاستقرائية، معقولًا بالنسبة لصاحبه؛ لأن مسألة إظهار المقدمات نزولًا عند حاجة المتلقي في هذا الشطر من العملية الاستقرائية مستحيلة مهما بلغت قناعة الشخص بلزومية هذه الطفرة؛ لأن عملية طي المراحل هنا مسألة حدسية خالصة، توجد تأثيرًا على قناعة الشخص. والاستنباط فيها يتم خارج العالم الموضوعي، أي خارج منطق المطابقة. فهي افتراضات، لأنها ممكنة قائمة على استصحاب حكم الممثول وتعديته إلى المثال، بعد إنزال المثال منزلة الممثول في الاعتبار. اللهم إلا أن ننفي مسألة الممكن على غرار بعض الظواهريين (=كجون بول سارتر في فلسفته الوجودية)، واقتصرنا على الموجود المتاح الذي أحاط به وسع المستقرئ للشواهد. فالكلية هنا تصبح معقولة. والاستقراء يغدو مرحلة واحدة بالفعل، مرحلة استنباطية. وما أوردناه آنفًا لا يستند إلى المنظور الأرسطي بخصوص الصدق، بوصفه مطابقة، ولا حتى بمنظور تارسكي في مفهوم الممكن المنطقي مقابل الممكن الواقعي-باعتباره تأسيسًا تشارطيًّا على التصور الأرسطي للصدق، بل الأمر هنا له علاقة بمنظور أوسع للصدق؛ منظور مفهومي، يقيم تصوره للصدق على أساس الاعتبار والاستبدال. من هنا، تصبح عملية طي الشواهد الاستقرائية معقولة، وصادقة، وإن لم تتم على نحو المطابقة الموضوعية. ما يجعل الدليل الاستقرائي مع وجود العجز عن برهنته دليلًا معقولًا وليس كما تراءى للبعض دليلًا غير معقول. لنقل بناء عليه، أن الطفرة الاستقرائية وإن بدت غير منطقية إلا أنها عقلية. وهذا ما يبرر قولنا بأن العقلي هو أوسع من المنطقي.
(28) يرى الأصولي أن القطع – أيًّا كان مصدره – حجة. ويميز هنا بين ما كان طريقيًّا، أي أن يكون طريقًا للحكم، وما كان موضوعيًّا، أي أن يكون القطع فيه له علقة بثبوت الحكم. وإذا كانوا قد رأوا في كل أشكال الظنون مرتبة أدنى من القطع، وإن قام دليل على اعتبارها – كما في الظن الخاص – فهي مجعولة. في حين رأوا إلى القطع درجة أسمى من باقي مراتب الظنون، لأن الحجة فيه ذاتية لا جعلية.
(29) الاستصحاب يأتي بمعنى “إبقاء ما كان”، وسريان العمل على مقتضى اليقين. ومثل هذا ـ في تصورنا ـ حاصل في الاستقراء، بمثابته نحو من استصحاب اليقين، وسريانه على الشواهد الافتراضية الممكنة غير المستوفاة في المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي.
(30) الفرض عند بوبر سابق على التجربة. من هنا ضرورة الإخضاع الدائم للتجريب واختيار مدى صمود النظرية أمام فعل الدحض. هذا ما يجعل الاختبار دائميًّا، والقضية في مواجهة الدحض أبدًا. فكل قضية تحمل قابلية التكذيب. بهذا يستعيض بوبر بمنطق التقدم على منطق التبرير، هروبًا من إشكالية البحث عن أسس منطقية للاستقراء. وما أشرنا إليه في المتن، من كون التكرار يقوي الظن، قصدنا به، أن التكرار يوجد درجة من التصديق أعلى بخصوص بقاء أو سريان الحكم والحضور المكثف للملزوم إلى جانب لازمه. ذلك لأن افتراض الممكن المثيل إذا تحقق، تحقق من كل الجهات، فيتحقق معه الحكم.
(31) إن لفظ “برهان” المذكور في الآية الكريمة، لا يحمل المفهوم نفسه للبرهان المنطقي الأرسطي؛ ذلك لأن البرهان في منطوق القرآن الكريم، ينصرف إلى جميع أشكال اللزوم، فهو أوسع في دليليته من البرهان المنطقي الأرسطي.
حينما اتهمت طريقة علي حرب بالنخبوية، لم أكن أقصد – طبعًا – اتهامه بالتخندق في جبهة الأنتلجونسيا بالمدلول البورجوازي للمثقف، بل عنيت أن هذا التيار التفكيكي، هو تيار تجريدي محض ولا علاقة له بالجماهير؛ هذه التي تنتظر المشاريع والبدائل. وإن صناعة متعة القول وممارسة الاختلاف بلا قصد، سوى تحقيقًا للذة، لا معنى له في مجتمع غارق في التخلف والفقر. وهذا أقرب إلى معزوفة أوكونسرتو لشبان أو فيفالدي في مجتمع الجوعى والبؤساء. إن التفكيكية، هي صنعة لا تبرح أوراش النخب. والجماهير بالتأكيد لن تستوعب قراءات دريدا أو فوكو أو دولوز أو جرار جنيت أو إمبراتو إيكو… ثم، إن نقد علي حرب للنخبة والمثقفين، لا يعني أنه مثقف غير نخبوي. إن نقد المثقف هي نفسها لعبة يراد منها تعزيز مكانة المثقف المتعالي، بقدر ما هي نزوع لاحتلال المواقع الشاغرة بعد إعلان موت المثقف. إن إعلان موت الإله قصد بها نيتشه إعادة بناء مفهوم الألوهية. وإن إعلان موت الإنسان قصد بها فوكو خلق مفهوم جديد عن الإنسان. وكذلك، إعلان موت المثقف، دعوة لمفهوم مختلف عن المثقف… ونزعة لاحتلال موقعه وإحراز هذه السلطة المعرفية بالتقويض والاستبعاد!
المقالات المرتبطة
مقاربة الوجود في الحكمة المتعالية وفق صياغة فلسفية (1)
واجهت الفلسفة في العالم الإسلامي هجومًا شديدًا وعداءً سافرًا في تهافت الغزالي، وفتاوى ابن الصلاح، ومقدّمة ابن خلدون، وموقف ابن تيمية ومدرسته.
الحداثة الفائضة في غربتها الأخلاقية
يبقى إشكال الإنسان على الإنسان شأنٌ أخلاقيٌّ من قبل أن يكون أي شيء آخر. وأصل القول في هذا كله، أنَّ حضور الإنسان في عالمه هو حضور موصول بقيمة هذا الحضور نفسه، وبمقام الخيريّة فيه.
الأيديولوجية الصهيونية والديانة اليهودية
كانت المعركة الحقيقية التي خاضتها الصهيونية في العقود الثلاثة الأولى من القرن الميلادي الماضي، هي التغلب على الرفض اليهودي لها، وأن تُقنع القوى الاستعمارية بأنها تبوأت موقع القيادة ليهود العالم.





