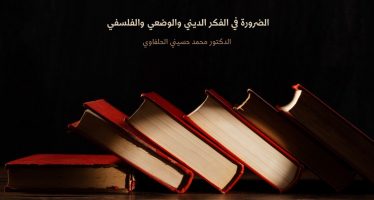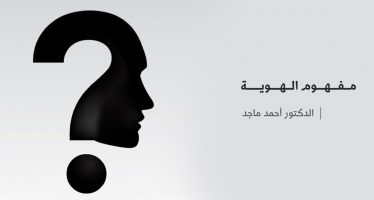نظرة حول الجدل المنهجي الفلسفي
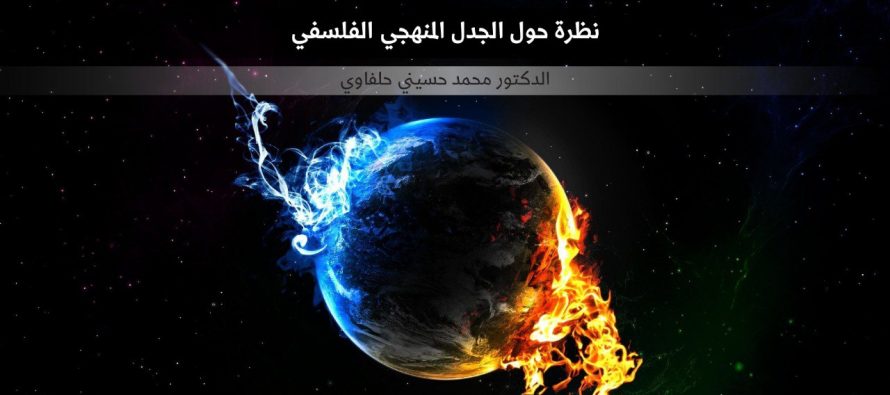
تعريفات
الجدل مصطلح يوناني يعني فن الحوار أو النقاش، وهو علم القوانين الأكثر عمومية التي تحكم الطبيعة والمجتمع والفكر[1]، وتدل كلمة dia على معنى التبادل أو المقايضة، والكلمة كلها تعني تبادل الكلام أو الحجج، وكله عن طريق الحوار، ومن خلال الاشتقاق اللغوي نفهم معنيين لكلمة جدل: أولًا، فن الكلام، لا الكلام الذي يؤثر ويقنع؛ إذ إن هذا موضوع علم البلاغة، وإنما المقصود هو الكلام الذي يجعلنا نفهم ونبرهن بالحجة والإقناع. وثانيًا، فن المناقشة، حيث إنها تتضمن فن البرهان وفن دحض كلام الخصم، فالمجادل يعرف كيف ينظم معرفته، ويصبها في نظام متماسك كما يعرف بصفة خاصة، أن يجد أساسًا منطقيًّا لآرائه، ومن ثمّ يتضح أن الجدل وثيق الصلة بالمنطق[2].
نشأة الجدل
نشأ الجدل في اليونان مع الفيلسوف زينون الإيلي[3] في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد كانت أغاليطه نماذج من الجدل الجاد، التي استثارت فلاسفة عصره للرد عليها، ولكن هذا الجدل الذي كان فنًّا للتحاور بغية الوصول إلى الحقيقة بطرح الفكرة والفكرة المضادة لها عن طريق السؤال والجواب، تحول مع السفسطائيين إلى منهج مهني تعليمي نقدي، ووسيلة للعب بالألفاظ لإخفاء الحقيقة، ثم جاء تهكم سقراط صورة متقدمة لجدل الفيلسوف زينون، فأصبح أسلوب تفكير ومنهج توليد للحقيقة، وذلك بتوجيه الأسئلة للخصم وتوليد الإجابات عليها، محاولًا أن يوقع خصمه في التناقض بطريقته التهكمية التي تقوم على طرح معنى ينفي المعنى الأول.
ثمّ صار الجدل مع أفلاطون إلى علم تصنيف المفاهيم وتقسيم الأشياء إلى أجناس وأنواع، إضافةً إلى أنه فن إلقاء الأسئلة والأجوبة، أي إنه تحول إلى منهج وعلم، فهو المنهج الذي يرتفع بالعقل من المحسوس إلى المعقول، وهو العلم بالمبادئ الأولى التي يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية، لذلك قسمه أفلاطون إلى جدل صاعد ينقل الفكر من الجزئي إلى الكلي، من المدركات الحسية إلى المعاني الكلية إلى التعقل الخالص إلى “المثل”، وجدل نازل ينزل بالعقل من أرفع المثل إلى أدناها بتحليلها وترتيبها في أجناس وأنواع.
واستخلص أرسطو قياسه من قسمة أفلاطون، وبنى منطقه الصوري على فهمه للجدل كاستدلال، فأطلق على الجدل الأرسطي اسم منطق الاحتمال logic of probability، لأن موضوعه الاستدلالات التي تكون مقدماتها محتملة، فقد فرّق بين الجدل؛ أي علم الآراء الاحتمالية، وعلم التحليلات؛ أي علم البرهان، وتمتع الجدل عند أرسطو بقيمة كبيرة، بوصفه وسيلة للتدريب على التفكير وطرائقه، واختبار صدق المبادئ الأولى غير المبرهنة للعلوم.
المدارس الجدلية
احتل الجدل مكانة عالية عند الرواقيين، وخاصة عند أقريسيبوس، فهو عندهم المنطق الصوري، وقد طوره سينيكا ليشمل أشكالًا من الاستدلال تُدرج اليوم مع حساب القضايا، كما استخدم الجدل في الفلسفة المدرسية ليشير إلى المنطق الصوري مقابل فن البلاغة، وبرغم تفشي الميتافيزيقية، فقد قدم الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في نظريته عن خلق الكون، وباروخ اسبينوزا في رأيه عن الجوهر، باعتباره علة ذاته، نماذج من الفكر الجدلي الحقيقي، كما قدم الفرنسي جان جاك روسو ثروة من الأفكار الجدلية، عالجت التناقض في الوعي الاجتماعي باعتباره شرطًا للتطور التاريخي[4].
ثمّ أظهرت المثالية الكلاسيكية الألمانية أهم مرحلة قبل الماركسية في تطور الجدل، فقد أحدث كانط، في تبنيه موقف ديكارت عن إدخال التطور في معرفة الطبيعة، أول ثغرة في الميتافيزيقية، فطوّر الأفكار الجدلية الخاصة بالنقائض في مبحث المعرفة، وكرّس بحثه في المنطق لمناقشة الجدل “الترانسدنتالي” بغية كشف وَهْم الأحكام الترانسندنتالية؛ (أي الأحكام التي تتخذ موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة)، وبهذا جعل “كانط” من الجدل طريقة مشروعة للبرهنة العقلية، وعملية ضرورية من عمليات العقل في محاولاته الفرار من دائرة الحس والظواهر والدخول في عالم الأشياء في ذاتها، لاقتناعه أن العالم يمكن أن يكون موضوعًا للمعرفة النظرية التأملية، فالجدل عند كانط، هو منطق للظاهر وما يقتضيه من قواعد وقوانين تستخدم في تحديد الموضوعات التي لا تتفق مع المعايير الصورية للحقيقة.
ودعا “فيخته” في كتابه “النظرية العلمية” إلى منهج يحتوي على أفكار جدلية مهمة، أطلق عليه تعبير “منهج التناقض للمقولات الاستدلالية”، وقدّم أول مرة ثلاثيته الشهيرة: القضية thesis، والنقيض antithesis، ومركب القضية والنقيض synthesis، وتابعه عليها شيلنغ، مؤكّدًا الاستيعاب الجدلي لظواهر الطبيعة[5].
الجدل من المنظور الإسلامي
أخذ الجدل منهجيًّا في التطور الفكري، وكان للإسلام دور مهم في فكرة الجدل المنطقي القائم على الحوار الداخلي للإنسان وبين الجماعة الإنسانية المختلفة عقائديًّا، حيث يدور جدل القرآن على ضروب من القضايا يكشف عن وجه الحق فيها، وأنواع من الدعاوى الباطلة يدحضها، ويدل على ما بِها من زيف، ومن أجل ذلك يؤدب الله عباده في شخص رسوله الكريم بما يكفل للجدل أن يصل إلى الحقيقة التي دعتهم إليه، فيقول سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَ﴾[6]، ويقول: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾[7]. فلم يكتف القرآن في هذه الآية بحثِّ المؤمنين على أن يكون جدالهم لأهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولكنه زاد فحث الرسول على مودتهم واستمالة قلوبهم، والمجاهرة بأنهم يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل إلى أنبيائهم، وأنهم وإياهم يعبدون إلهًا واحدًا لا خلاف عليه، وينهى عن الجدال في الحجِّ، ويَجعله فيما ينهى عنه قرين الرفث والفسوق، فيقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[8]. وهذه الثلاثة أنواع لذلك الجدل تُعتبر قبيحة مستهجنة في غير الحج، لكن تخصيص الحج يجعلها فيه أشدَّ قبحًا واستهجانًا، وبالتالي كان لعلماء المسلمين دور إنساني في التطور الجدلي، مثل ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم، ولكن المؤرخ المسلم ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون طوّر المنهج الجدلي في التعامل مع النصوص التاريخية لتمحيصها وتجريدها من الأساطير والخرافات بإعمال العقل والمنطق ومقارعة الرواية بالرواية والحجة[9].
تطور الجدل الفلسفي
ثمّ استمر هذا الفهم سائدًا بشكل عام في العصر الوسيط، حيث كانت الجدلية أو المفهوم الجامعي، أي خارج ما كان يُصطلَح على تسميته بالفلسفة، مرافقةً للنحو والصرف وعلم البلاغة، وبالعودة للتطوّر الجدلي، فقد عادت الجدلية على يد الألماني “جورج فيلهلم فريدريش هيغل” لتكتسب معنى فلسفيًّا جديدًا وعميقًا، ما زال سائدًا حتى هذه الساعة، لأن مؤسِّس المثالية المطلقة جعل منها قانونًا يحدِّد مسيرة الفكر والواقع عبر تفاعلات النفي المتتالي وحلِّ إشكاليات المتناقضات القائمة من خلال الارتقاء إلى الشميلة أو الشمائل، تلك التي سرعان ما يجري تجاوزُها هي الأخرى، ومن نفس المنطلق، وهكذا يتحول “الفعل السلبي” ليصبح جزءًا من الصيرورة، الأمر الذي يجعله، وفق هيغل، محركًا للتاريخ وللطبيعة وللفلسفة[10].
ويقبل كارل ماركس وفريدريك إنغلز جدلية هيغل كطريقة، لكن على حدِّ قولهما، “بعد إنزالها من السماء إلى الأرض”، ثمّ أصبحت الجدلية تعني كلَّ فكر يأخذ بعين الاعتبار، بشكل جذري، ديناميَّة الظاهرات التاريخية وتناقضاتها.
من هذا المنطلق، كان مفهوم غاستون باشلار عن “فلسفة اللا” محاولةً عقلانيةً لتطوير المفاهيم العلمية، التي وصفها أيضًا بـ”الجدلية”، كي يبيِّن في العلوم، الحركة التدرجية لنظريات سبق أن كانت مقبولة عالميًّا، ثم تمَّ تجاوزها، وذلك من خلال شَمْلها ضمن مفاهيم أوسع وأكثر انفتاحًا، كميكانيكا نيوتن، وهندسة إقليدس.
الجدل في العصر الحديث
بلغ الجدل مع هيغل ذروته، وأصبح منهجًا فلسفيًّا شاملًا، قدّم معه العالم كله الطبيعي منه والتاريخي والعقلي أول مرة على أنه صيرورة؛ أي في حالة حركة وتغير وتحول وتطور دائم. آمن هيغل بأن الجدل ليس صفة عارضة للتفكير، ولا خاصية أو نشاط ذاتي له يمكن أن ينطبق على الموضوع من الخارج، بل له طابع موضوعي عام، فالمنهج لا ينفصل عن موضوعه، إنه المضمون وما يكمن في هذا المضمون من تناقض هو الذي يحركه، يجعل منه مبدأً عامًّا يدرس الأشياء في طبيعة وجودها ذاته وفي حركتها، فالجدل عنده مبدأ كل حركة تكون علمية، أي فلسفية.
وتطور عن الجدل الهيغلي الجدل الوجودي عند سيرون كيركغورد، الذي انتقده لقيامه على مبدأ التناقض بين الذات والموضوع، وتقسيمه العالم إلى موضوعي وذاتي، واعتباره العالم بما فيه الإنسان موضوعًا غريبًا عن الإنسان.
وبرز مع ماركس وأنغلز الجدل العلمي، الذي يضم القوانين التي تحكم تطور الوجود وقوانين المعرفة، فقد استأصلا المضمون المثالي لفلسفة هيغل، وأقاما الجدل على فهمهما المادي للعملية التاريخية، وتطور المعرفة، وعلى تعميمها للعمليات الواقعية التي تحدث في الطبيعة والمجتمع والفكر، وهكذا أصبح الجدل المادي منطقًا يعدّ الفكر والمعرفة مساويين للوجود، الذي هو في حالة حركة وتطور، ومساويين للأشياء والظواهر، وهي في حالة صيرورة في عملية التطور، وهو المنهج الفلسفي لبحث الطبيعة والمجتمع، كما أن الجدل الماركسي هو الجدل التاريخي الذي يعتمد على الظروف الفعلية الكامنة في المجتمع، والفعل الإنساني هو أساس الجدل الماركسي، أي إن الجدل الماركسي يجد قوانينه من داخل الإنسان لا معطى من خارج الإنسان[11].
ولكن يظل للجدل تعريفاته المتعددة، خاصة في الجدل العلماني الأوروبي، الذي يأخذ أبجدياته من الجدل الماركسي والجدل الكنسي والجدل الليبرالي، وتختلط جميعها بالمفاهيم السياسية، لأن الفكرة في الجدل الليبرالي العلماني بالتحديد، تقوم على القيم الكونية المشتركة لأي أمة، والتي هي حصيلة مسارها التنويري التحديثي المعاصر، كما يرون.
[1]سامح عسكر، مفهوم الجدل dialectic، موقع http://azhar.forumegypt.net/، 16 /4/2012.
[2] د. محمد فتحي عبد الله، الجدل بين أرسطو وكانط- دراسة مقارنة، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1995، الصفحة 11.
[3] المصدر نفسه، الصفحة 23.
[4] سامح عسكر، مفهوم الجدل dialectic، مصدر سابق. وأيضًا، قراءة كتاب جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمه عن الفرنسية عادل زعيتر، القاهرة، دار العالم العربي، 2011.
[5] The Encyclopedia of Philosophy , edited by Paul Edwards, 1967 , Vol. 11 , p.385.
[6] سورة النحل، الآية 125.
[7] سورة العنكبوت، الآية 46.
[8]سورة البقرة، الآية 197.
[9] يراجع كتاب المقدمة لابن خلدون، اعتمدنا على نسخة مكتبة الأسرة، القاهرة، 2006.
[10] نسخة محفوظة رقم 29 في ويكيبيديا، في شهر يونيو 2016 على موقع ويكيبيديا، الصفحة 160.
[11] روجيه غارودي، ماركسية القرن العشرين، القاهرة، دار الآداب للدراسات والنشر، 1983، الصفحة 64.
المقالات المرتبطة
إشكاليّةُ المِتافيزيقا وأزمةُ تجاوزها في فلسفة العلم المعاصرة
فاقم انهيار اعتبارات الفيزياء الكلاسيكيّة، مع ظهور نظريّة الكوانتُم، من الحملة التي شنّها الريبيّون والكانتيّون على المِتافيزيقا كمبحثٍ شرعيّ في المعرفة الإنسانيّة.
الضرورة في الفكر الديني والوضعي والفلسفي
الضرورة في معاجم اللغة العربية هي الحاجة والشدة والمشقة، وتوجد عندما تنعدم الفرص، ولا يجد المرء مناصًّا للجوء إلى الحاجة الضرورية المتاحة…
مفهوم الهوية
تقول إحدى الأساطير الإغريقية: إنّ سفينة توجهت من مرفأ بيراس إلى ديلوس وفي طريقها تعرضت للكثير من المحن أدت مع