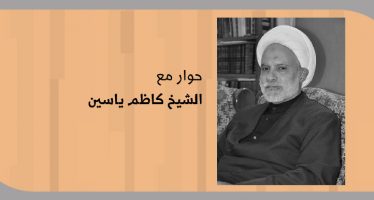قراءة ثورية في خطبة الحوراء (ع)

القرآن ثوري في معانيه ورؤيته للتغيير، وأن الأصل في الأديان هي الأريحية والنقاء والتسامح، كما أن الإسلام له عالميته الخاصة به، لا يدعو لفناء الجنس البشري في دين واحد أو لغة واحدة، بل إن الإسلام حرص على حراسة التمايز بين البشر.
وفي عصرنا الذي نعيش فيه ضعفًا إسلاميًّا، وتكالبًا على التعامل مع أعداء الأمة، وتغافلًا عن الدور الثوري للقرآن وللسيرة النبوية، وعن عالم الأئمة (ع) الذين انتصروا بالدم على السيف والكلمة الثورية ضد الباطل، أيًّا كان مصدر هذا الباطل. نكتب عن نموذج ثوري إسلامي، حق كامل ضد ظلم شامل، انتصر الباطل عسكريًّا، وانتهى إلى هزائم معنوية، كما سنرى.
من خلال هذا الفهم، نكتب عن ثورة كلمة، قادتها السيدة الحوراء زينب بنت علي والزهراء (ع)، بعد أن صُرع أخوها الإمام الحسين (ع) في كربلاء، كانت ثورة الحسين ثورية سلمية، قال: “والله لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا، ولكني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله”، ولكن الدولة بقيادة يزيد بن معاوية لم تتورع عن سفك الدم الحرام في الشهر الحرام، وعندما وصل له الخبر المشين اعتقد أن المُلك قد دام له، والدنيا صارت تحت قدميه، ولكن جاءت السيدة زينب بحديثها الثوري داخل قلعة الظلم لتحيل النصر اليزيدي إلى كارثة عليه.
إننا عندما نتحّدث عن الإسلام، فإننا نتحدّث عن ثورة سلمية تقود العالم بأسره للأصلح وللأقوم، للخير والعدل والإخاء والمساواة، ويكرم القرآن الإنسان على اختلاف مذاهبه وأديانه وأعراقه، ثورة كلمة تحيي القلوب وتعمر الضمائر، وتسكب في جوانح الحياة ندى الخير وفجر الآمال، هذا هو الإسلام، ولكن ولأسباب كثيرة متنوعة متعدّدة، ليس مجالها الآن، ابتعد المسلمون عن روح القرآن وسيرة الرسول، واستكانوا للاستبداد السياسي المتغطي بالدين من خلال فتاوى شيوخ السلاطين والأمراء والخلفاء.
وكانت المعارضة الأولى السلمية للسلطة كانت من الحسين بن علي في كربلاء، خرج لا ليقاتل ولكن ليصلح، ثورة كلمة في ثياب تسامح، ولكن طغاة الأمويين تصدوا لها بالسلاح… فعشرات الألوف ضد عشرات الأفراد، فانتصر السلطان عسكريًّا ولكن انتصر الدم فيما بعد روحيًّا وثوريًّا.
لقد رفع الحسين شعار الموت بعزة خير من الحياة بذلة، وهيهات منه الذلة.
بعد انتهاء موقعة كربلاء واستشهاد النسل النبوي، اعتقد يزيد بن معاوية أنه انتصر النصر النهائي، ولكن جاءت السيدة زينب بنت علي والزهراء لتجعل طعم النصر ليزيد علقمًا، وهو ما نكتب عنه.
ثورة الكلمة الزينبية.
أهل بيت النبي (ص) هم: (عيش العلم، وموت الجهل)، كما قال الإمام علي، فهم عيش العلم أنّى يكون العلم، ولم يقتصر العلم على الدين وحده، فقد صار الأئمة من أهل البيت أنموذجًا فريدًا في المواءمة بين العلم والحياة والدين والسياسة، وبين كل هذه المفردات وبين إماتة الجهل، فقد حاول الأمويون أن يتخذوا من يوم عاشوراء عيدًا يصنعون فيه أنواع الأطعمة، ويظهرون منه السرور والفرح، ويسبون فيه الإمام الذي كرم الله وجهه لا لشيء إلا لديمومة بقاء السلطة فيهم والدنيا لهم من خلال الدعاية السياسية النشطة التي تذم أهل البيت وتتنكّر لهم، وتروج لأحاديث موضوعة عن صاحب الرسالة المعصوم (ص) في فضائل الأمويين.
وكل ذلك من أجل إضفاء الشرعية الغائبة على حكمهم، والتي رفضها المسلمون في شتي ديار الإسلام، تلك الشرعية التي اهتزت بخطبة السيدة زينب التي قالتها ليزيد بن معاوية بعد مصرع سيد الشهداء في كربلاء، والمجيء بحرائر أهل البيت سبايا على الأقتاب.
السيدة زينب التي هي عالمة غير معلّمة كما قال عنها الإمام السجاد زين العابدين، هي نبع من فيض بيت النبوة، وغصن من شجرتها، دكّت بخطبتها صرح الطغيان والقبلية التي سادت بعد تسلط الأمويين على الخلافة.
وتوجد علاقة وثيقة وآصرة متينة بين خطبة الحوراء زينب أمام يزيد، وبين انهيار الدولة الأموية متمثلة في:
أولًا: في البيت السفياني الذي انهار بعد يزيد، فقد تولّى ابنه معاوية الثاني، ثم كشف مساوئ أبيه وجده الذي نازع الإمام عليًّا ما لا يستحق لأنه طليق، والطليق لا يصلح للخلافة.
وثانيًا: في البيت المرواني، وكلا البيتين لم يبقيا في الحكم سوي بضع وثمانين سنة ذكرها البعض أنها ألف شهر ظلوا ينزون خلالها على المنابر.
وخطبة الحوراء نجد فيها أبعادًا سياسية ثورية، لأنها مثّلت بجانب بعدها الديني – وما زالت – صيحة الحق ممزوجة بدماء أهل الحق والعدل ضد هيجان الظلم والاستبداد والقهر وفرحة الطغيان عندما ينتصر ويظن أن النصر سيدوم له.
إن الشرعية السياسية من ضرورات الحكم أينما يكون، وكل حاكم بحث له عن ظل شرعي يضيء تحته حتى لا ترفضه العامة، والأمويون تمسكوا بدم عثمان لكي يضفوا على حكمهم شرعية مفقودة، ثم لجأوا إلى أحاديث نسبوها إلى النبي الكريم (ص) لإثبات أحقيتهم في حكم رفضه المسلمون.
لقد رأت الحوراء يزيد يعبث برأس الحسين (ع) وبقية رؤوس الشهداء، متشفّيًا أمام نساء البيت النبوي مردّدًا شعرًا لابن الزبعري قاله بعد انتصار المشركين في أحد:
ليت أشياخي ببدر شهدوا
|
جزع الخزرج من وقع الأسل
|
قد قتلنا القوم من ساداتهم
|
وعدلنا ميل بدر فاعتدل
|
ثم يضيف من عنده:
لأهلوا واستهلوا فرحًا
|
ثم قالوا يا بزيد لا تشل
|
خطبة الثورة السلمية.
عندما رأت العقيلة زينب (ع) كل هذا الانتقام والتشفّي والرغبة المحمومة في الثأر لمن قتل الأمويين في بدر وأحد والخندق وغيرها، وعندما شاهدت أحد الجهلاء يطلب إحدى بنات النبي (ص) لتكون سبية له، صاحت في يزيد خطبتها التي دونها التاريخ بأحرف من نور[1]:
الحمد للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله كذلك يقول: ثُمّ كانَ عاقبةَ الذينَ أساؤوا السُّوأى أنْ كَذَّبوا بآياتِ اللهِ وكانُوا بها يَستهزِئُون. أظنَنْتَ يا يزيد حيث أخَذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبَحنا نُساق كما تُساق الأُسارى، أنّ بنا على الله هَواناً وبك عليه كرامة ؟! وأنّ ذلك لِعِظَم خَطَرِك عنده! فشَمَختَ بأنفِك، ونظرتَ في عِطفِك، جَذلانَ مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مُستَوسِقة، والأمورَ مُتَّسِقة، وحين صفا لك مُلكنا وسلطاننا. مهلاً مهلا! أنَسِيتَ قول الله تعالى: ولا يَحسَبنَّ الذين كفروا أنّما نُملي لَهُم خيرٌ لأنفسِهِم، إنّما نُملي لَهُم ليزدادوا إثماً ولهم عذابٌ مُهين ؟! أمِن العدلِ، يا ابنَ الطُّلَقاء، تخديرُك حَرائرَكَ وإماءَك وسَوقُك بناتِ رسول الله سبايا قد هُتِكت سُتورُهنّ، وأُبدِيت وجوهُهنّ ؟! تَحْدُو بهنّ الأعداء من بلدٍ إلى بلد، ويستشرفهنّ أهلُ المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوهَهنّ القريب والبعيد والدنيّ والشريف! ليس معهنّ مِن رجالهنّ وَليّ، ولا مِن حُماتِهنّ حَمِيّ، وكيف يُرتجى مراقبةُ مَن لفَظَ فُوهُ أكبادَ الأزكياء، ونَبَت لحمه بدماء الشهداء ؟! وكيف يستبطئ في بُغضنا أهلَ البيت مَن نظرَ إلينا بالشَّنَف والشَّنآن، والإحَن والأضغان ؟! ثمّ تقول غيرَ متأثّم.. ولا مُستعظِم:
وأهَلُّوا واستَهلُّـوا فرَحَـاً ثمّ قالوا: يا يزيدُ لا تُشَـلّْ!…. مُنتَحياً على ثنايا أبي عبدالله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمِخْصَرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأتَ القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماءَ ذريّة محمّد صلّى الله عليه وآله، ونجومِ الأرض مِن آل عبدالمطلب! وتهتف بأشياخك زعمتَ أنّك تناديهم، فَلَتَرِدَنّ وَشيكاً مَورِدَهم، ولَتَوَدّنّ أنّك شُلِلتَ وبُكِمتَ ولم يكن قلتَ ما قلتَ وفَعَلتَ ما فعلت.
اَللّهمّ خُذْ بحقِّنا، وانتَقِمْ ممّن ظَلَمَنا، وأحلِلْ غضبَك بمن سفك دماءنا وقتَلَ حُماتَنا. (ثمّ توجّهت بالتوبيخ إلى يزيد قائلةً له): فوَ اللهِ ما فَرَيتَ إلاّ جِلْدَك، ولا جَزَزْتَ إلاّ لحمك، ولَتَرِدنّ على رسول الله بما تحمّلت مِن سَفكِ دماءِ ذريّتهِ، وانتهكتَ مِن حُرمته في عِترته ولُحمته! حيث يجمع الله شملهم، ويَلُمّ شعَثَهم، ويأخذ بحقّهم.. ولا تَحسَبنَّ الذينَ قُتِلوا في سبيلِ اللهِ أمواتاً بل أحياءٌ عندَ ربِّهم يُرزَقون. حَسْبُك بالله حاكماً، وبمحمّدٍ خَصيماً، وبجبرائيل ظَهيراً، وسيعلم مَن سوّى لك ومكّنك من رقاب المسلمين (أي أبوك معاوية) بئس للظالمين بدلاً! وأيُّكم شرٌّ مكاناً وأضعَفُ جُنْداً! ولئن جَرَّت علَيّ الدواهي مُخاطبتَك، إنّي لأستصغرُ قَدْرَك، وأستَعظمُ تَقريعك، واستكبر توبيخك!! لكنّ العيون عَبْرى، والصدور حَرّى (وهنا جاء التنبيه إلى عظم المصيبة والفاجعة التي أوقعها يزيد في آل بيت المصطفى).
ألا فالعَجَب كلّ العجب.. لقتلِ حزبِ الله النجباء، بحزب الشيطان الطلقاء! (ومنهم يزيد الطليق بعد فتح مكّة، ولم يسمح الشرع الشريف للطلقاء أن يتقلّدوا الحُكْم!)، فهذه الأيدي تَنطِف من دمائنا، والأفواه تَتَحلّب مِن لحومنا، وتلك الجُثث الطَّواهر الزواكي تنتابها العَواسِل (أي الذئاب)، وتهفوها أُمّهاتُ الفَراعل.
ولئن اتّخَذْتَنا مَغْنَماً، لَتجِدَنّا وشيكاً مَغْرٓماً، حين لا تجدُ إلاّ ما قدَّمْتَ وما ربُّكَ بظَلاّمٍ للعبيد، فإلى الله المشتكي وعليه المعوَّل. فكِدْ كيدَك، واسْعَ سعيَك، وناصِبْ جهدك، فوَاللهِ لا تمحو ذِكْرَنا، ولا تُميت وحيَنا، ولا تُدرِكُ أمَدَنا، ولا تَرحضُ عنك عارها (أي لا تغسله)، وهل رأيُك إلاّ فَنَد، وأيّامك إلاّ عَدَد، وجمعك إلاّ بَدَد!! يوم ينادي المنادي: ألاَ لَعنةُ اللهِ علَى الظالمين !
فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يُكملَ لهم الثواب، ويُوجِبَ لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنّه رحيمٌ ودود، وحسبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيل”
ملاحظات.
كانت الخطبة الدينية الشريفة المقصد قائمة على المنطق، فهي تستدرجه وتسأل سؤالًا منطقيًّا، هل النصر حليف القوة وحدها، وأن الله يعطي الأقوى سبل النصر ثم يدعه يحتفي به رغم أنه على غير درب سبيل المؤمنين، وأن السلطان زائل، والدنيا نفسها زائلة، وأن الحق لا يعدم من يدافع عنه في عرين السلطان؟
ولم تتردّد الحوراء في تذكيره بأصله فهو من نسل الطلقاء، وجدته هي هند آكلة الأكباد عندما لاكت كبد حمزة في يوم موقعة أحد، وأن الطليق لا يحل له حكم بلاد المسلمين، فشريعة الحكم ليزيد باطلة، وبطلانها نابع من كون القابع فوق كرسي الحكم لا يملك دليلًا واحدًا أو معنى فقهيًّا، أو حتى أخلاقيًّا يعطيه شرعية الحكم، ولكنه لاقى تلك الشرعية من شرعية السيف وفقهاء السلطة الذين يبيعون الفتوى ببعض الذهب والفضة، والدور والإماء الحسان، ومن يحكم بشرعية السيف يظل حكمه مهدّدًا، واحتمال انهيار حكمه قائمًا في أي وقت إذا وجد من يكشف هذا الزيف، وقد كشفه من قبل أمير المؤمنين علي (ع) عندما ذكر معاوية بأنه طليق ولكن معاوية يتجاسر ويقول: (إن معي مئة ألف مقاتل لا يعرفون عمّارًا وسابقته، ولا عليًّا وقرابته، ولا سعدًا ودعوته، إنهم لا يعرفون إلا العطاء).
وقد كشف الحسين هذا الزيف عندما أكّد بدمه الشريف الذي أريق في كربلاء بأن القبلية الجاهلية لا تعترف بقرابة من النبي الذي ينسبون أنفسهم إليه.
ولكن الحكم وحده، لقد قال معاوية: (إني ما قاتلتكم لكي تصلّوا أو لتصوموا أو لتحجّوا أو تتزكّوا، وإنكم تفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لكي أتأمّر عليكم)[2]. هذا هو المنطق الذي أسّسه معاوية، الإمارة والحكم والسلطان.
ولذلك لم يجد يزيد أي حرج أن يستبيح المدينة المنورة يوم الحرّة، يقتل فيها من بقي من أهل بدر، ويفتض جنوده العذارى المسلمات ليلدن أطفالًا لا يعرفون آباءهم.
إنه الملك فاحرص عليه فلا نعرف ما الجنة ولا النار، كما قال زعيمهم أبو سفيان عندما آل الأمر إلى الأمويين، ثم يجد من ينصر الظالم بدعائه وزعمه أنه يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، أو من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية، وغيرها من أحاديث تحث على طاعة السلطان، أي سلطان ولو كان يلغ في دعاء المسلمين لغًا، ولو قتل سبط النبي وسيد الشهداء.
كل ذلك شرعية باطلة لحكم باطل أكّدته الحوراء في خطبتها (فالعجب كل العجب تقتل الأتقياء، وأسباط الأنبياء وسليل الأوصياء بأيدي الطلقاء الخبيثة ومن يفعل ذلك لا يحق له الخلافة، وأن استعصى على من يجلس على الحكم الخضوع فإنه يلجأ للسيف).
ولذلك، فإن عبد الملك بن مروان يخاطب الحجّاج الثقفي ويقول له: (جنّبني دماء بني عبد المطلب، فليس فيها شفاء بالحرب، وإني رأيت الملك نزع من أيدي آل أبي سفيان لما قتلوا الحسين).
وقد قام الحجاج بالمهمّة خير قيام، فترك الأئمة ثم ضيّق عليهم السبل، ولكنه قتل الألوف من محبيهم قتلًا وصبرًا وبكل أنواع القتل.
وأكّدت الحوراء في خطبتها أنّ الشرعية للحاكم لا ينالها بفتاوى البطانة غير الصالحة منهم الذين جوزوا الرضوخ لمن للحكم بحدّ السيف طالما أنه أصبح وليًّا للأمر، وسوف نرى فيما بعد كم قاست الأمة من أمثال هؤلاء العلماء الذين زينوا الباطل لكل ملك أو رئيس أو أمير، وادّعوا العصمة لهم من الزلل، يتدارسون خطيهم كأنها من الكتب المنزلة، قبروا ضمائرهم وتباهوا بما أتاهم الحطام من فضائل شعوبهم المغلوبة المقهورة على أمرهم.
وقد ذكر الإمام في نهج البلاغة وصفًا بليغًا في العلاقة الشائكة بين الحاكم والمحكوم (قد استطعموكم القتال، فأقروا على مذلّة، وتأخير محلّة، أو رووا السيوف من الدماء ترووا الماء فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين)[3]
وقد أكّدت الحوراء ذلك كما أكّدها أخوها سيد الشهداء بقوله: (الموت بعزة خير من الحياة بذله) فقالت: (فمهلًا مهلًا لا تطمعن جاهلًا)، وكم طاش جاهلًا، وطاش حكّام الدولة الأموية مهلًا على أنفسهم وغيرهم حتى ضاعت دولتهم، وبقيت أريحية أهل البيت الذين زكّوا بدمائهم ووهبوها للأمة وهم (فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم يسبقوا). وقد صمتت الحوراء فلم يسبقها أحد في إظهار باطل يزيد بعد مصرع سيد الشهداء، وعندما نطقت فقد نطقت صدقًا، وقالت حقًّا، ووضعت للأمة نهجًا فريدًا في التصدّي للظلم والظالم، وهي أسيرة بين يديه، فأذهلته وجعلته يخرس حتى انتهت خطبتها، وتلك كانت قمة الشجاعة المسؤولة.
رد الفعل اليزيدي.
لم يتمكّن يزيد من الرد المفحم لكلمات العقيلة، فهي كلمات تدل على روح ثورية مفعمة بالإيمان، جعلت طعم النصر علقمًا، ولذلك رحّلها يزيد إلى المدينة المنورة، ولكن الحوراء في المدينة استكملت ثورة الكلمة التي بدأت منذ خروج سيد الشهداء إلى الطف بأرض كربلاء.
فكانت بداية لثورة يثرب، فقام يزيد بترحيلها من جديد، فيما يُقال إلى الشام في دمشق، أو إلى أرض الكنانة المصرية كما يؤكّد المصريون، لتستقر روحها في قلوب المصريين قبل بيوتهم، وأطلق عليها المصريون أم هاشم، وأم العواجز ويكنسون ضريحها وهم يدعون على الظالمين، وهو ما حدث كثيرًا طوال تاريخ أرض المحروسة…سلام على الحوراء… عليها السلام.
[1] كتبنا خطبة السيدة زينب من كتب التاريخ، ومن كتاب عقلية بني هاشم للسيدة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ.
[2] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، (القاهرة: دار الريان، 1987)، الجزء3، الصفحة 124.
[3] نهج البلاغة، تحقيق الإمام محمد عبده.
المقالات المرتبطة
الروحانيّة وعلاقتها بالأخلاق (9)*
الأخلاق هي مجموعةٌ من الصفات الراسخة في النفس، والتي توجب صدور أفعالٍ تناسبها بدون الحاجة إلى التأمّل والتفكّر، كما تُكسب السلوك والحياة صبغةً خاصّةً ونمطًا خاصًّا.
السيرة الحسينية… مصادرها وأهدافها
ابتدأت بدراسة المقدمات عند المقدس الوالد الشيخ خليل ياسين، إلا أنني كنت قد تمكنت قبل ذلك من دراسة العربية وآدابها، فقهًا ونحوًا وبلاغةً
قراءة في رسائل نابليون في مصر 1
على مدى التاريخ انشغل الباحثون بعدد من القادة العسكريين، الذين أيًا كان عددهم فسوف يكون نابليون بونابرت بالتأكيد أحدهم، إن لم يكن أهمهم.