إرجاع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري من وجهة نظر العلامة الطباطبائي

المستخلص
يعدّ البحث عن مبنى العلم والمعرفة من المباحث المهمَّة في علم المعرفة (نظرية المعرفة)، على أن تكون صحَّة هذا المبنى مضمونه وذاتيّة وليست مكتسبة من الغير.
ومن مصاديق هذه المبنائية إرجاع العلوم الحصولية إلى العلم الحضوري التي أوضحها بشكل بارز العلامة الطباطبائي (رحمه الله)، ولها نتائج معرفية مهمَّة، لا سِيَّما مع قيام تلامذته ـ أمثال الشهيد مطهري وغيره ـ بتطويرها بعده.
ومن جملة هذه الإرجاعات، إرجاع المفاهيم الفلسفية إلى العلوم الحضورية، التي يدخل ضمنها مفهوم العلَّة والمعلول، وهي المفاهيم التي تصوَّرها هيوم مخلوقاتٍ ذهنيّة، وحسبها كانت أطرًا ذهنية وجرَّها إلى النزعة الشكِّية واعتبرها نوع من النسبيّة.
وبإرجاع هذه الطائفة من المفاهيم إلى العلم الحضوري تكون القضايا الناتجة عنها مضمونة الصحّة وقد تكون ناظرة إلى الواقع، كما ويمكن الدفاع عن إثبات أصل العليَّة والبديهيات الأولية للبشر من دون هذه الإرجاعات، وهذا يحتاج إلى بحث مستقلّ جاء مطلبه الأساسي في كلمات الفارابي.
ومن الإرجاعات الأخرى، إرجاع المحسوسات الظاهرية إلى العلم الحضوري، ويتّضح هذا الأمر جليًّا من خلال مطلبين:
المطلب الأول: إنَّ الخطأ لا يكون في الإحساس، بل في التطبيق.
المطلب الثاني: إنَّ المحسوسات بحاجة إلى تبيين لغرض المطابقة، ولا يمكن دعوى القطع بوجود أمر محسوس في الخارج أو ذكر خصوصّياته بمجرّد الإحساس المحض.
الكلمات المفتاحية: العلم الحضوري، العلم الحصولي، إرجاع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، المعقولات الثانية الفلسفية، العلامة الطباطبائي.
مقدمة
جرت عادة الفلسفة الإسلامية بشكل واضح وبارز على تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي، وتقسيم العلم الحصولي إلى تصوّر وتصديق، وتقسيم التصوّر الكلّي إلى: ماهوي، وفلسفي، ومنطقي، على المنوال نفسه.
وقد أتمّ العلّامة الطباطبائي متابعة هذه الابتكارات الثلاثة العظيمة إنجاز عمل عظيم آخر بعدما قام به الفلاسفة بشكل ضمني، وهو إرجاع العلوم الحصولية إلى العلم الحضوري؛ ولهذا صار من الضروري توضيح الخطوات السابقة باختصار لكي تتضّح الخطوة الكبيرة التي خطاها العلامة (رحمه الله).
وبناء على ذلك، سنقوم بتناول المباحث المتعلقة بهذا الموضوع على حسب العناوين التالية:
- تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي.
- مصونيّة العلوم الحضورية عن الخطأ.
- تقسيم العلم الحصولي إلى تصوّر وتصديق.
- تقسيم التصوّر إلى كلِّي وجزئي.
- تقسيم التصوّر الكلِّي إلى ماهوي وفلسفي ومنطقي.
- إرجاع العلوم الحصولية إلى العلم الحضوري.
- الثمرات المترتبة على هذا الإرجاع في علم الوجود (الأنطولوجيا) وعلم المعرفة (نظرية المعرفة).
تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي
ينقسم العلم ـ وفق تقسيم أوَّلي ـ إلى حضوري وحصولي، والحصولي هو: العلم بالشيء بواسطة صورة الشيء أو مفهومه. وبعبارة أخرى: إنَّ العلم الحصولي يكون علمًا بالواسطة، والعلم الحضوري علم من دون واسطة (الصورة والمفهوم أو الحاكي)، وعليه يمكن تعريف العلم الحضوري بأنَّه: حضور الشيء لدى العالِم أو شهودُه له، والعلم الحصولي حضور مفهوم الشيء أو صورته لدى العالِم أو شهودُه لهما.
إنَّ علمنا بالأشياء الخارجيّة ـ كالشجرة والسماء والأرض والماء والمناظر الطبيعيّة وأمثال ذلك ـ علم حصولي؛ لأنَّه علم بالصورة أو مفهومها، لكنَّ علمنا بذات الصورة ومفهومها المنطبع في الذهن هو علم حضوري ذهني، وكذلك علمنا بأنفسنا أو بالحالات التي تطرأ عليها من فرح وحزن ووجع وألم، هو علم حضوري.
مصونية العلوم الحضورية عن الخطأ
تُعدّ مصونية العلوم الحضورية عن الخطأ من خصوصيّات هذا العلم التي لها أهميّتها الخاصّة في علم المعرفة، بمعنى أنَّها الحجر الأساس للعم الحضوري؛ وكنه ذلك هو إنّ الواقع نفسه يحضر بعينه لدى العالِم في العلم الحضوري وليس الصورة أو المفهوم كما في العلم الحصولي، أو الحاكي عنه بتعبير أدَّق، وليس هناك معنى للخطأ في هذه الحالة؛ لأنَّ ذلك يكون في المطابقة وعدم المطابقة، ويتحقّق معنى المطابقة عندما يكون هناك تقابل وإثنينية؛ أي وجود شيئين أحدهما يحكي عن الآخر. وبكلمات أخرى: أن يكون لدينا حاكي ومحكي. ويتحقّق معنى الحاكي والمحكي عندما توجد واسطة بين العالِم والمعلوم من صورة أو مفهوم، ليتسنّى القول: إنَّ هذه الصورة أو المفهوم والحاكي مطابقٌ أو مخالف للواقع، لكن مع عدم وجود الصورة أو المفهوم أو الحاكي (باعتبار حضور نفس المعلوم بعينه لدى العالِم)، لا يبقى مجال للحكاية، وبتبع ذلك أيضًا لا يبقى مجال للتعبير بالمطابقة والخطأ والصواب.
وخلاصة القول هي: إنَّ الواقع بعينه يكون مكشوفًا في العلم الحضوري؛ ولأجل ذلك يمكن التعبير عن العلم الحضوري بالعلم الحقيقي والعلم بالواقع، وعن العلم الحصولي [الصادق] بالعلم المطابق للواقع.
تقسيم العلم الحصولي إلى تصوّر وتصديق
ينقسم العلم الحصولي (حضور صورة الواقع ومفهومه لدى الذهن) إلى قسمين: العلم بصدق القضية وغيره، والأوّل يُسمَّى تصديق، والثاني تصوّر.
تقسيم التصوّر إلى كلّي وجزئي
وقد قسَّموا الصورة الذهنية التي هي غير العلم بصدق قضية ما (التصوّر) إلى قسمين: التصوّر الذي يقبل الصدق على كثيرين، والتصوّر الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، من قبيل مفهوم الإنسان الذي يصدق على حسن وحسين وعلي، ومفهوم حسن وطهران وجبل دماوند التي لا تقبل الصدق إلا على مصداق واحد فحسب، ويطلق على الطائفة الأولى الكلّي وعلى الطائفة الثانية الجزئي.
تقسيم التصوّر الكلّي إلى ماهوي وفلسفي ومنطقي
قسَّم فلاسفة المسلمين “المفاهيم الكليَّة” إلى ثلاثة أقسام: الماهوية والفلسفية والمنطقية، ولتقسيمهم المبتَكر هذا فوائد معرفية كثيرة، كما أنَّهم ذكروا لكلِّ مفهوم من هذه المفاهيم خصوصيات.
وعلى هذا الأساس يكون تفصيل أنواع المفاهيم الكليَّة كالآتي:
ألف) المفاهيم الماهوية: هي المفاهيم التي تأتي في جواب السؤال عن ما هو، وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: المفاهيم التي يكون لها صورة حسّية وخيالية قبل أن نتصوّرها بصورة مفهوم كلّي، مثل مفهوم الأبيض، والأسود، والجسم، والمكعّب، والمستطيل، والخوف، والفرح، والحزن.
القسم الثاني: المفاهيم التي لها تصوّر فقط، ولا توجد لها صورة حسيّة وخيالية، مثل العقل، والصورة، والمادة.
ب) المفاهيم الفلسفية: وهي المفاهيم التي تكون ناظرة إلى الواقع قبل أن تُشير إلى ماهيّة الشيء، ويكون واقعها أعم من الوجود والعدم، وتشمل صفات الوجود أيضًا، مثل مفهوم الوجود والعدم، والعلَّة والمعلول، والوجوب والامتناع، والثبوت والتغيّر، والقوَّة والفعل وأمثال ذلك.
وإنَّ أغلب هذه المفاهيم تحصل من خلال المقارنة؛ أي إنَّ الحسّ الباطني أو الظاهري يجعل العقل يتوصّل إليها عن طريق المقارنة بينها، ومن باب المثال عندما نقارن بين النفْس والإرادة ونُدرِك توقّف الإرادة على النفْس، ينتزع العقل مفهوم العلَّة من النفْس، ومفهوم المعلول من الإرادة، ولولا وجود مثل هذه المقارنة لم يتوصّل العقل أبدًا إلى مفهوم العلَّة والمعلول.
وللحسّ الظاهري والباطني دور في إيجاد هذه المفاهيم، ولا يمكن التوصّل إلى مفهوم العلَّة والمعلوم وأمثالها إلَّا عن طريق العلوم الحضورية.
ج) المفاهيم المنطقية: إنَّ هذه المفاهيم لا تصدق إلَّا على المفاهيم الذهنيّة، وهي غير صادقة على الموجودات الخارجة عن الذهن، ويكون مصداقها في الذهن فقط؛ أي ظرف تحقّقها هو الذهن، كما أنَّ الأشياء الذهنيّة تتّصف بها أيضًا، ولا توجد لها صلة بالخارج بشكل مباشر إطلاقًا، فعندما تتحقّق المفاهيم الماهوية أو الفلسفية، يحصل الذهن على هذه الطائفة من المفاهيم باللحاظ الثانوي لها، مثل مفهوم الحدّ والرسم والقياس والبرهان.
إرجاع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري
إنَّ العلم ـ وكما أسلفنا ـ ينقسم إلى حضوري وحصولي، والحصولي هو العلم بالواقع بواسطة الصورة والمفهوم أو الحاكي عنه، والعلم الحضوري هو العلم بالواقع من دون وساطة الحاكي. وهنا يتبادر السؤال التالي: من هو الأصل والمبنى للآخر في نشوء المعرفة البشرية، أو من الذي يكون مقدّمة للآخر، أو من الذي يمكن إرجاعه إلى الآخر. وبتعبير ثاني: هل أنَّ العلوم الحضورية هي المنشأ للعلوم أم العلوم الحصولية هي المنشأ؟
ويعتبر العلامة الطباطبائي أوّل من سلّط الضوء على هذا البحث؛ وإلَّا فإنَّ أصل البحث كان موجودًا في كلمات ابن سينا (1403ق، ج2، ص296؛ 1392ق، ص79، 148، 169) الذي عدّ العلم بالنفْس مقدَّم على كلِّ علم.
ومن خلال تفحّص كتب فلاسفة الإسلام يمكن التعرُّف على ثمان أنواع من الإرجاعات، البعض منها يتمثّل بإرجاع التصوّرات إلى العلم الحضوري، والبعض الآخر يتمثل بإرجاع القضايا والتصديقات إلى العلم الحضوري. كما أنَّ لبعضها ثمرات في علم الوجود، ولبعضها الآخر ثمرات مهمة في علم المعرفة، فضلًا عن ثمرات علم الوجود، وهذا ما سنحاول توضيحه فيما يأتي.
أنواع إرجاع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري
1ـ العلم بالنفْس مقدّم على جميع العلوم الحصوليّة ومقوِّم لها.
2ـ جميع العلوم الحصولية هي علوم حضورية.
3ـ جميع العلوم الحسّية منتزعة من الإحساس والانفعال الباطني.
4ـ جميع المفاهيم المنطقية منتزعة من المفاهيم الموجودة في الذهن.
5ـ جميع أو أكثر المعقولات الثانية الفلسفية مأخوذة من العلوم الحضورية.
6ـ المعلوم في العلوم الحصولية موجود عقلي مجرّد (عند إدراك المفاهيم العقلية)، أو مثالي مجرّد (عند إدراك المفاهيم الحسّية والخيالية).
7ـ البديهيّات الأوّلية ترجع إلى العلوم الحضورية.
8ـ الوجدانيات (القضايا التي تخبر عن الحالات الباطنيّة) مأخوذة من العلوم الحضورية.
ولقد سُلِّطت الأضواء بشدَّة في كلمات العلامة الطباطبائي(رحمه الله)، على القسم الثالث والخامس والسادس من هذه الأقسام الثمانية، ولقد كانت كلماته ناظرة إلى الشبهات في باب علم المعرفة، لا سِيَّما القسم الخامس، وهو ما يُمثّل خطوة كبيرة على مستوى الذهن، كما سيتّضح من خلال البحث.
وتوضيح الأقسام المذكورة هو:
1ـ العلم بالنفْس مقدَّم على جميع العلوم الحضورية والحصولية ومقوِّم لها: إنَّ العلم بالنفْس (الأنا) مقدّم على كل علم؛ لأنَّه علم دائم وبالفعل، بل حتّى العلم بالشكّ والحالات النفسانية الأخرى متأخّر عن العلم بالنفْس، ومن باب أولى تكون العلوم الحصولية متأخّرة عن هذا العلم أيضًا (المصدر السابق).
ويعتقد الملا صدرا بأنَّ معرفة أي شيء تكون بعد معرفة ذات العالِم، ولا يمكن أن يعلم الإنسان بأي شيء إلَّا بواسطة ما يجده في ذاته، وأنَّ علمنا بالأشياء يكون بحضور صورتها في أنفسنا (صدر الدين الشيرازي، 1341، ص248؛ 1981م، ج 8، ص203).
2ـ جميع العلوم الحصولية هي علوم حضورية: إنَّ جميع التصوّرات والمفاهيم والقضايا ـ التصوّرات المقترنة بحكم ـ التي تكشف عن شيء ورائها، وتكون علمًا حصوليًّا بالنسبة لذلك الأمر (الذي هو ورائها ومحكي عنها)، يكون لها حضور في النفْس ويكون علم الإنسان بها علمًا حضوريًّا؛ إذ لا توجد بينها وبين نفْس الإنسان مفاهيم أخرى، كما أسلفنا ذلك.
والحقيقة هي أن للصورة الذهنية ـ الموجودة في ذهن الإنسان ـ حيثيّتان: حيثيّة إراءة الغير والحكاية عنه، وحيثيّة وجودها في نفسها. [أي الحيثية الآلية والحيثية الاستقلالية]، ويطلق على اللحاظ الأول وهو إراءة الغير والحكاية عمَّا ورائها بالعلم الحصولي، وتكون الصورة الذهنية في هذه النظرة طريق إلى الواقع وليست لها موضوعيّة بذاتها، لكن في اللحاظ الثاني حيث تتمتّع الصورة ذاتها باستقلالية وتحظى بموضوعية، يكون علم الإنسان نفسه بهذه الصورة وبهذا المفهوم علمًا حضوريًّا، فمثلًا إذا قمنا بمقارنة بين صورة الشجرة وواقعها وجعلنا العلم بواقعها مِلاكًا، فعندها يكون علمنا هذا علمًا حصوليًّا، ولكن إذا كانت صورة الشجرة لا من جهة أنَّها تحكي واقع الشجرة، بل من باب كونها حاضرة بذاتها لدى النفس (والحضور يعني اجتماع العِلم والمعلوم بعد أن يصبح العلم معلومًا بالعلم الحضوري)، فعند ذلك تكون جميع الصور والمفاهيم معلومة بالعلم الحضوري بلحاظ حضورها في الذهن والنفس، وإن كانت تُدعى علمًا حصوليًّا باعتبار اللحاظ الأوّل وبالنسبة لما تحكي عنه.
ويتحصَّل من ذلك، أن بالإمكان اعتبار العلوم الحصولية قسمًا من العلوم الحضورية ومن مصاديقها.
3ـ جميع العلوم الحسّية منتزعة من الإحساس والانفعال الباطني: عندما نفتح أعيننا ونرى شجرة، ينعكس نورٌ من الشجرة على العين، فتنتقل صورة الشجرة ـ التي انعكست في أعيننا ـ من الجهاز العصبي إلى المخ، فينفعل المخ بها، فتنفعل مرتبة من النفْس ـ والتي تسمَّى الباصرة ـ نتيجة لهذا العمل المادي؛ وذلك بسبب ارتباط النفْس بالبدن أو اتحادهما، وبعد ذلك يخلق ذهنُ الإنسان صورةً من هذا الإحساس الباطني. وبناء على ذلك، لا يخلق ذهننا صورة من الأشياء الخارجية، بل من الإحساس الباطني والانفعالات النفسانيّة.
وكذلك تجري نفسُ هذه القاعدة بالنسبة للحواس الأخرى؛ أي إنَّ الحاسّة اللامسة أيضًا تؤدّي إلى انفعال نفساني وانفعال باطني نتيجة للتماس مع الأشياء الخارجية والانفعالات المادّية، فيخلق الذهن من هذا الانفعال المادّي مفهوم وصورة.
ويتحصَّل من ذلك، أنَّ الحواس الظاهرية كالعين والأذن وأمثال ذلك، وكذلك النور والأشياء الخارجيّة، والجهاز العصبي والمخ، بأجمعها أفعال وانفعالات مادّية وعلل إعدادية لتهيئة الأرضية للانفعال الباطني والنفساني، أو للإحساس الباطني. كما أنَّ الذهن أيضًا يخلق مفهومه وصورته من هذا الإحساس والانفعال الباطني، وليس من الأشياء الخارجية. وعليه فجميع العلوم الحصوليّة الحسّية؛ أي المفاهيم والصور التي تُخبرُ عن الأشياء الخارجية الناشئة عن الحواس الظاهرية، ترجع إلى العلوم الحضورية؛ أي الإحساسات الباطنية؛ بمعنى أنَّها قد انتُزعت من الإحساسات الباطنيّة، وهذا ما سيتّضح أكثر فيما سيأتي من البحث.
4ـ جميع المفاهيم المنطقية منتزعة من المفاهيم الموجودة في الذهن: إنَّ المفاهيم المنطقية مفاهيم تحكي عن خصوصيّات المفاهيم الذهنية الباطنية، فعلى سبيل المثال مفهوم “الكلّية”، ومفهوم “الجزئية” هما مفهومان منطقيان؛ لأنَّهما يُشيران إلى خصوصيّتين من خصوصيّات المفاهيم الذهنيّة؛ أي خصوصية قابلية الانطباق على كثيرين وعدم قابلية الانطباق، فمثلًا إنَّ مفهوم “الإنسان” كلّي، ومفهوم “الإمام الخميني” جزئي.
ومعنى أنَّ مفهوم “الإنسان” كلّي؛ أي إنَّه مفهوم يقبل الصدق والانطباق على مصاديق كثيرة؛ بخلاف مفهوم “الإمام الخميني” فهو يقبل الانطباق على فردٍ واحد فقط. إنَّ خصوصية الانطباق وعدم الانطباق هما خصوصيّتان لمفهوم “الإنسان” و “الإمام الخميني”. مضافًا إلى أن هذه المفاهيم لا توجد إلَّا في الذهن؛ أي إنَّ مفهوم “الإنسان”، ومفهوم “الإمام الخميني” موجودان في الذهن، وخصوصيّة قابلية الانطباق وعدم قابلية الانطباق من خصوصيّاتها التي في الذهن.
5ـ جميع أو أكثر المعقولات الثانية الفلسفية مأخوذة من العلوم الحضورية: إنَّ مفهوم الوجود والعدم، والعلَّة والمعلول، والجوهر والعرض وأمثال ذلك، هي مفاهيم لا تُكتسب عن طريق الحواس الخمس؛ أي إنَّها ليست حقائق محسوسة بالحواس الظاهرية. ومن باب المثال، لا يمكن رؤية حقيقة ومعنى العليّة واستشمامها أو لمسها وتذوّقها، بل إنَّ نوع إدراكها يختلف عن نوع إدراك المحسوسات؛ لذلك نجد في الفلسفة الغربية أنَّ هيوم وقع في الشكّ من حكاية هذه المفاهيم للواقع (كامينز، ج2، ص168، 170، 174؛ كاپلستون، 1362، ج5، ص259 ـ 297)؛ لأنَّه كان يعتقد أنَّ كل مفهوم لم يُكتسب من الخارج عن طريق الحواس الخمس يكون من صناعة الذهن، وكلُّ ما يخلقه الذهن ليس له ارتباط بما هو خارج الذهن، وهو أمر ذهني. وهذا ما أوقعه في التردّد تجاه أصل العليَّة؛ لأنَّ مفاهيمها من هذا القبيل، وإنَّ ما أوضحه الشهيد مطهري بخصوص هذا المطلب يفيد في هذا الباب، حيث قال:
“هي مفاهيم تُستخدم في الفلسفة، فتُطرح في الأمور العامّة من الفلسفية وغير العامّة أيضًا، وهي سلسلة من المعاني العجيبة وكأنَّ إحدى قدميها في الذهن والأخرى في الخارج، وعندما نعبّر بـ(كأن) إذ هي ليست كذلك في الواقع، فهي من ناحية ليست صورًا للأشياء العينيّة كالمعقولات الأوّلية، كما أنَّها لا ترد إلى الذهن مباشرة عن طريق الحواس كما في المقولات الأرسطية. وهي من ناحية ثالثة ليست كالمعقولات الثانية المنطقية التي يكون موطن صدقها هو الذهن. ومع أنَّها لم تأت إلى الذهن من خلال الحواس مباشرة إلَّا أنَّ موطن صدقها هو الخارج، أي إنها تصدق على الأشياء في الخارج، ولا يمكن هناك أن نقول الإنسان في الخارج نوع، فهو نوع في ظرف الذهن فقط وليس نوعًا في الخارج.
ولكن هذه المعقولات مع أنَّها ليست معقولات أولية إلَّا أنَّها تصدق على الأشياء في ظرف الخارج، مثل مفهوم (الموجودية) و (المعدوميّة)، وحتى مفهوم العدم أيضًا. فعندما نقول إنَّ زيدًا معدوم هنا، وزيد معدوم في هذه الغرفة، وزيد لا يوجد هنا؛ يعني زيد معدوم في الخارج.
بل إنَّ مفهوم (الضرورة)، أو (الحتميّة)، أو (الوجوب) التي هي ـ إلى حدّ ما ـ ركيزة الفكر البشري، وكذلك (الإمكان) و(الامتناع)، كل هذه المفاهيم من المعقولات الثانية الفلسفية، وهي أوصاف لأشياء خارجية؛ لأنَّ الأمور في الخارج تتّصف بالضرورة والإمكان والامتناع، وحين نقول إنَّ نظام العالم ضروري، لا يعني ذلك أنَّه ضروري في أذهاننا، وإنَّما هو ضروري في الخارج.
ومن جهة أخرى إذا قال قائل: كما تُشيرون إلى المعقولات الأولية وهي لها تعيّن في الأشياء وتشكّل طائفة خاصّة، تعالوا شيروا لنا إلى الضروة وأين هي التي لا يمكن لكم أن تُشيروا إليها… لكن الضرورة لا يمكن الإشارة إليها، كما هو حال الإمكان والامتناع التي لا يمكن الإشارة إليها في الخارج” (مطهري، 1380، ج10، ص66 ـ 68).
وتابع الشهيد مطهري كلامه معتبرًا أنَّ مفهوم “العلَّة والمعلول” من هذا القسم أيضًا، حيث قال:
“هيوم أدرك جيّدًا أنَّ العليَّة ليست أمرًا محسوسًا، وما يحسّه الإنسان هو التوالي والتتابع والمعيّة، أمَّا العلّية فهي أمر ينتزعه الذهن.
أما كانت وأضرابه فقد حذفو العلية من الخارج، وقوله صحيح لكن ليس إلى الحدّ الذي انساق له وحذفها من الخارج بالمرّة.
وأما ابن سينا ومن مثله فقد وصلوا إلى مفاد هذا الأمر، إذ يقول في أول (الشفاء): إنَّ ما يحسّه الإنسان هو تعاقب الأشياء وتواليها ومعيّتها، وأنه لا يحسّ المعية نفسها؛ لأنَّ المعية نفسها غير محسوسة، ولكن بمعنى أنَّه يرى شيئًا وفي نفس الوقت يرى ذلك الشيء شيئًا آخر، لا أنه يرى ثلاثة أشياء”. (المصدر السابق، ج10 ، ص68 ـ 69).
والعلامة الطباطبائي (رحمه الله) هو أوّل الذي سعى للكشف عن أنَّ منشأ انتزاع هذه المفاهيم هو منشأ واقعي؛ لذلك توجّه نحو العلم الحضوري، وعثر على منشأ انتزاع قسم من هذه المفاهيم عن طريق المقارنة بين النفْس وحالاتها وأفعالها.
6ـ المعلوم في العلوم الحصولية موجود عقلي مجرّد (عند إدراك المفاهيم العقلية)، أو مثالي مجرّد (عند إدراك المفاهيم الحسّية والخيالية): لقد كان البحث مطروحًا في باب المفاهيم الكلية منذ عهد أفلاطون، بل وقبل ذلك أيضًا، فقد طرح أفلاطون مسألة المُثُل وفسَّر الكلّي بمشاهدة الموجودات النورانيّة المجرّدة؛ أي إنَّ روح الإنسان ترى الموجودات النورانية المجرّدة قبل التعلّق بالبدن، وعندئذ تتذكّرها حين رؤية ظلالها في عالم الطبيعة.
وفي الفلسفة الإسلامية أيَّد شيخ الإشراق والملا صدرا والعلامة الطباطبائي هذه النظرية بنحو من الأنحاء في بعض كلماتهم، علمًا أنَّ شيخ الإشراق قد فصل حساب المفاهيم الكلية عن مشاهدة مُثُل أفلاطون وأيَّدهما كلاهما، ولكنَّ الملا صدرا والعلامة الطباطبائي فسَّرا الكلّي في بعض كلماتهم بمشاهدة الموجودات.
ولقد أرجع العلامة الطباطبائي (رحمه الله) بهذا البيان مطلق العلوم الحصولية إلى العلوم الحضورية؛ أي إنَّه ذهب إلى الرأي الذي يؤمن بمشاهدة المجرّدات العقلّية في باب المفاهيم الكلّية وبالمجرّدات المثالية في باب المحسوسات.
ونتيجة هذه النظرية هي: إنَّ المفاهيم الكلية والعقلية، وكذلك المفاهيم الحسّية والخيالية مسبوقة بالمشاهدات النورية المجرّدة، وأن قبل كل علم حصولي تحصل مشاهدة حضورية، وأنَّ هذه المعلومات الحضورية هي غير العلوم الحضورية بالنفْس وحالاتها وإحساساتها وقواها وأفعالها، بل هي مشاهدة المجرّدات المنفصلة عن نفْس الإنسان وروحه.
7ـ البديهيّات الأوّلية ترجع إلى العلوم الحضورية: كانت كافّة الإرجاعات السابقة تتعلّق بالتصوّرات، ولكن هذا الإرجاع يتعلّق بالتصديقات، والتصديقات البديهيّة والأوّليّة على وجه التحديد.
إنَّ البديهيات الأوّلية هي القضايا التي يكفي مجرّد تصوّر الموضوع والمحمول والنسبة بينهما للتصديق بها. وعلى سبيل المثال، في قضايا من قبيل “لكل معلول علَّة”، أو “الكل أكبر من أجزائه”، أو “اثنان في اثنان يساوي أربعة”، لو تصوّرنا مفهوم العلَّة والمعلول بصورة صحيحة وأخذنا بنظر الاعتبار النسبة بينهما فسنصدّق بأنَّ لكل معلول علَّة، وعلى هذا المنوال القضايا الأخرى.
ولقد أوضح الفلاسفة المسلمون أنَّ العقل يصدّق بثبوت المحمول للموضوع من خلال التصوّر الدقيق للموضوع والمحمول والنسبة بينهما، وهذا التصديق تصديق ضروري وبديهي، وأنَّ للعقل حكمان ويقينان في هذه القضايا، وهما:
1ـ اليقين بأنَّ “أ هو ج” مثلًا: لكل معلول علَّة.
2ـ اليقين “باستحالة أن لا يكون أ هو ج”، وهذا من قبيل استحالة وجود معلول من دون علَّة، وهذا اليقين مطابق للواقع وثابت؛ أي إنَّه يقين لا يمكن زواله، ولقد اكتفى الفلاسفة بهذا المقدار من مطابقة هذه القضايا للواقع.
ولتبيين مطابقة البديهيّات الأوّلية، ومضافًا إلى ما أوضحه الفلاسفة السابقون لمسألة مطابقة البديهيات الأولية، طرح الأستاذ مصباح يزدي إرجاعها إلى العلوم الحضورية، فهو يعتقد بأنَّ البديهيّات الأوّلية قضايا تحليلية؛ أي قضايا محمولها مستتر في باطن الموضوع، وعلى سبيل المثال، في قضية “لكل معلول علَّة” يكون معنى “له علَّة” مستتر في باطن معنى “معلول”؛ لأنَّ “المعلول” يعني شيء له علَّة، فمعنى المحمول مستتر في باطن معنى الموضوع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إنَّ معنى العلَّة والمعلول معلوم بالعلم الحضوري؛ لأنَّه ـ وكما أسلفنا ـ إنَّ التصوّرات والمفاهيم مصداق من مصاديق العلوم الحضورية.
ويتّضح من خلال المقدّمتين السابقتين أنَّ ثبوت المحمول للموضوع في هذه القضايا يعود في الحقيقة إلى رجوع هذه القضايا إلى العلم الحضوري؛ لأنَّه عندما يكون مفهوم الموضوع والمحمول معلوم حضوري، وحضور المحمول في الموضوع حضوري كذلك، فستكون النتيجة أنَّ إدراك ثبوت المحمول للموضوع يكون حضوريًّا أيضًا.
8ـ رجوع “الوجدانيات” إلى العلوم الحضورية: إن قضايا من قبيل “أنا أخاف”، و”أشعر بالألم”، و”أشعر بالجوع”، و”اتخذت قرارًا” وأمثال ذلك تسمَّى بالقضايا الوجدانية، والقضايا الوجدانية تكشف عن الحالات والمشاعر والعواطف والصفات والأفعال الباطنية لنفس الإنسان وروحه، وهي في الحقيقة علوم حصولية تُخبر عن الحالات والعلوم الحضورية؛ أي إنَّها أخذت أوّلًا من العلوم الحضورية، وصارت تُخبر عنها ثانيًا.
والقضايا الوجدانية ترجع إلى العلوم الحضورية تصوّرًا وتصديقًا؛ أي إنَّ مفاهيمها التصوّرية مأخوذة من العلوم الحضورية، وكذلك التصديق بها يرجع إلى العلوم الحضورية، فمثلًا في قضية “أنا أشعر بألم” فإن كلًّا من مفهوم “أنا” و “ألم” معلوم بالعلم الحضوري سواء كان العلم بهما الآن أو في السابق، وقد أخذنا منها مفهوم “أنا”، و “الألم” ثمَّ كوَّنا منهما جملة: “أنا أشعر بألم”؛ ومن هنا فلا توجد أي مشكلة من ناحية مطابقة مثل هذه القضايا مع الواقع، وتعتبر معرفة حقيقية.
وتوضيح ذلك هو: إنَّ المعرفة الحقيقيّة ـ وكما مرَّ معنا سابقًا ـ هي العلم المطابق للواقع، والقضايا الوجدانية تعتبر يقينية ومطابقة للواقع لأنها قضايا حضورية؛ لأنَّنا قلنا إنَّ القضايا الوجدانية مأخوذة من العلوم الحضورية، والعلوم الحضورية غير قابلة للخطأ؛ لذلك لم يقع هيوم بالشكّ والترديد في الأمور الباطنية والعلوم الحضورية والقضايا المأخوذة منها رغم شكّه وترديده في أمور كثيرة.
ولقد أشار الفلاسفة إلى هذا المورد الثامن في أقسام اليقينيّات ومقدّمات البرهان، وطرحوه تحت عنوان المشاهدات الباطنية أو المحسوسات الباطنية، وعبَّروا عنه أحيانًا بالوجدانيات.
وكما أسلفنا، فإنَّ ثلاثة أقسام من هذه الأقسام الثمانية كانت محط نظر العلامة الطباطبائي (رحمه الله)، ولقد صرَّح بها وسلَّط عليها الأضواء، وأجاب على بعض الشبهات بواسطة بعض الإرجاعات.
وفيما يلي نعرض عباراته وتوضيحات الشهيد مطهري عليها أوّلًا، ثمَّ نقوم باستعرض ثمرتها في علم المعرفة.
يقول العلامة الطباطبائي (رحمه الله) فيما يتعلّق بالقسم الثالث آنف الذكر:
“ينقسم العلم ـ أولًا ـ إلى العلم التصوّري والتصديقي… ومن الواضح أن العلم التصديقي لا يتحقّق من دون العلم التصوّري… .
وينقسم العلم ـ ثانيًا ـ إلى الجزئي والكلّي؛ لأنه إن كان غير قابل للانطباق على كثيرين فهو الجزئي، من قبيل هذه الحرارة التي أحسّ بها، وهذا الإنسان الذي أراه. وإن كان قابلًا للانطباق على كثيرين فكلّي، مثل مفهوم الإنسان ومفهوم الشجر اللذان يقبلان الانطباق على كل إنسان مفروض وكل شجرة مفروضة.
والعلم الكلّي يتحقّق بعد العلم بالجزئيات، فلا يمكن لنا تصوّر الإنسان الكلّي ـ مثلًا ـ إلا إذا كنّا قد شاهدنا وتصوّرنا من قبل أفرادًا للإنسان؛ وذلك لأننا لو كنا نستطيع أن نتصوّر الكلّي من دون أي علاقة بجزئياته لأصبحت نسبة الكلّي المفروض إلى جزئيّاته وإلى غيرها متساوية، أي إنَّه إمَّا أن يكون منطبقًا على كلّ شيء، وإمَّا أن لا يكون منطبقًا على شيء، مع أننا نطبّق مفهوم الإنسان ـ مثلًا ـ دائمًا على جزئياته فقط ولا نراه قابلًا للانطباق على غير جزئياته، وإذن فلا محالة من أن هناك علاقة ما بين تصوّر الإنسان الكلّي وتصوّر جزئياته، وأن النسبة بينهما ثابتة غير قابلة للتغيّر.
ويمكن تسرية هذا الكلام إلى العلاقة بين الصورة الخيالية والصورة المحسوسة؛ إذ لو لم تكن ثمّة علاقة ورابطة بين الصورة الخيالية ـ التي نتصوّرها بدون وساطة الحواس ـ والصورة المحسوسة لتلك الصورة الخيالية لانطبقت كل صورة خيالية على كلّ صورة حسّية (مهما كانت)، أو لما انطبقت إطلاقًا على أية صورة حسّية، مع أننا نلاحظ أنَّ الصورة الخيالية التي نتصوّرها لفردٍ ما لا تنطبق إلا على صورة ذلك الفرد وحسب.
وعليه فثمّة رابطة حقيقيّة بين “الصورة المحسوسة والصورة المتخيّلة”، وبين “الصورة المتخيّلة والمفهوم الكلّي”، وبين “الصورة المحسوسة والمفهوم الكلّي”.
ولو كنَّا نستطيع أن نصوغ المفهوم الكلّي دون الالتفات إلى الصورة المحسوسة، فعند صياغة ذلك المفهوم نكون إمَّا قد لاحظنا منشأ الآثار أو لا؛ أي في تصوّر الإنسان الكلّي لفرد خارجي إمَّا أن نلاحظ الفرد الخارجي ـ الذي هو منشأ الآثار ـ ثمَّ نصوغ المفهوم الكلّي خاليًا من تلك الآثار أو لا، وفي الصورة الأولى (أي في حالة ملاحظة الفرد الخارجي الذي هو منشأ الآثار) لا بد أن نكون قد أدركنا من قبل حقيقة منشأ الآثار وهو بعينه الصورة المحسوسة، وفي الصورة الثانية (أي في حالة عدم ملاحظة الفرد الخارجي) نكون قد صنعنا لأنفسنا واقعًا خارجيًّا وليس مفهومًا ذهنيًّا؛ لأنَّ وجوده ليس مقيسًا وهو بنفسه منشأ للآثار فهو ليس بمفهوم.
أجل إنَّ هذا المفهوم المفروض بالنظر إلى ذاته الذي هو معلول لنا، سيكون معلومًا بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، وكلامنا في العلم الحصولي (مرحلة المفهوم الذهني) لا في العلم الحضوري (مرحلة الوجود الخارجي)، ويجري هذا الكلام في الصورة الخيالية أيضًا كما كان جاريًا في المفهوم الكلّي.
ولذا فالعلم الكلّي مسبوق بالصورة الخيالية، والصورة الخيالية مسبوقة بالصورة الحسية.
وبغض النظر عمَّا سبق فالتجربة قد أثبتت أنَّ الأشخاص الفاقدين لبعض الحواس ـ كالبصر أو السمع ـ عاجزون عن التصوّر الخيالي الذي يأتي عن طريق ذلك الحسّ المفقود.
ونستنتج من هذا ما يأتي:
1ـ هناك نسبة ثابتة بين الصورة المحسوسة والصورة المتخيلة والصورة المعقولة (المفهوم الكلّي) لأي شيء.
2ـ إنَّ تحقّق المفهوم الكلّي متوقّف على تحقّق التصوّر الخيالي، وتحقّق التصوّر الخيالي متوقّف على تحقّق الصورة الحسية، وكل واحد من هذه الثلاثة يأتي مرتّبًا بعد الآخر.
3ـ إن كل المعلومات والمفاهيم التصوّرية تنتهي إلى الحواس، بمعنى أنَّ كلَّ مفهوم تصوّري نفرضه فهو إما أن يكون محسوسًا بصورة مباشرة أو محسوسًا قد مسّته يد التغيير فاكتسب خاصّية وجودية جديدة. مثل حرارة الشخص المحسوس فإنَّها صورة محسوسة تتّصف بالتشخّص والتغيّر، والصورة الخيالية لها تتمتّع بماهية الحرارة والتشخّص ولكنَّها ثابتة من جهة كونها متخيلة، أما مفهومها الكلّي فليس له إلا ماهية الحرارة وليس له تشخص ولا تغير.
4ـ لو ضممنا هذه النتيجة الثالثة إلى المقدمة التي أثبتناها في المقالة الثانية (وهي أننا نستطيع إدراك ـ في الجملة ـ بالواقع الخارج عن ذواتنا) لكانت النتيجة هي أننا نستطيع الوصول ـ في الجملة ـ إلى الماهية الواقعية للمحسوسات (وبمقدار بساطة وسهولة هذه القضية فهي دقيقة وصعبة الفهم، والفلسفة تأخذ على عاتقها إثبات معناها الدقيق لا معناها الساذج السطحي، وسوف يُشرح ذلك في المكان المناسب)) (الطباطبائي، 1380، ج1، ص133ـ 135 [مجموعة آثار الشهيد مطهري ج6]).
وله عبارة أخرى في مكان آخر نصّها:
“ويمكننا صياغة البرهان بشكل أدقّ، على هذا النحو: على أساس مرآتية وكاشفية العلم والإدراك يكون الوصول إلى الواقعيّة أمرًا ضروريًّا، بمعنى أنَّ هناك علمًا حضوريًّا في مورد كلِّ علم حصولي. وعلى أساس هذا يمكن توسعة دائرة البرهان والحصول على نتيجة أكثر عمومية، فنقول: حيث إنَّ لكل علم وإدراك سمة الكشف والحكاية عن الخارج، وهو صورة له، يلزم أن يتوفّر على سمة الارتباط بالخارج عنه، وأن لا يكون منشأ الآثار، ومن هنا يلزم أن ننتهي إلى واقع تنشأ منه الآثار، ويتطابق مع العلم المفترض؛ أي نكون قد وصلنا إلى عين الواقع بالعلم الحضوري، ثمَّ يؤخذ منه العلم الحصول إما مباشرة (عين المعلوم الحضوري مع سلب منشأية الآثار)، أو يؤخذ منه بواسطة تصرّف القوَّة المدركة فيه. ومصداق ذلك يكون أحيانًا المدركات الحسية التي توجد بواقعها في الحس، وتدركها القوَّة المدركة في نفس ذلك الموطن، وأحيانًا أخرى يكون مصداقه المدركات غير الحسّية.
ومن هنا، يتضح أنَّنا إذا أردنا معرفة كيفية تكثر وتنوع العلوم والإدراكات يلزمنا أن نعطف أنظارنا نحو الأصل، فنتفحّص الإدراكات والعلوم الحضورية؛ لأنَّ الفروع جميعًا ترجع إلى هذا الجذر، ومنه تشتق حياتها؛ فإن العلم الحضوري يتحوّل إلى علم حصولي بواسطة سلب منشأية الآثار”. (المصدر السابق، ج2، ص27 ـ 31).
ولقد سلَّط الشهيد مطهري الأضواء على بعض المطالب ضمن توضيحه لكلام العلامة الطباطبائي، فقال:
“يمكن تلخيص هذه النظرية في أنَّ القوَّة المدركة أو قوَّة الخيال هي قوَّة عملها أخذ الصور للأشياء والواقعيات سواء أكانت واقعيات خارجية أم واقعيات باطنية (نفسية)، فإن هذه القوَّة هي التي تهيّء جميع الصور الذهنية المتمركزة في الحافظة والتي تجري فيها أعمال الذهن المتعدّدة والمختلفة. وهذه القوّة لا تستطيع أن تولّد تصوّرًا من ذاتها، وإنَّما العمل الوحيد الذي تستطيعه هو أنَّها إذا اتصلت باتصال وجودي بواقع من الواقعيات فإنَّها تصوّر له صورة ثم تدّخرها في الحافظة. فالشرط الأساسي لظهور صور الأشياء والواقعيات في الذهن هو الاتصال والارتباط الوجودي بين تلك الواقعيات والقوَّة المدركة، والقوَّة المدركة ـ التي عملها التصوير ـ ليس لها وجود مستقلّ بذاته وإنَّما هي فرع من القوى النفسية، ولا يتم اتصالها الوجودي بواقعٍ ما إلَّا إذا تمَّ اتصال وجودي بين النفس ذاتها وذلك الواقع، إذن يمكن القول: إنَّ الشرط الأساسي لظهور صور الأشياء والواقعيات في الذهن هو الاتصال الوجودي الحاصل بين تلك الواقعيات وواقع النفس، وكما سوف يُذكر فيما بعد فإنَّ الاتصال الوجودي بين واقعٍ معين وحقيقة النفس يؤدّي بالنفس لتدرك ذلك الواقع بالعلم الحضوري. وعلى هذا فإنَّ نشاط الذهن أو القوَّة المدركة يبدأ من هنا أي عندما تظفر النفس بعين الواقع وتدركه بالعلم الحضوري فإنَّ القوَّة المدركة (قوَّة الخيال) ـ التي أطلق عليها في هذه المقالة بالقوَّة التي تبدّل العلم الحضوري إلى علم حصولي ـ تصوغ صورة له وتودعها في الحافظة، وبعبارة فنّية إنَّها تصوغ منه معلومًا بالعلم الحصولي.
وطبقًا لهذه النظرية فإنَّ مبنى ومأخذ كل علم حصولي ـ أي جميع معلوماتنا الذهنية العادية بالنسبة للعالم الخارجي والعالم الباطني (النفسي) ـ هو العلم الحضوري، وملاك ومناط العلم الحضوري هو الاتصال والاتحاد الوجودي بين واقع الشيء المدرَك وواقع الشيء المدرِك”. (المصدر السابق، ج 2، ص27 ـ 28).
وقال في موضع آخر:
“إن عالم الذهن أو عالم صور الأَشياء عندنا مخلوقُ جهازٍ منظم يؤدّي أعمالًا متعدّدة حتى يصوغ عالم الذهن، ونستطيع أن نطلق على مجموع ذلك الجهاز اسم جهاز الإِدراك.
والأعمال المختلفة التي يقوم بها هذا الجهاز هي عبارة عن تهيئة الصور الجزئية والحفظ والتذكر والتجريد والتعميم والمقارنة والتحليل والتركيب والحكم والاستدلال وغيرها. وكما ذكرنا سابقًا فإنَّ الإِنسان في البداية ـ أي قبل أن يبدأ هذا الجهاز الخاص بالعمل ـ يكون فاقدًا للذهن، ثم بالتدريج ونتيجة لنشاط هذا الجهاز يصبح متمتّعًا بقوى وجوانب عالم الذهن المختلفة. والآن لننظر إلى نشاط هذا الجهاز من أية نقطة يبدأ؟ إنَّ نشاط هذا الجهاز يبدأ أولًا من ناحية قوَّة خاصة متعلقة بهذا الجهاز تعرف في الفلسفة باسم قوَّة الخيال. وعمل قوَّة الخيال هو أنَّها دائمًا عندما تتصل بأي واقع تلتقط له صورة وتعدّها لتسلّمها إلى قوَّة أُخرى تُسمَّى قوَّة الحافظة. وبناء على ذلك فإنَّ وظيفة هذه القوَّة هي تهيئة الصور الجزئية وتبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي، ولهذا فقد سُميت هذه القوَّة في هذه المقالة باسم القوَّة المبدّلة للعلم الحضوري إلى علم حصولي”. (المصدر السابق، ج2، ص41).
ويصرّح الشهيد مطهري في بحث الوجود الذهني بأنَّ الوجود الذهني يدل على وحدة الصورة الذهنية المنتزعة من ماهية الأشياء، مع الواقع الذي ظفر به الذهن بلا واسطة، وليست بواسطة الأشياء الخارجية كالحائط والشجر وأمثال ذلك؛ وبما أنَّ الذهن لم ينتزع صورته من الأشياء الخارجية، وانتزعها من الانفعال والإحساس الباطني (الواقع في باطن النفس)، فعليه تكون المطابقة في هذه المرحلة قطعية، ولكنَّ المطابقة مع العالم الخارجي بحاجة إلى دليل آخر.
والنتيجة هي أنَّ العلامة الطباطبائي (رحمه الله) وبتبعه الشهيد مطهري يعتبران أنَّ سير نشوء المفاهيم الماهوية يتحقق بواسطة الحواس والفعل والانفعالات المادية، الذي هو مقدّمة للإحساس والانفعال الباطني، وهذا الانفعال الباطني هو منشأ الانتزاع والمفاهيم الماهوية.
ويتحصّل من ذلك:
1ـ وجود منشأ ومبدأ حضوري لكافة العلوم الحصولية (أعم من التصوّر والتصديق، وإن كانت في الغالب ناظرة إلى التصوّرات).
2ـ المقصود من العلوم الحصولية أعم من تلك التي للحواس الظاهرية دخل في نشوئها وغيرها؛ أي أنَّ العلوم الحصولية تحكي عن الحالات والأفعال والإحساسات والصفات والعواطف الباطنية، وقد وضعنا هذا القسم ضمن أنواع الإرجاعات من القسم الثامن.
3ـ فيما يتعلّق بالقسم الأول ـ العلوم الحصولية التي للحواس الظاهرية مدخل في نشوئها ـ فإنَّ الحواس الظاهرية وجهاز الدماغ العصبي والأمور البدنية الأخرى جميعها هي علل معدّة وأرضية للانفعال الباطني؛ ليقوم الذهن بالتقاط صورة لهذا الانفعال والإحساس الباطني الذي هو معلوم حضوري.
4ـ الواقع أنَّ النفس لها مراتب وقوى متعدّدة، ومن هذه المراتب الذهن والجهاز الذهني وعمله تهيئة الصورة والتقاطها وخلق المفهوم.
5ـ إنَّ الذهن دائمًا يخلق الصورة والمفهوم من المراتب الأخرى للنفس ولا يعكس صورة أو يخلق مفهومًا من خارج حدود النفس أبدًا.
6ـ دائمًا تكون الصورة والمفاهيم الذهنية متطابقة مع مبدأ نشوئها، ولا يمكن أن يقع الخطأ في هذه المرحلة؛ لأنَّه، أولًا: إنَّ الصور والمفاهيم معلومات بالعلم الحضوري، وثانيًا: إنَّ الإحساس والانفعالات الباطنية معلومات بالعلم الحضوري ولا يمكن أن يقع الخطأ في هذا القسم. ولقد أكَّد على هذه المسألة الشهيد مطهري وكذلك العلامة الطباطبائي، وإنَّ أصل هذا الكلام يرجع إلى المحقّق الطوسي، فالخواجة الطوسي يعتقد بعدم وقوع الخطأ في مرتبة الحسّ، بل إنَّ الخطأ يحصل في مقام تطبيق العقل (عندما يطابق العقل مفاهيمه على الخارج)، ويعدّ أفلاطون أوّل من أشار إلى هذا المطلب في الفلسفة الغربية.
سيتّضح في مباحث الوجود الذهني أنَّ ما يثبت ويستبان في ذلك المقام، هو تطابق الصور الذهنية مع الإحساسات الباطنية، لا مع الأشياء الخارجية، وقد صرَّح الشهيد مطهري بهذا المطلب أيضًا.
والجدير بالذكر هو أنَّ هذه النظرية وهذا البيان لا يتناول مشكلة تطابق الصورة والمفاهيم الحسية ـ المنتزعة من الحواس الظاهرية؛ يعني الصور والمفاهيم التي للحس الظاهري مدخلية في نشوئها ـ مع الواقع الخارجي، بل نحتاج إلى أصل العلية والسنخية بين العلَّة والمعلولية لإثبات هذا الأمر المهم، كما أنَّ أدلَّة الوجود الذهني ليست قادرة على حلِّ مشكلة التطابق هذه[1].
بالتأكيد إنَّ هذه النظرية التي هي نظرية وجودية [أنطولوجية] فيما يتعلّق بنشوء المفاهيم الذهنية، يمكنها أن تساعد بشكل واضح في مباحث علم المعرفة ووضع اليد على محلّ النزاع في التطابق، وهذه بحدّ ذاتها تعدّ مسألة مهمَّة.
ولقد تحدَّث العلامة الطباطبائي (رحمه الله) فيما يتعلَّق بالقسم الخامس، حيث قال:
“ومن ناحية أُخرى فكما قلنا إن نفسنا وقوانا النفسية وأفعالنا النفسانية حاضرة لدينا ومعلومة لنا بالعلم الحضوري، وقوّتنا المدركة تتّصل وترتبط بها، إذن لا بد أنَّها ستجدها وتصوّرها. وفي هذا الإِدراك الحصولي تكون ماهية النفس وماهية القوى والأفعال النفسانية ـ من حيث كونها قوى وأفعالًا نفسانية ـ حاضرة بكنهها لدى القوى المدركة (ويقصد من الكنه هنا أنَّها قد لوحظت “على ما هي عليه”، لا بمعنى أنَّها أحاطت بها تفصيليًّا)، وكما أنَّ النسبة بين القوى والأفعال والنفس قد عُلمت حضورًا فإنَّها ستكون معلومة أيضًا بالعلم الحصولي كما كانت تعلم النسب بين المحسوسات. ولا بدّ أننا ـ عند مشاهدة هذه النسبة ـ نشاهد الحاجة الوجودية لهذه القوى والأَفعال إلى النفس وقيامها بها، ونشاهد أيضًا الاستقلال الوجودي للنفس، وفي هذه المشاهدة تتجلى لدينا الصورة المفهومية لـ”الجوهر”؛ وذلك لأننا نجد أن النفس إذا لم تكن فإنَّ جميع هذه القوى والأفعال سوف تذهب من ساحة الوجود، ومن ناحية أُخرى نشاهد نسبة احتياج هذه القوى والأَفعال، ونفهم أنَّ هذا الاحتياج يستلزم وجود أمر مستقل، ونقبل هذا الحكم بشكل عام.
ومن هنا فإننا نحكم في جميع موارد المحسوسات ـ التي لم يكن لنا لحد الآن أي علم عمَّا يكمن وراءها ـ بأنَّها من الأعراض ونثبت لها جميعًا موضوعًا جوهريًّا، وتتحول جميع هذه الأوصاف مرَّة واحدة؛ أي إننا كنَّا لحد الآن نرى الضياء والظلام والبرودة والحرارة، ولكننا منذ الآن فصاعدًا نفهم أيضًا المضيءِ والمظلم والبارد والحار، ومن هنا يتمّ الانتقال إلى قانون العلية والمعلولية العام.
وبعد هذه المرحلة تبدأ قوّتنا المدركة بإدراك المفردات والنسب وتركيب وتحليل المحسوسات والمتخيّلات، ومن الواضح أن تفصيل ذلك خارج عن قدرتنا في هذا المجال، وكل ما يهمنا هنا هو أن ملاحظة النكات الثلاث الآتية عمومًا:
1ـ لما كانت قوّتنا المدركة قادرة على النظر مرَّة أُخرى نظرة استقلالية إلى ما كانت قد حصلت عليه في النظرة الأُولى، فهي تنظر نظرة استقلالية إلى النسب التي كانت قد حصلت عليها بوصفها رابطة بين مفهومين وتصوغ في مورد كل نسبة مفهومًا استقلاليًّا أو أكثر، وخلال هذه الجولة تتصوّر مفاهيم الوجود والعدم والوحدة والكثرة التي كانت قد أدركتها في البدء على شكل نسبة ـ تتصوّرها أولًا في حالة إضافة (وجود المحمول للموضوع) (عدم المحمول للموضوع) (وحدة الموضوع والمحمول) (كثرة الموضوع والمحمول في القضية السالبة)، ثمَّ بعد ذلك من دون إضافة (الوجود، العدم، الوحدة، الكثرة)، وكذا سائر المفاهيم العامّة والخاصة التي هي من الاعتباريات”. (الطباطبائي،1380، ج2، ص5).
وفيما يتعلّق بمفهوم “الوجود والعدم والوحدة والكثرة” قال العلامة:
“عندما يقع بصرنا لأول مرَّة على بُنية العالم الخارجي (على أنَّنا نسوق هذا الحديث على نحو المثال، إذ هناك مراحل حسّية كثيرة قبل هذه المرحلة، خصوصًا الحسّ اللمسي)، فنتعرّف في حدودٍ معينة على خواص الأجسام المتنوعة، ولنفرض أنَّنا شاهدنا سوادًا وبياضًا (والسواد والبياض هنا على نحو المثال، والمقصود سمتين حقيقيتين من سمات الأجسام الحسية)، ولنفرض أنَّنا شاهدنا بالبصر السواد أولًا، ثمَّ أدركنا البياض، وحينما نُدرك البياض ندركه كمفهوم جرَّدناه من الحس؛ أي حفظناه عندنا في ملف الإدراك، ثمَّ عكفنا على إدراك البياض. وحينما نصل عبر الحركة الثانية إلى البياض وعندنا السواد، وعندما نُدرك البياض لا نجد السواد هناك، فندرك المعلوم الثاني لأننا أدركنا المعلوم الأول، ونشاهد أن الثاني لا ينطبق على الأول، كما ينطبق الأول على نفسه؛ أي نلاحظ أنَّ نسبة السواد إلى السواد بشكل لا نجده في نسبة السواد إلى البياض. ومن ثمَّ فما نصل إليه هو حملٌ (هذا السواد سواد)، وعدم حملٍ؛ أي إنَّ الذهن لا يجد النسبة القائمة بين السواد والسواد قائمةً بين السواد والبياض.
وبعبارة أخرى: إنَّ الذهن أقام حكمًا بين السواد والسواد، أوجد نسبة بينهما، لكنَّه لم يقم بعمل بين السواد والبياض، إلَّا أنَّه بحكم مشاهدته ـ في المرَّة الأولى أو بعد تكرار الحكم الإثباتي ـ لنفسه ناسبًا وحكمًا، يحسب أنَّه في حال (عدم الفعل) قد قام بعمل، فيظن أنَّ عدم وجود النسبة الإثباتية بين السواد والبياض نسبةً أخرى، تغاير النسبة الإثباتية، وحينئذٍ تظهر نسبة “العدم” الخيالي، مقابل نسبة “الربط” الخارجي، وعندئذ تصاغ القضيتان: “هذا السواد سواد” و “هذا البياض ليس بسواد”. والحقيقة في القضية الأولى هي أنَّ القوَّة المدركة قامت بعمل بين الموضوع والمحمول، نسمّيه الحكم (هذا هو هذا). وحقيقة القضية الثانية أنَّه لم يقم بعمل فيما بين الموضوع والمحمول، لكنَّه حَسِبَ خلوّ وفاضه وعدم قيامه بعمل عملًا، وجعله عملًا ثانيًا مقابل العمل الأول (“ليس” مقابل “الهوهوية”)، وحيث إنَّ هذه القوَّة تُعبِّر عن عملها، الذي هو الحكم، بصورة ذهنية: “هذا هو هذا” فهي تنسج صورة لفقدان العمل، بحكم كونها في مقام العمل، وتُعبِّر عنه لكن هذه الصورة (بحكم صناعتها في ضوء الأولى) تنسب إلى الأول (الربط ـ عدم “الربط”). وقد أكَّدنا في المقالات المتقدّمة أنَّ كل خطأ وأمر اعتباري لا يوجد ما لم يضاف إلى أمر صحيح وحقيقي.
وبعد نسج هذين المفهومين (الربط ـ عدم الربط)، وعندما تلاحظ القوَّة المدركة سمة النسبة، حيث تقوم بين الطرفين، تنسب في القضية السالبة (نظير: هذا البياض ليس ذلك السواد) السلب إلى الطرفين، وعن هذا الطريق ينفصل كل منهما عن الآخر، ويطرد كل منهما الآخر.
ومن هنا يظهر مفهوم الكثرة النسبية أو “العدد”، وحيث إنَّ القضية الموجبة خالية عن هذا المفهوم (الكثرة أو العدد) فيسمها الذهن بـ “الوحدة”. ومن هنا يتّضح أنَّ “الكثرة” مفهوم سلبي، و “الوحدة” سلب السلب. إلَّا أنَّ سلب السلب يتطابق مع النسبة الإيجابية “الربط”، ومن هنا تتحد نسبة الوحدة ونسبة الإيجاب في المصداق.
في ضوء هذا التحليل الذهني نتوفّر على ستّة مفاهيم:
1ـ مفهوم السواد.
2ـ مفهوم البياض.
3ـ الربط.
4ـ عدم الربط.
5ـ الكثرة النسبية.
6ـ الوحدة النسبية”. (الطباطبائي، 1380، ج2، ص42 ـ 49؛ د.ت، ص257).
ويتحصَّل من كلام العلامة الطباطبائي (رحمه الله) ما يلي:
1ـ إنَّ مفهوم الجوهر والعرض يُكتسب من العلاقة بين النفس وصفاتها.
2ـ إن مفهوم العلة والمعلول يحصل أيضًا من العلاقة بين صفات النفس وأفعالها وبين النفس.
3ـ إن مفهوم الوجود والعدم يحصل من النسبة بين القضايا؛ حيث يُنسج أولًا مفهوم الربط وعدم الربط، فنحصل على المعنى الأسمي للوجود والعدم، وبعد حصولنا على مفهوم الوجود والعدم، تصل النوبة إلى الحصول على مفهوم الوحدة والكثرة.
ولإكمال هذا المطلب يقول الشهيد مطهري:
“تبتني نظرية هذه المقالة على أن قانون العلة والمعلول أمر واقعي، وسوف تناقش وتدحض جميع الشبهات القديمة والحديثة في هذا المجال وذلك في المقالة التاسعة المخصّصة لدراسة هذا القانون. وبحسب النظرية العامة التي مرّ بيانها في صدر هذه المقالة “كلّ علم حصولي فهو مسبوق بعلم حضوري”، وما دام الذهن لم يجد واقعية الشيء فإنه لا يستطيع أن يصوغ تصوّرًا له، سواء أكان يجدها في ذات النفس أم أنَّه يظفر بها عن طريق الحواس الخارجية. ويجد الذهن في البدء نموذجًا للعلة والمعلول في داخل النفس فيصوغ من ذلك تصوّرًا ثم يقوم بتوسيع ذلك التصوّر وبسطه. وكما ذكرنا سابقًا فإنَّ النفس تجد ذاتها وتجد في نفس الوقت آثارها وأفعالها كالأَفكار والتصوّرات، وعلمها بهذه الأُمور علم حضوري لا حصولي، أي إنَّ النفس بواقعها تجد عين واقعيات هذه الأُمور، ولما كانت المعلولية عين حقيقة ووجود هذه الآثار، إذن فإدراك هذه الآثار هو عين إدراك معلوليتها، وبعبارة أُخرى: إنَّ النفس تحيط علمًا بذاتها وآثارها وأفعالها وهو علم حضوري، وتجد هذه الآثار والأفعال متعلقة الوجود بذاتها، وهذا اللون من الإِدراك هو عين إدراك المعلولية”. (المصدر السابق، 1380، ج2، ص62).
وفي مفهوم الجوهر والعرض، قال:
“وحقيقة الموضوع هي أننا قد شاهدنا في باطن أنفسنا حقيقة الجوهر وحقيقة العرض، أي جوهرية الجوهر وعرضية العرض، وبعبارة أُخرى: شاهدنا فيها واقع الاستقلال الوجودي وواقع الحاجة، فمنشأ ظهور هذين التصوّرين هو الشهود الباطني”. (المصدر السابق،ج 2، ص56).
وعبارة العلامة المتعلّقة بالقسم السادس هي:
“… واعلم أنَّ هاهنا نظرًا أدقّ من هذا النظر وذلك بإرجاع العلم الحصولي إلی العلم الحضوري فينتج أنَّ المعلوم بالعلم الحصولي سواء کان کليًّا أو جزئيًّا جوهر مجرّد عقلي أو مثالي يتّحد به العالِم نوعًا من الاتّحاد، وسيجيء الإشارة إليه”. (صدر الدين الشيرازي، 1981م، ج3، ص280 (الهامش رقم 1)، ج1، ص284).
ويتحصَّل من رأي العلامة الطباطبائي (رحمه الله) النتائج التالية:
1ـ إنَّ الإحساس في الحواس الخمس يكون حضوريًّا في البداية؛ أي إنَّ قوَّة النفس الباصرة مثلًا ـ والتي هي أمر باطني ومرتبة من مراتب النفس ـ تنفعل، فيخلق ذهن الإنسان ـ الذي هو مرتبة أخرى من مراتب النفس ـ من هذا الانفعال الباطني صورة ومفهومًا، ثمَّ يطبِّق هذا المفهوم على الموجودات الخارجية؛ ومن الطبيعي أن يكون للحواس الخمس مدخلية في إيجاد هذا الانفعال الباطني؛ أي إنَّ العين والأعصاب والأنف والدماغ وبقية الحواس الأخرى بأجمعها هي علَّة معدَّة لانفعال قوَّة النفس الباصرة والتقاط الذهن صورة نتيجة لهذا الانفعال الباطني الذي هو علم حضوري.
2ـ يكتشف الذهن مفاهيم لم تتوصّل إليها الحواس الخمس، وذلك عن طريق المقارنة بين النفس وحالاتها أو انفعالاتها؛ مثل مفهوم العلَّة والمعلولية أو الجوهر والعرض وغير ذلك، إذ إنَّ النفس تتوصّل إلى مفهوم الجوهر والعرض ومفهوم العلَّة والمعلول عن طريق الملاحظة والمقارنة بين النفس [التي هي جوهر] وبين الأعراض، حيث يكون كلاهما معلوم بالعلم الحضوري وأحدهما مرتبط بالآخر.
3ـ تحصل النفس على المفاهيم الجزئية والكلية بمشاهدة الموجودات المجرّدة المثالية أو العقلية[2].
إنَّ الثمرات المعرفيّة التي تترتب على القسم الأول تتمثّل بما يلي:
1) إنَّ النفس لا تخطئ في مرحلة الإحساس؛ وذلك لأنَّها تحصل على مفاهيمها من الانفعال الباطني المعلوم بالعلم الحضوري، أو تخلقها على أساسها، وإذا ما وقع خطأ فهو يقع في مرحلة تطبيق هذا المفهوم أو تصوير الموجودات الخارجة عن النفس والذهن.
2) إنَّ المحكي بالذات هو الانفعالات الباطنية للنفس، لا الموجودات الخارجية، وإنَّ كل مفهوم ينطبق مع محكيه بالذات، رغم أنه من الممكن أن لا ينطبق مع مصاديقه الخارجية التي انتزعها منها أو التي كانت مبدأ للشروع في نشوئها.
3) لا يثبت وجود المحسوسات أو خصوصيّاتها بمجرّد الإحساس، بل يلزم الاستدلال ـ حتى ولو كان ارتكازيًّا ـ لإثبات أصل وجود الموجودات المحسوسة في الخارج أو خصوصيّاتها؛ لذلك فإن ابن سينا (1392ق، ص68 و 88)، وكذلك الملا صدرا (1981م،ج3، ص 498 ـ 499) يعتقدان بعدم إمكانية إثبات وجود المحسوس بمجرّد وجود الإحساس.
أمَّا الثمرات المعرفيّة التي تترتّب على القسم الخامس فهي كما يلي:
1) إنَّ المفاهيم الفلسفية ـ كالوجود والعدم، والعلَّة والمعلول، والجوهر والعرض وأمثال ذلك ـ ليست من خلق الذهن كما كان يعتقد هيوم، بل تُنتزع من منشأ واقعي هو النفس وحالاتها وأفعالها الباطنية المعلومة بالعلم الحضوري، ولقد أذعن الفيلسوف التجريبي الإنجليزي جون لوك لهذا الأمر وأشار إليه بنحو من الأنحاء؛ أي إنَّه في مفهوم العلَّة والمعلول يعتبر التفات النفس وإرادتها أرضيّة مناسبة لانتزاع مفهوم العلَّة والمعلول من منشئها الواقعي (1349، ص142 ـ 143)[3].
2) إنَّ مجرّد عدم الحصول على المفهوم عن طريق الحواس الخمس ليس دليلًا على عدم توفّر هذا المفهوم على منشأ انتزاع واقعي وأنه ليس سوى تعمّل ذهني.
3) تتمتّع المفاهيم الفلسفيّة مثل مفهوم العلَّة والمعلول بضمان عالي من الصحَّة؛ لأنَّها تُنتزع من حقائق معلومة بالعلم الحضوري ولها مصداق واحد ـ على أقلّ تقدير ـ مسلَّم وغير قابل للترديد.
4) إنَّ القضايا المنتزعة من هذه المفاهيم ليست قضايا ذهنية، بل لها ـ على أقل تقدير ـ مصداق واحد في الخارج، وهي صادقة أيضًا على نحو القضية الحقيقية؛ مثل “لكلِّ معلول علَّة”. وإذن، فتشكيك أمثال هيوم في أصل العليَّة وزعمه أنها من مختلقات الذهن، أو اعتبارها من قوالب ذهنية كما تخيّل كانت، كل ذلك يبتني على مقدّمتين خاطئتين، هما:
1ـ إنَّ كل مفهوم لا يحصل عن طريق الحواس الخمس لا يكشف عن الواقع.
2ـ للكشف عن الواقع يجب أن يكون منشأ انتزاع المفهوم واضح لدينا، وإلا وقع فيه التشكيك والتردّد.
المقدّمة الأولى باطلة؛ إذ قد تحصل بعض المفاهيم عن طريق العلم الحضوري، كمفهوم العلَّة والمعلول، ويكون ضمان صحّتها أكثر من المفاهيم المحسوسة بالحواس الخمس، هذا أولًا، وثانيًا، إنَّ مجرّد عدم وجدان منشأ الانتزاع لا يدل على عدم وجوده.
والمقدّمة الثانية ـ وإن كان العلامة الطباطبائي (رحمه الله) وتلامذته اعترفوا بها ضمنًا كأصل من الأصول ـ ولكن يبدو أنه لا توجد ضرورة للالتزام بها؛ أي لو فرضنا مثلًا أنَّنا لم نعثر على منشأ انتزاع أحد المفاهيم، وكان العلم الحضوري هو الذي أوجده في ذهننا أو حتّى لو كان من تلبيسات الشيطان، فإن تلك القضايا المنتزعة منه كقضية حقيقية إذا كانت من البديهيّات الأوّلية أو من البديهيّات المستنتجة فإنها صادقة [ولا يضرّها عدم عثورنا على منشأ انتزاعها].
وتوضيح ذلك: هو إنَّ المهمّ في القضايا التحليلية والبديهيات الأوّلية أن يتحقّق التصديق بها بمجرّد تصوّر الموضوع والمحمول وتكون القضية صادقة، وعلى سبيل المثال في قضية “الكل أكبر من أجزائه” أو “لكلِّ معلول علَّة”، فإن مفهوم المعلول ـ أي ما يفتقر إلى الغير، فذلك الغير هو العلَّة، فله علّة، فهذه القضية صادقة؛ سواء وجد لها مصداق في الخارج أم لم يوجد، وسواء ظفرنا بمصداقها أم لم نظفر به.
نعم، لا يمكننا القول بوجود علَّة ومعلول في الخارج بمجرّد هذه القضية، ولكنها صادقة في حدود القضية الكلية الحقيقية، حتى لو كان مفهوم العلَّة والمعلول قد وجد في أذهاننا نتيجة لخدعة شيطانية؛ أي بما أن حكاية المفاهيم عن محكيها بالذات حكاية عقلية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار معنى القضايا الأولية، فإن تصوّر الموضوع والمحمول يؤدّي إلى التصديق، فيكون صدق هذه القضايا قطعيًّا، حتى وإن لم نعثر ـ إلى تلك اللحظة ـ على منشأ انتزاع هذه المفاهيم.
ولقد صرَّح الفارابي بهذا المطلب في العبارة التالية:
“فالمقدمات الکليّة التي بها يحصل اليقين الضروري لا عن قياس صنفان: أحدهما الحاصل بالطباع، والثاني الحاصل بالتجربة (البديهي الثانوي). والحاصل بالطباع هو الذي حصل لنا اليقين به من غير أن نعلم من أين حصل ولا کيف حصل، ومن غير أن نکون شعرنا في وقت من الأوقات أنَّا کنّا جاهلين به ولا أن نکون قد تشوّقنا معرفته، ولا جعلناه مطلوبًا أصلًا في وقتٍ من الأوقات، بل نجد أنفسنا کأنَّها فطرت عليه من أوَّل کوننا، کأنَّه غريزيّ لنا لم نخل منه. وهذه تُسمَّی “المقدّمات الأوّل الطبيعية للإنسان” وتُسمَّی “المبادئ الأوّل”، وليست بنا حاجةٌ في هذا الکتاب إلی أن نعرف کيف حصلت، وفي أين حصلت؛ لأنَّ جهلنا بجهة حصولها ليس يزيل اليقين بها، ولا ينقصه ولا يعوقنا عن أن نؤلف عنها قياسًا يوقع لنا اليقين باللازم عنها”. (الفارابي، ١۴٠٨ق، ج١، ص٢۶٩ ـ ٢٧١).
النتائج
إنَّ تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي وتسليط الضوء على ذلك، وكذلك الالتفات إلى مسألة عدم قبوله للخطأ، والكشف ـ تبعًا لذلك ـ عن سرّ عدم إمكانية وقوع الخطأ في العلم الحضوري يُعدّ خطوة رائدة في الفلسفة الإسلامية من أجل حلّ مشاكل علم المعرفة فيما يتعلّق بالتشكيك [الشكّاكيّة] والمطابقة، وقد كانت الخطوة الأخرى التي تلت هذه الحركة العظيمة والمصيرية هي إرجاع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، حيث كان لها في جملة من الموارد آثار عظيمة على صعيد علم المعرفة.
إن مجموع الإرجاعات التي تحصَّلت ـ حتّى الآن ـ هي ثمان موارد تركّز الضوء على ثلاثة أقسام منها في كلمات العلامة الطباطبائي (رحمه الله)، وكان قسم واحدًا منها ردًّا مهمًّا جدًّا وضروريًّا على شبهات هيوم فيما يتعلّق بانتزاع بعض المفاهيم كالعلَّة والمعلول، وبيان واقعية أصل العلية وفروعه، بل كافّة المعقولات الثانية، بل الفلسفة الإسلامية بأسرها. كما كان القسم الآخر وهو قسم المحسوسات بالحواس الظاهرة تحليل قيِّم وله وزنه بميزان فعّالية العلوم الحسّية في سبيل الوصول إلى الواقع. طبعًا إنَّ القسم الثالث من الإرجاعات ـ والذي هو مشاهدة المُثل والمجرّدات النورانية ـ ليس عليه دليل تامّ ولا تستتبعه ثمرة معرفية تُذكر، وهو ما يحتاج إلى البحث خارج إطار هذه المقالة.
لقد أجاب موضوع إرجاع المفاهيم الفلسفية ـ كالعلة والمعلول ـ على شبهة هيوم فيما يرتبط باعتبار مفهوم العلَّة والمعلول مفهومًا ذهنيًّا محضًا ومن ثم اعتبار أصل العليَّة أمرًا ذهنيًّا، وأنَّ أهميّة هذا الجواب ناشئة من أهميّة أصل العلية وآثاره المتمثّلة بما يلي:
1ـ إثبات واجب الوجود والمبادئ العالية للوجود.
2ـ إثبات العالم الجسماني.
3ـ عمومية القواعد العلمية.
4ـ إثبات المطابقة في قسم من صفات الأجسام.
ودراسة كل واحدة من هذه الموارد والآثار الأخرى مما هو بحاجة إلى مقالة مستقلّة.
ترجمة: نبيل اليعقوبي
مراجعة: محمد الربيعي
المصادر
- ابن سينا، حسين بن عبدالله (1403ق). الإشارات والتنبیهات. ج1، 2، 3، طهران: دفتر نشر كتاب، الطبعة الثانية.
- (1392ق). التعليقات. تحقيق عبد الرحمن بدوي. القاهرة: الهيئة العامة للکتاب.
- صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم (د.ت). الرسائل. قم: مکتبة المصطفوي.
- (1341). العرشية. تصحيح وترجمة غلام حسين آهني. إصفهان: مكتبة شهريار.
- (1981م). الأسفار. ج3 و 8. بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة.
- الطباطبائي، محمد حسين (1380) مجموعة الآثار. ج6 (أصول الفلسفة والمنهج الواقعي مع هامش الشهيد مطهري). طهران: صدرا، الطبعة الثامنة.
- (د.ت). نهاية الحکمة. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
- الفارابي، محمد بن محمد (1408ق). المنطقيات للفارابي. ج1. حقّقها وقدَّم لها محمد تقي دانش پژوه. قم: مکتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي.
- كامينز، (1362). فلسفه نظري (الفلسفة النظرية). ج2. ترجمة منوچهر بزرگمهر. طهران: انتشارات علمي وفرهنگي (دار النشر العلمية الثقافية).
- كاپلستون، فردريك (1362). فيلسوفان انگليسی (فلاسفة الإنجليز). ج5. ترجمة أمير جلال الدين أعلم. طهران: انتشارات سروش.
- لاك، جان (1349). تحقيق در فهم بشر (تحقيق في فهم البشر). تلخيص پرينكل ستيون. ترجمة الدكتور رضا زاده شفق. طهران: مكتبة دهخدا.
- مطهري، مرتضى (1380). مجموعة الآثار. ج10 (شرح المنظومة). طهران: صدرا، الطبعة الرابعة.
- معلمي، حسن (1386). پيشينه وپيرنگ معرفت شناسی (في تاريخ علم المعرفة). طهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي (مؤسسة الثقافة والفكر الإسلامي للبحوث).
- (1387). نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه اسلامی (نظرة في علم المعرفة في الفلسفة الإسلامية)، طهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامی (مؤسسة الثقافة والفكر الإسلامي للبحوث)، الطبعة الثانية.
- ( 1387 الف). نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه غرب (نظرة في علم المعرفة في الفلسفة الغربية). طهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامی، (مؤسسة الثقافة والفكر الإسلامي للبحوث)، الطبعة الثانية.
[1]. للتفصيل أكثر، أنظر: پيشينه و پيرنگ معرفت شناسي، بقلم المؤلف، قسم الوجود الذهني.
[2]. يتّضح من خلال المطالب التي ذكرها العلامة في تعليقته على الأسفار، ج1، الهامش ص284، ونهاية الحكمة، ص74 أنَّه لا يعتقد بمنافاة هذا القول للمطالب الأخرى، على أنَّ وجه الجمع يحتاج إلى مجال آخر.
[3] كذلك أنظر: معلمي، 1387 ألف، ص110.
المقالات المرتبطة
المحمل المصري لكسوة الكعبة تراجيديا سياسية بنكهة دينية
فتح المسلمون مصر عام 20 من الهجرة النبوية /641 من ميلاد السيد المسيح، فكانت إضافة مالية اقتصادية مهمة بالنسبة للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة، فقد كانت مصر سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية طوال 600 عام…
الأطر السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في زيارة الأربعينية الحسينية
كلمّا مضى عام وجاءت ذكرى كربلاء وأربعينية الإمام الحسين (ع)..
الفكر العربي الحديث والمعاصر | الأخلاق وموقعيتها في فكر الدكتور علي زيعور
بعد أن ألقينا نظرة على البعد النظري في فكر علي زيعور في الفلسفة والتصوف، ورأينا موقفه منهما، ندخل في المجال العمليّ والحكمة العملية لديه، هذا الجانب الذي شغل مساحة كبيرة


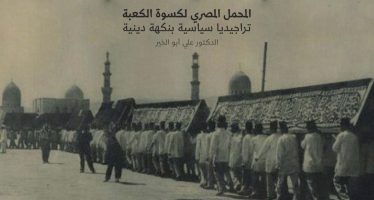



السلام عليكم
عندي سؤال يتعلق بالعلم الحضوري. كما اشرتم في هذه المقالة إلى أن العلم بالمحسوسات هو علم حضوري حيث أن الانفعال الباطني حاضر لدى النفس كالعلم بالحرارة عند ملامسة الجسم الحار ومن هذا الباب العلم بالألم والحزن والخوف وغيرها من المشاعر الباطنية المسواك بالوجدانيات. سؤالي هو كيفية علم المفارقات العقلية بل والحق تعالى بهذه الأمور حيث أن علمهم حضوري بجميع الأشياء؟ هل يستتبع علمهم بالألم الشعور بالألم كما يشعر الإنسان به عندما يعلمه بالعلم الحضور؟ واذا كان الجواب ان علمهم الحضوري بالأشياء علم اكتناهي كعلم العلة بالمعقول، يبقى السؤال ما هو حقيقة العلم الاكتناهي فلكي تعلم المفارقات العقلية حقيقة شعور المعلول بهذه الأمور، لابد أن تشعر بنفس الشعور. وكذلك علم الإنسان في المنشأة الآخرة علم حضوري، فكيف تعلم بهذه الأمور؟ ألا يستتبع العلم بالنار في الآخرة الشعور بحرارة النار؟ كل هذا حسب ما أفهمه من تعريف العلم الحضوري ولم أجد فيما اطلعت عليه من مواضيع فلسفية التطرف بحقيقة العلم الحضوري والطرق لهذه التساؤلات. اتمنى الاجابه على هذه التساؤلات او لحالتي إلى مؤلفات تتطرق لهذا الموضوع وشكرا على جهودكم المباركة.
تحياتي
هشام آل شيخ حسين