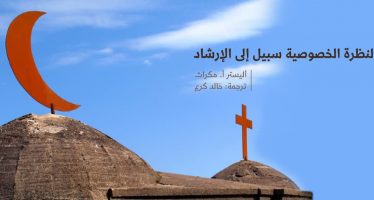الإناسة وأثرها في السياسة الاجتماعية والنظرية السياسية في عصر النهضة
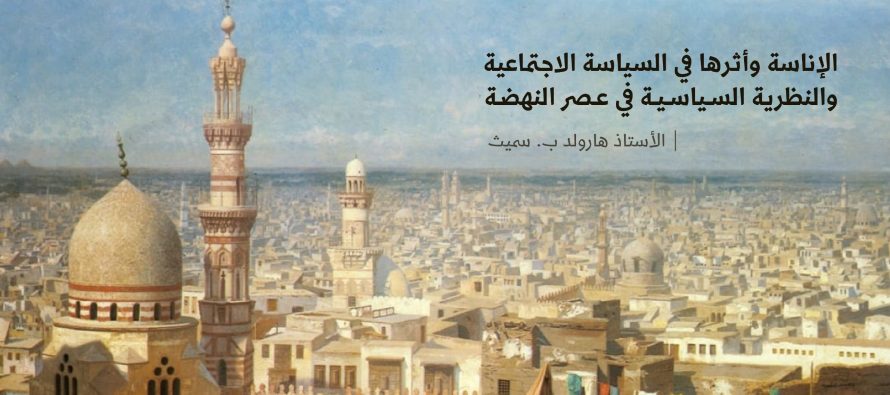
إن الموقف العالمي الحاضر، الذي يتميز أول ما يتميز بتصادم عنيف بين المذاهب الفكرية المتنافسة، ليجبر المفكّرين على أن يعيدوا تقرير آرائهم في الاعتقاد، وفي فلسفات الحياة، وهذا يصدق بوجه خاص على جملة الآراء المتعلقة بفهم الإنسان لنفسه، ولعلاقته بمجموع بيئته.
فمنذ قرون ونحن نرى في العالم الغربي مثلًا، جهدًا بالغ الأثر يبذله الفلاسفة، وعلماء الاجتماع، والسياسة، والإلهيات، لإعادة النظر في تقرير تصورهم عن الإنسان ومصيره، أو لتقويم هذا التصور من جديد. وهذا الاتجاه يدل عليه طائفة من عناوين الكتب مثل كتاب ستاس (Stace) “مصير الإنسان الغربي”، وكتاب دونوى (Du Nouy) “المصير الإنساني”، وكتاب بردييف (Berdyaev) “مصير الإنسان”، وكتاب رينهولد نيبوهر (Reinhold Niebuhr) “طبيعة الإنسان ومصيره”. هذا الاهتمام بالإنسان، وبطبيعته، وبمصيره قد أثاره شعور المفكّرين بأن الوصول إلى إدراك أوضح لماهية الإنسان أمر على درجة عظيمة من الأهمية في أيامنا هذه، التي تشهد اضطرابًا خطيرًا في السياسة والأخلاق، فإن الناس هم المادة الأولية لأي نظام سياسي، وهم وحدات كل نشاط سياسي، بل هم قطع اللعب في المناورات السياسية. ومن ثم كانت معرفتنا بعقيدتنا عن الإنسان، وحقيقته، وما يمكن أن يكون عليه، مسألة ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا، عندما نأخذ مواقفنا في المعسكرات السياسية المختلفة.
أما في العالم الإسلامي، فقد حدثت في السنوات المئة الماضية محاولات ذات بال في سبيل إعادة تقرير ما يسلم به الإسلام من آراء أساسية في الكلام وفي الفلسفة. غير أن هذه المحاولات اتجهت في الغالب اتجاهات عامة، ولم يكن بها إلا إشارات عارضة إلى هذا الموضوع الأهم، هذا إذا استثنينا بعض المحاولات الخاصة: كمحاولة الشاعر التركي؛ عالم الاجتماع الفيلسوف “ضيا كوك آلب”، وكمحاولة الشاعر الفيلسوف الهندي المسلم “محمد إقبال”، فقد حاول هذان أن يكوّنا نظرية في الإنسان، من حيث علاقته بمجموع بيئته – بالله، وبالمجتمع، وبالجماعة الإنسانية عامة – على أساس من التقاليد الدينية والثقافية التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. ولكن الأمر لا يزال يستدعي جهودًا أخرى كثيرة.
إن العالم الإسلامي في الوقت الحاضر يواجهه ويؤثر فيه نظامان عريضان من التفكير السياسي، مؤسّسان على نظريات كاملة في الإنسان إلا أنها متعارضة. ولذا كان من الضروري أن يحلّل مفكّروا الإسلام تصوراتهم الأساسية الخاصة بهذه المسألة الجوهرية، حتى لا تخدعهم الدعاية الماهرة لهذا الفريق أو ذاك، فيستسلموا من أجل غايات نفعية، لطرائق من التفكير، ومن التنظيم السياسي، أجنبية عن تقاليدهم المقدّسة لديهم.
والعالم الإسلامي لا يتعرّض لتيارات متحاربة تأتيه من خارجه فحسب فإن في داخله في الوقت الحاضر شيعًا وطوائف تنادي بآراء ومناهج مختلفة. وهذا من شأنه يضاعف من صعوبة أية محاولة تبذل، لكي يحدّد العالم الإسلامي موقفه من هذا الموضوع ذي الأهمية القصوى في أيامنا هذه، أو لكي يوحد رأيه فيه. هذه النظريات المختلفة يجب أن تدرس، ليرى إن كان ثمة سبيل إلى التأليف بينها، حتى يبدو العالم الإسلامي جبهة متحدة.
إن وجهتي في هذا المقال هو أن أستعرض بعض الاتجاهات الحديثة وأن أقترح طرقًا لدراسة النظرية الإسلامية المهمة في الإنسان، وأن أكشف في الإسلام نفسه عن مصادر لفلسفة سياسية أصيلة بالنسبة للعالم الإسلامي، وليست منقولة نقلًا أعمى عن نظم شرقية أو غربية، قد تكون غريبة عن نظرته الأساسية. ولا شك في أن القيام بهذه الدراسة على وجهها الكامل أمر متروك للعلماء المسلمين أنفسهم. وأنه ليكون من باب الادعاء أن أحاول أنا أو أي عالم آخر غير مسلم تجاوز هذا القدر من اقتراح طرق للدراسة.
ولما كان المصدر الأول لأوضاع الثقافة الإسلامية هو القرآن، فإنه من الأوفق أن ندرس ما في هذا النص المقدّس من أقوال صريحة، وآراء ضمنية، تتعلق بطبيعة الإنسان وأصله. كما أن استعراض العرف السائد في الجماعة الإسلامية الأولى قد يعمّق من إدراكنا لعبقرية الأخلاق الإسلامية، وللتقاليد الأولى التي استمدت منها تلك الأخلاق. أما ما أوجدته بعد ذلك من أقوال الشعراء والفلاسفة والفقهاء من المسلمين، فمن شأنه أن يضيف إلى الصورة الكلية ويزيدها وضوحًا. إذا نظرنا في القرآن وجدنا نصوصًا صريحة تقرّر أن الإنسان مدين بوجوده لله. فهو مخلوق من مادة سوّاها الله، كما يسوّي الخزّاف الطين، وهو مخلوق حي، لأنه مخلوق من الدم؛ والدم، كما هو الشأن في كل التفكير السامي، يمثل مبدأ الحياة، وهو تلقائي ومسير لنفسه إلى درجة ما. وقد ميّز الإنسان من سائر الأشكال الحية بأن الله ينفخ فيه من روحه. ولما كان الإنسان مخلوقًا، ومخلوقًا من تراب أو من طين، فلا يمكن أن يظن أنه مساوٍ لله في أي وجه من الوجوه، كما لا يستطيع هو نفسه أن يجرؤ على مناهضة السلطان الإلهي. والإنسان – باعتبار ما – من الأرض، فهو أرضي ومخلوق غير مستقل. إلا أن روح الله التي نفخت فيه تفصله عن سائر المخلوقات غير المستقلة، وتفضله عليهم، وتهب له علاقة فريدة بخالقه. إنه كائن قادر على السلوك العقلي، والحكم على الأشياء، والتقرير الإرادي، والاختبار الأخلاقي. والقرآن يدعم هذه الحقيقة الروحية بتقريره أن الله قد خلق الإنسان ليكون وكيله أو خليفته في الأرض. وقد أقيم الإنسان على الأرض ليسيطر على سائر المخلوقات التي جعلت خاضعة لإرادته.
إن من المسائل التي اشتد فيها الخلاف في التفكير الإسلامي مسألة الحرية الإنسانية إزاء القانون الإلهي، أو القضاء والقدر. وليس هذا مجال البحث في هذا الموضوع. ولكن يكفي أن نقول: إن في القرآن آيات صريحة تؤيد كلا الأمرين. فهناك آيات كثيرة تقرّر صراحة أو ضمنًا مبدأ الجبرية المطلقة. وأنا أرى أن استعراض الآيات المختلفة يتكشف عن الملاحظة التالية، وهي أنه حيث يكون الاهتمام موجهًا إلى الله فإن سلطانه المطلق الكامل يكون موضع تأكيد. وفي هذا السياق تعتبر أعمال البشر، خيرها وشرها على السواء، مسبّبة عن الإرادة الإلهية مباشرة، إذ أنه لا يحدث شيء ما لم يرده الله أو يأذن به، وأن مشيئة الله الأزلية الأبدية لتنفذ حتى في مسائل الاعتقاد وعدمه، فيهدي قوم إلى الإيمان، ويوجّه آخرون إلى الضلال. وأن إرادة الله هي العليا، فهو يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، ويصرف من يشاء إلى سبيل الكفر والضلال. هذا حين يكون الاهتمام موجهًا إلى الله، فأما حين يحول الاهتمام إلى الإنسان فإن التأكيد ينصب على أن الإنسان قد وهب له الله الحرية والمسؤولية الأخلاقية. فكل إنسان ذات أخلاقية حرة، وهو مسؤول أمام الله عن أفكاره وأحكامه وأعماله. وهذا هو الذي يجعله فردًا ذا مشابه من الله الذي هو الموجود الأسمى. والله يرشد الإنسان عن طريق الوحي إلى مبادئ أخلاقية عامة منبعثة عن إرادته الأبدية المقدّسة. إلّا أن في الإنسان قوة كامنة، إذ أن في استطاعته أن يتقبل هدى الله أو يتحول عنه. وفي السورة الثالثة والثلاثين آية هامة (رقم 72)[2] لا يتحقق معناها إلا على أساس التسليم بالحرية الإنسانية. فقد عرض الله على جميع مخلوقاته مسؤولية المحافظة على الإيمان، وإدارة العالم باسم الله، فقبِل الإنسان أن يحمل هذا العبء، في حين رفضته سائر المخلوقات خوفًا وإشفاقًا. ومع أن الإنسان لم يرع ذلك الإيمان، ولم يُدر العالم إدارة ذات قيمة، وسلك مسلك الظلم والجهل، فإن في هذا سر عظمته وخطيئته جميعًا. فلو لم يكن الإنسان حرًّا ما ارتكب الخطيئة، ولو لم يكن حرًّا ما ساغ أن يحمل الأمانة.
ولقد أصبح هذان الوجهان للنظرية الإسلامية موضع خلاف شديد عندما بُدئ في تقرير العقائد تقريرًا منهجيًّا: فذهب الأشعري السني مثلًا إلى استبعاد كل العلل الثانوية. وهذا المذهب – في محاولته إثبات أن القدرة الإلهية مطلقة – رأى في الأحوال والأفعال الإنسانية جميعها خيرها وشرها، تعبيرات مباشرة عن إرادة الله. غير أن التفكير الحديث كله يسير في الاتجاه المضاد لهذا. “فمحمد عبده”، و”محمد إقبال” يؤكّدان استقلال الإرادة الإنسانية. ولكن من الحق أن الحكم الأخلاقي الأخير لله، فحرية الإنسان تستتبع أن يكون الإنسان مسؤولًا أمام الله والسلطان الإلهي المطلق يظهر نفسه في التاريخ، أو فيما تتكشف عنه أحداثه.
إن التاريخ الإنساني متحرّك (دينمي). وهو – من أحد وجوهه – مجموع اختيارات البشر. إنه نتيجة استعمال الإنسان إرادته المستقلة بالإضافة على حكم الله على هذه الأحكام الإرادية. إن الكون يحكمه قانون أخلاقي. وهذا القانون لا ينفذ آليًّا، ولكنه نافذ حتمًا. إنه الحكم القاطع لإرادة الله على أعمال البشر. فإذا عصى البشر أوامر الله ونواهيه، ونبذوا وحي الله البين، وإذا خرجوا على المبادئ الأخلاقية الكلية، ذاقوا العواقب التي لا مفرّ منها. فالتاريخ – على هذا – نسيج مشترك من حرية الإنسان وحكم الله. وكثيرًا ما يشير القرآن إلى الماضي باعتباره شاهدًا على إرادة الله النافذة في شؤون الناس، وهو يتخذ هذا ذريعة إلى التأثير في أصحاب النفوس الخيّرة والنوايا الطيبة، كما يتخذه أساسًا للتأثير في المذنبين حتى يرعوا وحي الله، ويبدّلوا من طرقهم وفق مشيئة الله البيّنة.
ولما كانت إرادة الله هي الموجدة للبشر أجمعين، فقد ترتب على هذا أنه لا يفضل إنسان إنسانًا بشرف مولده، أو بنوع عمله، أو بجاهه في قومه. إن الإقرار بالمساواة الكاملة بين البشر باعتبارهم من خلق الله أمر من الأمور الأساسية في الإسلام، فليس فيه طبقات خاصة، ولا جماعات ممتازة، ولا أمم مختارة، إذ أن البشر جميعًا في أصلهم أمة واحدة (2: 209، 10: 20)[3]. والطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الناس أن يصنفوا أنفسهم هي نوع استجابتهم لله: هي القبول المخلص لهدى الله أو رفض وحيه. هذا المبدأ تتضمنه الأصول النظرية لشعائر الإسلام التي رمت إلى أن يكون الناس جميعًا سواسية أمام الله. ففي الصلاة يقف الأمير والسائل متجاورين يعبدان الله. ومن أغراض الصوم أن يكون وسيلة إلى أن يستشعر الناس، غنيهم وفقيرهم على السواء، خضوعهم لله، وأن يدركوا قسوة الجوع عندما يصيب الناس جميعًا على هيئة واحدة. وفي الحج يدخل المسلمون الحرم وقد ظهروا جميعًا في ثوب من قطعة واحدة، هو ثوب الإحرام، وهم بهذا يدركون أنهم في نظر الله متساوون متحدون، ويقضي على التمييز الطبقي والمالي اللذين يظهرهما الملبس. أما الزكاة فهي تجمع شيئين: عنصر عدم التعويل على المتاع المادي، والإحساس بالمسؤولية نحو خلق الله الذين تركتهم صروف الدنيا بلا ضمان. والزكاة في جوهرها نظام يقصد به التسوية بين الأفراد، وكذلك قوانين الميراث، رغم إساءة تطبيقها أحيانًا في مجتمعنا الحديث، تعبّر عن نفس المبدأ، مبدأ التسوية الاقتصادية. فليس لأي رجل أن يرث ثروة أبيه كلها، أرضًا كانت أو منقولًا، بل عليه أن يقتسمها وإخوته (وأهل قرابته طبقًا لنظام معين). وأخيرًا لما تطور التشريع، وجد مبدأ يمكن أن يكون له القدرة على إخماد النزاعات الاستبدادية لبعض الحكّام أو الفقهاء، ذلك هو مبدأ الإجماع، في نظر الدقة الفقهية، مقصور على ذوي الدراية من الفقهاء، فإنه يحمل في طواياه بذرة مبدأ ديمقراطي. وكان له أحيانًا عند التطبيق – كما يذكر “إقبال” – أثر كبير في التعبير عن إجماع صفوة قليلة. أما ما يقع من الأفراد من إساءة استعمال للقوانين، أو من عثرات أخلاقية، فإن الإرادة العامة تقوّمه، أو من شأنها أن تقوّمه، مع مرور الزمن.
رأينا كيف يعد الفرد مهمًّا لأنه وحدة من القوة الأخلاقية. وفي العرف الإسلامي تصور آخر يتعلق بالفرد في الجماعة، ويمنح الناس وسيلة للترابط، وإحساسًا بالاتحاد لا يوجد أحيانًا في التصورات الغربية الحديثة للإنسان. هذه الشخصية المتحدة يعمل على تكوينها التصور الخاص “بدار الإسلام”، أي تآخي المؤمنين. وليس هذا التصور مجرّد تفكير نظري، إنه واقع غير محسوس يضفي على كل مسلم شعورًا بالترابط الوجداني مع كل مسلم آخر، كما يهبه إحساسًا بالأمن. فهو ينتمي إلى كلٍّ يعلو على فروق اللون، والطبقة، والجنسية (بالمعنى الغربي للكلمة)، ونظم الدولة. إنه يستطيع أن يحس بأنه في داره في أرض شاسعة متناثرة من الساحل الأطلنطي لأفريقيا إلى قلب المحيط الهادي، حيثما كان الإسلام هو الدين السائد والثقافة الغالبة. كل هذا يخلق، أو هو قادر على أن يخلق، روحًا جماعيًّا، ووحدة بين شعوب لها أهمية بالغة. ولكن مما يؤسف له أن شعور التماسك الذي تمنحه “دار الإسلام” لم يحل في جميع الأحوال دون إراقة الدماء والصدام بين فرق من العالم الإسلامي. وينبغي أن نذكر أن هذه الأخوة تظهر أقوى ما تظهر عندما يهدّد العالم الإسلامي، أو أي قسم من أقسامه، مصدر غير إسلامي، وأنها تجنح أن تنسى حين لا يهدد الجماعة خطر وشيك من الخارج. ومع ذلك فهذه الرابطة قوة حقيقية، وفي الإمكان أن تصبح عامل تقوية في العالم الإسلامي كله.
ولننتقل الآن إلى تصور بعض المحدثين للإنسان. وأنا أحب أن أعرض بإيجاز لمحمد عبده، ومحمد إقبال، وضيا كوك آلب.
يؤكّد كل من “محمد عبده”، و “محمد إقبال” استقلال الإرادة الإنسانية. وقد تعرّض “محمد عبده” لهذه المسألة عند حديثه عما درج عليه الغربيون من نسبة ما قد توجد في البلاد الإسلامية – من أي تأخر أو جمود – إلى العقيدة الراسخة في نفوس المسلمين، في القانون الإلهي أو القضاء الأزلي. فبعد أن يسلّم “محمد عبده” بأن العامّة قد اصطبغ تفكيرهم بالقدرية المأخوذة من فكرة الجبر، أو القضاء، يؤكّد أن مفكّري المسلمين من جميع الفرق يعتنقون مذهب حرية الإنسان في الاختيار. وهو يقرّر في رسالة التوحيد أن الإنسان يدرك أعماله الاختيارية، ويزن عواقبها بعقله، وينسب إليها القيم عن طريق إرادته، ويقوم بها بدافع في نفسه. وأيًّا ما كان فالإنسان يعلم بالتجربة أن هناك قوة أعظم من نفسه هو مسؤول أمامها. وعندما يقول القرآن: “…. ما تصنعون”، و “… بما كسبت أيديكم” فإن قوله هذا يتضمن المسؤولية، ومن ثم – الحرية اللازمة – لأنه لن يكون ثمة عدل في اعتبار الإنسان مسؤولًا عن أعمال وأحوال تفرضها عليها إرادة أو قوة خارج نفسه. ويستدل “محمد عبده” على هذا بمبدأ “المجاهدة”. فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾[4]، يبين أن هدى الله ميسّر لمن يجاهدون في سبيل الاهتداء إلى الحق والخير والصواب. وكما أن الناس تحكمهم في حياتهم الاجتماعية قوانين خاصة كذلك تحكمهم في كل مكان وزمان قوانين الله الخلقية. والناس قادرون على معرفة هذه الشرائع الإلهية بالتدبّر، وعن طريق الوحي. ولكنهم أحرار حين يعملون بها، أو يخرجون عليها، كحريتهم في إطاعة القوانين الدنيوية أو عصيانها، وإذا خرقوا القانون فهم معرّضون في كلتا الحالتين، لقضاء السلطة الأخلاقية وعقابها. والأمم تصل إلى الرفعة، أو تقصر دونها، حسب اختياراتها الأخلاقية الإرادية، أو حسب الاتجاه الأخلاقي العام لسياساتها الاجتماعية. وهكذا فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾[5]. يتضمن أن النظام الذي رسمه الله يقوم على قانون العلة والمعلول، ولكن اختيار الطريق والمسؤولية ملقيان صراحة على الناس بسبب حريتهم التي منحهم الله إياها. والله ينفذ مشيئته في الحياة عن طريق دفع الناس بعضهم ببعض. ومع ذلك ففي هذا التدافع التاريخي يستطيع الإنسان أن يهتدي بالتجربة إلى سبيل الحق والصواب (سورة 2، الآية 251)[6]. لقد وهب الله الإنسان الحس والعقل، وفي هذين الكفاية ليستكشف ما هو ضروري للمحافظة على النفس، وليميز الصواب من الخطأ. وقد وهب الإنسان كذلك العاطفة والشعور اللذين يدفعان إدراكه العقلي، ووهب الإرادة الحرة ليتصرّف فيما يصل إليه العقل الذي تغذيه العاطفة.
أما “محمد إقبال” فإنه يذهب إلى أبعد من هذا في إثبات خصوصية الذات الفردية وسلطتها. ولما كان إقبال من أتباع مدرسة برادلي Bradly فهو يعنى بتقرير صدق الإدراك الباطني للإنسان وطهره، ويرتب على هذا تأكيد المسؤولية الأخلاقية المستقلة لكل كائن إنساني. وقد وجد أن القرآن يعبّر عن هذه الفكرة أوضح تعبير، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً﴾[7]، و ﴿… وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى …﴾[8]، و ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾[9]. وهكذا فالذات خاصة، فريدة، متميّزة من سائر الذوات من حيث استقلال الإرادة والمسؤولية. وملذات كل إنسان وآلامه خاصة به وحده. نعم قد يسرّ الغير لسروره ويألمون لألمه، ولكنهم لا يأخذون بنصيب من هذه الملذات والآلام بأي حال من الأحوال. بل ليس في نظام الله أن يشعر الإنسان، أو يحكم له، أو يختار من أجله عندما تتشعب أمام هذا الإنسان طرق العمل. فشخصية الإنسان غاية موجهة. وهذه الطبيعية التوجيهية للذات المحدودة مشتقة من قدرة الله التوجيهية، ونابعة منها. فالله عندما نفخ في الإنسان من روحه وضع ظلًّا من هذه الخاصة الجوهرية الفريدة التي تتصف بها طبيعته هو. إن الذي يقنع “إقبال” بقدرة الإنسان الفرد على أن يكون علة شخصية هو تجربة الإنسان الضرورية في الفعل الغائي، في المجاهدة في سبيل غايات، وفي بلوغ غايات. فهذه الرقابة التوجيهية هي التي تجعل من الإنسان موجودًا شخصيًّا حرًّا على صورة الذات المطلقة. فالله، “الذات المطلقة”، قد أذن بظهور ذات محدودة قادرة على العمل الخاص، بل سبَّب ظهور هذه الذات، التي تتمتع بحريتها بإذن من إرادة الله العليا. ويؤيّد إقبال رأيه هذا مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾[10]، وبقوله جلّ شأنه: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾[11].
ويقول إقبال، في معرض حديثه عن عقيدة ألـ “تقدير”: إن مصير أي شيء أو أي شخص ليس “قضاء صارمًا يعمل من خارج كأنه سيد آمر”، بل إنه “الغاية الذاتية لشيء من الأشياء، إنه إمكانياته التي يمكن إدراكها”، والتي قد تحقق نفسها “دون أي شعور بإكراه خارجي”. وإذن فقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾[12]؛ يعني أن كل مخلوق قد وهب “إمكانية محددة” هو “حر في تحقيقها أو عدم تحقيقها”. ويرى “إقبال” في قدرة الإنسان على الخلق دليلًا على حريته، لأن كل نشاط خالق يجب بالضرورة أن يكون حرًّا، فالخلق يقابل التكرار الذي هو صفة الفعل الآلي. وهكذا يرفض “إقبال” كل الصور المتطرفة من فكرة القضاء الأزلي سواء أنسبت إلى تقدير الله أم إلى الضرورة الآلية.
ويرجع عنصر القدرية في التفكير الإسلامي إلى ما حدث من فرض التفكير الفلسفي اليوناني على الآراء الدينية الأصلية للإسلام. فإن فلاسفة المسلمين لما عرفوا ما في التراث اليوناني القديم من الوصول، عن طريق سلسلة من العلل، إلى علة أولى نهائية، مالوا إلى اعتبار العلة الأولى المطلقة، العلة الوحيدة، ومن ثم أنكروا وجود الأسباب الثانوية الوسيطة جاعلين الله المنشأ الوحيد المباشر لكل ما يحدث في الكون. وقد عجل عاملان آخران بنمو عقيدة القدرية: أحدهما المصلحة السياسية التي كانت تستهدف تسويغ الأخطاء السياسية بإضافتها إلى ما خطه الله في قضائه، والآخر ما أصاب الإسلام نفسه من تناقص في قوته الحيوية الدافعة، هذا التناقض الذي أحدث ضعفًا وجمودًا يوافقان الإيمان بالقضاء والقدر.
ومن مناقشة علاقة الإنسان (الذات المحدودة) بالله (الذات المطلقة) استخلص إقبال نتائج أخرى عندما بحث فكرة الخلود. رأى إقبال أن بدء الذات الإنسانية في الزمن يوافق ظهورها في العالم المحدود مكانًا وزمانًا. ولكن هذه الطبيعة المحدودة ستقترب عن طريق وحدانية فرديتها التي لا يمكن أن يحل محلها شيء، من الذات اللانهائية لترى بنفسها عواقب أفعالها الماضية، ولتحدّد إمكانياتها المستقبلة. ويعتمد “إقبال” على قوله تعالى: ﴿… وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ * وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾[13] – فيما يقرّره من أنه “لن يصل ذاته بالذات اللانهائية” إلا من ارتقى على الدرجات العلى من السيطرة على النفس، (وتلك هي الإنسانية الكاملة)، باتباع…. أن الطريق ممهد أمام الإنسان ليأخذ مكانه في سر الكون…. وهذا الخلود الشخصي لا يناله الإنسان لأنه حق من حقوق… لا يتيسر الوصول إليه إلا بالجهد الشخصي؛ والعمل، … هو مقياس الوصول إلى الخلود. ويدعم إقبال رأيه هذا … قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾[14].
ولو تقدمنا خطوات في تحليل آراء هذين المفكّرين لوجدنا أنهما يقرّان أن للإنسان ما يمكن أن نسميه طبيعة ثنائية… إنسان محدود وحر معًا، هو خاضع للضرورة إلا أنه يتغلب عليها… الطرق. وأن شيئًا من مناقشاتهما ليذكّرنا ببحث رينولد نيبور…. Reinhold الشامل في كتابه “طبيعة الإنسان”…. فمحمد عبده يقول: إن الإنسان مدرك أن نفسه قد خلقت وهي تحتوي معلومات غير متناهية، وأنه يتطلع إلى لذائذ غير محدودة ولا يدرك غاية، وأن في قدرته السمو “لدرجات من الكمال لا تحدّدها أطراف… والغايات”[15]. ولكنّ الإنسان معرّض كذلك لمقاساة جموح وأهواء ونزوات الأمراض على الأجساد، وعرضة المطالب والحاجات. والإنسان يبحث عن الحق بدافع فطرته ولكنه – بدافع من إرادته الذاتية – يقلب الباطل حقًّا، هو مخلوق عجيب في شأنه. فهو “يصعد بقوة عقله إلى أعالي الملكوت، ويطاول بفكره أرفع معالم الجبروت. ويسامي … عن أن يسامى من قوى الكون الأعظم، ثم يصغر ويتضاءل إلى أدنى درك من الاستكانة والخضوع”[16] (رسالة التوحيد محمد عبده).
وكذلك إقبال، يصف الإنسان وصفًا مشابهًا: يصفه بأنه جم المواهب، قادر على التفكير، والتدبير، واستهداف الأغراض، والعمل المبدع. ولكن الإنسان، مع ذلك، يجد نفسه على الدرك الأسفل من سلّم الحياة، تحيط به قوى معوقة من كل الجهات. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾[17]. وهذا يدعو الإنسان إلى ألا يقر له قرار، فهو دائمًا يبحث عن مجال جديد للتعبير عن نفسه، وهو بهذا يضر نفسه. ولما كان الإنسان أسمى من الطبيعة فقد حمل أمانة أبت الطبيعة أن تحملها (سورة 33، الآية 72)[18]. وهذا الفضل في الحرية هو نفسه الذي يسبّب تردّي الإنسان. والإنسان قادر على تشكيل قوى الطبيعة وتوجيهها ولكنها تهزمه أحيانًا. وهو عندئذٍ يقيم عوالم روحية رحبة داخل وجوده الباطن، ويتمكّن بهذا من أن يسمو على الطبيعة. والإنسان يشكّل مصيره ومصير الكون بأن يلائم بين نفسه وبين قوى الكون حينًا، وبأن يكفي قوى الكون وفق غاياته وأغراضه حينًا آخر، وهو بصنيعه هذا ينمو روحيًّا. من هنا تأتينا الفكرة – ولو أننا لم نجدها مقرّرة في أي مكان بصورة واضحة – من أن الخطيئة الإنسانية، لا ترجع إلى قصور طبيعة الإنسان المحدودة، بل إلى فضل حريته، وخروجه عن نفسه. إن الإنسان يتردّى عندما يداخله الزهو بنفسه، ويكتفي بذاته. وقد أيد القرآن هذه الفكرة في غير موضع، وحسبنا أن نستشهد بهذين القولين الكريمين: ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[19]، و ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾[20]. ولما كان الإنسان – إذ يترك وشأنه، دون هداية يتلقاها من الله، ودون اعتماد منه عليه – يتخبط في الظلم، ويداخله الزهو الباطل، فقد احتيج إلى الوحي لتصحيح ضلال عقله، وزيغ إرادته.
وكذلك كان الخطأ الفردي ذا خطر كانت القوة المقوّمة من جانب الدولة ضرورية، على شريطة أن تكون الدولة نفسها قد بلغت إرشاد الله، والدولة في رأي محمد عبده ومحاولة لوضع مبادئ الله المثالية في أشكال مكانية زمانية. فالدولة تتطلع إلى تحقيق هذه المبادئ في تنظيمات إنسانية محدّدة. ويؤكّد محمد عبده أن الإسلام ثيوقراطي بهذا المعنى وحده، لا بمعنى أن على رأسه دائمًا خليفة لله على الأرض معصومًا. فالحاكم البشري عرضة دائمًا لأن يخفي إرادته المطلقة وراء ستار عصمته المدعاة.
ويجدر بنا أن نعرض هنا لمفكّر مسلم آخر، لما في فلسفته عن الإنسان من سمات مميزة. وأنا أعني الشاعر التركي، عالم الاجتماع الفيلسوف “ضيا كوك آلب”[21]، الذي يرى كثيرون أنه واضع الأسس النظرية للدولة التركية الحديثة. ولا يتسع هذا المقال لكي نعرض بالتفصيل لنظرية “كوك آلب” الاجتماعية كاملة. ولكن نذكر بعض الجوانب المثمرة من تفكيره. وأنا مدين بهذا الجزء من مقالي لكتاب أوريل هايد Uriel Heyd “أصول الوطنية التركية” Foundations Tursh Nationalism.
رأينا أن “محمد عبده”، و “محمد إقبال” يبرزان الأهمية الأخلاقية للفرد في المجتمع، ولكن “كوك آلب” يعكس هذا الوضع، فهو يرى أن الفرد لا يسمو إلى أعلى درجات رفعته إلا داخل مجتمع قوي. فالفردية والاستقلال الشخصي خاصان بالمراتب الدنيا من الحياة الإنسانية. إنهما مرتبطان بتكوينه الجسمي، وهما نتاج طبيعته الحيوانية والحسية. والفرد لا يصل إلى أقصى ما يمكن لشخصيته أن تبلغه إلا حين يتحرر من فرديته الحيوانية، ويفقد نفسه في الوعي الاجتماعي الكبير. إنه في هذه الحال يصبح إنسانًا حقًّا. وكوك آلب يعرّف الشخصية بأنها “مجموع الأفكار والمشاعر الموجودة في وعي المجتمع، والمنعكسة في وعي الفرد”. إن الفردية تعني عدم وجود المثل العليا، وهي أصل الانحلال الأخلاقي، والجمود، واليأس. أما الجماعية Collectivism وهي اندماج الأفراد في وحدة كلية لها إدراك جماعي، فهي المنبع الوحيد للمثل وللتقدم. ولقد صاغ “كوك آلب” جماعيته هذه تحت تأثير دوركايم Durkheim، ولكن الأصل الروحي لهذه النظرية قائم في العرف الإسلامي الخاص بأخوة المؤمنين، وتساويهم. وقبل أن يتأثر “كوك آلب” بدوركايم كتب قصيدة تعبّر عن الشعور بالعمل كما يتمثل في الوعي الجماعي، قال فيها:
“إن القوم الذين يجاهد كل منهم في سبيل غرضه وحده قد صاروا اليوم إخوة متحدي القلوب. لقد ولت الأثرة، وعم قلوبهم شعور جماعي”.
إن الشخصية الإنسانية لا تصل إلى مرتبة القداسة إلا حين تصبح حاملة “للوعي الجماعي”، عندما تفقد نفسها كل الفقد، بطريقة صوفية وتفنى في الوعي الأعم، وعي المجتمع. وعلى الرغم من أن “كوك آلب” كان يميل أول الأمر إلى أن يسوّى هذا الوجود الاجتماعي، الذي يخضع الفرد نفسه له، بالجماعة الدينية، إلا أنه قرّر بعد ذلك أن هذا مرحلة انتقالية من مراحل التطور، وأن المرحلة الأخيرة تحل عندما يجد الفرد نفسه ممتزجًا بالوعي الوطني.
ويعرف “كوك آلب” كذلك بنظريتين – لهما تأثير في السياسة الاجتماعية، والفلسفة السياسية – كانتا ثوريتين في وقته، ولا تزال معظم بلاد العالم الإسلامي تعدهما بدعتين. أما الأولى فنظريته في قانون الشريعة الإسلامية، وأما الثانية فانتصاره للفصل بين الدين والدولة.
ميّز ضيا كوك آلب تمييزًا قاطعًا بين المبادئ الأخلاقية الأبدية السامية التي تبلغ الإنسان عن طريق الوحي الإلهي، وبين القانون الوضعي الذي هو محاولة لتطبيق هذه المبادئ على حالات خاصة وعارضة. إن المبادئ الأولى ثابتة ومطلقة، أما الثانية فإنها – بطبيعة الحال – نسبية، وعرضة للتعديل ولإعادة صياغتها وفق الأحوال المتغيرة للتاريخ المتحرّك (الدينمي). ولما كان من أصعب المشكلات التي تعرض لكل دولة إسلامية تقدمية تلك المشكلة التي تجيء من ضرورة جعل الشريعة ملائمة للأحوال المتغيرة، مع محاولة التزام التعاليم الخاصة الواردة في القرآن، فإنه يبدو أن هذا التمييز الذي قام به عالم الاجتماع التركي أهل لأن يُدرس دراسة ممحّصة[22]. إن أية محاولة بشرية لجعل المبادئ الإلهية الأبدية ملائمة لأحوال بعينها، لا بدّ محدثة تعديلًا وتغييرًا في تلك المبادئ الأبدية. أما أن تعتبر القوانين الخاصة مساوية لمبادئ مطلقة، فهو دائمًا مشوب بالخطر، خطر تناول خير نسبيّ وقتي صاغه عقل بشري، ودمغه بالطابع النهائي، طابع القبول الإلهي. وهذا زهو وغرور ما بعدهما في بطلانهما شيء. لقد هيأ علم الفقه الإسلامي عدة مبادئ لتحقيق هذه الملاءمة هي الإجماع، والقياس، والاستحسان، وهي جميعًا صالحة، ما لم ترسم نتيجة هذا الجهد بكمال لا تتصف به إلا المبادئ الأخلاقية العامة الصادرة من الله، والتي تبلغ الإنسان عن طريق الوحي والإلهام. وأن هذه المبادئ الإلهية الماثلة دائمًا قدام الإنسان وخلفه، تدفعه إلى الأمام وإلى أعلى، كما أنها تحاسبه عندما يخفف من خطوه ويزعم أنه قد بلغ.
أما النظرية الثانية الجريئة التي قدمها كوك آلب فهي مبدأ الفصل بين الدولة والدين. ودعواه أنه في الأيام الأولى من الإسلام لم يكن رجال الدين – أو العلماء – عاملين في الحكومة. ولم يصبح لهم وضع رسمي، ولم يدخلوا في إدارة الدولة إلا بعد جيل أو جيلين. وإذا كان هذا قد أضاف إلى سلطانهم على سياسات الحكومة شيئًا كثيرًا، فإنه جردهم من الاستقلال الضروري للتأثير الديني النقدي على المجتمع. وقد نادى “كوك آلب” بالرجوع إلى الوضع الأول في سبيل إنشاء حكومة سليمة، وحياة دينية فعالة. ويبدو أن محمد عبده كان يمكن أن يوافق على هذا من حيث المبدأ، فهو – كما رأينا – قد رفض الفكرة الثيوقراطية إذا كانت الثيوقراطية تعني حكم رجل أو رجال يعتقدون أنهم خلفاء معصومون لله على الأرض في شؤون الاعتقاد والسياسة الاجتماعية. أما إن كانت الثيوقراطية محاولة الناس المستمرة لتشكيل نظمهم الدنيوية في أقرب صورة مستطاعة إلى مبادئ الله المثالية – كما اقترح “محمد عبده” – فإن هذا الأمر يمكن أن يخدم خدمة أكثر إنتاجًا على يد هيئة دينية مستقلة. فهذه الهيئة تظل دائمًا متنبّهة لأفضل الطرق لتعديل البناء الاجتماعي والسياسي، بحيث يتمشى والمبادئ الأبدية، ولن تغري مطلقًا بالاحتفاظ بالوضع القائم في سبيل مصالح أو امتيازات مكسوبة. ويبدو أن من أصول الدين الفعال أن يحرّر نفسه من إغراء استعمال السلطة الزمنية. إن فصل الدين عن الدولة لا يعني بالضرورة مجتمعًا دنيويًّا، ولو أنه قد نتج عنه هذا أحيانًا. فإذا كانت القوى الدينية يقظة وذات نفوذ فلن تضطر إلى الاعتماد على السلطة الزمنية لتندمج آراؤها في البناء الاجتماعي. إن المجتمع السليم في نظر الله هو المجتمع الذي يبلغ من اقتناع غالبية أفراده بصلاح المبادئ الأخلاقية والروحية أن يجاهدوا دائمًا في أن تكون جميع أعمالهم مطابقة لمقتضيات قانون الله الأخلاقي. وما لم يقتنعوا هذا الاقتناع فلن تفلح قوة مباشرة شرعية، أو سياسية، يصطنعها رؤساء الدين، في إجبارهم على الموقف الصحيح. إن على الجماعة الإسلامية اتجاه هذه القضية أن تبحثها على الأقل، وألا تقبلها أو ترفضها دون أن تفحص إمكانياتها فحصًا دقيقًا.
ما النتائج العامة التي يمكن استخلاصها من هذا العرض السريع؟ إن الحضارة الإسلامية ذات أساس متين يمكن من الإصلاح في ميدان السياسة الاجتماعية، فإن ما في نظام الإسلام الأساسي من مساواة ومن ديموقراطية يصلح أن يتخذ باعثًا مناسبًا على أية حركة اجتماعية ترمي إلى التخفيف من الحرمان والضعف اللذين تعانيهما أية طائفة داخل الجماعة سواء أكانوا نساء أم فلاحين، وسواء أكانوا من ذوي الحرف الصغيرة أم من العمال الصناعيين. وحيثما أنتج النظام الطبقي للمجتمع أقلية غنية وأغلبية ساحقة من الفقراء، فإن المصلحين يستطيعون أن يعتمدوا على المبادئ الأخلاقية الأساسية في الإسلام في المطالبة بإصدار تشريع يكون من شأنه رفع مستوى معيشة الفقراء، ومنح طبقات المجتمع كلها فرصًا متكافئة في التعليم، وفي الدخل المناسب وفي التعبير الاجتماعي.
وفي الميدان القانوني يستطيع المجتمع الإسلامي أن يدرك – وهو مطمئن – أن وراء جميع القوانين الإنسانية قانونًا إلهيًّا ثابتًا. وليست القوانين الإنسانية في أحسن صورها إلا تقريبًا للقانون الإلهي، وهي لهذا يحكم عليها بالقصور، ويتضح قصورها، عندما تقاس بما تقرره الإرادة الإلهية من مطلقات. وهذا من شأنه أن يشعر المشرّعين بالحرية في أن يعدلوا، ويحسنوا، وأن يلائموا بين قوانينهم وبين الأحوال المتغيرة التي تواجههم في العالم الحديث، متذكرين دائمًا المبادئ الخالدة: مبادئ المساواة، والعدالة، والرحمة، التي هي من جوهر حقيقة الربوبية، ومشيئة الله للناس. كما أن من شأنه أن يحرّرهم من خشية تجربة قوانين أخرى لئلا تكون مبطلة للشرائع الإلهية، فإن جميع الصياغات اللفظية نسبية، ومن ثم غير معصومة، لأنها ثمرة عقول بشرية ولأنها تعدل لتوافق أحوالًا خاصة.
أما في الميدان السياسي فإن العالم الإسلامي في وضع يسمح له أن ينمي فلسفته الخاصة المتميزة، دون أن يدفعه التقليد الأعمى إلى اتباع الأشكال الشيوعية، أو النظرية السياسية الغربية التي تتجه إلى الفردية الذرية. لقد رأينا أن الإسلام يعترف بالقيمة الذاتية للأفراد باعتبارهم مدينين بوجودهم لله، ومسؤولين أمامه عن أعمالهم. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي فرد أن يندمج اندماجًا كاملًا في بناء جماعي قاهر مثل البناء الشيوعي. إن الشيوعية – من الوجهتين النظرية والعملية – تستغني عن الفرد إن لم يخدم غرض الدولة، أو إن لم يتبع طريقة الحزب دون نقاش. وهذا لا يمكن أن يكون في مجتمع إسلامي كالذي تصوره “محمد عبده” أو “محمد إقبال”. كما أن الإسلام لا يمكن إطلاقًا أن يتفق والجبرية الاقتصادية أو التفسير المادي للتاريخ اللذين يعتبران أساسيين في المذاهب الماركسي. فالإنسان لا تتحكّم فيه المادة أو القوى الاقتصادية، إذ أنه في جوهره موجود روحي، ذو صلة بالله، ومن ثم كان كائنًا أخلاقيًّا حرًّا. وأن الله – لا المادة – هو المتصرف في الحركات التاريخية.
على أن في التصور الإسلامي للإنسان اتجاهًا جمعيًّا. فإدراك الإنسان أنه ينتمي إلى كل أكبر، وارتباطه بغيره ممن ينتمون إلى نفس الجماعة التي تؤمن إيمانه، يهيئان للحيوات الفردية وضعًا اجتماعيًّا ليس له في الغالب وجود في الغرب الذي ينزع إلى الفردية. فالأخوة في الإسلام تهب قوة، وأمنًا، ومجالًا من الوعي المشترك قد ينتج عنها ذلك النوع من الترابط الذي يتجاوز حدود الأوطان والأجناس، والذي يعمل الناس متلهفين في سبيل تحقيقه في سائر بلاد العالم، مجاهدين ضد العقبة الوحيدة العجيبة التي ظهرت في القرن الماضي، عقبة التقسيم إلى دول وطنية ذات سيادة. إنه لو أمكن إثارة التماسك الإسلامي في سبيل أغراض إيجابية، وتكتيل الأمم الإسلامية الكثيرة المختلفة في وحدة حية، لأمكن أن تصير هذه الوحدة قوة إيجابية في العالم. بل إن هذه الوحدة لتكون أكثر فاعلية إذا أدخلت في نطاقها من سواها، وإذا بلغ من سماحتها أن تشرك في وجدانها وفي أخوتها كل مخلوقات الله. ما أروع أن تحتج باكستان على مظالم حلب بأمة أخرى، شديدة البعد عنها جغرافيًّا، لأن تلك الأمة تنتمي إلى جماعة الأمم الإسلامية! وأروع منه وأجدر أن يضيء طرقًا جديدة في عالمنا الذي مزقته الحرب، أن تنهض أمة إسلامية – باسم المقاصد الحقة التي يوجه إليها الله الواحد، وباسم الرابطة التي تربط بني الإنسان – محتجة على ظلم أصاب أي شعب، ولو كان خارج الكتلة الإسلامية.
ولما كنا نتكلم عن الوطنية في مقابل العالمية فمن الخير أن نذكر أن الوطنية المتجزّئة هي ما يسميه “توينبي” (Toynbee) زيغًا من الغرب. وهذه الوطنية لم يصبح لها وجود في العالم الإسلامي إلا بالوراثة عن عصر الاستعمار. وهكذا ظهرت في الشرق الأوسط أوطان كثيرة تطابق خطوط تحديدها حدود مناطق النفوذ التي كانت – فيما سبق – تدعيها لنفسها قوى استعمارية أوروبية مختلفة. إن بين هذه الأوطان الآن تنافسًا وتحاسدًا، على حين أن الذي يجب أن يكون في دار الإسلام هو الوحدة.
بقيت كلمة أخيرة نقولها عن المسألة الخلافية، مسألة فصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية للدولة. لقد سار الغرب في هذا الطريق وخرج منه بنتائج مختلفة. ففي بعض الأحوال كانت النتيجة تقليل سلطان الدين ووطأته على الحياة الدنيوية المشتركة للأمة. وكانت النتيجة في حالات أخرى حماية الأقليات الدينية من ضغط الأغلبية الدينية القوية سياسيًّا. كذلك كان من آثارها تقدم إطلاق الحرية للمنظمات الدينية لتصبح وعيًا يقظًا في ضمير المجتمع، دون أن تغري ذلك الإغراء المخاتل المستتر، على إعطاء قدسية دينية إلهية للنظام القائم، وللطبقات المتسلطة التي تكون في وضع ممتاز. وهناك أثر آخر لفصل الدين عن الدولة: ذلك أنه أبطل إغراءً آخر شبيهًا بالسابق هو إغراء استعمال السلطة السياسية لفرض دين واحد على جميع أفراد الدولة. وربما كان القول القرآني الكريم: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾[23] ذا صلة بهذا الموضوع. إنه لو أمكن الإبقاء على الصلة بين الدين والدولة، دون أن يؤدي هذا إلى محافظة متعصّبة تجرح وتبطل أي فكرة أو نظرية جديدة، على أساس أنها معارضة للمبادئ الدينية المصطلح عليها، أو للعرف الديني المألوف، ولو أمكن كذلك أن تخلص الصلة بين الدين والدولة من العصبية ومن السياسة الاجتماعية الرجعية، لو أمكن هذا كله لكانت هذه الصلة قوة حقيقية في المجتمع. ومهما يكن من شيء فالظاهر أن التاريخ يدل على أن كل هذه الأخطار كانت قائمة حيثما كانت الهيئات الدينية تتدخل في الإدارة السياسية. وفي رأيي، إن على المخلصين والوطنيين من قادة المسلمين أن يزنوا أدق الوزن ما لهذا الموضوع وما عليه قبل أن يبرموا قرارهم في شكل متحجّر يصبح من العسير نقضه.
أما من حيث العلاقات الدولية، فإن الأمم الإسلامية، أو الجماعة الإسلامية الكبرى، يجب أن تكون في طليعة المنتصرين لخلق نوع من المجتمع العالمي من الأمم، ومن العاملين على إيجاد مثل ذلك المجتمع الذي ينظمه ويسيطر عليه قانون دولي، كما أوضح ذلك خير إيضاح الأستاذ نورثروب Northrop في كتابه “رياضة الأمم” (Taming of the nations).
[1] – “The Muslim doctrine of its Bearing on social policy and political theory” bye Harold B. Smith.
[2] ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾. (سورة الأحزاب، الآية 72).
[3] لعلّ الباحث يشير إلى الآية 213 من “سورة البقرة” وهي قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ…﴾.
وإلى الآية 19 من سورة “يونس” وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.
[4] سورة العنكبوت، الآية 69.
[5] سورة الرعد، الآية 11.
[6] يشير الكاتب إلى قوله تعالى: ﴿… وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾. (سورة البقرة، الآية 251).
[7] سورة مريم، الآية 95.
[8] سورة الأنعام، الآية 164.
[9] سورة المدثر، الآية 38.
[10] سورة الكهف، الآية 28.
[11] سورة الإسراء، الآية 7.
[12] سورة القمر، الآية 49.
[13] سورة الزمر، الآيتان 69و 70.
[14] سورة الشمس، الآيات 7- 10.
[15] محمد عبده، رسالة التوحيد، تعليق: السيد محمد رشيد رضا، (مصر: دار المنار، الطبعة العاشرة، سنة 1361)، الصفحة 106.
[16] وبقية هذا الكلام: “…. متى عرض له أم ما لم يكن………….يدرك منشأه ذلك لسر عرفه المستبصرون، واستشعرته نفوس الناس أجمعين”.
[17] سورة التين، الآيتان 4و 5.
[18] ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾. (سورة الأحزاب، الآية 72).
[19] سورة الإسراء، الآيتان 37و 38.
[20] سورة النمل، الآية 4.
[21] ولد ضيا كوك آلب بمدينة ديار بكر بالأناضول سنة 1867م. وبعد أن أتم دراسته في المدرسة الرشيدية (وشهادتها مقابلة لشهادة الكفاءة المصرية قديمًا) سافر إلى استانبول، حيث التحق بكلية الطب (القسم البيطري). ولما بلغ السنة الأخيرة بهذه الكلية طردته الحكومة منها لاشتغاله بالسياسة، فعاد إلى بلدته ومكث فيها إلى أن أعلن الدستور الثاني للدولة العثمانية سنة 1908 وقد سافر بعد الانقلاب إلى مدينة سلانيك (وكانت إذ ذاك من الولايات العثمانية)، وأصدر فيها مجلته المسمّاة “كنح قلملر” (الأقلام الفتية). ثم عاد إلى استانبول عقب نشوب حرب البلقان وعينته الحكومة مدرّسًا بجامعة استانبول، حيث قام بدور خطير في تنظيم الجامعة على نظام الجامعات الغربية. وقد أصدر كوك آلب ديوانين من الشعر سماهما “قيريل الما”، و “يكي حيات” (الحياة الجديدة) وعرض فيهما آراءه الخاصة في المجتمع التركي. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى نفته السلطات التي كانت تحتل الآستانة إلى جزيرة مالطة. ولما عاد منها سافر إلى ديار بكر، حيث أصدر مجلته المسمّاة (كوجوك مجموعة) (المجلة الصغيرة). وبعد الانقلاب “الكمالي عين رئيسًا للجنة التأليف والترجمة بوزارة المعارف التركية، وأصدر مؤلفاته المنظومة المسماة (تاريخ التمدّن التركي)، و (الضوء الذهبي)، و (أسس القومية التركية). وبعد انتخابه عضوًا في البرلمان المنعقد في أنقرة توفي سنة 1924.
[22] أبقينا عبارة المؤلف هنا بنصها لأنها تعبر عن وجهة نظر المشرّعين الأتراك في دولتهم الحديثة وقد سمعناها من بعضهم وناقشاناهم كما ناقشهم فيها كثير من أعضاء مؤتمر برنستون.
[23] سورة البقرة، الآية 256.
المقالات المرتبطة
النظرة الخصوصية سبيل إلى الإرشاد
ترجمة: خالد كريم لقد أصبحت التعددية الدينية أمرًا واقعًا في هذا العصر تمامًا كما جاء في سياق بشارة القديس
الإيمان والمعرفة
أعتقد أنّ هناك تمييزًا بين العلم والمعرفة، فعلى الرغم من أنّنا نسمّي رجال الدين علماء، غالبًا ما يُظنّ أنّ المعرفة دينيّة، بينما العلم يختصّ بالعلوم الطبيعيّة والتجريبيّة.
أيُّ “إسلامٍ”؟ استكشافُ المعاني الكثيرة للكلمة
عندما نبدأُ بمفهومِ الإسلامِ على أنَّه المصدرُ لكلِ الحقائقِ الأخرى يسهلُ علينا فهمُ سبب استخدام القرآنِ في بعضِ الأحيانِ كلمةَ “إسلام” لتعيينِ التسليمِ الجبريِّ الشامل لكلِّ شيءٍ في الكونِ