الضرورة في الفكر الديني والوضعي والفلسفي
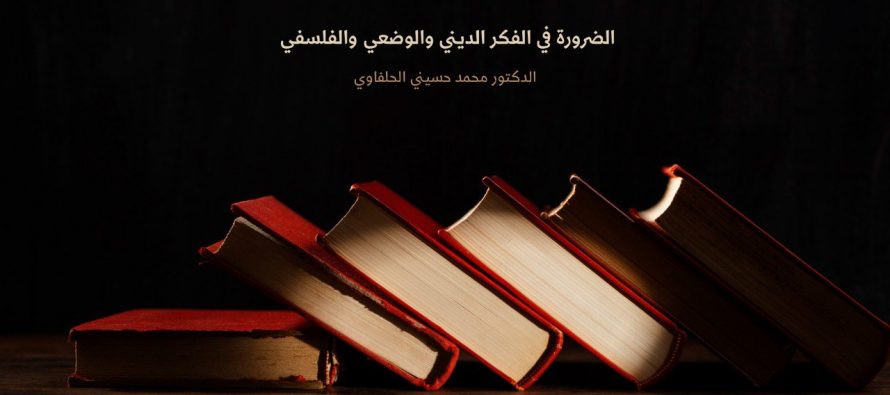
تعريف الضرورة لغة واصطلاحًا
الضرورة في معاجم اللغة العربية هي الحاجة والشدة والمشقة، وتوجد عندما تنعدم الفرص، ولا يجد المرء مناصًّا للجوء إلى الحاجة الضرورية المتاحة. الضرورة من الضرر، هي في الأصل مصدر ضر، يقال ضرّه ضررًا، وضرًّا، وضـرورًا. والاضطرار: افتعال من الضرر، وهو حمل الإنسان على ما فيه الضرر سواء كان الحامل من داخل الإنسان كالجوع والمرض، أو خارجه كالإكراه. قال ابن منظور: الاحتياج إلى الشيء، وقد اضطره إليه أمر، والاسم الضرة[1]. وقوله عز وجل: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾[2] ؛ أي فمن ألجئ إلى المحظور مثل أكل الميتة وما حرم وضيق عليه الأمر بالجوع، وأصله من الضرر، وهو الضيق. واصطلاحًا: يعرّف وهبة الزحيلي الضرورة بأنها أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين حينئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع[3].
وقد وردت الضرورة في القرآن الكريم بكل مشتقاتها ثمان مرات، كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[4]، والضرورة هو ما يحصل بعدمه الموت أو المرض أو العجز عن الواجبات، وهي من المصطلحات الشرعية التي يستخدمها الفقهاء والأُصوليون في الأحكام كقولهم: (الضرورات تبيح المحظورات). والاضطرار والضرورة بمعنى واحد عند الفقهاء.
الضرورة الفلسفية
الضرورة مصطلح عامي وفلسفي في آن واحد، فكثيرًا ما نستخدم الضرورة في حياتنا اليومية استخدامًا واسعًا، فنشير بها في الغالب الأعم إلى نوع من التأكيد على أشياء سوف تحدث، أو أمور سوف تتم بشكل حتمي، لا مناص من حدوثها.
إننا دائمًا ما نسلّم بأشياء، سوف نُصاب بدهشة شديدة لعدم حدوثها، فكلنا يعرف أن الشمس سوف تشرق في الصباح، وأن الليل آت لا ريب فيه، وأن الفصول الأربعة تتعاقب، وأن النار تحرق … وأن الموت ضرورة حتمية[5].
وهي تقترب من مفهوم الجبر، الذي ضد حرية الاختيار، وهو المعنى الفلسفي للضرورة التي تقود الشخص للتفكير في مصيره وحياته ذاتها، وكيفية حريته أو جبره على القيام بأفعاله، وهو التفكير، الذي نشأ مع الإنسان منذ صعود تفكيره، ولا يمكن تحديد زمن تكوّن هذه المسألة، لأنها من المسائل الفكريّة التي يتطلعُ لها كل إنسان لكي يحلها، سواء قَدِرَ عليها أم لا.
الضرورة في الفلسفة الإغريقية
كانت فكرة الضرورة مطروحة في الفلسفة الإغريقيّة، ثم طُرحت في الأوساط الإسلاميّة منذ العصر العباسي، وبحث عنها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون، كما وقع البحث عنها في المجتمعات الغربيّة الحديثة[6] حتى اليوم.
وقد تحدث عنها المفكّرون القدامى والمعاصرون، وفرّقوا بين الضرورة وقضيتي الجبر والاختيار، ولقد عرّف الفيلسوف والمؤرخ المسلم الشهرستاني الجبريين، بأنهم الذين يقولون: إنَّ الإنسانَ لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله: لا قدرة له، ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتُنسب إليه الأفعال مجازًا، كما تُنسبُ إلى الجمادات، كما يُقال: أثمرت الأشجار، وجرى الماء، وتحرّك الحجر، وطلعت الشمس وغربت، وتغيّمت السماء وأمطرت، واهتزت الأرض وأنبتت، إلى غير ذلك.
والثواب والعقاب جبرٌ، والأفعال كلها جبرٌ، قال: وإذا ثبت الجبر، فالتكليف أيضًا كان جبرًا[7]، ولكن فكرة الجبر ذاتها تقود لفكرة الضرورة، كما بحث عنها المتكلمون والفلاسفة والمفكرون عند كل الشعوب وكل الثقافات.
إن مصطلح الضرورة والحرية والجبر من المسائل التي شغلت الفكر الإنساني منذ فجر التاريخ، فكان الإنسان يبحث عن الضرورة الكامنة في الأشياء والطبيعة والكون والفكر، عن الضرورة للحياة ثمّ الموت.
ولقد تناولها فلاسفة اليونان الأوائل دون أن يدركوا معناها الواضح المحدد، إلا أن أول من تناولها بشكل واضح كان الفيلسوف اليوناني إنباذوقليس، الذي سمّاها “القسم الأعظم”، وتناولها من بعده الكثيرون من الفلاسفة في العصر اليوناني، وكان أهمهم ديمقريطس وأرسطو والمدارس المتأخرة، فقد تناولها كل منهم حسب مذهبه الفلسفي[8]، وانتقل مفهوم الضرورة بالتطور التدريجي إلى الفلاسفة الطبيعيين.
حيث ظهر لديهم من خلال فكرتين أساسيتين هما:
الفكرة الأولى: هي العلة المادية المتحركة سواء بذاتها، كما عند فلاسفة المدرسة الملطية وهرقليطس والذريين، التي جاءت وجهة نظرهم قريبة الشبه بما يقوله العلم الحديث على صورة تستوقف النظر فهم يعتقدون أن كل شيء مكون من ذرات atomos غير قابلة للانقسام يفصل بينها فراغ، وأن هذه الذرات أزلية يستحيل فناؤها، وستظل إلى الأبد في حركة دائمة.
والفكرة الثانية: كانت بواسطة مبدأ محرك منفصل عنها، كما عند إمبادوقليس وأنكساجوراس، إذ إنه لولا وجودها ما وجد شيء من موجودات الطبيعة، أو تغيّر بـفكرة القانون الصارم المتحكم في المادة وتغيراتها، سواء سُمّي هذا القانون بأسماء تتجلى فيها النزعة التشبيهية المتأصلة لدى الفلاسفة اليونانيين، كما عند أنكسمندر؛ إذ أطلق عليه اسم “العدالة”، وهرقليطس، الذي دعاه “باللوجوس”، إمبادوقليس، الذى سمّاه “القسم الأعظم”، أو سُمّي صراحةً “بالضرورة” كما عند الذريين[9].
الضرورة عند سقراط
لكن الضرورة لدى سقراط، فقد تجلت في آرائه الأخلاقية، التي تنفي حرية الإرادة والاختيار، وتصور الإنسان على أنه عقل فحسب، لا يريد إلا ما يقرر العقل صوابه، ولا يفعل الشر باختياره وإرادته وإنما عن جهل بطبيعة الخير، وقد أيّد أفلاطون آراء أستاذه سقراط تلك ولم يغير منها شيئًا، وإن كان قد أضاف عليها بعض التفصيلات التي تؤيد نفي حرية الإرادة الإنسانية ولا تنفيها، وأما في مجال الطبيعة، فقد آمن سقراط بفكرة العقل الإلهي المهيمن والمسيطر على كل كبيرة وصغيرة مما يحدث في الكون، وهذا العقل الإلهي يعدّ في حقيقة الأمر اسم جديد لمسمّى قديم وُجد حتى قبل ظهور الفلسفة الطبيعية ألا وهو فكرة القانون .
الضرورة عند أفلاطون
أمّا مفهوم الضرورة لدى أفلاطون فهو في مجالي الطبيعة والأخلاق، حيث تجلى فيهما تأثر أفلاطون بالفلاسفة السابقين عليه، إلّا أن هذا لا ينفي جدة كثير من آراء أفلاطون في هذين المجالين، ففي آرائه الطبيعية وإن كان قد أطلق اسم الضرورة على القابل، الذي هو العلة المادية، لوجود العالم المحسوس وموجوداته، إلا أن فكرة العقل المفارق المشكّل للمادة الصانع، وكذلك فكرة النموذج أو الصورة المثل، التي يحاكيها الصانع في تشكيله القابل، وكيفية إيجاد العالم المحسوس ذاته وما فيه من موجودات، إنما تعد مما يميّز أفلاطون عن الفلاسفة الطبيعيين.
وقد جعل أفلاطون كأستاذه سقراط للعقل الإلهي السيطرة الكاملة على ما يحدث في العالم المحسوس بعد تشكيله، وأما في مجال السياسة فإن آراء أفلاطون التي تتسم بالعمق والتطور النافية لحرية الإرادة الإنسانية في فعل الشيء أو تركه لا نجد لها نظيرًا عند من سبقوه من الفلاسفة اليونان[10] .
الضرورة عند أرسطو
كما نجد أن مفهوم الضرورة لدى أرسطو في مجالي الميتافيزيقا والفيزيقا، لم يختلف في مضمونه عما عناه هذا المفهوم لدى أفلاطون، وإنما تكمن جدة أرسطو وتفرده عن من سبقوه في فكرة الضرورة المنطقية المتمثّلة في العلاقة القائمة بين المقدمة أو المقدمتين، والنتيجة في الاستدلال بنوعيه، وكذلك في تصور القضية الضرورية وما يرتبط بها من استدلال مباشر وقياس .
إن أرسطو قد دافع في مجالي الأخلاق والسياسة عن حرية إرادة الفرد في اختيار ما يود القيام به من أفعال، وبالرغم من نفي أرسطو لحرية الإرادة والاختيار عن طبقتي النساء والعبيد في دولته، إلا أن هذا لا يتناقض مع اعترافه بحرية المواطنين الذكور الأحرار في دولته تلك؛ إذ إن أرسطو قد جمع في شتى نواحي مذهبه بين مفهومي الضرورة والإمكان .
الضرورة والحرية الإنسانية في الفكر الوضعي الحديث
الضرورة كما يتضح مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحرية الإنسانية للفرد، ومرتبطة أيضًا بمصير الأفراد الحياتية الشخصية والاجتماعية الجماعية.
ونجد ذلك عند الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا، الذي قال: “إن الشخص خاضع للضرورة والحرية مجرد اعتقاد وهمي”[11]؛ لأن الحرية وهم كما يؤكد سبينوزا، وذلك فيما يخص الشخص بين الضرورة والحرية، على أن لا وجود لحرية إنسانية، فالناس يعتقدون أنهم أحرار، لانهم يكونون على وعي بما يقومون به، إلا أن الحقيقة بخلاف ذلك، فالناس يجهلون الأسباب الحقيقية لأفعالهم، لذا فالشخص بين الضرورة والحرية، حسب سبينوزا، خاضع للضرورة ما دام محكومًا بعوامل لا متناهية في العالم المحيط به، وهكذا فإن الشخص لا يكون حرًّا إلا بتكوين فكرة متميزة عن عالم الضرورة، بحيث إن هذه الفكرة لا تعدو أن تكون سوى إدراك للأشياء وفق عالم الضرورة، يقول سبينوزا: “بقدر ما تدرك النفس الأشياء كلها على أنها ضرورية، تكون قدرتها على الانفعالات أعظم، أي إن خضوعها لها يكون أقل”[12].
الضرورة في الفكر الماركسي
أمّا في الماركسية، فقد تجلّت فكرة الضرورة، كما عبّر فلاديمير لينين عنها بقوله: “الضرورة عمياء طالما هي لم تعرف، ولكن إذا عُرفت الضرورة، وإذا عُرف القانون، وإذا أخضعنا فعله لمصالحنا، فإننا أسياد الطبيعة”.
وقد كتب فريدريك إنجلز من قبله في مؤلفه “ضد دوهرينغ”، والذي كان هذا الكتاب مساهمة إنجلز الرئيسية في شرح وتطوير ترجمة العنوان الكامل لثورة السيد أوجين دوهرنغ في العلوم، ولقد قام أوجين دوهرنغ بتطوير نسخته الخاصة من الاشتراكية، لتكون بديلًا عن الماركسية، بما أن كارل ماركس كان مشغولًا في ذلك الحين بتأليف كتابه رأس المال.
فقد تولى إنجلز كتابة دفاع عام عن فكر ماركس، يقول إنجلز: “لا تكمن الحرية في الاستقلال الموهوم عن قوانين الطبيعة، وإنما في معرفة هذه القوانين، وفي الإمكانية القائمة على هذه المعرفة لإرغام قوانين الطبيعة بصورة منهاجية على الفعل من أجل أهداف معينة”[13]، وهذا القول يصح بالنسبة لظواهر الطبيعية والحياة الاجتماعية، فقبل ظهور الماركسية، لم تكن قوانين التطور الاجتماعي معروفة، وقد بقي الناس عبيدًا للضرورة التاريخية، والماركسية كشفت عن هذه القوانين وعرفتها، وكانت تلك أول خطوة لكي يصبح الكادحون المتسلحون بهذه القوانين، المادية الديالكتيكية، أحرارًا لمصيرهم، فيبنوا حياتهم على نمط جديد طبقًا للضرورة التاريخية[14].
حرية الفرد ضرورة معرفية
وفي العصر الحديث تكون حرية الإنسان الفرد هي مجرد شجرة معرفتهم، والنموذج المعاصر لذلك هو المفكّر الوجودي الفرنسي المعاصر جون بول سارتر، الذي يرى أن “الشخص الفرد هو ذاتٌ حرة، ومن دون حرية لا وجود للإنسان”.
وفيما يخص الشخص الفرد بين الضرورة والحرية وبغية إعادة الاعتبار له، كمؤسس فرد للمعنى في الوجود، عبر فعله الحر، وبنائه لاختياراته ومبادراته.
يقول سارتر: “إننا لا ننفصل عن الأشياء إلا بواسطة الحرية، فمن دون حرية لا وجود للإنسان .. وإن السقوط يتضمن اختياراتنا لذاتنا بذاتنا”[15].
[1] محمد أبو الفضل بن منظور، لسان العرب، نسخة كمبيوتر، الجزء4، الصفحة 482.
[2] سورة البقرة، الآية 173.
[3] د. وهبه الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية –مقارنة مع القانون الوضعي، بيروت- لبنان، مؤسسة الرسالة، 1985، الصفحة 22.
[4] سورة الأنعام، الآية 119.
[5] السيد نفادي، الضرورة والاحتمال بين الفلسفة والعلم، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2009، الصفحة 5.
[6] جعفر السبحاني، محاضرات في الإلهيات، تحقيق: علي الكلبايكاني، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر، 2016، الصفحة 191.
[7] أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1972، الجزء1، الصفحة 87.
[8] السيد نفادي، الضرورة والاحتمال بين الفلسفة والعلم، مصدر سابق، الصفحة 5.
[9] د. جيهان السيد سعد الدين شريف، المقومات الأساسية لفلسفه أفلاطون وأرسطو … دراسة تحليليه نقدية لمفهوم الضرورة“، القاهرة، رسالة جامعية من منشورات جامعة عين شمس، 2001، بتصرف من بعض صفحات الكتاب.
[10] د. جيهان السيد سعد الدين شريف، المقومات الأساسية لفلسفه أفلاطون وأرسطو، مصدر سابق، بتصرف.
[11] باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة: د. حسن حنفي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1981، الصفحة 365.
[12] المصدر نفسه، الصفحة 367.
[13]خليل أندراوس، مقولات الديالكتيك الماركسي: الضرورة والحرية، موقع: http://www.ahewar.org/debat – 1|12|2008
[14] المصدر نفسه.
[15] جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ترجمه عن الفرنسية: عبد المنعم الحفني، القاهرة، المؤسسة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 1، 1964، الصفحة 17.
المقالات المرتبطة
جذور التحوّل الثقافيّ مقاربة نظريّة
يتضمّن النص القرآنيّ العديد من الآيات والشواهد التاريخيّة، التي تؤكّد على ضرورة أن يراجع الإنسان أفعاله، وينقد ممارساته من أجل تقويمها بما ينسجم والقيم الإسلاميّة العليا.
نظرة في الخصائص المنهجيّة لمدرسة صدر المتألّهين
مذ وُجدت مدرسة الحكمة المتعالية على يد صدر المتألهين الشيرازي حظيت بعدد من المنتقدين الذين يأخذون عليها، بحسب زعمهم، أنها مدرسة تلفيقية، تستورد التعاليم والمواقف المرتبطة من سائر المدارس من دون تحفظ على منهجها الفلسفي
العلمانيـة في الخطاب الإسلامي
ليس محددًا بدقة متى دخلت عبارة العلمانية إلى اللغة العربية، ولكن بدأ تداولها ما بعد عشرينات القرن العشرين بعدما كان





