العلمانيـة في الخطاب الإسلامي
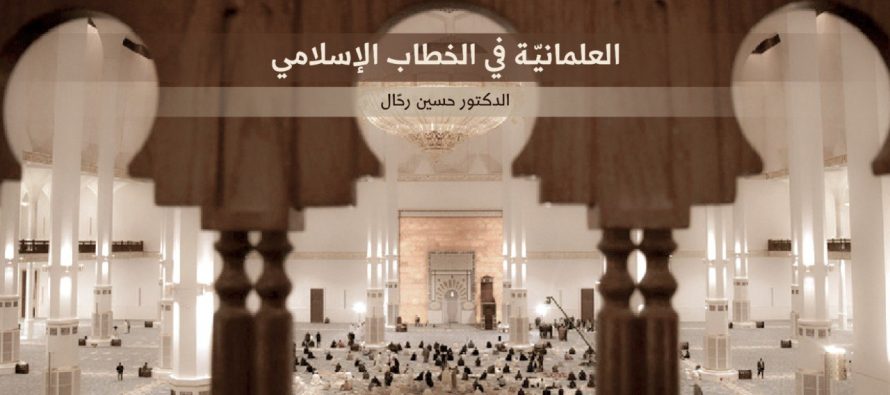
ليس محددًا بدقة متى دخلت عبارة العلمانية إلى اللغة العربية، ولكن بدأ تداولها ما بعد عشرينات القرن العشرين بعدما كان يشار إليها بعبارة “مدني”[1]، خصوصًا عند وصف المؤسسات ذات الأسس اللادينية. كما جرت الإشارة منذ ذلك الحين إلى استخدام العبارة نفسها للدلالة على فصل السلطتين الدينية والمدنية خصوصًا، والمفهوم منقول عن اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
ففي الفرنسية كلمة (Laïcitć) تعني العلمنة، وفي الإنكليزية – الألمانية (secularism) تعني النزعة الدنيويّة (أي الزمنية أو الدنيويّة). “فالعلمنة الفرنسية بكل انعكاساتها الثقافية والقانونية والفكرية تبدو أكثر جذرية من العلمنة الإنكليزية والألمانية، بل والأوروبية بشكل عام”[2].
وقد اسْتُقيَت عبارة (secularism) من الكلمة اللاتينية (Seculu Siécle)، التي تعني لغويًّا الجيل من الناس، والتي اتخذت بعد ذلك معنًى خاصًّا في اللاتينية يشير إلى العَالم الزمني في تميزه من العالم الروحي. وقد اعتمدت هذه العبارة في البلدان البروتستانتية عمومًا. أما في البلدان الكاثوليكية فقد استخدمت عبارة (Laik). وقد أكدت الأولى على النواحي الروحية والعقلانية للعلمانية، وشددت الثانية على النواحي المتعلقة بالمؤسسة الدينية كوحدة سياسية ودينية[3].
ورغم التمايزات بين العلمانية في الديار البروتستانتية، والعلمانية في الحواضر الكاثوليكية فإن بعض الباحثين حدّد جامعًا عامًّا يتضمنها معًا هو: “مساواة المرجعية الدينية في أمور الحياة والفكر بالمرجعيات الأخرى في مجتمع متمايز داخليًّا يعترف بالتمايزات بما يجعل من أمور العقل والسياسة والمجتمع وتقنينها العام أمورًا لا تخضع للسلطة المؤسسية أو الفكرية أو الرمزية الدينية، ولا يعتبرها المرجع الأساسي في الحياة”[4]. يصبح الدين – وفق هذا التعريف – في مجال العبادة الشخصية وتغدو التجمعات الدينية كالكنائس والفرق وغيرها، كالتجمعات الاختيارية الأخرى من أندية وغيرها.
لقد دار سجال فكري حول مصدر الاشتقاق اللغوي لكلمة “علمانية”، هل هي بفتح أول حروفها أم بكسره؟ وقد أدلى الفقيه اللغوي الشيخ عبد الله العلايلي برأي يؤيد فيه استخدام الكلمة بالفتح “علمانية”[5].
الخطاب الإسلامي والعلمانية
تميز الخطاب الإسلامي منذ العشرينات (في القرن العشرين) بموقف سلبي من العلمانية خصوصًا وأن الظروف السياسية المحيطة بأول تطبيقاتها في البلدان الإسلامية جاءت مقترنة بهزيمة عسكرية وإملاءات سياسية على الدول الإسلامية والعربية، وترافقت مع وقوع المنطقة العربية في قبضة الاستعمار الغربي، وسريان موجة من الليبرالية الثقافية والهويات الوطنية التفتيتية على حساب مفهوم الأمة الواحدة (الفرعونية، الفينيقية..). الأمر الذي دفع العديد من القوى الاجتماعية إلى فرز مواقفها بوضوح والابتعاد عن سياق الموقف التوفيقي بين الحضارتين الإسلامية والغربية. وهنا برز التيار السلفي (خارج الجزيرة العربية) الرافض لإلغاء الخلافة (العثمانية)، وفصل الدين عن الدولة (وأشهر رموزه السيد رشيد رضا)، والتيار المناهض له، المؤيد لفصل الدين عن الدولة واعتماد النموذج الغربي في الحكم والثقافة، واستطاع هذا التيار استمالة قلة من رجال الدين أشهرهم الأزهري الشيخ علي عبد الرازقن، الذي ألّف بإشراف هذا التيار كتاب الإسلام وأصول الحكم.
كان نشوء حركة الإخوان المسلمين في هذه الأجواء دعوة إلى العودة للشريعة وتطبيقها ومواجهة التغريب والعلمنة، واندرج خطابها تحت سياق الموقف السلفي الرافض لكل المفاعيل الغربية للحياة، قبل أن تبرز لاحقًا تشكيلة من المواقف داخل تيار الإخوان نفسه من قضايا الدولة الحديثة والديمقراطية والعلمانية والغرب.
في الخمسينات والستينات أضيف إلى الأدبيات الإسلامية مناهضة العلمانية الملحدة (السوفياتية)، وتضمنت الكتابات السائدة حينها (سيد قطب، محمد البهي، أنور الجندي وغيرهم) سجالًا حادًّا مع الحضارة الغربية المادية وعلمانيتها الرأسمالية والشيوعية. وتركز رفض العلمانية على النقاط التالية:
أ. العلمانية نتاج الحضارة الغربية، وبالتحديد الفلسفة المادية، وبما أنها كذلك فهي تقع في نطاق الجانب المعنوي والقيمي للحضارة الغربية، وهو الجانب المرفوض والمتناقض مع الجانب المعنوي والقيمي للحضارة الإسلامية، باستثناء الجانب المادي- التقني من الحضارة الغربية الذي يجوز اكتسابه باعتباره عنصرًا محايدًا حضاريًّا.
ب. إن مصدر التشريع ومصدر الحكم في النموذج العلماني هو البشر، أما في النموذج الإسلامي فهو الله تعالى، ولا يجوز التشريع إلا بما أنزله الله.
ج. النموذج العلماني يتعامل مع الإنسان ببعده المادي فقط ويهمل بعده الغيبي، لا بل إنه في كثير من الأحيان يحارب هذا البعد الإلهي ويستبعد العامل الأخلاقي والروحي باسم الإلحاد ويعادي الدين.
د. الحضارة العلمانية المادية ورطت الإنسانية في الحروب والمآسي، ويعاني نموذجاها الرأسمالي والاشتراكي أزمات عميقة ستؤدي إلى انهيارهما. وليس هناك من أمل للإنسانية سوى بالإسلام، الذي يملك الحل لكل أزمات البشر ولديه الأجوبة لكل التساؤلات وهو الخلاص من القلق والاضطراب خصوصًا لإنسان الحضارة الحديثة.
هـ. العلمانية نشأت في الغرب لأن المسيحية تفصل بين الدين والدنيا، ما لقيصر وما لله. أما الإسلام فهو دين ودنيا، عبادة ودولة، نظام شامل للحياة، لا فصل فيه للروحي من الزمني. كما أن المسيحية في أوروبا عارضت العلم والعلماء واستبدت بالبشر لذلك ثار عليها الناس، أما الإسلام فهو دين العلم والوحي، وليس فيه كنيسة وإكليروس وطبقة رجال دين ورجال دنيا. لذلك كله لا حاجة عند المسلمين للعلمانية.
على هذه الخلفية نشأ الخطاب الإسلامي السياسي، السني والشيعي المتعامل مع العصر والمنخرط في الصراع المجتمعي على قاعدة أن الإسلام قادر على تلبية الحاجات المعاصرة للإنسان المستجدة والمتمايزة عن حاجات الإنسان في العصور السابقة. وهو بذلك يختلف عن نظرة التيار السلفي المغرق في لاتاريخيته وفي جموده عند شكل واحد من التطبيق الإسلامي التاريخي.
أخذنا عينة لدراسة تفصيلية من الخطاب الإسلامي حول العلمانية تشمل الخطابين الشيعي والسني، متوقفين عند أبرز المواقف والنصوص من الموضوع، ثم قمنا بقراءتها من منظار سوسيولوجي معرفي. والعينة تضم كلًّا من: الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الشيخ راشد الغنوشي، والدكتور حسن الترابي.
أولًا: شمس الدين والعلمانية
منذ البداية اتّخذ شمس الدين موقفًا معارضًا للعلمانية من منطلقات عقائدية – دينية وعادة ما كان يقرن إثارتها بمسألتين:
- علاقتها بالاستعمار أو القوى الأجنبية.
- محاولة فرض المجال العلماني على الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، المواريث)، فهو يرى أن التشريع الإسلامي حُوِّر “حين عزل في أكثر مناطق العالم الإسلامي إن لم يكن كلها – عن الحياة العامة – وحصر دوره فيما يسمى (الأحوال الشخصية)… ثمة الآن – هنا وهناك – محاولات جادة تقوم بها القوى الثقافية الأجنبية والمحلية المتأثرة بالقوى الأجنبية لإقصاء التشريع الإسلامي حتى من دائرة الأحوال الشخصية (الزواج المدني – قوانين الطلاق الغربية – قوانين الإرث غير الإسلامية)… والمعتقد نفسه يتعرض لمحاولات التحوير والإلغاء بحركة الإلحاد المعاصرة تحت ظل شتى الشعارات…”[6].
بعد خمسة أعوام تقريبًا على هذا الموقف يقدّم شمس الدين أطروحة دفاعية واسعة ضد العلمانية في كتاب خاص[7]، رأى فيه أن بداية انتصار العلمانية في أوروبا ترافق “مع انطلاقة أوروبا في هجومها الاستعماري على العالم الإسلامي”[8]. مشيرًا بذلك إلى احتلال أندونيسيا العام 1602، والهند عام 1857 بعد قرنين من الحكم غير المباشر، الحملة الفرنسية على مصر (1798 ـ 1801) ثم الجزائر.
وإذا كانت العلمانية انتصرت في أوروبا على خلفية مواجهتها للكنيسة، وغدت سمة الدولة في أوروبا بسبب ظروف الأخيرة، فإن ذلك لا يعني أنها تلقى المصير نفسه في البلاد الإسلامية: “فلم يوجد في الإسلام تناقض بين مصدرين للسلطة… والمبررات النظرية للعلمانية التي استنبطها الفكر الأوروبي من مجمل النظريات الفلسفية والاجتماعية والسياسية التي ظهرت بين الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين منذ القرن السادس عشر – هذه المبررات لم تجد في الإسلام ما يدعو إليها على الإطلاق”[9].
وإذ يعتمد الفقيه الشيعي الاشتقاق الذي توصل إليه العلايلي العَلمانية (بفتح حرف العين)[10]، فهو يرى أن في ترجمة المصطلح من اللغات الأوروبية بـ “كلمة عِلمانية”[11] (بكسر العين)، “من وسائل الخداع والتمويه… لتكوّن انطباعًا لدى الإنسان الساذج أن هذه الدعوة تتصل بالعِلم وتنبع منه… قد تخادعوا ليشتروا بآيات الله ودينه وأحكامه ثمنًا قليلًا من عرض الدنيا…”[12].
رغم هذه النبرة الاتهامية يقدّر شمس الدين بعض إيجابيات النظم العلمانية باعتبارها تعطي مصدر شرعية السلطة للشعب، لكن بالنسبة إلى أساسها الثاني وهو التشريع فإنه سلبي باعتبارها دولًا لا دينية من حيث مظهرها التشريعي.
في إطار دفاعه عن قوانين الأحوال الشخصية السارية في التشريع اللبناني يرى شمس الدين أنها: “مظهر ديني ينوّع فئة من المجتمع، ويبثه في جميع مستوياته… في نطاق الإطار الحضاري العام الذي يشمل المجتمع كله ويتعدى حدود الطوائف”[13].
لهذا السبب يرفض شمس الدين تغيير القوانين خصوصًا ما يطالب به العلمانيون من قانون مدني للأحوال الشخصية فهذا “لا يدعو إلى إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الدينية التي يؤمن بها 99 بالمائة من الشعب لمصلحة (1 بالمائة) من الشعب لا تناسبه هذه القوانين، كما أن هذا لا يدعو إلى وضع قوانين مستقلة لهؤلاء تخالف وضع الدولة المؤمنة من جهة، وتشكل تحديًا لإيمان جمهور الشعب من جهة أخرى… إن المجتمع القائم فعلًا – بحكم الظروف التي تحكم حركته – يعترف لهذه القلة القليلة بحرية الاعتقاد، ولكنه ليس ملزمًا بأن ينشئ لها المؤسسات والأطر القانونية التي تتناسب مع موقفها السلبي من عقيدة المجتمع؟”[14].
رغم هذه الملاحظة الإيجابية الضئيلة للمجتمعات العلمانية يعود شمس الدين بعد سنوات قليلة للتأكيد على رفض الدولة العلمانية والتشديد على أولوية الحكم الإسلامي كمنطلق ثابت قبل التفكير بأي بديل آخر حسب الظروف الموضوعية لكن شرط الابتعاد عن الدولة العلمانية[15].
في العام (1985م) حصل تطور هام في العلاقة بالموضوع وهو إعلان شمس الدين لمشروع الديمقراطية العددية القائمة على مبدأ الشورى كحل لمشاكل النظام اللبناني، ففي تعليقه على ردود الفعل التي أعقبت طرحه لهذا المشروع، يقول شمس الدين: “إننا لا نؤمن بفكرة إقامة جمهورية إسلامية في لبنان ووصف مشروعنا (الديمقراطية العددية بأنه علماني)، وهذا ينبغي أن يشجع دعاة العلمانية على تبني هذا المشروع، ونحن نقول حقيقة إن هذا المشروع، لا هو علماني ولا هو جمهورية إسلامية، هو كاسمه ديمقراطي عددي يقوم على مبدأ الشورى يعترف بالإيمان ويحتضن الإيمان، ولكنه ليس مؤمنًا ولا يستمد شرعيته من الإيمان”[16].
رغم القبول بالتسوية المطروحة نظريًّا عام 85 عادت اللهجة الاتهامية للعلمانية في بداية التسعينات “إن على جميع القيادات أن تكون واقعية في طرح مواقفها وأن تراعي حالة المجتمع اللبناني المتنوع، وأن يعمل الجميع من أجل الاتحاد سياسيًّا في مواجهة التغريب والعلمانية والصّهينة أيضًا”[17].
هذه الدعوة لم تبق على حالها تجمع التغريب والعلمانية والصهينة بشكل حاسم، بل أخذت تبدو على صورة أخرى خلال سنوات قليلة، بدأت بالتحول نحو المرونة في مواجهة بعض النخب العلمانية وموقفها من قانون الأحوال الشخصية؛ إذ قدم شمس الدين مخرجًا لدعاة الزواج المدني يمكن أن يكون مدخلًا لتسوية أوضاعهم من وجهة نظر إسلامية تتمثل في الاعتراف بهم كقوم لا يرفضون جوهر الشريعة والدين وإنما يعاملون الفقه كإنتاج بشري: “إن الأشخاص الذين لا يتدينون بدين أو يتدينون بدين معين (إسلام، مسيحية أو غيرها) ولكنهم ينظرون إلى التفاصيل التشريعية المتعلقة بنظام العائلة أو نظام الزوجية أو نظام المواريث أو ما إلى ذلك باعتبارها أمورًا غير مستمدّة من الوحي الإلهي، لا إنهم يكذّبون الوحي، بل يؤمنون بالوحي ويؤمنون بالنبوة ولكنهم يرون أن التفصيلات التشريعية نتيجة الفكر الفقهي والتطبيقي في مرحلة معينة.. فهل يمكن أن يقال إن هؤلاء (قوم) بالمعنى الفكري الاعتقادي.. وينطبق عليهم بهذا الاعتبار القاعدة التشريعية الثابتة في السنة “لكل قوم نكاح”، وعلى هذا الأساس يكون زواجهم – مع تعدد انتمائهم الديني – شرعيًّا لا باعتبارهم مسلمين قد انتهكوا مبدأ من مبادئ الإسلام، بل باعتبارهم ينتمون إلى نظام عقائدي وتشريعي آخر، هذه المسألة من المسائل المطروحة عندنا والتي لم نجزم فيها بعد برأي محدد وهي مطروحة للنقاش العلمي”[18].
كان هذا الموقف ذروة التحول في آراء شمس الدين من الموضوع الذي توصل إليه في المرحلة الثالثة من مسيرته الفكرية التي بدأت بوضوح منذ 1992م، وعبّرت عنها مواقف مماثلة من موضوع العلمانية، ففي محاولته تقديم رؤية لا تنحصر في الثنائيات التي قدمها العلمانيون والإسلاميون يعبّر شمس الدين عن تسامحه اتجاه مسألة العلمانية في المجتمع: “… بحسب المبادئ العامة للشرعية، أرى أن الحضارة الإسلامية يمكن أن تنشئ مجتمعات مدنية، وبتعديل بسيط يمكن أن نسميها علمانية، وفي الوقت نفسه تكون دينية أو مبنية على الشريعة، فإذا كان مفهوم المجتمع المدني يعني أن المجتمع يكون قادرًا على بناء مفاهيم ومقولات في تنظيم السلطة وتداولها، وفي إدارة لشأن العام وفقًا للمعطيات الموضوعية البحتة، فإن المجتمع في الإسلام يمكن أن يكون علمانيًّا أو مدنيًا، وفي الوقت نفسه مستندًا إلى الشريعة”[19]. هذا الموقف لا يعني الفصل داخل الإسلام بين الزمني والديني أو إسلام علماني وإسلام لا علماني: “في المضمون لا أوافق على تسمية الإسلام العلماني الإسلام هو علماني“[20].
في النصف الثاني من التسعينات حصل انقلاب كامل على الموقف الذي انطلق منه في كتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام عام 1955 (الطبعة الأولى)؛ إذ اكتشف شمس الدين – بعد 35 عامًا – أن ليس في الإسلام شكل محدّد لنظام الحكم، إنما ذلك متروك للأمة فهي صاحبة الولاية على نفسها: “فليس في جميع ما استدل به الشيعة ما يتضمن تحديدًا لنظام الحكم بعد النبي (ص)، وإنما تعين النصوص “الإمام/الخليفة” بعد النبي (ص)” (شمس الدين، نظام الحكم، الطبعة الثانية، 1991). مثل ذلك ذروة الاقتراب من الخطاب العلماني.
ثانيًا: الترابي والعلمانية
في إطار رفضه للعلمانية يرفض الترابي ثنائية الدين والدنيا باعتبارها تتناقض ودين الحق: “تتمثل تلك الثنائية في تمييز جانب من شؤون الحياة يسمى دنيويًّا، تكون الولاية فيه للأهواء الوضعية وما تزينه العقول والرغائب في غايات ووسائل، وجانب آخر – يسمى دينًا – تسوده نيات العبادة وشعائرها… وذلك شائع في مصطلحات الأوروبيين التي أوحت بها تربيتهم الدينية حيث فرقوا دينهم وقسموا الحياة في مجال الحكم بين الخضوع لعنصر سلطان الأرض، والخضوع للكنيسة ظل الله فيما يزعمون”[21].
ينسب الترابي مشكلة الثنائيات: عام/مقدس، زمني/أزلي إلى الثقافة الأوروبية وليس الإسلامية، ويضيف إليها الثنائية العازلة بين الدين والدنيا في مجال العلم، “تمييزًا بين العلم المنقول عن الوحي أو التراث الآخذ من الوحي والعلم المكتسب بالتجربة الإدراكية المباشرة والعقل الحر. ويقع التفريق من ثم بين علم ديني وعلم دنيوي”[22].
كل ذلك يجانب مذهب التوحيد حسب الترابي وهو مؤسس على مذهب “الإشراك الذي أصاب الحياة الأوروبية بعلة الثنائية والتعددية في أصول توجهاتها”[23].
ردًّا على هذا الفصل اتبع الترابي استراتيجية الدمج: الديني هو نفسه الزمني حتى في الاختصاص القانوني والفقهي، وجد الترابي حلًّا متمايزًا من الآخرين، فبدل تقديم خطاب دفاعي عن عدم حاجة الدين الإسلامي للعلمانية لحل مشكلاته، دمج الفقه والفقهاء في مفاصل الحياة العملية، وهو لذلك ينتقد وجود فئة اسمها علماء الدين في المجتمع الإسلامي، لأنه يريد للعالم المختص في شؤون علمية خاصة أن يكون هو أيضًا عالم دين، ذلك: “أن الدين لا يقوم أبدًا إلا بهاتين الشعبتين من العلم، ولكن تباعد ما بين العلم الشرعي النقلي والعلم الطبيعي، وأصبح عندنا من يُسمون علماء دين، ومن يسمون علماء دنيا، حتى في مجال القانون، فأصبح عندنا علماء قانون وضعي وعلماء أحكام شرعية متمايزون في المعاهد وفي المناهج حتى في الأزياء، وأصبح لذلك أمر تجديد الدين في أزمة”[24].
لهذا يقول الترابي إن حركته قاومت “أن يُعزل علماء الفقه النظري فيها في كيان خاص لتسند إليهم الفتوى المبادرة أو الضابطة”[25] انطلاقًا من أنه: “ينبغي دمج الفقهاء في العملية نفسها باعتبار أن دورهم هو تنوير الناس وإرشادهم في مسالك الحياة من داخل البرلمان لا من خارجه، وإلا انتهى الأمر إلى انقطاع الدين عن الناس”[26]. المنهج نفسه يبثه الترابي في القطاعات الأخرى المصرفية أو الاقتصادية، إلا أن الإنجاز الأهم هو سلوكه في مجال التشريع القانوني حيث تفاعل فكريًّا وسياسيًّا مع معطيات السودان الداخلية محاولًا الاستفادة منها لتطبيق الشريعة الإسلامية عبر وضع: “تصور لدستور إسلامي للسودان (1956 – 1965)، ومشروع نظام المعاملات الاقتصادية الإسلامية (1977م)، وسياسة تطبيق القوانين الشرعية (1983م)”[27]. كانت الذروة عام 1989 بتأييد انقلاب “ثورة الإنقاذ الوطني” التي أوصلت الإسلاميين إلى الحكم على أنقاض الدولة ذات المنحى العلماني غير المستقرة وتطبيق “نظام إسلامي” فيها.
ثالثًا: الغنوشي والعلمانية
يناضل الغنوشي منذ بداية مسيرته الفكرية ضد فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، ففي بيان حركة الاتجاه الإسلامي التأسيسي يعتبر “أن هذا الفهم يعبّر عن تصور كنسي دخيل على ثقافتنا الأصيلة”[28].
كما أن الحركة “ترى من حقها تبني تصور للإسلام يكون من الشمول بحيث يشكل الأرضية العقائدية التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدد هوية هذه الحركة”[29]، لذلك فهي تعتمد: “التصور الشمولي للإسلام، والتزام العمل السياسي بعيدًا عن اللائكية والانتهازية.. تحرير ضمير المسلم من الانهزام الحضاري إزاء الغرب”[30].
بعد بضع سنوات لم يستطع الغنوشي الحديث بوضوح عن مناهضته للعلمانية، بل هو غير اسم الحزب الذي أسسته مجموعة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة التزامًا بمقتضيات الدستور التونسي، فقد تم نزع الإشارات الواضحة عن تبني الدين الإسلامي كمرجعية فكرية وسياسية لعمل حركة النهضة[31].
بداية التسعينات شهدت مرحلة جديدة في خطاب الغنوشي حيث رأى أن: “مشكلنا الأساسي، إن كان لنا مشكل، ليس مع الحداثة بما هي تقدم علمي وتقني ولا حتى مع العلمانية، بما هي حياد الدولة إزاء العقائد، وإنما مشكلنا المزمن مع حداثة مزيفة، مع تسلط للأقلية المنعزلة على الشعب محتكرة للثروة والقرار السياسي، متسلطة على ضمائر الناس وأرواحهم وعقولهم باسم الديمقراطية والحداثة والعلمانية والمجتمع المدني، وأحيانًا باسم الإسلام أيضًا”[32]. يفصل الغنوشي هنا بين الحداثة والعلمانية: “وإذا كان الغرب دخل الحداثة من بابه الخاص أي التراث اليوناني والروماني والمسيحي، فنحن أُريد لنا أن ننسلخ عن كل ماضينا وحاضرنا والتفريط في هويتنا واستقلالنا حتى ننال حركة الحداثة كما فهمت في الغرب، وندخل إليها من الباب نفسه أي العلمانية”[33].
في هذه المرحلة بات للعلمانية مفهومان واحد في الغرب وآخر في البلدان العربية: “الحداثة والعلمانية والديمقراطية في الغرب قد حرّرت العقل وحرّرت الشعب، وأعطت السلطة للعقل، وأعطت السلطة للشعوب، وفصلت الدولة عن شخص الحاكم.. بينما الحداثة المزعومة والعلمانية المدعاة في منطق بورقيبة وأتاتورك[(1881-1938م)]، وشاه إيران [محمد رضا بهلوي (1919 – 1980)] وأمثالهم من بقية الدكتاتوريين والأقليات المتطرفة من حولهم لم تكن كذلك”[34].
مشكلة العلمانية عند الغنوشي لا تقتصر على تونس، بل تشمل معظم الدول العربية والإسلامية: “ولقد بلغ الأمر في الجزائر إلى حد خروج حشود العلمانيين، إثر فوز الجبهة الإسلامية، في مظاهرة يستصرخون الدبابات لمنع قيام حكم إسلامي، شاهدين على أن العلمانية قدمت إلى بلادنا على ظهر دبابة ولا تزال غير قادرة على الحياة إلا في حمايتها”[35].
في هذه المرحلة يلاحظ الغنوشي فروقات في التجارب العلمانية في العالم. بعض هذه التجارب قريبة من التجربة التي عايشها: “تقدم التجربتان التركية والتونسية أنموذجًا لدولة الحداثة العلمانية في حجم العنف الهائل الذي ظلت تمارسه لتفكيك المجتمع الإسلامي وفرض إلحاقه بالخارج وقمع كل مبادراته، الأمر الذي يؤكد أنه لا حرية لمجتمع ولا سلطة خارج ثقافته وهويته واستقلال أسواقه، وأن التغريب والدكتاتورية قرينان اقتران الإسلام وسلطة الجماعة والتحررية”[36].
هذا الموقف الحاد من اجتماع العلمانية والدكتاتورية لا يمنع من تمييز العلمانية في مصادرها الأساسية (الغربية) وعلاقتها بمجتمعاتها، والعلمانية المنقولة إلينا، فرغم أن الغنوشي يرى الحداثة الفرنسية متطرفة في بعض أبعادها بخلاف البلدان الإنغلوسكسونية التي لم تعرف الاحتدام بين الدين والعلم وبين الدين والثورة، رغم ذلك يرى الغنوشي أن العلمانية في الغرب كانت جزءًا من تاريخ البلاد الغربية ومن تطورها الاجتماعي، وعامل تحرير لها من الاستبداد[37]، بخلاف ما هو حاصل عندنا، فالعلمنة اتباع للأجنبي و”امتداد لهيمنته ومصالحه وطريق لتجذير القطيعة بين الدولة والمجتمع أو تغريب هذا الأخير وتهميشه”[38].
في موقف لا سابق له يظهر يأسه من النموذج العربي لتطبيق العلمانية المجتزأة والمشوهة والعنفية يندفع الغنوشي ليقول: “وذلك ما يجعلنا فيما لو لم نجد بدًّا من الاختيار بين علمانية غربية، وتدين كنسي مستبد منحط، ستختار العلمانية الغربية والديمقراطية بحلوها ومرها”[39].
(يمكن العودة إلى الجدول رقم ب/1 لمراجعة سياق التحول الفكري في الخطاب الإسلامي الراهن من موضوع العلمانية).
جدول ب/1 مسار التحولات في الخطاب اتجاه العلمانية
الفترة الزمنية شمس الدين الترابي الغنوشي
منذ ما قبل1970 حتى 1975 |
رفض مطلق للعلمانية وقرنها بالاستعمار ومحاولة عزل الدين عن الحياة المجتمعية وهي استهداف للعقيدة والشريعة الإسلاميين. | معارضة للعلمانية والعلمانيين ومطالبة بدستور إسلامي للسودان.
|
رفض فصل الدين عن الدولة
الإسلام شمولي ويجب عدم الانهزام الحضاري أمام العلمانية والغرب.
|
|
منذ 75 حتى أواخر الثمانينات |
تفهم مبررات العلمانية في أوروبا ورفضها في دار الإسلام، ملاحظة بعض إيجابيات النظم العلمانية لكن في أوروبا والغرب فقط.
الحكم الإسلامي واجب. دعوة واضحة لمواجهة المشاريع العلمانية في لبنان والعالم العربي. رفض كامل لأي تعديل لقوانين الأحوال الشخصية حتى لمشروع اختياري للزواج المدني. |
رفض الفصل بين الديني والدنيوي لأن أصله شرك أوروبي لا وجود له في الإسلام الديني التوحيدي.
طرح برامج لأسلمة الدولة والمجتمع. |
تقبل نزع صفة الإسلامية عن حركة النهضة “إسميًّا”
تفهم علمانية الغرب وعدم قبولها في المجتمعات الإسلامية |
|
منذ أوائل التسعينات وما بعدها |
لا دولة دينية في الإسلام، الإسلام هو شريعة وأيضًا علماني، مصالحة مع العلمانية، التشريعات والقوانين الإسلامية تريد مجتمعات علمانية ـ مدنية.
محاولة إيجاد موجب للزواج المدني لبعض النخب. |
تأييد تطبيق الشريعة مع استثناء الولايات ذات الأغلبية غير المسلمة.
معارضة إقامة طبقة أو حكم الفقهاء ودعوة لدمجهم في المؤسسات الاقتصادية والتشريعية والقضائية.
|
التمييز بين علمانية فرنسية ـ تونسية مرفوضة وعلمانية بروتستناتية متفهمة
ـ في حال التخيير بين العيش في دولة علمانية غربية أو ديكتاتورية عربية يختار الأولى. مصالحة الأسلمة مع العلمانية. |
رابعًا: العلمانية في الخطاب الإسلامي: قراءة في التحولات
تتشابه ردود فعل الغنوشي وشمس الدين بشأن العلمانية في سياق مسيرتها الفكرية، فهي سلبية وحادة في السبعينات، ثم بداية تفهّم لدورها في أوروبا والغرب أوائل الثمانينات، لتنتهي في التسعينات إلى اقتراب ومصالحة بين “الأسلمة” و”العلمنة” بمعنى قبول نمط التحديث الغربي للمجتمعات بخصوصية إسلامية؛ أي قبول نوع من العلمنة تحت إطار إسلامي، لقد توصلا إلى هذا الموقع التصالحي مع العلمانية في المرحلة الأخيرة من إنتاجهما الفكري بعد تحولات معرفية ومجتمعية كبيرة مرّا بها.
أما الترابي فله تجربته الخاصة التي تنسجم مع البيئة السودانية والتي جاءت أكثر التصاقًا بها وأكثر عملانية. فرغم المنحى الشمولي (الجامع للدين والدنيا معًا في إطار الفكر الإسلامي) الذي ميّز خطابه حتى الثمانينات فإن انخراطه في الصراع المجتمعي (خصوصًا السياسي) أكسبه فعالية جعلته يمارس بعضًا من هذا الخطاب في المجتمع السوداني على شكل صيغ قانونية تشريعية تحاول أسلمة الدولة والمجتمع من الداخل.
لقد دعا أركون إلى تطوير المجتمعات الإسلامية وفقًا للنموذج العلماني، لكنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الإسلام “يسمح بالعلمنة والتمييز بين الديني والسياسي على عكس ما يتوهم الجميع”[40].
ومهما يكن من أمر الجدل الذي مارسه شمس الدين فإن التطور الأخير في خطابه حول العلمانية أظهر اقترابًا من هذه النقطة بالذات بالقول إن الإسلام هو علماني، وهو قادر على إنتاج مجتمعات مدنية أو علمانية يمكنها الاستناد في أمور التنظيم والإدارة المعطيات الموضوعية البحتة، كذلك محاولته إيجاد مخرج فكري إسلامي لموضوعة الزواج المدني من خلال قول “لكل قوم نكاح” التي منعت الاعتبارات السياسية، وموقع شمس الدين نفسه على رأس إحدى الطوائف الإسلامية من دفعها إلى الضوء والبلورة بصوت عالٍ فبقيت ضمن إطار تساؤلي، وحُصرت في إطار شريحة أكاديمية فيما دعت الدوافع السياسية إلى ممارسة خطاب معارض للعلمانية في الفترة نفسها[41].
أ ـ الغنوشي بين خصوصية المجتمع التونسي ومرجعية النموذج الغربي
لم تتح البيئة المجتمعية للغنوشي أن يطور مصالحة مبكرة مع العلمانية، فقد كانت الظروف السياسية التي عاشتها تونس تقدم العلمانية في إطار تشكيلة من التطبيقات (في المجتمع والدولة) جمعت التغريب والحزب الواحد واستبعاد الحريات، وممارسة العنف الرسمي، وسحب الشرعية عن ممارسة الأحزاب الدينية والمعارضة الفاعلة بشكل ربط العلمانية بممارسات سلبية لم تسمح بداية لأنصار الاتجاه الإسلامي وعلى رأسهم الغنوشي وغيره من المعارضين بإدراك مستقل وناضج لسياق العلمانية وتطورها التاريخي: “كانت علمانية تفتقد إلى مضمونها الديمقراطي العام. وبالتالي فإن عقلانيتها كانت عقلانية “ثورة من الأعلى”، لأن الحركة الإصلاحية التي اضطلعت بها الدولة الجديدة، بهدف إضفاء تجانس اجتماعي وتحديث البنى والعقليات قد قادت إلى أن تصبح الدولة ذاتها جهازًا للهيمنة خارجًا على المجتمع، وصولًا إلى إلغائه، وهو ما كانت نتيجته تفاقم القطيعة بين الحاكمين والمحكومين”[42].
في ظل نظام كهذا مارس العنف الإلغائي ضد مظاهر الوجود الديني، كان خطاب الغنوشي الأولي، معاديًا لهذه العلمانية القاسية المتطرفة التي فاقت النموذج الفرنسي، واعتمدت النموذج التركي في اجتثاث مقومات إنتاج الثقافة الدينية في المجتمع، فقدّم خطابًا يركّز بالمقابل على شمولية الإسلام وحقه في تقديم رؤى فكرية وسياسية للمجتمع والحكم، واقترن نقده “للائكية” بنقد التغريب القسري والانفصام الثقافي وتغيير الهوية الذاتية.
جاء ذلك في ظل قيام جهاز الدولة المستقلة حديثًا في تونس “باحتكار الشرعية الدينية والثقافية واحتواء المؤسسة الدينية التقليدية.. وبالتالي تحقيق الهيمنة على المؤسسات التقليدية والأجهزة الأيديولوجية كالمساجد والكتاتيب والمدارس.. وهكذا صفى بورقيبة البنية التحتية الاقتصادية للمؤسسة الإسلامية التقليدية من خلال إلغاء مؤسسة الحبس والأوقاف”[43].
لقد طبقت الدولة في مجتمع عربي إسلامي تقليدي غير صناعي وخارج لتوه من استعمار لم يسمح له بتطوير بناه تلقائيًّا، علمانية “تعليمية” بهدف “خلق نمط من الرجال قادرين على استيعاب الحضارة المعاصرة”؛ أي استيعاب الحضارة “الرأسمالية الغربية”[44]. لقد ساهمت هذه العلمانية المتطرفة في إحداث صدمة لدى كثير من أفراد النخبة الذين أحسوا بالفارق والتمايز والبحث عن هويتهم المصدومة، ومن بين هؤلاء الغنوشي ورفاقه من الإسلاميين.
لكن نفي الغنوشي إلى الغرب سمح له برؤية علمانية مختلفة خصوصًا العلمانية الإنغلوسكسونية، علمانية لا تبنى على السيطرة على مؤسسات الإنتاج الثقافي الديني، وإنما تقوم على تنظيمها في إطار دولة المواطنة والحرية والديمقراطية وحماية حق الاعتقاد الديني وغير الديني بما في ذلك السماح بالمدارس الدينية الممنوعة والمصادرة في بلادها الأصلية.
على أن هذا الموقف لا يمكن فصله عن وضع الغنوشي نفسه كضيف (منفي) في الغرب، فهو لا خيارات أخرى لديه، سياسيًّا أو فكريًّا سوى تبرير ما أتاحه له الغرب من حرية أمّنتها علمانية لإسلامي هارب. لقد أنتج الغنوشي هذا التسامح مع العلمانية والغرب في لحظة حاجته إليه. وفي لحظة يبدو فيها العيش في الغرب أقرب إلى التطلعات “اليوتوبية” للمنفيين أو الهاربين الإسلاميين من مجتمعات بلدانهم.
كان ذلك أواخر الثمانينات وترافق مع بداية تفهم صدور العلمانية في مجتمعاتها وبناء تطورها المجتمعي والثقافي كعامل تحرير من الاستبداد[45]، بات الفارق واضحًا بينها وبين علمانية الأنظمة العربية المقطوعة عن جذورها المعرفية والمقطوعة أيضًا عن هوية مجتمعاتها، وهو ما سمح للغنوشي بإعادة النظر في موقفه من العلمانية في التسعينات بشكل أكثر دقة، ولكن بخطاب منفتح يجعلها أحد الخيارات الصعبة التي قد يلجأ للعيش في إطارها الغربي إذا ما خيّر بينها وبين إطارها الممارس في بلده الأم.
ب ـ شمس الدين بين خصوصية المجتمع اللبناني والتباسات التحول المعرفي
بالمقابل لم يمر شمس الدين بالظروف المجتمعية نفسها فهو في مأمن من مصادرة مؤسساته الدينية والتعليمية، لا بل يحظى بحماية نظام طائفي، لكن شمس الدين حمل معه من مدرسته الفكرية (النجف) ذلك الصراع ضد التحديث العلماني والمادية والجاهلية فكان الموقف الدفاعي عن الإسلام موقفًا مشتركًا مع الغنوشي والترابي قبل أن ينخرطوا جميعًا في مسالك الصراع المجتمعي، ليبلور كل منهم مسارًا متمايزًا من مدرسته الأم، وليلتقوا فيما بينهم في كثير من خطوط التشابه.
كان التحدي الذي واجه شمس الدين في السبعينات مختلفًا عن الغنوشي والترابي؛ إذ إنه يتعلق بالحفاظ على الطابع الطائفي الديني للنظام السياسي في لبنان، وفي الوقت نفسه إلغاء الطابع الطائفي السياسي له[46]. في المستوى الأول مثّل موضوع الأحوال الشخصية هدفًا للقوى العلمانية الصاعدة آنذاك في محاولة منها لإلغائه[47]، أو على الأقل إيجاد قانون زواج مدني اختياري. في حمأة هذا الصراع السياسي – الفكري كتب شمس الدين كتابه العلمانية عام 1978 (وصدرت طبعته الأولى عام 1980)، وهو كما يقول عنوانه الفرعي: تحليل ونقد للعلمانية محتوًى وتاريخًا في مواجهة المسيحية والإسلام وهل تصلح حلًّا لمشاكل لبنان؟ وقد تضمن إلى ذلك دفاعًا عن قانون الأحوال الشخصية الطائفي المعمول به، ورفضًا عقائديًّا وسياسيًّا لأي تعديل له باتجاه قانون مدني موحد أو اختياري.
كانت هذه المحطة هامة في سياق تطور المرجعية المعرفية لشمس الدين لأسباب عديدة:
ـ محاولة لمغادرة الدفاع السلبي عن الخطاب الديني التقليدي باتجاه خطاب يحاول تحليل المفهوم المرفوض، وتقديم مواقف أكثر تفصيلية منه، واعتماد جدال غير ديني في رفضه (بالإضافة إلى الموقف الديني الأساسي).
ـ بداية التواصل مع فكر التوفيق والانتقاء الذي بدأه رواد عصر النهضة (الأفغاني، وعبده، وإقبال) بعد فترة من انتقادهم بسبب ممارستهم “التوفيق” بين الحضارتين الغربية والإسلامية.
ـ الانخراط أكثر في الصراع المجتمعي (السياسي – الفكري) الذي تعيشه النخب والفئات اللبنانية، ومحاولة الرد التفصيلي على التحديات والمشاكل التي تثار وهو أمر ضروري لإحداث إجابات مطلوبة واحتكاك فكري – مجتمعي سيولد هذه الإجابات، أو على الأقل التساؤلات الواقعية والدقيقة، ويحاول الإجابة عنها وفقًا لإطاره المرجعي الفكري.
رغم أن هذه المحاولة لم تسفر عن إعطاء بديل فكري عملي من الطروحات التغييرية للقوانين الطائفية باستثناء تمسك شمس الدين الدفاعي بالمكتسبات القانونية للأحوال الشخصية، إلا أنها سمحت له بالاطلاع النظري على بعض التجارب الغربية المتمايزة في التطبيق العلماني: “وهكذا ولدت العلمانية في مواجهة الكنيسة، فقدت سمة الدولة في أوروبا، هذا هو مضمونها على اختلاف في بعض السمات والمميزات في أوروبا وأميركا بين دولة وأخرى”[48].
يميز شمس الدين هنا بين علمانية معتدلة وعلمانية متطرفة. في الأولى تسهم الدولة من ميزانيتها في مساعدة التعليم الديني كذلك ترعى وزارات الخارجية نشاطات كنسية وتبشيرية وتحميها[49].
مع ذلك تطور موقف شمس الدين بالتفاعل مع الساحة المحلية إلى حدود قبول وصف الإسلام بأنه علماني وإلى حدود محاولة إيجاد مخرج للزواج المدني لفئة من اللبنانيين مختلفي الطوائف. إلا أن السؤال المطلوب الإجابة عنه هنا: لماذا لم يتطور هذا الموقف إلى مشروع حل في ذروة المطالبة بقبول إسلامي للزواج المدني، ولماذا انضوى شمس الدين مجددًا في التيار السياسي العام للطوائف اللبنانية الرافض لمشروع قانون الزواج المدني الاختياري، الذي طرحه رئيس الجمهورية اللبنانية السابق إلياس الهراوي قبيل انتهاء ولايته الدستورية عام 1998م؟
إن ذلك لا يمكن تفسيره خارج العلاقة بين المعرفة والفئات المجتمعية التي تعبر عن تطلعاتها، ذلك أن كبت الحل التجديدي الذي توصل إليه شمس الدين استنادًا إلى مقولة “لكل قوم نكاح”، وعدم تطويره إلى موقف سياسي ـ فكري، وإبقائه حبيس التساؤل وحبيس فئات نخبوية للمناقشة الفكرية الداخلية فقط، كان نتيجة حسم الصراع بين وضعيّتين: الأولى يمثلها موقف شمس الدين الشخصي ـ المفكر ـ الفقيه، الثانية، شمس الدين صاحب الموقع المجتمعي ـ السياسي ـ الطائفي الذي يمثل طائفة إسلامية كبرى في لبنان، ويعبّر عن مصالح سياسية وقانونية لفئات مجتمعية يتزعم الدفاع عنها، وقد حسم الصراع لصالح الثانية خصوصًا، وأنه جاء في لحظة تثبيت شمس الدين من قبل مؤسسات الدولة كرئيس للمجلس الشيعي الأعلى؛ ذلك أن السلطة التي يمارسها المجلس وغيره من المجالس الملّية[50] اللبنانية ستتأثر سلبًا في حال إلغاء الأحوال الشخصية المذهبية، أو إقرار قانون مدني اختياري لها. وهنا يظهر كيف تعبّر المعرفة عن تطلعات ومصالح فئات محددة بناءً للموقع والوضعية المجتمعية لمنتجها، وكما يقول مانهايم، فإن الأفراد حين يفكرون لا يقدمون بذلك كأفراد مجرّدين، بل كأفراد في المجتمع وفي فئة اجتماعية محددة لها تطلعاتها ومصالحها وفي حالتنا هذه كانت التطلعات ذات صبغة أيديولوجية تحبذ الإبقاء على الوضع القائم وليس تغييره.
ج ـ الترابي بين التجربة السودانية والمؤثرات الغربية
منذ بداية الستينات شارك الترابي في النشاطات التنظيمية والسياسية العامة للإخوان المسلمين، ثم ترشح لعضوية البرلمان بما يشير إلى بداية اصطدامه بالتحديات المجتمعية التفصيلية قبل الغنوشي وشمس الدين بنحو 15 سنة أو أكثر بقليل، وهو ما يفسر أسبقيته في كثير من الإجابات والحلول التي صدرت عنه، وامتيازه بسلوك مسار خاص مميز من مؤسسته الفكرية الأم، قبلهما بمدة موازية أي منذ أواسط السبعينات[51].
أدرك الترابي باكرًا هذا التداخل بين الدولة الحديثة والمفاهيم السائدة في الغرب من المواطنة، إلى العلمانية، إلى المؤسسات الحديثة والأجهزة التي تتبع لها، لذلك فهو لم يطلق خطابًا مضادًّا للعلمنة فقط، بل هو تميز بتقديمه في إطار بديل واضح. لقد كان تركيزه عمليًّا أكثر مما هو معارضة لفظية حارة، امتزج الحديث عن كون الإسلام ليس دينًا روحيًّا فقط، (بل يجمع الدين والدنيا) باقتراح عملي نحو الدستور.
لم تكن مواجهة العلمانية مع ذلك، أولوية مطلقة على ما عداها عند الترابي، بل لديه أولويات أخرى كإصلاح الفكر الإسلامي ومعالجة وضع النساء وحقوقهن. ذلك يعود في جانب منه إلى المنحى العلماني غير المتشدد في الثقافة الإنكلوسكسونية التي كان ينتمي إليها مستعمرو السودان، بخلاف الاستعمار الفرنسي ذي الميول العلمانية المتشددة[52].
لقد عاش الترابي فترة دراسته العليا في بلدين علمانيين متمايزين: بريطانيا وفرنسا، كما زار الولايات المتحدة باكرًا، لذلك أدرك أهمية التأثير في مؤسسات الدولة نفسها خصوصًا وأنه هو شخصيًّا تخصص في الجانب القانوني الدستوري، لذلك طبع تحركه المعادي للعلمانية بالطابع القانوني – الدستوري، فرفع لواء التشريع الإسلامي والدستور الإسلامي، وصولًا إلى أسلمة المجتمع من فوق (أي من هيكل الدولة المهيمن) مثلما تحرك في القاعدة (في المجتمع)، لذا فإن همّ الحركة الإسلامية التي قادها الترابي وأصبحت جزءًا من البرلمانات المتتالية منذ أوائل الثمانينات كان: “منصبًا على مسألة الدستور الإسلامي، أي فكّ للدولة الحديثة عن الإطار الثقافي الغربي الذي أفرزها، وإعادة ربطها بأصول الاعتقاد الإسلامي، وبالقواعد التي يقوم عليها مجتمع المسلمين، وهي العملية التي يمكن أن نسميها عملية “التأصيل”[53]. إن إدراك الترابي لدور الدولة الحديثة والهامش الذي يمكن تطويره في اقترابها أو ابتعادها من الدين، أو مستوى علمانيتها، سمح له بالمناورة السياسية والتشريعية في إطار مشروعات الدستور الإسلامي، وتطبيق الشريعة الإسلامية سواء في فترة جعفر النميري التي امتدت من العام 1969 حتى 1985م أو قبله، أو في فترة الجبهة القومية الإسلامية، أو “ثورة الإنقاذ الوطني”.
خامسًا: المعرفي في خضم الاجتماعي ـ التاريخي
كانت إحدى العقبات أمام الخطاب الإسلامي التقليدي عدم الإدراك لعمق العلاقة بين النـزوع العلماني ونشوء الدول والمجتمعات العربية والإسلامية في العصر الحديث. لقد بدأت عوامل الحداثة الغربية وتنظيماتها تغزو جسد الدول الإسلامية منذ القرن التاسع عشر سواء في تركيا العثمانية أم في بلاد فارس، حيث ساعدت التنظيمات الجديدة، عدا عن تحديث الإدارة والتعليم والقضاء، في وضع هذه القطاعات تحت إشراف الدولة والحد من سيطرة المؤسسة الدينية عليها ولو جزئيًّا[54].
إن الحديث عن العلمانية باعتبارها عنصرًا منفصلًا عن المجتمع الإسلامي يمثل تجريدًا لاواقعيًّا لمسألة مجتمعية معقدة؛ إذ لا يمكن الحديث عن مجتمعات عربية أو إسلامية خالصة دخل إليها الاستعمار مع العلمانية كما أشار إلى ذلك كثير من الإسلاميين، فهذه المجتمعات ليست ذات حضارة صافية ومنعزلة عن تفاعلات الحضارات الأخرى، لا بل هي تحمل في أحشاء مؤسساتها وداخل هياكلها عناصر غربية – تحديثية أو ذات طابع علماني منذ قرنين على الأقل.
لا يعني ذلك أن الدول العربية والإسلامية أصبحت دولًا علمانية على النمط الغربي. على العكس يعني ذلك أنها بدأت بالتفاعل مع المؤسسات الحديثة والنـزعة المدنية وفقًا لآليات خاصة بها ووفقًا لمنظوراتها الثقافية التي بدأت مع رواد عصر النهضة خصوصًا مدرسة محمد عبده في فهم مدنية الدولة ودنيويّة بعض مجالات الحياة في إطار فهمه للإصلاح الإسلامي، ولم يُسمح لها بأخذ مجالها التلقائي للنضوج بحيث تقدم نموذجًا مدنيًّا لمجتمع عربي (أو إسلامي) يؤقلم مفاهيم المدننة أو العلمانية غير المشددة ضمن مستوى محدد وفقًا لآليات عمل خاصة تتلاءم مع الثقافة الإسلامية، أو تتطور في إطار لا يتعارض معها.
ما حصل هو انقطاع مجتمعي تمثل بدخول علمانية من نوع حاد ومعادٍ للدين بآليات خارجية في البلد الإسلامي، الذي كان يحظى لتمثيل الشرعية التاريخية للدولة الإسلامية (الخلافة) والصدمة التي تركها في الوعي الإسلامي الهام من خلال إلغاء الخلافة من جهة، وانقطاع معرفي إسلامي مع فكر عصر النهضة، من جهة ثانية، مثّل نموذجًا له رشيد رضا في تحوّله نحو السلفية منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى.
لقد استطاع الخطاب الإسلامي الراهن التواصل مع فكر النهضة منذ الثمانينات جزئيًّا، ومنذ التسعينات فعليًّا مشكّلًا بذلك بداية تراكم معرفي لكن مع فارق انقطاع حوالى 80 عامًا ليس فقط من قبل هذا الخطاب الإسلامي، بل أيضًا من قبل الخطاب العلماني المتطرف.
كيف حصل هذا الانقطاع الفكري وما هي دوافعه المجتمعية؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلّا بالعودة إلى لحظات الانقطاع الأولى عن فكر مجتمع عصر النهضة.
أ ـ التجربة الكماليّة ودورها في انقطاع التواصل
مثلّت التجربة الكمالية في تركيا أول انقطاع حاد عن مرحلة فكر النهضة باتجاه علمانية حادة لم تكن نتيجة تطور مجتمعي داخلي وتلقائي كما حصل في فرنسا أو بلدان أوروبا الغربية الأخرى، بل جاءت نتيجة تداخل عوامل خارجية أكثر منها داخلية مرتبطة بنتائج فوز الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.
لقد كشفت مذكرات رضا نور أحد المفاوضين في محادثات مؤتمر “لوزان” (المدينة السويسرية) عن الجانب التركي أنه تعهد بعلمنة تركيا تمهيدًا لقبول المؤتمر بالميثاق القومي التركي، وأبلغ المؤتمر بالتالي: “أن تركيا أصبحت علمانية، وقد انفصل الدين عن الدولة، وإذا ما تم الصلح فإننا سنقوم بوضع القوانين المدنية…”، ويضيف نور: “… كلامي هذا سجل في محاضر الجلسات كانت هذه من أهم نقاط الارتكاز والاستناد التي كنا نستند إليها في لوزان، وقد سبق وأن وضعت شرط فصل الدين عن الدولة في التقرير الذي وضعته عن إلغاء السلطنة. وهذا الفصل هو أساس العلمانية”[55].
ويستنتج الدكتور وجيه كوثراني بناء على ذلك “أن الاعتراف الدولي بالميثاق القومي التركي في مؤتمر لوزان عام 1923 كان مهد الطريق لقانون 1924 الذي ألغيت بموجبه الخلافة إلغاءً نهائيًّا باعتبارها مؤسسة مناهضة لفكرة الدولة القومية التركية”[56].
هذا الانقطاع شكل صدمة كبيرة في الأوساط الفقهية الإسلامية، وولّد ردود فعل متباينة أبرزها اتجاه سلفي يريد البحث عن خلافة[57] جديدة ويعارض العلمانية بكل شدة (وكان رشيد رضا أحد أقطابه)، واتجاه آخر استفاد من هذه التجربة ومن النتاج الفكري الذي قدمته الدولة الكمالية لإقناع المسلمين به وهو عبارة عن وثيقة رسمية غير موقعة أعدتّها مجموعة من العلماء بتوجيه من أحد أعضاء الجمعية الوطنية التركية المؤيدين للعلمانية ولإلغاء الخلافة تحمل الحجج والمبررات الفقهية والقانونية لهذا التيار.
شكّلت هذه الوثيقة (التي ترجمت إلى العربية عام 1923، ونشرت في جريدة الأهرام، ثم طبعت في كتاب عام 1924) أحد المصادر الهامة التي تأثر بها علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، والذي أصدره عام 1925[58].
تشير هذه التطورات إلى مدى تحكم العامل السياسي، في المجتمعات العربية والإسلامية، بالعامل المعرفي (الفقهي ـ الفكري) وفي إنتاجه وإعادة تسويقه مجتمعيًّا، وكيف تتحكم السلطة بظهور أو تقوية تيارات فكرية تحمل خطابًا مفيدًا لها حتى داخل الوسط الفقهي ـ الديني. يعقد باحث أوروبي مقارنة بين تركيا والدانمارك؛ في الأولى علمانية متطرفة متأزمة ومتوترة مع المجتمع، وفي الثانية علمانية ملطفة لكنها منسجمة مع الثقافة الوطنية والدينية للبلاد وهي “اللوثرية التي هي الديانة الوطنية والمجتمع المدني متمرد جدًّا بالنسبة إلى أي وصاية دينية، أما تركيا فتقدم مثلًا نموذجًا عن بلد علماني غير متمدن[59]؛ لأن الإسلام الذي سبق وأبطل كديانة للدولة في أثناء ثورة كمال (أتاتورك)، ما زال يتمتع بتأثير كبير في الحياة الاجتماعية”[60]. تظهر هذه المقارنة الفارق بين “مدنية” أو “دنيوة” الدولة المنسجمة مع مجتمعها، وعلمانية متطرفة تشكل أزمة بين الدولة والمجتمع كما هو حال تركيا أو كما هو حال تونس. الأمر نفسه ينبّه إليه باحث غربي آخر هو “براين تيرنر” ( BryanS Turner ) الذي يميز بين ظهور العلمانية في سياق تغيرات مجتمعية داخلية على غرار ما حدث في أوروبا الغربية بفعل التطور الرأسمالي، وفرض العلمانية ببرنامج سياسي من قبل الدولة، أي من أعلى، مثلما حصل في تركيا وفي روسيا وبلدان أوروبا الشرقية[61]. يصل الباحث إلى حد التأكيد أن العلمانية في الإسلام إن حدثت فستكون مختلفة عن العلمانية في المسيحية، وأن من ينظر إليها نظرة حتمية وكونية هو مخطىء لأنه يتجاهل الطابع السوسيولوجي للعلمانية وتفاوت تطورها نسبة إلى اختلاف الأنماط الثقافية والاقتصادية للمجتمعات[62].
ب ـ العلمانية بين التاريخية والجوهرانية
يوضح محمد أركون أن العلمانية المتطرفة في أوروبا نفسها، وفي فرنسا تحديدًا، بدأت تأخذ منحًى أكثر انفتاحًا على الدين، وهو برغم دعوته لعلمنة المجتمعات العربية الإسلامية كحل لأزمات هذه المجتمعات فإنه بالمقابل يوجه نقدًا قويًّا لتطرف العلمنة، حيث تساهم العلوم الحديثة، في طرح الأسئلة المطموسة من جديد، وفي إعادة الاعتبار للمسائل اللاهوتية والدينية: “لم يعد التحدث في المسائل الدينية شيئًا مستقبحًا أو مكروهًا، أو منعوتًا بالرجعية من قبل العلمانيين. على العكس أصبح الكثيرون يدعون إلى توسيع العلمانية القديمة وتشكيل علمانية جديدة، منفتحة وواسعة”[63].
وإذا كان شمس الدين يلتقي جزئيًّا مع أركون في توقع انحسار تيار العلمانية المتطرفة داخل البلدان الحاكمة فيها[64]، فإن تيارًا فكريًّا بدأ ينمو في لبنان والعالم العربي جاعلًا من العلمانية فلسفة قائمة لها جوهرها غير القابل للتعديل والمس[65].
يبتعد هذا الاتجاه عن قراءة تطور العلمانية في أبعادها في موقف لا يتخذ من الاعتبارات السوسيولوجية أو التاريخية أو السياسية أو الأخلاقية وما شابه ذلك أساسًا أو مسوغًا أخيرًا لها[66].
العلمانية الصلبة هذه كما يسميها أصحابها تتجاوز كل الاعتبارات التاريخية التي رافقت نشوء مفهوم العلمانية وتطبيقاته المتمايزة للعودة إلى النواة السيمانتية الجوهرية للمفهوم وهي السمات الأبسط ذات الأسبقية المنطقية على كل السمات الأخرى، وهي المكونات الأساسية للمفهوم[67].
لا يتعلق الأمر بوجود مؤسسة دينية كمؤسسة الكنيسة، أنها علمانية تتصل بشيء أعمق من هذا بكثير أي بالطابع الكلياني للدولة الدينية، كما أن الأساس الأخير للإلزام السياسي أو القانوني يكمن في الأخلاق بوصفها نشاطًا معرفيًّا مستقلًا منطقيًّا عن الدين[68].
يحول هذا الاتجاه العلمانية إلى “فلسفة” قائمة بذاتها بعيدًا من تفاعلها مع المجتمع، ويكاد يعطيها هالة من القداسة أكثر بكثير مما يعطيه أتباع الأديان لأديانهم والذين تريد هذه العلمانية “الصلبة” عزلهم تمامًا عن المفاعيل المجتمعية، وهو أمر باتت تحذر منه الأوساط العلمية في فرنسا نفسها، ولا عجب إذا رأينا أن محمد أركون نفسه يحذر من هذا الاتجاه السلبي: “لا يعني أبدًا أن العلمنة ينبغي أن تصبح بدورها سلطة عليا تضبط الأمور وتحدد لنا ما ينبغي التفكير فيه وما لا ينبغي التفكير فيه كما فعلت سلفية الفقهاء والأكليروس سابقًا”[69].
بدوره يشدد عزيز العظمة على أن العلمانية أخذت سياقات اجتماعية عديدة: “ولا يمكن فهمها كلفظ ثابت، بل هي مضامين متحولة تحول الاشتقاقات والمعاني اللغوية إلى معانٍ عرفية تتخذ مضامينها المعينة من التاريخ”[70].
هكذا نجد أن محاولات “جوهرة” العلمانية بعيدًا عن فهمها في إطار اجتماعي – تاريخي، يخرجها ليس من سياقها التاريخي الطبيعي فقط، بل يحاول فرضها على المجتمعات العربية – الإسلامية دونما مراعاة لخصوصياتها أو لإمكانية تبلور صيغة ما من صيغها وفقًا لتفاعل مجتمعي – تحديثي داخلي، فإذا كان الخطاب الإسلامي الراهن يغادر طوباويته نحو مصالحة ما مع الواقع، يأتي خطاب جديد حاملًا طوباويته العلمانية وكأنها ديانة جديدة أو ديانة سياسية كما أسماها جان بول ويليام لديها إكليروس علموي وأنظمة من المعتقدات والممارسات تنحو بها نحو “الديانات العلمانية”[71].
إن صعود مثل هذا الخطاب العلمانوي يشكل استفزازًا سلبيًّا للخطاب الإسلامي ولقاعدته المجتمعية، بما لا يتيح له تقديم رؤيته “المدنيّة” التي تشهد تبلورًا واضحًا منذ الثمانينات مثلما حصل مع خطاب رواد النهضة الذي انشطرت توفيقيته منذ العشرينات نحو تيارات غير توفيقية.
لقد أشار المرجع الميرزا محمد حسين النائيني (1857-1936 ) – وليس فقط محمد عبده (ت-1905)، ورشيد رضا(1865- 1935) في مرحلته الفكرية الأولى – إلى أن “الحصول على الحرية أو الخضوع والاستبداد لا يؤثران سلبًا أو إيجابًا في التزام المؤمنين بمقتضيات ديانتهم”[72]، وذلك في سياق تقديم فهم جديد لعلاقة التدين بالدولة الحديثة الديمقراطية.
لكن هذا الفهم والدفاع عن الاتجاه “المدني” للدولة الحديثة لقي نكوصًا وانقطاعًا داخل المؤسسة الدينية لأسباب عديدة من بينها التطورات السياسية والمجتمعية التي عزلت المؤسسة نفسها عن الحياة المجتمعية منذ العشرينات وطغيان خطاب علمانوي حاد (عبّر ساطع الحصري (ت 1968) عن أحد وجوهه) دفع الخطاب الديني إلى الدفاع عن وجوده وكيانه قبل أن يمارس عملية التواصل مع جهود مفكري النهضة في العقد الأخير من القرن العشرين[73].
احتاج هذا التحول في خطاب الإسلاميين إلى انخراط واسع في الشأن المجتمعي، وانتقال من مرحلة الخطاب الدفاعي التبريري إلى خطاب متفاعل مع التحديات يقدم إجاباتًا وحلولًا.
يقوّم فرانسوا بورجا خطاب “الإسلام السياسي” كما يسميه بأنه يقدم إشارات متزايدة عن قبوله بالخصوصيات العائدة للدولة الحديثة بعيدًا من مفاهيم “الأمة” السابقة وأمثالها مغادرًا دوغمائياته السابقة: “أن الإسلام الراديكالي سيستوعب في النهاية – ورغمًا عنه – وبعد أن يتأكد من استقرار جذوره في الواقع، مجال السياسة المعاصرة حتى لو لم يتم التعبير عن ذلك بصراحة أن الدولة العلمانية المعاصرة على وشك أن تحصل على الجنسية الإسلامية”[74].
بالرغم من هذا التطور الذي أشار إليه بورجا تبقى الحاجة لدى مفكري الإسلام السياسي هؤلاء إلى تطوير البنية المعرفية للاجتهاد لاستيعاب التطورات المجتمعية الراهنة، أن التغيير الأولي في الخطاب الإسلامي نحو مصالحة أو استيعاب “مدنيّة الدولة الحديثة”، أو التركيز على “مدننة” الدولة الدينية يبقى ذا دوافع سياسية عملانية قابلة للتغيير حتى في الاتجاه المعاكس، كما حصل بعد فترة عصر النهضة، إلا إذا تحول إلى نقلة معرفية جديدة داخل الفكر الإسلامي.
مراجع عامة:
- محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، عابدين(مصر)، الطبعة 4، 1964م.
- محمد البهي، مشكلات الحكم، 1965م.
- محمد البهي، مشكلات الأسرة، بيروت: دار الفكر، 1973م.
- أنور الجندي، سقوط العلمانية، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1973.
- عماد الدين خليل، تهافت العلمانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1975م.
- يوسف القرضاوي، الحلول المستوردة، القاهرة: مكتبة وهبي، 1971م.
- يوسف القرضاوي، بيّنات الحل الإسلامي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1988م.
[1] عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1992م، الصفحة 17. وكذلك جمال باروت (وآخرون)، الاجتهاد النص ـ الواقع ـ المصلحة، دمشق: دار الفكر 2000م، الصفحة 128.
[2] محمد أركون، قضايا في نقد العقل الدين، ترجمة هاشم صالح، بيروت، دار الطليعة، دون تاريخ، الصفحة 215.
[3] العظمة، مصدر سابق، الصفحة 18.
[4] المصدر نفسه.
3 مجلة آفاق، بيروت، العدد 17 حزيران 1978، الصفحتان 1 و2. وقد اقترح العلايلي لفظة عربية بديلة للعلمانية هي “حلانية“، ويقابلها “حبرانية“؛ حكم الأحبار، من “حبرن السلطة”. المصدر نفسه، الصفحة 2.
[6] محمد مهدي شمس الدين، بين الجاهلية والإسلام، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، دون تاريخ، الصفحتان 85 – 86.
[7] حمل الكتاب اسم: العلمانية: تحليل ونقد للعلمانية محتوًى وتاريخًا في مواجهة المسيحية والإسلام، وهل تصلح حلًّا لمشاكل لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، 1980.
[8] محمد مهدي شمس الدين، العلمانية، الصفحة 83.
[9] المصدر نفسه، الصفحة 162.
[10]صدر كتاب شمس الدين المناهض للعلمانية بعد عامين من إصدار مجلة آفاق التي رأس تحريرها جيروم شاهين عددًا خاصًّا عن العلمنة، قدم له مداخلة لغوية عبد الله العلايلي، وقد تضمنت المجلة (عدد حزيران 1978) مقالًا خاصًّا يدعو لاعتماد الزواج المدني اختياريًّا.
[11] ما زالت المعركة الفكرية حول العلِمانية أو العَلمانية قائمة حتى الآن؛ فعزيز العظمة يتبنّى كتابه العلمانية من منظور مختلف الصادر عام 1992 (العِلمانية) رغم استدلاله اللغوي القريب للذي يقدمه العلايلي عن الاشتقاق من كلمة Laïcité المشيرة إلى عامة الناس والسلطة الزمنية العائدة للعالم الزمني الدنيوي.
[12] شمس الدين، العلمانية: (تحليل ونقد..) مصدر سابق، الصفحتان 84 – 85.
[13] شمس الدين، المصدر السابق، الصفحة 166.
[14] المصدر السابق، الصفحات 209 – 212.
[15] محمد مهدي شمس الدين، دراسات ومواقف، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، 1990، الجزء2، الصفحة 315. (راجع تفصيل الموقف في الفصل السابق، الحرية الفكرية عند شمس الدين، ج ـ الموقف من الأطر الديني).
[16] فرح موسى، خيارات الأمة وضرورات الأنظمة عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الحركات الإسلامية المعاصرة بين القبض والبسط، نقد وتحليل، بيروت: دار الهادي 1990م، الصفحتان 195 ـ 196.
[17] المصدر نفسه، الصفحتان 186 – 187. نقلًا عن خطبة الجمعة في 11 – 11 – 1993.
[18] شمس الدين، الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي، بيروت: المؤسسة الدولية، 1999، الصفحتان 244 – 245.
[19] مجلة منبر الحوار، بيروت، العدد 34 ـ خريف 1994م، الصفحة 7.
[20] المصدر نفسه، الصفحة 8.
[21] حسن الترابي، قضايا التجديد، نحو منهج أصولي، الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية، 1990، الصفحتان 41 – 42.
[22] المصدر نفسه، الصفحة 42.
[23] المصدر نفسه، الصفحة 42.
[24] الترابي، قضايا التجديد، مصدر سابق، الصفحة 177.
[25] الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، لاهور: الشركة العربية العالمية، 1990، الصفحة 118.
[26] الترابي، حوارات في الإسلام والغرب، بيروت: دار الجديد، 1995، الصفحة 70.
[27] الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، مصدر سابق، الصفحة 242.
[28] -الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993، الصفحة 336.
[29] الغنوشي، الحريات العامة، مصدر سابق، الصفحة 336.
[30] المصدر نفسه، الصفحة 338.
[31] المصدر نفسه، الصفحة 338. (القانون الأساسي لحركة النهضة في تونس).
[32] الغنوشي، مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني، لندن: المركز المغاربي للبحوث والترجمة، 1995، الصفحة 158.
[33] الغنوشي، المصدر السابق، الصفحة 150.
[34] – الغنوشي، المصدر السابق نفسه، الصفحة 151.
[35] الغنوشي، المصدر نفسه، الصفحة 191.
[36] الغنوشي، مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني، مصدر سابق، الصفحتان 60 – 61.
[37] الغنوشي، الحركة الإسلامية ومسألة التغيير، لندن: المركز المغاربي للبحوث والترجمة، 2000، الصفحة 198.
[38] المصدر السابق نفسه.
[39] الغنوشي، مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني، مصدر سابق، الصفحة 158.
[40] محمد أركون، قضايا في نقد العقل الدين، مصدر سابق، الصفحة 210.
[41] دعوته التي حرّضت للوقوف بوجه (التغريب والعلمانية والصهينة).
[42] توفيق المديني، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 1997، الصفحة 589.
[43] المصدر نفسه، الصفحة 594. ويشير الباحث هنا إلى قوانين 13 أيار 1965، و18 تموز 1957م.
[44] المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، مصدر سابق، الصفحة 593.
[45] الغنوشي، الحركة الإسلامية ومسألة التغيير، مصدر سابق، الصفحة 42.
[46] لأخذ عينة من الصراع الفكري – السياسي، الذي طبع تلك الفترة يمكن مراجعة مجلة آفاق العدد 17 حزيران 1978 – عدد خاص عن العلمنة، مقال غريغوار حداد بعنوان: العلمنة استراتيجية أم تكتيك.
[47] انظر مجلة آفاق، العدد 17، مصدر سابق، وتضمن مقالة لعبد الله لحود عن قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لجميع اللبنانيين.
[48] شمس الدين، العلمانية، مصدر سابق، الصفحة 149.
[49] شمس الدين، المصدر نفسه، الصفحتان 149 – 150.
50 المجالس الملّية – المذهبية لها سلطاتها القانونية ضمن النظام الطائفي اللبناني.
51 دخل الترابي البرلمان عام 1965م وتفرغ للعمل السياسي منذ ذلك الوقت تاركًا التدريس في الجامعة (كلية الحقوق في الخرطوم). الحامدي، حسن الترابي آراؤه، الصفحة 18.
52 تشير إحدى الدراسات البريطانية إلى أن الهدف من إدخال التعليم العالي إلى السودان (بدءًا بكلية غوردن التذكارية التي تخرج فيها الترابي نفسه) خلال فترة الحكم الإنكليزي – المصري (1898 – 1955) هو تخريج كوادر تساعد الإدارة المستعمرة في إدارة المرافق الهامة كسد سنّار (1925)، ومشروع الجزيرة الزراعي العملاق (1927) حيث دخلت العلمانية مع التحديث والتعليم العالي إلى السودان:
Trinningham. J. S., Islam in The Sudan, London – Frank cas, 1965, PP. 252 – 265.
[53] مجلة قراءات سياسية عدد 3/ صيف 1992. الصفحة 43.
[54] بادي، برتران، الدولتان/ الدولة المجتمع في الغرب وفي دار الإسلام، بيروت، المركز الثقافي العربي، دون تاريخ، الصفحة 186. بدوره فإن عزيز العظمة قدّم رؤية تاريخية واجتماعية متعلقة لهذا الجانب في كتابه: العلمانية من منظور مختلف، مصدر سابق.
[55] وجيه كوثراني، الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا، بيروت: دار الطليعة 1996، الصفحة 8.
[56] كوثراني، المصدر نفسه.
[57] لا تزال بعض الحركات الإسلامية ترفع شعار إعادة إحياء الخلافة الإسلامية كما جرت في التاريخ كبرنامج سياسي وفكري لها، ومنها حزب التحرير الإسلامي الذي أسسه تقي الدين النبهاني (1909 ـ 1977م) المحظور في غالبية البلدان الإسلامية، حيث يعتبر الحزب أن إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924 أدى إلى زوال حكم الإسلام عن كل الأرض المستمر منذ عهد الرسول محمد (ص)، وبذلك صارت البلاد الإسلامية “دار كفر”. وقد أعد مشروع دولة إسلامية تقوم على الخلافة. (دراج وباروت، (منسقان)، الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية، مصدر سابق، الجزء2، الصفحة 51 حتى 55).
[58] أعيد طبع كتاب عبد الرازق في تونس عام 1999م لأسباب سياسية وفكرية معًا، وصدر عن دار المعارف للطباعة والنشر بسوسة. وتشير ملابسات صدور كتابه الإسلام وأصول الحكم إلى ارتباطه بظروف إلغاء الخلافة في تركيا والحملة الفكرية الآتية من خارج مؤسسة الأزهر، وليس كنتاج تجديدي داخلي خصوصًا لحظة نشوء التيار العلماني المصري، وقد كان طه حسين (1900 – 1973م) من الذين قرأوا مخطوطة الكتاب قبل صدوره وأتبعه بكتابه الذي يكمل السياق نفسه وهو “في الشعر الجاهلي”، كما أن عبد الرازق الذي كان عضوًا في هيئة علماء الأزهر كان أيضًا موظفًا رسميًّا كقاضٍ في سلك القضاء، الأمر الذي أدّى بمؤسسة الأزهر إلى طرده من هيئتها والضغط على الحكومة لطرده من القضاء. لقد كانت مسألة الخلافة إحدى محاور النقاش السياسي والفكري التي شارك عبد الرازق وطه حسين فيها وخلفهم حزب الأحرار الدستوريين ذي التوجه العلماني؛ وهو الحزب الذي يعتبر امتدادًا لحزب أسسه البريطانيون في مصر قبل الحرب العالمية الأولى. (انظر: دراج وباروت، مصدر سابق، الجزء1، الصفحات 29-35).
[59] نقصد بالترجمة هنا تمدين مقابل العلمانية؛ أي التمدين كعبارة تطلق على العلمانية في البلدان البروتستانية وهي العلمانية غير المعادية للدين.
[60] جان بول ويليم، الأديان في علم الاجتماع، بيروت: دون ناشر، 2001، الصفحة 148.
[61] – Bryan S.Turner:Weber And Islam (A Critical Study) ,London / Boston-Routledge & Kegan Paul ,1974, Page163.
[63] محمد أركون، قضايا في نقد العقل الدين، مصدر سابق، الصفحة 258، وكذلك انظر، الصفحة 314.
[64] شمس الدين، العلمانية، مصدر سابق، الصفحة 156.
5 من أبرز دعاة هذا التيار عادل ضاهر صاحب كتاب الأسس الفلسفية للعلمانية.
[66] عادل ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، بيروت: دار الساقي، الطبعة1، 1993، الصفحة 62.
[67] المصدر نفسه، الصفحة 43.
[68] المصدر نفسه، الصفحات 48 ـ 53.
[69] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، مصدر سابق، الصفحة 294.
[70] عزيز العظمة، العلمانية، مصدر سابق، الصفحة 18.
[71] جان بول ويليم، الأديان في علم الاجتماع، مصدر سابق، الصفحتان 122 – 123.
[72] توفيق السيف، ضد الاستبداد، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1998، الصفحتان 199 – 200.
[73] هناك بعض الاستثناءات التي لم تشكل تيارات فاعلة ضمن المؤسسة الدينية، ويمكن الإشارة هنا إلى أطروحات المفكر السوري الإسلامي مصطفى السباعي (1915- 1964م)، الذي وصف التشريع الإسلامي بأنه “مـدني علماني يضع القوانين للناس على أساس من مصلحتهم وكرامتهم”. نقلًا عن: باروت محمد جمال (وآخرون)، الاجتهاد …، مصدر سابق، الصفحة 132.
[74] بورجا، الإسلام السياسي، ترجمة وتقديم: نصر حامد أبو زيد، القاهرة: دار العالم الثالث، 1992، الصفحتان 56 – 57.
المقالات المرتبطة
أزمــة الإبـداع الموصـول عند طـه عبد الرحمن القراءة الحداثية للنص القرآني أنموذجًا..
تثير الدراسات الحداثية للنص القرآني، الكثير من ردود الفعل، من قبل الباحثين الذين تصدوا لها، إما إقصاءً، أو تبنيًا مطلقًا،
التعددية الدينية
التعددية الدينية[1] الشيخ مصباح اليزدي اكتسب مصطلح البلورالية مدلولًا معاصرًا في الميدان الثقافي، وهو يعني في المجال الفكري والديني ضرورة
كربلاء الجمال والجلال
سؤال واحد يجول منذ أمد لماذا أمسك بيد نافع بن هلال وسار معه في تلك الليلة ؟ إي نافع …





