العلمانية والدين الحدود من وجهة النظر الغربية
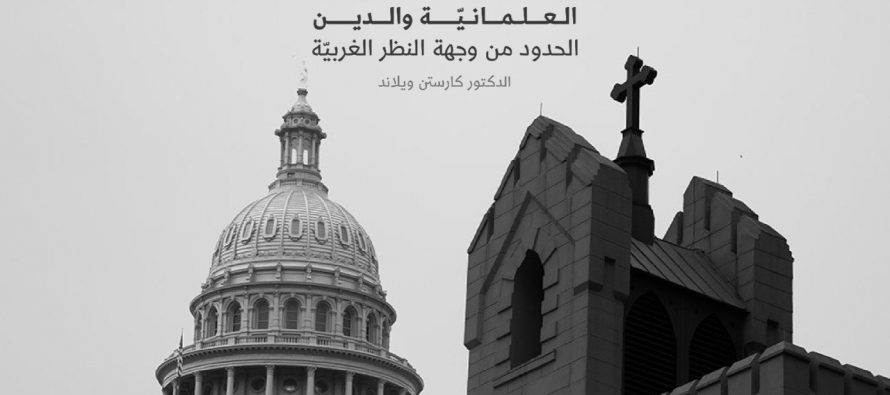
العنوان المعطى لعرضي قصد به “حدود العلاقات بين العلمانية والدين” من المنظور الغربي. ومن خلال سياق هذه المناظرة سأركّز بشكل رئيسي على العلمانية من جهة، والإسلام من جهة أخرى.
هناك على الأقل عقبتان في هذا العنوان:
العقبة الأولى: أصبح من الصعوبة بمكان إعطاء وجهة النظر الغربية حول هذه المواضيع، وسنواجه نفس الصعوبة على الأقل في حال وجهة النظر الإسلامية، حيث لا حدود واضحة المعالم.
لقد فقدت نظرية التجديد بريقها للعديد من المفكرين الغربيين أيضًا، وطبقًا لهذه النظرية هنالك نمط موحد أو أكثر للتطور، يتضمن التصنيع، تقسيم العمل، زيادة الكفاءة عن طريق تسريح الفائض عن الحاجة استنادًا إلى مبدأ Weber، التفرد، العلمنة. تظهر ملامح الحداثة في العديد من الدول الإسلامية بينما تضمحل العلمنة شيئًا فشيئًا. ولقد دعا العديد من المفكّرين كالمفكر السوري الطيب تيزيني إلى التمييز بدقة بين الحداثة والتجديد، خصوصًا في إطار المسلم العربي لأن التجديد له مفهوم سلبي، ويثير ردود أفعال عكسية عند الآخرين حيث يذكر بعهود الاستعمار.
وبالرغم من أن نظرية التجديد تجاوزت ذروتها في العالم الغربي، ما تزال هناك نزعة إلى اعتبار العلمنة عنصر أساسي في التطور المعاصر.
في هذا السياق يعرف التقدم الاجتماعي والسياسي اصطلاحًا على أنه عتق البشر من التراكيب الدينية والتقليدية السالفة التصور. المبدأ هو أن حقوق الإنسان يمكن أن تعرف دون اللجوء إلى مذاهب دينية هو جزء من هذه المدرسة.
العقبة الثانية: هي في مصطلح العلمانية نفسه فهو مثير للجدل. ولإيجاد الحدود بين العلمانية والدين يجب أن نقابل مفهوم العلمانية الغربي بالمفهوم المسلم العربي.
أولًا للعلمانية مظاهر عديدة موجودة بتفسيرات مختلفة في دول الغرب نفسها. بالإضافة إلى ذلك وبوضوح أكثر العلمانية لها مضامين مختلفة في الغرب وفي الشخصية العربية.
مرت العلمانية في أوروبا بمراحل تطور طويلة نظرية، اجتماعية، اقتصادية، وسياسية. إنها للكثيرين وليدة حركة التنوير التي قام أبطالها بالتدقيق في التفاسير والمبادئ الدينية، وارتابوا فيها علنًا، وفي بعض الأحيان خاطروا بحياتهم بمواجهتهم للمؤسسة الكنسية.
الربوبية، الاستقراء، العقلانية، التشكيك أصبحت ميول مفكري ذلك العصر، مع الإيمان المتفائل بتقدم الإنسان وتطور القانون الطبيعي (على عكس التعاليم القانونية الدينية التقليدية)[2]. هذه التيارات الفكرية قصدت فوق كل شيء: أنا أؤمن فقط بما أرى وبما أضع بنفسي، أنا لا أؤمن بالتفسيرات الدينية السابقة التصور. وإذا آمنت بالله، فإنه سيكون مستقلًّا تعريفًا عن مؤسسات الكنيسة التي هي من صنع الإنسان. إنه فكرة ناتجة عن قدراتي العقلانية.
ووفقًا لذلك عرّف الفيلسوف الألماني إمانويل كانط التنوير بأنه “خروج الإنسان من أعباء نفسه الأخلاقية الفجة”[3]. عرّف الإدراك بأنه استخدام المنطق دون الحاجة إلى إرشاد الآخرين، وهذا كما توقع لا يحتاج فقط إلى المنطق بل إلى الشجاعة أيضًا.
ولذلك العلمانية في الغرب هدفت أساسًا إلى الحد من “تسلط القلة” الذين يفسرون كتابًا يعتبر مقدّسًا، والذين يشعرون بأنهم مخولون بتشكيل أجواء الناس الخاصة، الاجتماعية وكذلك الحياة السياسية. العلمانية أكثر من مجرد أيديولوجيا سياسية، مع أنها أحدثت تغييرات سياسية عميقة. إنها مفهوم شخصي، وفي الوقت نفسه جزء من التطور المجتمعي. وما الفصل بين الكنيسة والدولة إلا ميزة واحدة فقط، وغالبًا ما تكون المحصلة السياسية النهائية.
هذا الفصل كان له بوادر سياسية في مؤتمر المصالحة الدينية في أوغسبرغ 1555م، وفي مؤتمر المصالحة في ويستفاليا 1648م بعد حرب طويلة دامت 30 عامًا دمّرت أجزاء كبيرة من وسط أوروبا. فقدت الكاثوليكية احتكارها الروحي، الاجتماعي والسياسي بعد إصلاح مارتن لوثر البروتستانتي. أصبحت الطائفية سببًا دائمًا للنزاع. ومن خلال مصالحة ويستفاليا، أصبح الدين خاضعًا لتنظيمات الدولة القانونية. بكلام رمزي دُعي المحامون إلى طاولة المفاوضات، وأجبر رجال الدين أصحاب السلطة سابقًا على الرحيل.
وقضي على الدعوة إلى كونية دينية واستبدادية بشكل نهائي، حيث كان لا بدّ من الفصل بين قانون الدولة الداخلي والدين بهدف تحقيق السلام ونظام جديد من المساواة وسيادة الدول في أوروبا.
بالرغم من ذلك بعد ويستفاليا قويت الكنائس ضمن دولها، وحظر الدين على السياسة الخارجية واتضح فيما بعد بأنه وسيلة فعّالة لمنع حروب دينية أو طائفية، مع ذلك ليس كل الحروب بشكل عام. وسوف يتطلب بعض الوقت حتى يتحدى الدين بشكله العرفي والروحي من قبل السياسة المحلية. حدث هذا خلال الثورة الفرنسية في 1789م، ومهد الأرض للشكل اللاحق من العلمانية السياسية في فرنسا وحتى يومنا هذا.
وكما أسلفنا، العلمانية بالمعنى الأوروبي أكثر من الفصل بين الكنيسة والدولة (laïcité). وبمحاذاته تخصيص الدين، وعلى نطاق أوسع، لا تدين الناس (تردي في العقيدة الشخصية والممارسات الدينية) وخاصة في أوروبا وبشكل متزايد في أواخر القرن الماضي[4].
الإلحاد كظاهرة جماهيرية هو تطور حديث جدًّا. هيأ له التنوير ودخل الكثير منه حيّز التطبيق بعد انتشار الفكر الماركسي عن طريق ثورة أكتوبر في روسيا في 1917 م، وبشكل أقوى بعد ثورات 1968م الاجتماعية في المجتمعات الغربية التي تحدت السلطات القديمة بشكلها الروحي، الاجتماعي أو السياسي. وهيمن اللاتدين في أوروبا على المهاجرين المسلمين والمسلمين الأوروبيين كالبوسنيين مثلًا[5].
ومع ذلك فإن مظاهر العلمانية الثلاث – فصل الكنيسة عن الدولة، تخصيص الدين، اللاتدين – ليست بالضرورة ظاهرة بنفس المدى في كل الأماكن. وهنا ندخل إلى الفروقات بين الدول الغربية.
على سبيل المثال، ألمانيا الشرقية أصبحت واحدة من أكثر الأقاليم اللادينية بنسبة 69% من الناس بدون مذهب (عام 2000)[6]. وكذلك اللاتدين بلغ قمة عالية، وبشكل متزايد في ألمانيا الغربية حيث لا يوجد فصل تام بين الكنيسة والدولة بشكل تام. فالدولة تجمع ضرائب الكنيسة من مدخولات الناس (طالما هم من أتباع الكنيسة) وتدفعها أوتوماتيكيًّا إلى الكنيسة. في إسكندنافيا هنالك كنيسة بروتستانتية حكومية، بالرغم من وجود مستوى متدني للإيمان والممارسة الدينية بين الشعب. وفي فرنسا الفصل بين الكنيسة والدولة صارم ومستمر، حيث ويا للعار أجزاء كبيرة من الشعب هم كاثوليك حتى الصميم في إيمانهم الشخصي.
في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وخصوصًا خلال إدارة بوش، نشهد دورًا واضحًا ومتزايدًا للدين وبروز الإيمان الشخصي في الحياة اليومية. الإشارة البلاغية إلى الله موجودة كليًّا في المحيطين الشعبي والسياسي. فحماسة بوش التبشيرية في السياسة الداخلية والخارجية، وطرقه الحثيث والجاد لمواضيع اجتماعية محددة كالشذوذ الجنسي، الإجهاض، السلوك الجنسي، تعريفه المبسط للخير والشر… إلخ، نظرته الشاملة للعالم تذكر بالأصوليين الدينيين في أنحاء أخرى من العالم، وكذلك في الإسلام. ولكن قي الوقت نفسه الصلاة ممنوعة مثلًا في مدارس الولايات المتحدة قانونًا، والمنظمات الدينية متعددة وخاصة ومستقلة عن الدولة.
الخلاف الكبير بين أوروبا وأمريكا حدث على الأرجح تاريخيًّا في القرن الثامن عشر. فالدين للمستوطنين الأوائل ومؤسسي الولايات المتحدة لعب دوره كنوع من “التحرر اللاهوتي”. وساعد كمؤسس روحي أثناء عملية البناء الصعبة للأمة الجديدة. في هذه النقطة اعتبر قوة تحرّرية. وفي المقابل الأوروبيون اعتبروا الدين وبشكل متزايد على أنه جزء من مؤسسة سياسية مستبدة. لم يهربوا منها بالهجرة (بدينهم)، ولكن بتحررهم (من الدين).
تظهر هذه الأمثلة أن التفسيرات العملية لعناصر العلمانية الثلاث في الغرب مختلفة إلى حد كبير. على الرغم من ذلك يظل هناك قاسم مشترك: الخبرة الثقافية، الحركة الفكرية والاجتماعية مع تزامن وتلازم تطورات الديموقراطية التحررية، سيادة القانون، حريات الأفراد، وحقوق الإنسان عامة مستقلة عن الإيمان الشخصي أو المذهب.
في المقابل، العلمانية في العالم العربي كانت شيئًا مختلفًا تمامًا. القيم التي تجلها القوى الغربية في دولها، طبقت بقسوة في مستعمراتها، وبناءً عليه، فالعديد من الأفكار العقلانية أصبحت عناوين فاسدة ودلّت على مفهوم سيء منذ ذلك الحين فقط لأنها أتت من الغرب. بالنسبة للكثير من المسلمين اليوم أصبحت العلمانية مفهومًا معاديًا مضادًّا للدين بشكل هائل. مع أنه وكما رأينا – في مختلف تفسيراتها الغربية – العلمانية لا تعني بالضرورة الإلحاد، حتى لو فسحت له المجال. العلمانية كانت في الأساس أداة لتحدي “تسلط القلة” الذين يدعون تفسير “كلمة الله” ولذلك يحتكرون الشؤون الاجتماعية والسياسية أيضًا.
على أي حال العلمانية كما خبرها الكثير من العرب، هي استبدال استبداد بآخر. العلمانية كأيديولوجيا مستوردة فرضت بشكل مشوه على مجتمعات مختلفة تمامًا في تجربتها. فقد أتت متلازمة مع الإمبريالية، وفيما بعد مع الفاشستية من قبل النخبة المحلية المدعومة من الغرب، بالتزامن مع هيمنة الدولة على الدين، التضليل الثقافي، وغالبًا انتهاك حقوق الإنسان والحريات الشخصية. إنه برنامج سياسي لمعظم النخبة المتعلمين في الغرب الإمساك بالسلطة وإضفاء الصفة الشرعية على حكمهم دون الالتزام بالأسس الفكرية والمجتمعية للعلمانية الغربية غالبًا.
وهكذا انحدرت العلمانية إلى معان سياسية وأيديولوجية ضعيفة بمظهر كاذب. هذا يوضح مثلًا لم تم استبدال العلمانية بسهولة في العراق بالمبادئ الإسلامية: حالما شعر صدام حسين بحاجته إلى دعم أكثر من علماء السنة والجماهير بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 م، تحول وبسرعة من “العلمانية البعثية ” إلى “الإسلام”. من الصعب التصور أن مثل هذا التحول ممكن في ضوابط الغرب العلمانية. الخطر هنا يكمن في حقيقة أن لا الخيار الأول علماني حقيقي، ولا الخيار الثاني إسلامي حقيقي.
واستنادًا إلى هذه الخلفية يمكننا التحدث عن العلمانية المتضمنة في الغرب كمفهوم نما بالتناغم مع التطلعات الفكرية والاجتماعية والأخلاقية. وفي العالم العربي في المقابل، نشهد شكلًا من العلمانية المتراكبة.
لذلك، عندما نتحدث عن العلاقة بين الدين والعلمانية، يجب أن نكون حذرين من استعمال مفاهيم مبسطة بغرض تعزيز آراء متصورة مسبقًا. لقد أصبح من الواضح بأن العلمانية الغربية هي مصطلح معقد يظهر قدرًا من المرونة اتجاه محتوياته، وحتى اتجاه الدين.
من وجهة النظر الغربية، هذا الشكل من العلمانية سبر أغوارًا جديدة أيضًا في الفلسفة الأخلاقية تجاوزت التعاليم الدينية. أحد هذه الإنجازات هو مفهوم جديد للتسامح. صحيح أن المفهوم الإسلامي للتسامح يعتبر نموذجًا رائعًا على مر العصور. في المقابل للممارسة المسيحية، فعلى سبيل المثال أظهر القادة السياسيون المسلمون قدرًا كبيرًا من التسامح مع الرعايا من مختلف العقائد، كما نعلم من التركيبة الداخلية للإمبراطورية العثمانية، أو حتى من خلال ممارسات صلاح الدين بعد هزيمته للصليبيين المسيحيين.
من ناحية أخرى المفهوم الإسلامي للتسامح لا يعطي غير المسلم نفس القدر من المساواة. إنه نوع من سياسة التسامح الديني أكثر منه تسامحًا. المسيحي أو اليهودي هو ذمّي، أي هو شخص منح أكبر قدر من الحماية القانونية، المجتمعية، الاقتصادية والسياسية. ولكنه في نظام الحكم الإسلامي لا يتمتع بمساواة كاملة، وفوق كل ذلك ليس له مرتبة أخلاقية مساوية. وإلا لماذا يجب على الرجل أن يتحول إلى الإسلام إذا أراد أن يتزوج من امرأة مسلمة؟ وتباينات أخرى أيضًا: غير المسلمين تحت حكم المسلمين، غالبًا وليس دائمًا، يجب أن يدفعوا ضريبة أعلى من المسلمين (مثلًا، في أيام الإمبراطورية العثمانية في عهود بعض الحكام المسلمين في الهند…إلخ). وأكثر من ذلك في الأقطار الإسلامية وحتى يومنا هذا لا يمكن لغير المسلم أن يصبح رئيسًا للدولة، ولا حتى في دول “علمانية” رسميًّا كسوريا. وبكلام مثالي إذا كان المسلمون هم الأكثرية في دولة، فإن الدولة يجب أن تكون إسلامية.
التسامح الإسلامي يضع شروطًا معيارية مسبقًا: الذمّي يجب أن يكون من دين معروف، على الأقل استنادًا إلى التفاسير الإسلامية السائدة، لا مكان اجتماعيًّا، أخلاقيًّا وقانونيًّا للمشركين أو للملحدين. ثانيًا، الذمّي يجب أن يكون “تقيًّا” ويظهر “أعماله الصالحة”[7]. ولكن من يحدد صلاح أعماله؟ بالطبع، الجواب هو الإطار الإسلامي. وهذا يترك مجالًا للاختلاف تبعًا للظروف السياسية ويترافق معه خطر إساءة المعاملة. ومرة أخرى هؤلاء الذين يفسرون كلام القرآن يقررون ما عنى الإسلام في سياق الكلام وفي وقت معين. وخاصة في التاريخ المعاصر، حيث أصبح المجال محدودًا للمعارضة.
من خلال حركة التنوير وشكل العلمانية الأوروبي نشأت نسخة جديدة من التسامح – ومن وجهة النظر الغربية – تغلبت لأول مرة على السبق الإسلامي في شكل التسامح المحرض دينيًّا أو سياسة التسامح الديني. النسخة الأوروبية تأتي مع ديموقراطية تحررية وتعددية، دون إملاء شروط معيارية مسبقة وافتراضات استنتاجية.
المسلمون (في حال المواطنة) نالوا مراتب متساوية اجتماعيًّا، سياسيًّا وأخلاقيًّا في دول كانت مسيحية والآن تهيمن عليها العلمنة بدرجات متفاوتة[8]. الناس أقل تقيّدًا بدينهم وبالمفهوم الشمولي المسبق للـ”الصالح ” منهم بسلوكهم وبمفهوم أكثر اعتدالًا للـ”الحق”[9].
وعلى هذا المنحى لا توجد مواصفات استنتاجية محرضة دينيًّا للزوج، رئيس الدولة كائنًا من يكن.
بالطبع المتحاملين والمعادين للمسلمين ما يزالون موجودين في الدول الغربية واكتسبوا زخمًا جديدًا بعد 11 سبتمبر 2001. لكن هذه ظواهر منفصلة عن الأفكار الأساسية للمجتمعات، في تطبيق القانون، والنظم السياسية (كما أن هجمات 11 سبتمبر نفسها اعتبرت أعمالًا لا إسلامية من قبل الكثير من المسلمين).
عندما برزت فكرة التسامح في ثورة التنوير، الكاتب الألماني المعروف غوتلد إفرايم ليسينغ، صورها في قصة صغيرة. اسم الكتاب الصغير هو “ناتان الحكيم” عام 1779[10].
ناتان هو يهودي يعيش في الشرق الأوسط في أيام الصليبيين العنيفة. تبنّى طفلة مسيحية يتيمة وكونه مستشارًا للسلطان المسلم صلاح الدين، سأله صلاح الدين يومًا أي الأديان هو الأفضل. شكّك صلاح الدين وطلب النصيحة حيث إنه يحكم بلدًا لا يكف فيه اليهود والمسيحيون والمسلمون عن قتال بعضهم بعضًا.
لذلك يروي ناثان لصلاح الدين أمثولة الخاتم: هنالك خاتم ملون وثمين وتقليديًّا كانت تتناقله الأسرة من الأب إلى أقرب ابن إلى قلبه، واستمر الأمر هكذا لأجيال. وفي يوم كان لأب ثلاثة أبناء، وكان يحبهم جميعًا بالقدر نفسه. وفي لحظة يأس يذهب إلى الصائغ ويطلب أن يصنع له نسختين من الخاتم. يصنع الصائغ نسختين مطابقتين للخاتم وشعر الأب عندها بالارتياح. وقبل أن يموت بوقت قصير طلب كل ابن من أبنائه إلى فراشه على حدة، وبعد موت الأب اكتشف الأبناء أن كل واحد منهم معه خاتم. وبدأ القتال بينهم حول من سيكون سيد المنزل. وحيث إنهم لم يجدوا حلًّا لجأوا إلى القاضي وحكم بالتالي: إنه من المستحيل معرفة الخاتم الأصلي فالثلاثة هي نفسها. والطريقة الوحيدة لمعرفة الشخص الأفضل ومن يحمل الخاتم الحقيقي هي رؤية من يتصف بأفضل سلوك في الحياة، ومن هو أكثر أخلاقية ويظهر تسامحًا مع الآخرين. لا أحد مؤهّل ليكون “أفضل شخص” وسيد البيت سلفًا، فقط بسبب حيازته الخاتم. المستقبل فقط وسلوكه الشخصي سوف يظهر الفارق.
بالطبع رمز ليسينغ بالخواتم الثلاثة للأديان الثلاثة الرئيسية الموجودة في الشرق الأوسط. واليوم في سياق العلمانية الغربية المتنورة يمكن أن نضيف بأنه حتى الذي لا يملك خاتمًا يجب أن يمنح الفرصة ذاتها ليثبت بأنه أخلاقيًّا شخص صالح، وأن يمنح نفس المرتبة الأخلاقية والاحترام. هناك اعتراض شائع واحد من جانب الأديان الراسخة، بما فيها الإسلام، ألا وهو في أوروبا هناك بالضرورة أخلاقيات أقل بسبب قلة الدين.
وموضوع التسامح هو بالتأكيد نقطة تظهر الخلاف بين الدين والعلمانية، خصوصًا بين الإسلام والعلمانية الغربية.
ومن جهة أخرى، فإن نظرة شمولية تبيّن وجود مفاهيم أساسية وقيم إنسانية تشابه بعضها إلى حد بعيد في كل الأديان[11].
الحكمة العامة بين معتنقي التسامح، هي أنها حديث فلسفي أخلاقي. على سبيل المثال، طريقة وصف كانط للطبيعة البشرية، تُجذّر العقلانية، وتُجذّر الواجب الأخلاقي، ويبدو بأنها تقترب من المفهوم الإسلامي الفطرة، الطبيعة البشرية الأساسية التي خلقها الله – وإن لم تكن بالمعنى الحقيقي- هي نفسها على أي حال[12].
قدّم كانط الحجة الدامغة على أن العلمانية والحركة الإنسانية لا تعنيان بالضرورة نسبية علم الأخلاق أو حتى نهاية الأخلاق، كما ادعى الكثير من الدارسين المسلمين [13].
من منظور مغاير حاول مفكرون مسلمون مثل أمير علي إظهار توافقية الإسلام مع حركة التنوير الغربية الحديثة[14]. وطُرحت قدمًا مشاريع مشابهة من قبل مفكرين مسلمين معاصرين أيضًا كالمؤرخ الإيراني هاشم آغادشيري، الذي اقترح حركة إنسانية إسلامية “بروتستانتية إسلامية” (وحكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2002 )[15].
وهكذا بعيدًا عن الحدود نجد بعض القواسم المشتركة. وإذا أدّت الطرق المنهجية المختلفة إلى نفس المبادئ الأساسية للطبيعة البشرية والقيم الأخلاقية تقريبًا، فإن النتيجة هي التي تهمنا. إذا اعتقد أتباع الحركة الإنسانية بأن الكائن البشري هو أعلى نقطة بداية ممكنة، فالقيم العليا وكذلك المثل الأخلاقية، والمسلمون يعتقدون بالمثل بالنسبة لله، فكلاهما بالمحصّلة، يطور مواقف أخلاقية ومبادئ سلوكية في المجتمع متقاربة جدًّا (كالنزاهة، الاحترام، إلخ)، فأين هي المشكلة؟[16].
على أي حال إذا قبلنا الرأي القائل بأن التراث العام للقيم الإنسانية لا يمكن أن يوجد دون الحاجة إلى الممارسات الدينية، الطقوس والمعتقدات، فيجب أن نواجه السؤال التالي للتطبيق الاجتماعي بالقوة لهذه القيم. هل هذا أكثر فاعلية إذا تم في مجتمع مع أو بلا دين، وإذا كان هناك اختلاف مطلقًا، وإن وجد فمع أي دين؟ هنا نصل إلى مفترق طرق حيث تختلف الآراء بكل تأكيد.
العلماني الذي يجادل بأن الأخلاق موجودة دون الحاجة إلى الدين، والمتدين ينزع إلى الإصرار بأن وجود الأخلاق مستحيل بدون الدين.
وهذا لن يحدث مشكلة إذا بقي الأمر مسألة رأي شخصي ونمط حياة. كلتا وجهتا النظر قد تكونان قريبتان جدًّا من بعضهما في الجوهر. ومع ذلك تبرز المشكلة عندما نصل إلى تشكيل المؤسسات الاجتماعية والسياسية، وعندما نصل إلى دمج المجتمع وتسييس عقيدة الفرد.
الجدل الشائع عمومًا عن الاختلاف بين الإسلام والعالم الغربي هو أنه لا يمكن فصل الدين عن السياسة في الإسلام[17].
فمحمد لم يكن نبيًّا فقط، بل كان أيضًا زعيمًا سياسيًّا حاول التغلب على الفئوية بتشكيل محيط سياسي جديد طبقًا لأفكاره الدينية.
في المقابل كان المسيح شخصية معارضة تحت سلطة الرومان. فمنذ البداية خبر اليهود والمسيحيون هذه الازدواجية بين الدولة والدين[18]. وكذلك الكنيسة المسيحية في أوروبا أظهرت نفسها على أنها ترتيب هرمي مغلق وفي أغلب الأحيان كمؤسسة وحشية، والتي لا نظير لها في الإسلام. لكن بعد حركة التنوير، الثورة الفرنسية، وانبثاق القومية الحديثة، فإن الفصل بين التعاليم الدينية والإجراءات العالمية أصبح مبرمًا.
الديموقراطية التحررية ببساطة لا يمكنها ولا تنوي فرض قيم دينية. إنها وسيط محايد بين الناس من مختلف المذاهب. فالدولة يجب أن تكون علمانية على نحو صارم بهدف حماية الحرية وأمن المؤمنين وغير المؤمنين، من المؤمنين المتطرفين والمواطنين الحياديين، من الأغلبية والأقليات. وهذا ليس له علاقة بالتخلي عن العدالة والحقيقة. عالم اجتماع ألماني وصف إلغاء أي أيديولوجيا بأنه “المرحلة الأخيرة للعلمانية” في الدولة الحديثة[19].
على هذه الخلفية يبرز السؤال حول إمكانية الديموقراطية في السياق الإسلامي. هذا نقاش يطول ولا يمكن التوسع فيه هنا. المشكلة تكمن في المقام الأول في مسألة الشرعية والتشريع. في الرأي الغربي فإنها تأتي من إرادة الشعب صاحب السيادة. وفي الرأي الإسلامي، أعلى مصدر للشرعية والسيادة هو الله والقوانين لا يمكن أن تكون بالكامل من صنع البشر، بل يجب أن تشتق من مصدر أعلى.
من وجهة النظر الغربية، هناك مواجهة مفتوحة: القلة التي فسّرت هذه القوانين للناس كسبت تأثيرًا سياسيًّا حاسمًا وحتى خوّلوا تولي السلطة بأنفسهم دون أي تشريع سياسي. إذا قيّض للإجراءات أن تكون ديموقراطية، فيمكن أن تكون ديموقراطية فقط من هذه النقطة نزولًا. المواجهة نشهدها في إيران اليوم. هذا النوع من الترتيب يضيق الخيارات السياسية، ويركب العديد من التعاليم ما قبل السياسية في الجو العام والخاص بإسم الدين والتقاليد، والتي لن يقبلها مناصرو الديموقراطية والعلمانية الغربية. قد يشير البعض الآخر إلى حقيقة، أنه حتى تلك التعاليم ما قبل السياسية، كالحجاب وتفسيرات أخرى عديدة، هي جدلية بين المسلمين أنفسهم.
التفاسير المعارضة للشريعة في القرآن أُسكتت من قبل السلطة السياسية، التي تستمد شرعيتها من “صدق” تفسير هذه القوانين. الدوغماتية السياسية تغذي السياسات العقائدية والعكس بالعكس[20].
وحيث إن للإسلاميين مطالب أكثر إلحاحًا وأعلى من أي مدى يمكن أن تمنحه السياسات والمجتمع، قد يجدون صعوبة في القبول بتصويت يزيحهم عن السلطة. ولهذا السبب فإن النقاد المسلمين العرب، أمثال صادق جلال العظم، أشار إلى: “الإسلاميون هم دائمًا مع الديموقراطية عندما يعلمون أن الأغلبية تساندهم، وضد الديموقراطية عندما يخشون خسارة الانتخابات”[21].
ويبحث آخرون عن “طريقة ثالثة”، ويشددون على الأوجه الديموقراطية في النموذج الإسلامي. فمصطلح الشورى بمعنى مجلس استشاري، ذُكر غالبًا كجسر محتمل بين المفاهيم الغربية والإسلامية للمشاركة. بعض الدارسين المسلمين يرى بأنه منذ انقضاء عهد الأنبياء، لم يعد دمج الدين بالدولة أمرًا شرعيًّا. فديموقراطية المجلس والعقد الاجتماعي يجب أن تأخذ مكانها[22].
هنالك خلافات هامة بين تصورات السُنّة والشيعة للنظام السياسي، وآراء جدلية فيما بينهم، ولذلك العديد من الاختلافات ممكنة وقابلة للتحقق. وبشكل عام تبقى قضية الشرعية (النهائية) قضية مثيرة للجدل.
إن التقارب بين العلمانية الغربية والأفكار الإسلامية قد يكون ممكنًا، من ناحية أخرى، عن طريق التعقيب على أساس أطروحة الوحدة في الإسلام. الدارس الألماني ديتريش يونغ، على سبيل المثال يرى أن وحدة السياسة والدين في الإسلام هي أسطورة[23].
وهذا ليس رأيًا غربيًّا فقط، بل إن دارسين إسلاميين يعبّرون عن هذا المنحى.
على سبيل المثال كتب إقبال أحمد: “أن دمج الدين والسلطة السياسية كان وسيبقى مثاليًّا في تقاليد المسلم” [24].
وطبقًا ليونغ، لم يكن محمد رجل دولة بالمعنى الحديث لأنه لم تكن هناك بنى دولة حديثة. كان أقرب إلى “حَكم” تقليدي في مجتمع عربي تقليدي جدًّا. ولم يعط القرآن تلميحات مفصلة عن كيفية إنشاء نظام سياسي. لكن الأكثر أهمية، الممارسة السياسية للحكومات المسلمة أعطت صورة مغايرة للسياسة والدين، من عهود الإمبراطوريات السُنّية القديمة إلى الحقبة الحديثة حيث رسّخ المصطلح الغربي دول الأمة نفسه في كل العالم الإسلامي. وحتى التراكيب الاصطلاحية لحالة الدولة الإيرانية مبنية على حكم القانون، وهي شبيهة بدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة. ناهيك عن ذكر العديد – في بعض الأحيان أكثر علمانية، وفي أحيان أخرى محافظة أكثر – من الدول السنية في الشرق الأوسط والمغرب.
كتب يونغ، إن النخبة السياسية في هذه الدول تستخدم الإسلام لإضفاء الشرعية على سلطتهم، في الأردن والمغرب لإضفاء الشرعية على السلالة الملكية الحاكمة، نظرًا لافتقارهم لأشكال الشرعية السياسية. بهذا المعنى للفكرة الإسلامية عن وحدة السياسة والدين هي نفسها مفهوم حديث من القرن العشرين، لقد كان رد الفعل جوهريًّا لهذه التأثيرات بعد دخول الأفكار الغربية وعناصر التحديث إلى العالم الإسلامي. ضمن آخرين، نشر جمال الدين الأفغاني رأيه بأن مركز الإسلام تحول من الدين إلى الحضارة. ولكن فكرة الحضارة هي مصطلح غربي من القرن التاسع عشر، والأفغاني جلبها إلى العالم الإسلامي. ومعها آزر الوطنية من أجل “الوطن القومي”؛ وهو مصطلح حديث مناقض تمامًا للمبادئ الإسلامية[25].
وإذا أخذنا في الحسبان تفسير أحمد ويونغ، فإن الهوة بين العلمانية السياسية والدين لا تبدو غير قابلة للردم حتى في العالم الإسلامي، حيث هنالك آراء متنوعة في الأكاديميات الغربية حول هذا الموضوع، هناك بالطبع آراء مختلفة أكثر بكثير في العالم الإسلامي، حيث لا توجد إجابات نهائية وواضحة للحدود بين العلمانية والدين.
المكونات الثلاث للعلمانية الغربية – فصل الكنيسة عن الدولة، خصوصية الدين، واللاتدين – بهذا الترتيب يمكن اعتبارها كمقياس منزلق مع الأخذ بعين الاعتبار الانسجام مع الإسلام.
يبقى مبدأ التعارض موجودًا على المستوى الاجتماعي العملي والخاص، عندما نصل إلى فرض النظام المفصّل للإدارة بالقوة طبقًا لمجموعة موسعة من الافتراضات الدينية المتصورة سلفًا، أو/و، والمسلمات التقليدية التي أضيفت لتحدد “الواجب الأخلاقي” عمليًّا، وهذا يحد من الحرية الشخصية للرجال والنساء. الحرية الدينية، وحرية تغيير الدين له ولها. حرية نمط الحياة، في الملبس. حرية خرق المحظورات، في النقد والنقد الذاتي. حرية اختيار الإلحاد. فإن قلة قليلة فقط من المفكرين المسلمين تدعم حرية الاختيار هذه[26].
واستنادًا إلى المذاهب الغربية، هذه كلها مظاهر عفة ثانوية لا تقرر بحد ذاتها إذا كان الشخص جيدًا أخلاقيًّا أم لا، وإذا ما يجب أن يمنح الشخص حقوقًا معينة أم لا.
نحن نعلم من التاريخ أن الثقافة الإغريقية الغربية (الأغروغربية) تأثرت بشكل كبير بالثقافة العربية الشرقية والعكس بالعكس. كلا العالمين أغنيا وشوّها بعضهما وهما المسؤولان جزئيًّا عن حالهما اليوم. يجب أن ندرك بأنه في كلا الجانبين عدد من التفسيرات المختلفة، المدارس الفكرية والمفاهيم السياسية. وما سبق رأينا بأن العلمانية ليست مفهومًا متراصًّا وقطعيًّا، وبدرجة أقل الإسلام.
لسوء الحظ، يبدو أنه في السنوات الأخيرة تمكنت التيارات الأكثر تصلّبًا وتشدّدًا من أن تصبح منظورة ومسموعة أكثر في المحيط الاجتماعي والسياسي في كلا الجانبين. والتأثير العظيم للتطرف يشوّه الوقائع في هذا الإقليم، ويمتد إلى أبعد من ذلك، بدون أدنى شك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بالرغم من هذا أو فقط بسبب هذا، يجب ألا نمنح المتطرفين أو أبطال اللاتسامح الفرصة التي يبحثون عنها. فالجهل، اللا تسامح، والاندفاع الديني والسياسي عند كلا الطرفين هي دلالة سيئة للحلول في القرن الحادي والعشرين.
أنا أؤمن بوجود الكثير من العناصر المشتركة، على سبيل المثال، الفلسفة الأخلاقية للإنسانية العلمانية ومبادئ التسامح الديني لم تستنفذ بعد.
الاختلافات قد تبقى، خصوصًا كمفهوم حرية الإنسان. لكن مرة أخرى لن يختلف المفهوم كثيرًا إذا فكرنا بالحرية مرتبطة بالواجب الأخلاقي الفطري كما عرضه كانط. الاختلاف يحدث أكثر على المستوى العملي.
لردم الفجوة الفكرية على الأقل بين النظرات الدينية والعلمانية، أقترح المبدأ التالي كدليل معتدل للحوار بين الناس من مختلف الخلفيات الثقافية والمذاهب الأيديولوجية، وكتصور للحياة معًا في أي نموذج معطى. وعلى خلفية الخلافات الآنفة الذكر القيمة الأسمى يجب أن تكون التسامح، ولكن وبهدف المحافظة على مبدأ التسامح من ضعفه المتأصّل أمام المذاهب المتشددة، النسبية، التضليل، الاستبداد يجب أن نضيف إليه واحدًا والوحيد مظهر المعيار المسبق التصور. وبناءً عليه يصبح المبدأ كما أسميه “التسامح المُقاوم”. هذا يعني في أي سياق للكلام: التسامح نحو المتسامحين وموجّه نحوهم فقط.
[1] كارستن ويلاند باحث ومحلل سياسي. يحمل شهادة دكتوراه في التاريخ، ودرس العلوم السياسية والفلسفة في برلين، دورام (كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة)، وفي نيو دلهي. عمل كمحرر لوكالة الصحافة الألمانية (dpa) ومقيم حاليًّا في دمشق. نشر كتابًا ومقالات مختلفة، تحديدًا عن الوطنية والنزاعات العرقية، ودور الدين والسياسة.
[2] محمد أركون عرف مصطلح أورثوذوكسي “هيمنة سياسية تحول نفسها إلى هيمنة لاهوتية”(من كلمته في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق 13آذار 2004 ). بهذا المعنى اللاهوتي وبالتالي الأخلاقي يختلف المحتوى طبقًا للأوضاع السياسية. وهذا ما حاول القانون الطبيعي أن يتغلب عليه.
[3] إيمانويل كانط في مقالة في Berlinische Monatszeitschrift 1784.
[4] تيودور هانف وضع هذا التمييز خلال المناظرة “حكم الله وحكم قيصر: استكشاف الأجواء بين التيوقراطية والعلمانية” في بيبلوس لبنان 9-10 أيلول 2003.
[5] راجع كارستن ويلاند: Nationalstaat wider Willen Die Politisierung Von Ethnien Und Die Ethnisierung Der Politik، Bosnien، Indien، Pakistan، Frankfurt-M./New York 2000، p.260ff يصدر قريبًا بالعربية عن دار المدى للنشر بدمشق.
[6] كارل شميت خلال مناظرة “حكم الله وحكم قيصر: استكشاف الأجواء بين التيوقراطية والعلمانية”، في بيبلوس لبنان 9-10 أيلول 2003. كانت مصادره كنيسة ألمانيا البروتستنتية (EKD) وكذلك مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان.
[7] أبو الحسن بني صدر: حقوق الإنسان في الإسلام، (دار المعرفة العربية)، غير مؤرخ، الصفحة 24:
Peter Heine/ Reinhold Stipek: Ethnizität und Islam: Differenzierung Und Integration Muslimischer Bevölkerungsgruppen، Gelsenkirchen 1984، P. 19.
Syrien: Religion und Politik im Nahen Osten، Stuttgart 1998، p.73.
[9] من الملفت للنظر في اللغة العربية، كلمة الحق تعني الحقيقة (قياسيًّا)، والتصحيح/الصحيح (إيجابيًّا، إجرائيًّا) في الوقت نفسه، لأنه في الفكر الإسلامي لا اختلاف بينهم.
[10] غوتلد إفرايم ليسينغ: ناتان الحكيم، شتوتغارت 1987 (أصل 1779).
[11] بالرغم أن الجدل حول نسبية الأخلاق هو خلاف كبير بين فلاسفة العصر الحديث. الاسدر ماكنتاير مثلًا في كتابه بعد الفضيلة ( نوتردام 1981) يبين عدم توافقية الأسس الأخلاقية والبيئة المحيطة بالدرجة الأولى، في حين أتباع المذهب الكانطي الجدد مثل جون راولز مقتنعين بالجذور المشتركة وبالإجرائية.
[12] عزاتي يعتقد بأن كانط من بين كل الفلاسفة الغربيين اقترب إلى الفطرة، ولكن عزاتي فاته أن يشرح أين يكمن الاختلاف الصغير. أ. عزاتي: الإسلام والقانون الطبيعي، لندن 2002، الصفحات 96، 105- 106، 110.
[13] القاسم المشترك الأصغر وفي الوقت نفسه الرابط الأقوى بين مختلف المذاهب الأخلاقية الثقافية، هو إلزامية كانط القاطعة “تصرف طبقًا للحكمة طالما تستطيع وستصبح قانونًا عامًا”، في كتابه ما وراء الأخلاق (1797).
[14] هاشم آغادشيري: “نحن أخطئنا الإنسانية الإسلامية” في 2002. وهاجم أيضًا المؤسسة الدينية الإيرانية وامتيازاتها.
[15] بشكل مشابه إضفاء الصفة البشرية على ظروف العمل للبروليتاريا نشأ في ألمانيا على يد الماركسيين وحركة العمل المارقة الرئيسية، ومن قبل أرباب عمل كاثوليك محافظين جدًّا اتبعوا المبدأ الاجتماعي الكاثوليكي (مجتمعي كاثوليكي). الكثير من الملتزمين الإسلاميين اليوم يعتبرون أنفسهم ديموقراطيين اجتماعيًّا، وفيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية (مثل إحسان سنقر، رجل أعمال سوري وعضو سابق في البرلمان في مقابلة مع الكاتب في دمشق في 16 آذار 2004) هنالك اختلاف صغير في المحصلة العملية لهذه المناحي. ويمكن حتى أن تندمج.
[16] بشكل مشابه إضفاء الصفة البشرية على ظروف العمل للبروليتاريا نشأ في ألمانيا على يد الماركسيين وحركة العمل المارقة الرئيسية، ومن قبل أرباب عمل كاثوليك محافظين جدًّا اتبعوا المبدأ الاجتماعي الكاثوليكي (مجتمعي كاثوليكي). الكثير من الملتزمين الإسلاميين اليوم يعتبرون أنفسهم ديموقراطيين اجتماعيًّا وفيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية (مثل إحسان سنقر، رجل أعمال سوري وعضو سابق في البرلمان في مقابلة مع الكاتب في دمشق في 16 آذار 2004) هنالك اختلاف صغير في المحصلة العملية لهذه المناحي. ويمكن حتى أن تندمج.
[17] من بين الآخرين، بيرنهارد لويس تبنى هذا الرأي في: لغة الإسلام السياسية، شيكاغو/لندن 1988. كذلك الكثير من المفكرين الإسلاميين مقتنعين بوحدة المُسلمات.
[18] أنظر أيضًا بيرنهارد لويس: تعدد هويات الشرق الأوسط، لندن 1998، الصفحة 27.
[19] ولفغانغ سوفسكي: ” Weder Kopftuch noch Kreuz “، 18 آذار 2004. انتقد ألمانيا لعدم بلوغها هذه المرحلة بعد وبأنها ما تزال راسخة جدًّا في التقاليد واشتراكية الدولة.
[20] المثال الجدلي الأشهر هو على الأرجح هو المناظرة حول التعليم للاهوتي الإسلامي المتحرر ناصر حامد أبو زيد، الذي اضطر إلى الهروب من مصر ويعيش في المنفى في هولندا.
[21] مقابلة مع الكاتب في دمشق، 4 نيسان 2003.
[22]يسار نوري أوزترك: ” Die Zeit nach dem Propheten “، 09/2003.
[23]ديتريش يونغ: Religion und Politik in der islamischen Welt، in: Aus Politik und Zeitgeschichte 21 اكتوبر 2002، الصفحات 31- 38.
[24] إقبال أحمد، الإسلام والسياسة، إشكار م خان، إسلام، السياسة والدولة: التجربة الباكستانية، لندن 1985، الصفحة 19. هو يحدد تاريخ فصل الدين عن سلطة الدولة عام 945 م. حينما زحف الأمير البويهي معز الدولة أحمد إلى العاصمة بغداد. وبذلك أنهى حكم الخلافة العباسية التي وحدت عالميًّا وروحيًّا سلطة “الأمة” الإسلامية (أحمد). حتى أن بعض العلماء يعترفون بأسف بهذا الفصل.
[25] بيتر مانسفيلد، العرب، لندن، طبعة ثالثة، 1992، الصفحة 142. أنظر ويلاند (2000)، الصفحة 82 ff. كذلك جافيد إقبال ابن صاحب فكرة باكستان عرف الإسلام على أنه “شكل للحياة….. الذي يجمع عدا عن المظاهر الدينية النقية، الاجتماعية، السياسية، القانونية، الاقتصادية، العسكرية، الأخلاقية، الأدبية، الفنية، الصوفية، الفلسفية والعلمية”. كما دعا الإسلام حضارة. ولكن هذه كانت مناظرة محرضة سياسيًّا لتبرير انفصال باكستان عن الهند، وإنشاء دولة باكستان الإسلامية. هذه كانت فكرة غربية جدًّا عن الوطنية العرقية وكرد على الاستعمار البريطاني للهند.
جافيد إقبال: Der Islam schuf Pakistan، in: Rolf Italiaander (ed.): Die Herausforderung des Islam: Ein ökumenisches Lesebuch، Göttingen 1987، الصفحة 121.
[26] محمد أركون في محاضرة في المعهد الثقافي الفرنسي بدمشق 13 آذار 2004.
المقالات المرتبطة
ثورات المهمّشين المنسية في التاريخ الإسلامي
يهمل التاريخ الإسلامي قصة ثورات كثيرة قام بها المهمّشون في عصور مختلفة للخلافات الإسلامية. ولم يهتم المؤرخون بها حتى لا يبرزوا سيئات الأنظمة القمعية السلطوية وغير العادلة المخفيّة خلف مصطلح “الخلافة”.
الفكر العربي الحديث والمعاصر | حسن حنفي ومشروعه الفكري
يعتبر الدكتور حسن حنفي إنّ مشكلة الفلسفة الإسلامية غير منفصلة عن المشكلة العامة للعلوم الإسلامية، وهي ناتجة عن أزمة عامة تعاني منها المجتمعات العربية، وبالتالي فعلى الباحث معالجة أزمة علوم التراث في الحضارة العربية، من أجل جعلها قادرة على تلبية متطلبات العصر،
التدبر التربوي في ســـورة الفاتحــــة
توجد آثار تربوية، تصلح للمسلم، من صباه إلى شيخوخته، فالتربية القرآنية حركة مستمرة طوال الحياة على الأرض، ونورد بعض الآثار التربوية لسورة الفاتحة





