تجربة الحياة عند الإنسان
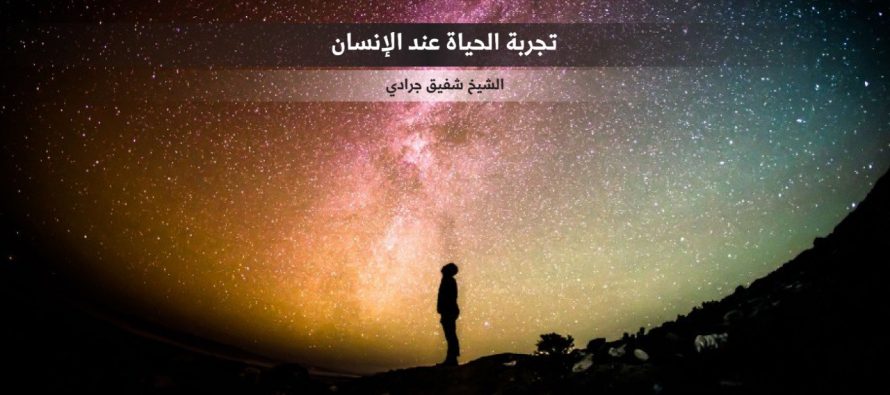
تفتتح تجربة الحياة عند الإنسان، على عالم الأحداث التي تحيطه منذ ماضيه الخاص وحاضره، مرورًا بما يمكِّنه من المدى والعمر… إلا أنها لا تتوقف عند ذلك؛ إذ قاطرة الحياة تتجاوز “أناه” في حدودها الزمنية لتنطلق من تاريخ خاص به ينتمي إليه بتراث جماعته، وتاريخ عام يحوطه بأفق إنسانيته الشاملة لكل فئة وجماعة على امتداد كل زمن، وهو ما نُطلق عليه اسم “حاضرة الدهر”. وبين حدود الزمن بتنوّعاته الخاصة والعامة، و “حاضرة الدهر” الشاملة، لكل الزمن بأبعاده يأخذ الانتماء أشكاله وطبقاته التي تُميِّزه ذاتًا عن ذات. وتنسج الهويات والسرديات الثقافية والحضارية والدينية في تحيّزات الأمم والشعوب والقبائل، التي تقف في قبال بعضها البعض واحدة من خيارات ثلاث:
- إما الحرب من أجل الحفاظ على الخصوصية والمصالح، أو إنفاذًا لنسيج نسقيٍّ بنيت عليه الذات في مواجهة الآخر، ولا تحتمل معه للآخر وجودًا مضاهيًا؛ إذ لا ترى فيه إلا النقيض والضد المعادي.
- الانطواء على الذات خشية الانغماس مع المختلف، والوقوع بفتنة الخليط الذي تأسّست الذات في مفاهيمها ومصالحها وتقاليدها وثقافتها على تصويره كرجس لا يُمس، أو صوَّرته تارةً أخرى كوحش مسرحه غابات المجهول البعيدة عن حمى القبيلة والمذهب، أو توأم أسطورة فصلته إرادة الحق فأرْدَتْه شرًّا مظلمًا، مقابل نور الخير. وجسّدته مثالًا لهابيل وقابيل في صراعهما المستمر. وهذان التصوران نجد أوليةً لهما تتضمنها أساطير العديد من القبائل والشعوب المؤمنة بأنها وحدها تنتمي لبني البشر، بينما تفرد لكل آخر ممتدٍ في الزمن صورة الآخر – الضد… حتى إذا ما أرادت أن تشكّل رؤيتها للمقدّس والغيب والإله، فإنها تصنعه بحدود القبيلة وتربط قيمها بقيمه المتصلة بمصالحها وفرادتها، فإذا ما تعارض الوسيط المقدّس سواءً أكان الساحر، أو المُطبِّب أو الكاهن، أو غير ذلك مع حفظ تلك المصالح نالت منه بأبشع الأساليب والطرق.
- أما الخيار الثالث فهو الدخول مع الآخر في حوار، تُقعَّد فيه الذات على أركان.
الركن الأول: الأنا الخاص بما هي ضمير منفصل يأخذ معناه من حراكه داخل جملة الذات الفاعلة.
الركن الثاني: الآخر الذي قد نُعبِّر عنه بـ “أنت”، أو “هو”، والذي يتداخل مع قيم الأنا في سياق الذات الفاعلة لتحصَّل قيمة المعنى والمفاد والمقصد.
والملفت هنا أن هذا الآخر قد يكون مغايرًا بالتمام أو مغايرًا بالحيثية. فإذا ما غاير بالتمام تحوّل إلى نقيض وصار له بعد الشيئية والاستهلاك الذي يدخل في رصيد الذات الأنوية ليُعلي من حضورها عند كل منعطف استثماري أو احترابي. إذ كثيرًا ما نجد أن أممًا وشعوبًا، بل وحضارات تبحث عن ضد معادي، من أجل أن تُبرز خصوصيتها وفرادتها، ومن أجل أن تحفظ استمرارية مركزيتها وسطوتها. فهذا فرعون في التاريخ مثالًا حيًّا على إعلانه دخول حلبة الحوارية الاصطراعية في وجه النبي موسى عندما أمر الناس بمعاداة موسى لأنه يريهم ما لا يرى فرعون، وهو حسب دعواه ربهم الأعلى. فحتى عندما قبل فرعون التحدي – أمام جموع الناس – مع خصمه موسى الذي جاءه بالقول الليّن. أبرز سحرة فرعون أحابيلهم وفتنهم بصورة الأفعى، ومن المعلوم ما لرمزية الأفعى في تلك الحضارات من شرّ العداء والإخصاب لولادات جديدة في آن واحد. حتى إذا ما انكسرت الأحابيل أمام برهان موسى الذي أدانهم بنفس رمزيتهم التي استقووا بها “الأفعى”، إذ التقمت أفعاه ما أفكوا؛ اتهم فرعون المتصدّين لبعضهم البعض بالمؤامرة والكيد. وليس بعيدًا عنا اليوم تكرار تجارب الاختصام بخلق صورة العداوة من قبل المتسلّطين بزرع الفتن بين القيم الدينية وحضارات شعوبها، تحت عناوين من مثل: “صراع الحضارات”. وما صورة العداء لما أطلقت عليه دول أساطير السيادة المطلقة الفوبيات إلا أفعى فتنة جديدة توقع بين أهل العالم الإسلامي بحروب المذهبية، وبين أهل الأديان بنزاعات دينية، وبين أهل الإنسانية بصراع التطرّف والاعتدال. وكل ذلك ليبقى السيد المتحكّم هو المخيال المحرِّك للذات الفاعلة في العام بنظامه الأحادي.
أما إن قامت جدلية الأنا والآخر على أساس الحيثية فهناك القاسم المشترك الذي يُغني الذات الفاعلة بالأنا والأنت كحضور متشارك، رغم تعداده وتنوعه. فلا يقع التشاحن ولا تُلقى الذات في انفصام الغربة بين المتحاورين.
وهذا يعني أن هناك سُنةً وقانونًا يأخذ موقعه الحاسم في طبيعة الهوية بحسب فعل الرؤية والإرادة. فتتشكّل الذات الفاعلة على مقتضى السنن والرؤية والإرادة، وهو ما يمكن لنا بحثه بصعيد أنطولوجي نطلق عليه اسم “الكون”؛ لأن الكون في اصطلاح التصوف والدين؛ وهما أعلى مستويات التجربة الحياتية والروحية؛ يعني التبدّل والتغير والتجدّد والاندثار، رغم حضور الثابت المركزي فيه كمعنى حافظ. كما ونعبِّر عنهما على صعيد اللغة بمفردات فعل الكلام من مثل: أنا – أنت – هو – نحن – هم. وتلتحم اللغة مع مسار الأنطولوجيا، لتطل على وحدة يجمعها معنى الوجود وقيمه الروحية البانية لثنائية الأشياء والإلهيات، أو الظاهر والباطن لتترقى الذات من (كونها) المحكوم بمسار الزمن، إلى الذات الحاضرة بالحق والوجود الكامل. ومن الكثرة المهمومة، إلى الوحدة المتوافقة على أصول الرحمة. فمفردات الضمائر المنفصلة تتوحّد معنىً وقيمةً في سياق التصاريف. وكون التجدّد والاندثار ينسجم مع تلاقي الوحدة المركزية للوجود الجامع المستجمع لكل كثير.
أما الركن الثالث: فهو المعرفة بما يتجاوز حدود الإدراك الذهني دون أن يستثنيه؛ لأن المعرفة في علاقة الكون بالوجود، والواحد بالكثير تحضر بكل ما للذات من فاعلية وجدانية وروحية وفكرية وعملية، وبكل ما عندها من امتدادات فردية وجماعية، وبكل ما لها من مراتب متدانية ومتسامية. وهو ما يسمح لحوارية بين الأنا والآخر على مسرح الذات. تنقل الحراك التكوّني أو الصيروري إلى واحدية الوجود في نفس أمر حقيقة الموجودات على تعدادها.
ومن المفيد هنا أن نذكر الملاحظات التالية انطلاقًا مما أوردناه:
الملاحظة الأولى: قدرة الأنا على فرض حال من التفرد الشخصي أو القبلي، ورسم صورة لمثلها الأعلى، بحيث إنها تنكسر عند انكشاف المثل الأعلى على حقيقة الوهم العاجز موضوعيًّا عن تحقيق المصالح الخاصة. الأمر الذي يُبقي المثل الأعلى “المقدّس أو الإله” أسير فروضات معيشية أو ذهنية ولّدتها الاحتياجات والموروثات، لكنها رغم ذلك تبقى قادرة على صنع مؤسستها الأسطورية منها.
لكن يلاحظ في نفس الوقت أن ما تسقطه الأنا من قيمةٍ على آلهتها ومقدّساتها يشي بمقاربة مع تلك المقدّسات والآلهة الشاملة، وإن من حيث القيمة المعطاة لها. مما يؤكّد أن هناك في اللاوعي عند تلك الجماعات ما يتجاوز وعيها المباشر واللاوعي المعبِّر عن الأنا الحاكمة بسبب الموروثات. وهو ما سنطلق عليه فيما بعد اسم “الجعل الفطري” المتعالي في فعاليته الأولية على كل فعالية، وإن حمل خاصية تسمح لأي خاصة أخرى أن تتلبسه. وليس مثل الشك وقلق الوجود علاجًا لهذا الانفصام بين الأولية الجعلية الفطرية، والحدود المصطنعة التي تفرضها الأنا على عينها وعلى المثال الأعلى الذي تولِّده؛ إذ “الخداع هنا هو بالضبط تمرير ما يبدو ويظهر على أنه الوجود الحقيقي. وبفضل الشك فإني أقنع نفسي بأنه لا يوجد شيء (المثال الوهمي الأعلى) كان موجودًا. ولكن ما أريد أن أجده هو شيء يكون أكيدًا وحقيقيًّا”[1].
فما نريد تبيانه هنا أن فارقًا هائلًا بين وجودٍ نولِّده بفعل خداع الوهم، وبين وجودٍ نكتشفه حقيقة، نتوالد في حاضره ونولِّده حضورًا فينا، نسعى لمعرفته.
الملاحظة الثانية: أن الذات إذا لوحظت في صعيد الصيرورة والكون لم تقدِّم لنا إلا ما فيه التباين والاختلاف المفتوح على الضدية، إلا أن هذا الصعيد ينبئنا دومًا عن وجود قواسم مشتركة عند كل تجربة إنسانية تتفاعل مع الذات، أو الوعي العلمي للمحسوسات، بل ومع خصوص التجارب الروحية، التي لا أقصد بها الدينية الوحيانية فقط، وإن بلغت شأوها العالي مع الأديان الوحيانية التوحيدية.
فبرصد حاوله (ولتر ستيس) في كتابه التصوّف والفلسفة لمعرفة مدى الموضوعية في التجارب الصوفية لاحظ أن “مثل هذه التجارب في جميع العصور، والبلدان، والثقافات، كانت أساسًا واحدة، أو أنه على الرغم من وجود بعض الاختلافات، فإن لها محورًا كليًّا هو عبارة عن خصائص مشتركة”[2]، بحيث إنه ألزم نفسه بتحديد الإشكالية التي يريد أن يعالجها لهذه الواقعة الموضوعية وهي تتمثل بسؤاله “هل التجربة الصوفية موضوعية؟ ولو قرّرنا أنها كذلك فسوف يظهر سؤال: ما هو نوع الكائن الذي تكشّف عنه؟”[3].
فبعد أن قرّر موضوعيتها واستجمع جملة من الخصائص لها عند الذين سبقوه بمعالجة هذا السؤال؛ فقد لاحظ أنها خصائص تتعلق بالشق الأول من السؤال، وهو ما تثيره التجربة في النفس والوعي للذات والعالم والكائن الذي لم يُسمِّه إلا بسمةٍ واحدةٍ فقط هي “الإبهام”. وبناءً عليه، فلقد كان منطلقه في بحثه ملاحظة التجربة كظاهرة انفصامية بين الذات والموضوع المقصود. الأمر الذي كان يحتِّم عليه الاهتمام أكثر بالمنطلق الموضوعي – للذات الروحية في فاعلية حركتها نحو الكائن المقصود. وهو ما نؤكد عليه مجددًا أنه منطلق “الجعل الفطري” الذي إذا ما حُسم، وانجلى فهمنا له أمكن لنا معرفة طبيعة الكائن، أو إن شئت الدقة فقل: خصائص الكائن المقصود. ولتحصيل مثل هذه النتيجة فإن علينا مراجعة معنى الجعل الفطري وكيف يمكن لمعرفته أن توصلنا إلى معرفة ما تكدح النفس جهدها الروحي إليه. ثم نؤسّس على ذلك محاولة فهم: الـ “أنا”، و “العالم”، و “الله”، لنطرح بعدها سؤالًا إشكاليًّا حول علاقة الرؤية بحقيقة الوجود في سريانه الكوني الدنيوي والوجودي المجرّد، وكيف يظهر أمامنا الله بعد معرفة الذات؟ وكيف يظهر أمامنا العالم بعد ظهور الله أمام الذات، بل بعد حضور الله في الذات وحضور الذات في الله؟
الملاحظة الثالثة: هناك عند الحوارية الوجودية المولِّدة للذات العارفة صنفان من التحولات، وصنفان من الآثار.
أما صنفا التحولات فهما ما أطلق عليه العرفاء من أهل التصوف والروح اسم “التفكّر الآفاقي”، و “التأمّل الأنفسي”. وقد طاب للبعض تسميتهما خطأً باسم “البسط” و “القبض”. ونحن هنا لسنا بصدد المعالجة الاصطلاحية إلا بالمقدار الذي سيؤثر على أصل المعنى والمقصد.
فلقد عنى البعض بالبسط نظرة العارف الصوفي إلى الموجودات الخارجية عندما ينظر إليها ليجد فيها برغم تكثرها من سماء وأرض وشجر وبشر وأشياء، حياة تنضح بالروح والمعنى والاتحاد ليصل إلى معنى الوحدة الوجودية، بل هي عند بعضهم وحدةً شخصية. فالتحوّل هنا يحصل في معرفة معنى الموجود الخارجي، وهذا التحوّل يوفِّر تجدّدًا في النظرة تحدث انقلابًا في قيمة الأشياء والمخلوقات فيربطها بما يتجاوز معنى الصيرورة والزمن والحركة.
أما القبض فهو بحسب القائلين به من أصحاب “الصوفية من النوع الانطوائي الذين يؤكّدون أنهم بلغوا تلك الحالة من الفراغ الكامل للمحتويات الذهنية الجزئية، لكن ما حدث بعد ذلك يختلف أتم الاختلاف عن الانزلاق إلى اللاشعور، بل على العكس إن ما ينبثق هو حالة من الوعي الخالص؛ وهي خالصة بمعنى أنها ليست وعيًا بأي مضمون تجريبي، فليس لها أي مضمون سوى ذاتها”[4].
فالمقصود هنا هو التخلّي عن كل مضمون مفهومي، أو عقيدي، أو فكري. والتوجه نحو المعنى المطلق الذي يعود ليعني الإبهام، المؤهّل ليستوعب كل المعاني وكل أصحاب التوجهات العقيدية والدينية والفكرية…
فالإصرار في تحليل هذين المنعطفين من التحول بالشكل المطروح هو تأكيد للثنائية الفاصلة بين الذات والآخر الخارج، وإيجاد رابط بينهما هو الفراغ أو الإبهام؛ أي اللامعنى ليكون الوعي الخالص والوحدة الخالصة مجرّد قيمة اللامحدّد والمبهم. وهنا يفترق العرفان الإسلامي كما هو عند ابن عربي ليعتبر أن القبض والبسط هو حالة نفسية وليست معرفية.
وبناءً عليه فهما حالتان تنقضيان ولا تحدثان أي انعطافة أو تحولٍ[5]. وبحسب الموقفين من مفاد القبض والبسط نتلمّس أثرين في الاستجابة هما: الصمت والكلام… فعند أهل الإبهام يكون الأصل هو الصمت وكل كلام هو مجرّد وجهة فلسفية أو موروث عقيدي لا يمت للتجربة الروحية بصلة. أما الاستجابة الثانية فهي الكلام بعد الامتلاء بالمعنى وتوحيد الذات بحيث تضيع المسافة بين الأنا والخارج أو الآخر. لتحضر الأنا في الكون والوجود، ويحضر العالم أو الآخر عند الذات والوجود. والوجود هو مظهر الواحد الذي ما فاض عنه إلا الواحد، فيكون الكلام وسيط الوحدة بينهما سواءً أكان وحيًا أو إلهامًا، ويُعبَّر عنه في فلسفة الجعل الفطري بـ “مخزن أسرار الأسماء”، أو “علم الأسماء”.
ولو أردنا التدقيق في مفادات مثل هذه الصياغات لألفيناها صياغات تأويلية تعمل لإسقاط المفاهيم على التجربة، بدل رصد التجربة ومتابعتها في انطباعها الفينومينولوجي حتى تتحدث الظاهرة عن نفسها بمقاصدها ليعاد قراءة تأويلها ضمن تلك المقاصد المنطبعة في الذات أو الوعي المتلقي. وهو ما عمل عليه الذين استبدلوا مصطلح البسط والقبض بـ “الانبساط” و “الانقباض”، بحيث حفظوا للنفس حضورها في حركتين متقابلتين هما الداخل الانطوائي أو الانقباضي والخارج الانبساطي. وأحالوا رغم هذا التدارك الاصطلاحي الوحدة عند صنف كلٍ من الحركتين إلى “التعمية والإبهام”، والقول: إن كل كلام هو خروج عن التجربة وعناد أو قطع لطريق سيرها كما في بعض الفلسفات الهندوسية.
وقد غاب في ذاك التحليل والنتائج أن المحور الثابت هنا كانت النفس أو الذات في حركتيها، وأن لكل من حركتي الذات امتدادات خاصة تبدؤها مع الخارج بعلاقة مع الزمن في ثلاثيته: الماضي والحاضر والمستقبل… لتعطي من طبيعتها المجرّدة بعد ذلك إذن استعادة الزمن في فاصلة الحاضر وحده عبر انتشار النفس فيه، إذ لا يمكن أن نتصور زمنًا وحركة خارج حراك النفس التي تستقرئ الماضي ليحضر عندها حاضرًا يتجه نحو الأبدية وحضورها، وهو ما أشار إليه “بول ريكو” في كتاب (الزمان والسرد) عند قراءته (للقديس أوغطسين) عندما نقل صرخة أوغسطين حول معنى الزمان وربطه بالأبدية؛ إذ قال: “أعرف أن خطابي عن الزمان موجود في الزمان، ولذلك أعرف أن الزمان يوجد، وأنه يقاس. لكني لا أعرف ما هو الزمان، ولا كيف يقاس. إنني في حالة يرثى لها، لأني لا أعرف ما لا أعرفه”[6].
وبعد نقل هذه الصرخة يدرس ريكور الفكرة ليعتبر أن النفس بانتشارها في ثلاثي الزمن تشكّل الزمان “فيبقى إذن أن امتداد الزمن هو تمدد الروح وانتشارها. وبالطبع لقد قال أفلوطين ذلك قبل أوغسطين، لكنه كان يفكّر بروح العالم، أو بالنفس الكلية، لا بالنفس الإنسانية”[7].
وإذا ما كانت الحركة باتجاه الخارج مصدرها النفس بما هي قبسٌ من نور العالم الكلي القدرة والضابط للكل. فمن باب مؤكّد أن النفس بانطوائها على ذاتها لا تنطوي على ما يخرجها عن الآخرة، بل على الذات التي تملأ العالم. وهذا ما سعى الباحث النفسي الكبير (كارل يونغ) إلى استكماله في كتابه “الإله اليهودي” عندما ذهب للقول: إن النفس رغم كامل حقوقها في معرفة واعية للوجود والحياة والإله، إلا أنها تعود في مطافها الأخير لتأكيد ما يسميه بـ “الإبانات الدينية”؛ إذ هو يؤكّد أننا نستطيع تصور الله طاقة حياة دافقة أبدًا يتغير شكلها إلى ما لا نهاية، كما نستطيع تصوره جوهرًا ساكنًا لا يتغير أبدًا. لكننا واثقون من شيء واحد فقط هو أن عقلنا يتناول الصور والفكر التي تعتمد على الخيال البشري وظروفه الزمانية والمكانية التي تعرضت – لهذا السبب – إلى تغييرات لا حصر لها على مدى تاريخها الطويل. وما من شك في أن شيئًا واحدًا وراء هذه الصور، يعلو على الواعية، ويفعل بطريقة لا تتفاوت العبارات فيها تفاوتًا غير محدود، أو تفاوتًا عشوائيًّا، لكنها ترجع جميعها رجوعًا بيِّنًا إلى بضعة مبادئ أساسية أو نماذج بدئية Archetypes. هذه النماذج البدئية، كالنفس أو كالمادة، لا يمكن معرفتها كما هي. وكل ما نستطيعه حيالها أن نصوغ منها نماذج نعلم أنها غير مكافئة، وهي حقيقة تؤكدها الإبانات الدينية في كل مرة. غير أن عالم أفكارنا الدينية، رغم أنه مؤلف من صور بشرية لا تستطيع أبدًا أن تثبت أمام النقد العقلي، يجب ألا ننسى أن هذه الفِكر تستند إلى نماذج بدئية إلهية أو مقدّسة[8].
من هنا، فإن البحث في إطار علم نفس الدين وفلسفته كما البحث من موقع الالتزام المسيحي، أوصله إلى أن فعل الروح قادرٌ على إنشاء المعنى والفكرة والحقيقة والتعبير إلى مجالات الوعي البشري، وميادين تعابيره عن مكنوناته. لهذا يؤكّد يونغ موضوعية هذه الإفادات والتجليات الإلهية عند النفس إذ يقول: “والأفكار التي من هذا النوع لا نخترعها أبدًا، بل تدخل ميدان الإدراك الباطني بما هي نواتج تامة الصنع،.. لذا يحق لنا أن ننسب إليها قدرًا من الاستقلالية فلا ننظر إليها بما هي موضوعات Objects وحسب، وإنما بما هي ذوات Subjects أيضًا بما لها من قوانين خاصة”[9].
لذا، فإن الكلام الإلهي يأخذ مجراه القدسي في عالم الطبيعة التي ليست بحقيقة أمرها إلا ذاك الشوق إلى لقاء الله كما عبّر الفيلسوف والحكيم الإسلامي الملا صدرا. ولا يمكن لمثل هذا الشوق الساري في عالم الطبيعة والوجود بحسب جعلها الذي جعلها الله عليه أن يكتسب فعليته إلا بالقرب من الواحد والمثول عند حضرته التامة الإلهية. فلا ينظر إلى أي موجود ومخلوق خارج ذاك الحضور الإلهي، الذي هو الرحمة التي وسعت كل شيء، بحيث يرتفع في سماء العبارة الدينية ما قاله الإمام علي (ع): “ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه”. فليس نكران الخلائق وانفصال الـ “أنا” عنهم ما يصنع الهوية الإيمانية، بل ذاك الاندماج بالآخر من الناس والحياة والوجود هو ركيزة فعل الذات الإيمانية؛ إذ أشرف العبادة لله هو مراعاة الله في خلقه، فعن الرسول الأكرم (ص) أنه قال: “الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله”[10].
والحضور “أنت” المقابل “للأنا” حينما يكون الذات الشاملة الرحمة، فإنها تكون عند كافة أهل الأديان والمعتقدات من بني الإنسان الذين لا تتكامل الذات ولا نعرف النفس التي بها نعرف الله إلا بهم. وهو ما أوجب في منطق الاعتقاد الإسلامي بناء الحياة الدنيا على وفق الحضور الإلهي. وهذا ما أشار إليه ابن سينا في كتابه “الإشارات والتنبيهات” بقوله: “لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه، وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير، وكان مما يتعسّر إن أمكن؛ وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميّز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بآيات تدل على أنها عند ربه، ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء عند القدير الخبير، فوجب معرفة المجازي والشارع. ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكِّرة إلى العدل المقيم لحياة النوع، ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الأجر الجزيل في الأخرى، ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوهم شطره. فانظر إلى الحكمة، ثم إلى الرحمة والنعمة تلحظ جنابًا تبهرك عجائبه، ثم أقم واستقم”[11].
وقد أقام ابن سينا في هذا النص حبكة تمدد الأنا مع الآخر من الجماعة، ليقوِّم قوام الأنا على التعاضد مع الآخر، بحيث يتم بناء مؤسسة الجماعة على جملة من الأصول هي:
- الطبع المدني للإنسان، وهي حقيقة لحظتها الفلسفات على تنوعها، كما لحظت فيها أن هذا الطبع التعاضدي المدني فيه سر تحقيق المصالح العامة المراعية للمصلحة الشخصية.
- ضرورة وجود القانون الناظم، وهو المسمّى بالشريعة.
- ضرورة مفارقة الشارع لضغط المصالح الأنانية الشخصية في صياغة القانون، وبالتالي فقيم العدل والقسط وإقامة الحق هي دواعي تنصيصه للقانون.
- وجود الجزاء والقصاص لحفظ سير القانون وتطبيقه.
- احترام الشريعة والشارع إلى حد القداسة، بحيث يكون منبع هذا التقديس، نزوع طبعي نحو الشارع واحترامه والإيمان به وبأحكامه…
- ثم يعود النص ليربط كل ذلك بجنبة روحية عنوانها إقامة العبادات كأصل لذكر الشارع “حافظ القانون” فيكون القانون وليد الذات المقدّسة، ونزوع الطبع الإنساني بالتزامه الأخلاقي، الذي فيه التزامات الإقرار بالوجوب والامتناع، ثم الإقرار النفسي والروحي بالإيمان بهذا القانون ومصدره، بحيث تسير شؤون الحياة برؤية ترى في العلاقة بين الناس صلة صلاة مع مصدر حكمة ورحمة ونعمة…
- وبمقدار ما تتملّك هذه الأصول، من الخبرة في معرفة القانون “الشريعة” وعدالة الضابط الأخلاقي، وحكمة التدبير، والرحمة بالعباد والبلاد، والسعي لتعميم أنعم الله في الحياة؛ في شخص معين يكون هو الأولى بتولي حمل مسؤولية الأمانة الإلهية بالاستخلاف. وهنا يقدر دور النبي والوصي والفقيه العارف…
ومن مجموع هذه الأسس والمنطلقات تتشكّل الذات التي يتقاطع فيها الفرد بنزوعه نحو الآخر من الجماعة وهو المسمّى في الأدبيات الإسلامية بالصداقة. كما ويتقاطع الفرد والجماعة مع الذات المطلقة الشاملة على حسب مقتضى الجعل الفطري وهو المسمى بالإيمان، والذي يطيب لنا تسميته بالإيمان الخلاّق والمولد لصبغة الله في الحياة.
ومجموع هذه الأسس والمنطلقات إنما تتقوّم بالذكر بما هو كلمات إلهية منها الآيات التكوينية الآفاقية والأنفسية، التي يعايشها المتفكّر والمتأمّل ليكتشف فيها روابط العلاقة وليسخّرها في إعمارها الأرض كما ويحيا فيها مع المعنى والمضمون ليتوحد مع العالم بسر التوحيد. كما أن من الكلمات الإلهية الخطاب الإلهي الموحى للناس برسالات التوراة والإنجيل والقرآن، باعتبارها آيات بينات فيها هدى الناس وسبيل رشاد حياتهم ووجودهم الدنيوي ليكون على غرار قداسة القرب من الله سبحانه.
هذا، وتقاطع الفرد مع الجماعة المعبَّر عنه بالصداقة عرّفها مسكويه بالقول: إن الصديق شخص آخر هو أنت. لذا حث على أن يتأكّد المرء من وجود الاستعداد الروحي والتناغم النفسي لديه اتجاه الآخر؛ إذ التبادل المتكافئ هو الذي ينبغي أن يوجِّه كل العلاقات الإنسانية الموصلة إلى الصداقة، إذ الإنسان خيِّرًا كان أو شريرًا بحاجة إلى الأصدقاء، إذ بواسطتهم يكتشف نفسه كإنسان خيِّر أو سعيد، وعن طريقهم يتوصل إلى تجاوز تعاسته وحظه العاثر؛ ذلك أن معرفة الذات، أو معرفة المرء بنفسه؛ يضاء ويترسّخ عن طريق الاحتكاك بالآخر[12]… وتسري هذه الصداقة بحسب ما توارثته بعض الأدبيات الفلسفية الإسلامية، إلى الصداقة مع الله، بل يمكن لنا القول: إن الصداقة مع الإنسان إنما تنبع من الصداقة مع الخير المطلق. فمنها “وجب أن يكون الناس يحب بعضهم بعضًا، لأن كل واحد يرى كماله عند الآخر،… فيكون إذن كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن، وقوام الإنسان بتمام أعضاء بدنه”[13].
عليه، فإن الصداقة تقع تحت عنوان أشرف هو المحبة… إذ “الجوهر الإلهي إذا صفا من كدورته… اشتاق إلى شبيهه، ورأى بعين عقله الخير الأول المحض حينئذٍ يفيض نور ذلك الخير الأول عليه فيلتذ به”[14]. فأول حراك بين الأنا والآخر هو نزوع العشق الفطري، ومحبة الله التي تحرق كدورة صفحة النفس ليصبح القلب عرش الحضور الإلهي، فيفيض نور ذلك الخير الإلهي عليه من أنعم حضوره ليؤنس وحشة غربته بعد البعد، بوصال وصداقة وخليلية تحاكي كل أثر من الوجود الإلهي سواءً أكانت في العالم أو بين الناس..
ومثل هؤلاء يطلق عليهم القرآن الكريم بالذين ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ﴾[15]، وهم المحفوظون في رقابة الله ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾[16]، إذ بمجموعهم؛ من الذين انقضوا مع التاريخ الماضي، والذين هم اليوم أو الذين سيقدمون الحياة ضمن صداق العهد مع الله؛.. تحُفظ الأرض لحفظهم سنة الله فيها والتي هي عين العدالة والحق والناموس، التي ما بدّلوها، بل حفظوها ذكر محبة لله وصداقة مودة لخلقه…
أما منبع مثل هذه الأصول فهي نابعة من عمق الفطرة الإنسانية والجعل الإلهي. وهذا ما يستدعينا للبحث عن معنى الجعل الإلهي الفطري عند الإنسان بحسب القرآن الكريم.
الجعل بحسب الدلالة في القرآن والأدبيات الإسلامية
أورد الراغب الأصفهاني في مفرداته، أن الجعل هو لفظ عام في الأفعال كلها، وأنه يتصرّف بعدة معاني وموارد منها:
- أنه يجري مجرى أوجد، مثل قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾[17]. ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ﴾[18].
- في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه نحو ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾[19].
- في تصيير الشيء على حالة دون حالة، نحو ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشاً﴾[20]. ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً﴾[21].
- الحكم بالشيء على الشيء، حقًّا كان أو باطلًا، فأما الحق فنحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾[22]. وأما الباطل فنحو قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنْعَامِ نَصِيباً﴾[23]. ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾[24]“[25].
هذا ويمكن أن يأتي الجعل للتشريف، بحيث يستخلف الله الإنسان على الأرض تشريفًا لهذا الإنسان ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرْضِ﴾[26]. ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ﴾[27]. وهذا التشريف إنما يكون تشريف تأهيل لحمل مسؤولية الناس ورعاية العباد والبلاد. والملاحظ من مجموع الآيات الآنفة الذكر أن “الجعل” هو عبارة عن جملة من سنن العلاقة الوجودية والأخلاقية والحياة الضابطة لطبيعة العلاقة بين الأشياء والمخلوقات كما ومعايير الحكم على قيم المقاصد والمعاني. من هنا، فإن هذا الجعل هو رابط علاقة الله بالإنسان، ورابط علاقته سبحانه بحركة الحياة والموجودات. وهذا ما استدعى الفلسفة الحكمية، والعرفان الإسلامي إلى إيلاء هذا الموضوع أهمية تأويلية خاصة قد تسمح لنا فهم المقصود من مجموع الآيات وخاصة آية الاستخلاف ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً﴾[28].
هذا ويعدّ بحث “الجعل” من ضمن المسائل الفلسفية التي اندرجت في مباحث العلة والمعلول وهي تتعلق بالرابط بينهما. وقد قسموها إلى قسمين هما: الجعل البسيط، والجعل التأليفي. أما “الجعل البسيط فهو يعني (جعل الشيء)؛ والجعل التأليفي أو الجعل المركّب يعني (جعل الشيء شيئًا)”[29].
والمقصود بالجعل البسيط أن العلة هي التي تتنزّل فتوجد ذات المعلول ووجوده، لا أن هناك ذاتًا ترتبط بالعلة، بل نفس المعلول هو تنزّل علته، بالتالي فإن نفس هذا الموجود أو ذاك إنما هو مظهر وتجلي علته. وهو بتمام ذاته ووجوده مرتبط بمصدره سبحانه الذي هو مآله بل ونفس حضوره. أما التفكيك الذي يحصل بين الجاعل والمجعول؛ والشيء الذي جعله الجاعل للمجعول، وعملية الجعل نفسها، فهي أمور يفرزها الذهن ويفصلها، وإن كانت بحقيقتها عبارة عن أمر واحد، هو فعل الجاعل. من هنا ظلت الربوبية في جعل الاستخلاف مختصةً بالله سواءً أكان الذي يمارس إدارة شؤون الأرض من أهل الخير أو غيرهم، فإن “جعل الخلافة الأرضية نوع من التدبير مشوب بالخلق غير منفك عنه، ولذلك استدل به على توحده تعالى في ربوبيته لأنه مختص به تعالى لا مجال لدعواه لغيره. فقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرْضِ﴾[30] حجة على توحده تعالى في ربوبيته… وجعل الخلافة لا ينفك عن نوع الخلق، فخالق الإنسان هو رب الإنسان”[31].
بناء عليه، فحينما تنص الآية القرآنية ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ﴾[32].
فالجعل هنا له جملة من المقاصد منها، أن الله سبحانه أراد إيجاد سنة وقانون للتدبير يحاكي تدبير الله للموجودات برعاية شؤون العباد ونسب هذا الجعل السنني إلى آدم، مما يعني أن هناك جعل تأليفي مركّب أوله وجود آدم، وثانيه جعل خاصية ذاتية لوظيفة هذا الموجود هي الاستخلاف التدبيري المحاكي لله سبحانه.
إلا أن الملائكة نظروا إلى طبيعة التعارض بين بني البشر. ونظروا إلى أن الاستخلاف ينبغي أن يحاكي الجلال الإلهي بالتسبيح والتقديس، وهذا ما يتعارض وأفعال الاجتماع البشري بالوقت الذي هو يتوافق مع طبيعتهم وشأنيتهم. وبالتالي فقد غاب عنهم أن هذا الاستخلاف الجعلي قيمته إنما تكمن بتدبير شؤون خلق الله وإعمار الأرض بما يعود بالنفع العام على قطانها.
بل إن مما غاب عنهم إن هذا الجعل ليس وظيفة تكليفية، بمقدار ما هو طبيعة تكوينية تميّز الجعل الوجودي للإنسان بجعل فطريٍّ فيه، هو النزوع الشوقيٌّ نحو الله، ومعرفة خصائص الذات الإلهية التي تحكيها الأسماء الإلهية وأسرار الوجود. وآدم هذا فضلًا عما ينطوي عليه في أصل وجوده من توق نحو الله، فإنه قد استودع فيه الله علم الأسماء، بما هي أربابٌ سيالة في صياغة صورة الحياة والوقائع، والقضاء والقدر، لتعبِّر عن المشيئة الإلهية. والمُستخلف عن حق هو المجهّز تكوينًا لمثل هذه المحاكاة والانتساب إلى الله، والذي تحضر فيه الأسماء كأسرارٍ للحضور الإلهي الفاعل في كل شؤون الوجود، بحيث يكون الوجود كله ساحة التشؤونات الإلهية.
ثم إنه فضلًا عن كل ما مر، فإن الملائكة يعجزون عن الإفصاح والتدليل على أسرار الله في الوجود والحياة. وهو الأمر المتوفر بغنًى في قدرة الإنسان ومؤهلاته؛ إذ لما سألهم ربهم أن ينبئوه بالأسماء قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَ مَا عَلَّمْتَنَا﴾[33]، وأثبت بذلك قدرته على نقل الكلام الإلهي إلى الوجود، وعلى تصوير مفاد ومقاصد الكلام الإلهي إلى أذهان وأفئدة المتلقين حسب استعداداتهم. واللغة كما أنها حركة توسط الفكر بين الأنا والعالم. هي حركة التعبير عن تفاعل الذات مع الحضور الإلهي فيها وفي العالم، بالتالي فإنها حافظة مراسيل الهداية والنور الإلهي إلى الوجود. لتعبّر عن إرادة الرحمة الإلهية في صياغة شريعة الإنسان بالحياة على وفق الهدى الإلهي.
بناءً عليه، فإن الدين القيّم هو “فطرة الله التي فطر الناس عليها”، والتي تمثل سنة الاتجاه الإنساني نحو الله ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾[34].
وهذا يعني أن الدين القيِّم هو جعل إلهي فطري في طبيعة كل إنسان، ذلك أن الآية لا تنشيء حكمًا، بل هي تحكي واقعة موضوعية قائمة بالذات الإنسانية… فأصل كل دين هو ذاك الجعل الفطري للدين في ذات كل إنسان حتى ولو غفل الناس عن تلك الحقيقة. فإنهم متوحِّدون مع قيمهم الوجودية الفطرية النزّاعة نحو الله. وما الاستخلاف الإلهي إلا تعبير عن طبيعة الوجود الإنساني الذي يقوم على أركان هي: الإنسان نفسه، وثانيها علاقة الإنسان الفرد بالعالم وبالإنسان العام، وثالثها الأرض التي تجمع كل إنسان بإنسان آخر. وإذا كانت كل الجماعات تتوافق فيما بينها بطبيعة الإنسان وبالتواجد في الأرض، فإن الاختلاف إنما يحصل على حسب طبيعة التمايزات الواقعة في العلاقة بين الإنسان كإنسان، وبين الأرض وأهل الأرض. حتى إذا ما دخل العنصر الرابع في العلاقة وهو المتمثل بالعلاقة بين هذه الأركان الثلاث، وبين الله عن وعي وإرادة وحرية اختيار نتجت صيغة الاستخلاف الإلهي، مما يعني أن الإرادة وحرية الاختيار عند الإنسان هي شرط الاستخلاف وأداء الأمانة؛ حسب القرآن الكريم، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ﴾[35]، فدائرة صياغة المجتمع والتاريخ الإنساني يقوم على عرض إلهي تكويني غير حتمي بالمعنى الجبري للكلمة؛ بل هو حتمي بالمعنى الاقتضائي لمسار التكوّن الوجودي عند الإنسان وهو المسمى بالجعل الإلهي. ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ﴾[36]. كما ويقوم على نوعية التقبل الإيماني لذاك العرض ﴿وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ﴾[37] وأي إنسان؟ إنه الذي قال عنه الله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾[38]… فقد يتمرّد الإنسان على هذا العرض الجعلي الفطري بالظلم والجهل لكنه سيكون بذلك سببًا لإفساد صيغ الحياة الممهورة بالعلاقة مع الحضور الإلهي، فمن الناس ﴿مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾[39].
أما إن كان ممن تناغمت حقيقة سره وإرادته مع حقيقة جعله الفطري الاستخلافي فهو الذي ينعكس فيه التصالح مع الله والدين القيّم بنشر الصلاح والنور والعدالة ووفرة الخير ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[40]. ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لاَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً﴾[41]…
فبناء العلاقة المجتمعية لا تقوم على أساس التفكير الجبري والاستسلامي، بل هي قائمة على جهد التصالح بين الوعي والإرادة الإنسانية على مصدر جعلها التكويني ومآلها المصيري الحياتي المتمثل بالحضور الإلهي بالذات الفردية عبر تغيير مسار الغفلة والانطوائية للانفتاح على نور المحبة الشاملة لكل وجود ومعتقد وموجود، وعلى الحضور الإلهي بالذات الجمعية الصانعة لتحولات مسار التاريخ، وإعادة صياغة معنى الزمن وحركة الأحداث والتطلعات.
وهذا ما لا يتم بدون الكلمة كما لا يتم بالكلمة وحدها؛ إذ لا بدّ للكلمة الإلهية من فاعلية تتجسّد عند حاملها من الأنبياء والأوصياء وأهل الله من قادة الإيمان والصلاح. وهو ما تعبِّر عنه الأدبيات الإسلامية بمبدأ الولاية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾[42]، فبمحاكاة الرسول والذين آمنوا لله في تدبير شؤون الناس والحياة على مقتضى هدي الكلمة الرسالية تتم صياغة ظروف التاريخ المشرق بالأمل عبر الحضور الإلهي وهو المقصود بالوحي والعرفان. وحضور الكلام الإلهي، وهو المقصود بالرسالة والفقه الأكبر والأصغر، وهنا يكون دور الرسول والفقيه. والمعرفة بصروف الأحداث وضرورات الحياة، وهو المقصود بالولي الرسول، والولي الإمام، والولي الفقيه.
إذ بهم تتم مشيئة الله في الجعل الفطري للدين القيّم الساطع في مقاصد كل دين وحياني. والصانع لجسور الأمل بين أهل الأديان. بعيدًا عن تراكم الاختلاف التغايري الاحترابي. ويبحث عن سبل صراط الحب والرحمة الإلهية الشاملة.
[1] بول ريكور، الذات عينها كالآخر، ترجمة: جورج زيناتي، الصفحة 76.
[2] ولتر ستيس، التصوف والفلسفة، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، الصفحتان 60- 61.
[3] المصدر نفسه.
[4] ولتر ستيس، التصوف والفلسفة، مصدر سابق، الصفحة 113.
[5] راجع: ابن عربي، الفتوحات المكية، الصفحة 898، والمعجم الصوفي.
[6] نقلًا عن الزمان والسرد، لبول ريكور، الجزء1، الكتاب الجديد، الصفحة 39.
[7] المصدر نفسه، الصفحة 40.
[8] ك.غ، يونغ، الإله اليهودي، ترجمة: نهاد خياطة، اللاذقية، سوريا، دار الحوار، الطبعة 1، 1986، الصفحة 7.
[9] المصدر نفسه، الصفحة 9.
[10] الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، الجزء 12، الصفحة 391.
[11] ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، الجزء 1، الصفحة 144.
[12] محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، بيروت، دار الساقي، الصفحة 52.
[13] مسكويه، تهذيب الأخلاق، الصفحة 37.
[14] مسكويه، تهذيب الأخلاق، مصدر سابق، الصفحة 128.
[15] سورة الأحزاب، الآية 23.
[16] سورة الأحزاب، الآية 23.
[17] سورة الأنعام، الآية 1.
[18] سورة النحل، الآية 78.
[19] سورة النحل، الآية 72.
[20] سورة البقرة، الآية 22.
[21] سورة الزخرف، الآية 3
[22] سورة القصص، الآية 7.
[23] سورة الأنعام، الآية 57.
[24] سورة الحجر، الآية 91.
[25] الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن الكريم، دمشق، دار القلم، الصفحتان 196 – 197.
[26] سورة الأنعام، الآية 165.
[27] سورة ص، الآية 26.
[28] سورة البقرة، الآية 30.
[29] مرتضى مطهري، شرح المنظومة، الجزء2، الصفحة 228.
[30] سورة الأنعام، الآية 165.
[31] العلامة الطباطبائي، الميزان، بيروت، مؤسسة الأعلمي، الجزء 17، الصفحة 53.
[32] سورة البقرة، الآيات 30- 33.
[33] سورة البقرة، الآية 32.
[34] سورة الروم، الآية 30
[35] سورة الأحزاب، الآية 72.
[36] سورة الأحزاب، الآية 72.
[37] سورة الأحزاب، الآية 72.
[38] سورة البلد، الآية 10.
[39] سورة البقرة، الآيتان 204 – 205.
[40] سورة الأعراف، الآية 96.
[41] سورة الجن، الآية 16.
[42] سورة المائدة، الآية 55.
المقالات المرتبطة
الانتظار الثوري والشورى في ولاية الفقيه (1)
تهيأت للإمام الخميني (قده) كل عوامل التفوق العبقري على المستويات الروحية والعقلية والعرفانية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء…
“تساؤلات في المبنى العقيديّ والمنهج” عند الدكتور حسن حنفي
نحن أمام مشروع رؤيويّ، منهجيّ، ذي مادة غنيّة وغزيرة، يسعى لبناء نسق كلاميّ، عقائديّ، ثوريّ جديد، وذلك على أرض علم
منهجية سيد قطب في قراءة الإسلام
شكّل الإسلام السياسي منذ سقوط السلطنة العثمانية، وإلى يومنا هذا، الشغل الشاغل للمهتمين بالواقع السياسي للعالمين العربي والإسلامي…





